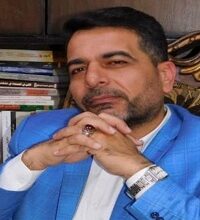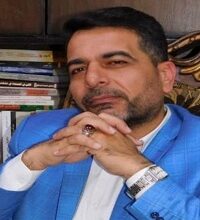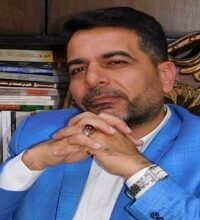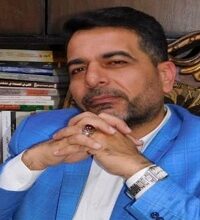مع التحوُّلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها المنطقةُ العربية حديثاً، غدت الثقافةُ العربية أمام مفترقاتِ طُرقٍ صعبة ومفصلية وشديدة الوعورة، ذلك أنّ الشعبَ العربيَّ أصبح أمام تداعيات سلبية من شأنها أن تُؤثِّرَ في الهوية الثقافية العربية الوطنية، وربما تُؤدّي إلى انسلاخٍ تدريجيٍّ عنها، ولا سيما مع حالة التشبُّه، بل التماهي والتباهي، بالثقافات الوافدة التي من شأنها أن تُؤدّي إلى خلق وضعٍ غيرِ متوازن في الانتماء ومعرفة الذات.
وقد بدا هذا جليّاً في ارتماء فئة غير قليلة من أبناء الأمة ومثقفيها في أحضان الثقافات الأجنبية (الاستعمارية)، مع الإساءة المنهجية الكبيرة إليها وإلى أهلها، والاستخفاف بثقافة أمتها القومية وتراثها الحضاريّ، وهذا لا يعني انعدامَ وجود مثقفين وطنيين حاوَلُوا، ولا يزالونَ، إعادةَ الاعتبار إلى الموضوعات الثقافية الوطنية الأصيلة، ووقفُوا في وجه المُخطَّطات التي تستهدفُ أمّتَهم، وتعملُ على تزييف وعي شعوبهم وتشويه تراث أمّتهم وثقافتها، إلّا أنّ ما ينبغي العمل عليه هو خلقُ استراتيجية منهجية مشتركة بين المعنيين جميعاً، استراتيجية يكونُ أساسها العمل على تقدُّم الوعي القوميّ لدى المثقف العربي، بحيث يستطيعُ أن يتجاوزَ مرحلةَ الصُّراخ، وأن يُحيلَ الشكوى إلى نداءٍ وعمل حقيقيّ، وأن يُصبحَ النداءُ في مرحلةٍ ثانية شعاراً، وهذا يعني أنّ المُثقّفَ بدأ بتوضيح المعلومات وتبصير الناشئة بحقيقة ما تتعرّض له من تهديدات تحاولُ اقتلاعَها من جذورها، وهذا لا يُمكنُ أن يتحقّقَ إلّا عَبْرَ تعميق الأدب والثقافة الوطنية وتجذير حضورهما ثقافياً وتربوياً وإعلامياً، وهذا يحتاجُ إلى وعي كبير من المُثقّف وبَذْل الجهود كلّها لأجل التخلُّص من التوتر الذي طالما قادَ بعضَهُم إلى التفريغ الانفعاليّ، ولا سيّما أنّ التوتُّرَ يقودُنا إلى مواقعَ حماسيّة آنيّة تُنمّي في أنفُسِنا حساسيةً مفرطةً شديدةَ التأذّي، سريعةَ الانجراح، منطوية على نفسها، وهو انطواءٌ يذهبُ بصاحبه إلى الانكفاء، ويجعلُ مرحلةَ القلق مُسيطرةً على هذا المثقف.
إنّ الثقافةَ العربية تمتلكُ من الأسس والمُقوّمات الحضارية ما يجعلُها أعمقَ أثراً من أن تُجنَّبَ أو تُزاحَ إلى الحدِّ الذي تفقدُ فيه طاقتَها وفاعليتَها كُلّها، لأنها راسخةُ البنيان ومُستمرّةٌ ومُتمدّدةٌ في الزمان والمكان.
وأوّلُ هذه العناصر أنّ المنطقةَ العربية هي مهدُ الحضارات الإنسانية، إذ إنّ الفرعونيةَ والبابلية والآشورية تُعَدُّ من أقدم الحضارات، كما أنّ هذه المنطقةَ مهبطُ الأديان السماوية: اليهودية والمسيحية والإسلام. وهذان العُنصُران انصهرا مع عناصرَ أُخرى في عمليةِ إنتاجِ التاريخ الاجتماعيّ للعالم العربيّ، ولا يُمكنُ فهمُهُ إلّا في حضورهما، وجاءت اللغةُ العربية من خلال قوتها الذاتية لتُعزّزَ عناصرَ التوحُّد الثقافي العربي، وتجعلَهُ أكثرَ تماسُكاً وقوّة. صحيحٌ أنّ بعضَهُم يرى أنّ الثقافةَ العربية عنصرٌ كثيرُ التعدُّد، شديدُ الاختلاف، إلا أنّها في الوقت نفسِه غزيرةُ التنوُّع، راسخةُ الحضور، قويّةُ البُنيان، وعلى أساسها تتمايَزُ المجتمعاتُ، وتختلفُ الجماعاتُ تمايُزاً واختلافاً مكّنا علماءَ الإناسة من استنباط الوسائل النظرية التي أتاحت لهم دراسةَ الخصائص الاثنية التي تُميّزُ البشرَ في صنوف اجتماعهم وطرائق معاشهم، إذ يتّسعُ لنا أن نتَبيّنَ إلى أي حدٍّ يُمكنُ للثقافيِّ أن يكونَ ثريّاً في تَعدُّدِه، وعبقريّاً في تنوُّعِه، كما أنّ الثقافةَ انعكاسٌ للمستوى الحضاريّ لأيّ أمة أو بلد أو جماعة، وهي حصيلةُ فهم الإنسان لتُراثِه ودينه أيّاً كان، وهذا لا يتحقّقُ إلّا عَبْرَ تواصُل الجيل القديم مع الجيل الجديد، وحرصه على تنمية مواهبه وتطوير ثقافته والارتقاء بها، ولا سيّما في مرحلة الحداثة وما بعدَ الحداثة، وفي ظلِّ عزوف المجتمع عن الألوان الثقافية، وهو ما يجبُ أن يحظى برعاية المُؤسّسات الثقافية الرسمية في الدول العربية كلّها، لتحقيق دعمٍ للأنشطة والفعاليات الثقافية، والعمل على تنشيط الوزارات المعنيّة: إعلام، ثقافة، تربية، تعليم، أوقاف، وغيرها… وهذا لا يمكن أن يحدثَ إلّا بعدَ إدراكٍ عميق لأهمية هذا العنصر الناعم الذي يُضاهي في قُوّتِهِ وجماله كلَّ شيء.
لقد آنَ الأوانُ لتغيير واقع التعاطي مع الثقافة على أنها عنصرٌ هامشيّ، دونَ إدراك أبعاد العامل الثقافيّ ودوره في صناعة التحوُّلات، ورسم الحدود الجيوسياسية، ذلك أنّ رَسْمَ المسار الثقافيّ الحضاريّ القائم على الوعي والأصالة، من شأنه أن يُسهِمَ في إعلاء قيم الخير والفنّ والجمال، وأنْ يضعَ حدّاً لتغوُّل الصراعات السياسية والعسكرية وما تَجُرُّهُ من كوارثَ وسلبيّاتٍ على المشهد الثقافيّ.
إنَّ مدَّ جسور التبادُل الثقافيّ وتدعيمها بين الدول العربية، هو وحدَهُ الكفيلُ بإزالة الحواجز النفسية التي خلّفَتْها السياسةُ والحروب، كما أنّهُ وحدَهُ القادر على تبديد وحشة المعارك الإعلاميّة التي أُريدَ لها أن تُشتِّتَ الأمّةَ، وتُدمِّرَ بُنيانَها الحضاريّ والمعرفيّ.
من جهةٍ أُخرى فإنّ حالةَ الضعف التي تعيشُها الثقافةُ العربية تعودُ في بعض أسبابها إلى نرجسيّةِ المُثقّف وجُمودِه، كما أنّ حالةَ التبعية للسياسيّ وقبول بعض المثقفين بانتعال بعض الساسة لهم، يُشكّلُ أحدَ أهمِّ أسباب ضعف الثقافة وقصورها، فضلاً عن مجاراة بعض المثقفين لبعض رجال الدين على الخطأ قبلَ الصواب، وانطلاقاً منه، لا بُدَّ من تكثيف الجهود مُستقبلاً لتقوية الجانب الدنيويّ للثقافة العربية ومعالجة القضايا الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية التي يتخبّطُ فيها الوطنُ العربيّ، حسبَ رؤيةِ المُفكّر والاقتصاديّ اللبناني جورج قرم، من دون أن يتمكّنَ من الخروج من التخلُّف الاقتصاديّ والمعرفيّ، مع إشارة خاصة إلى هجرة الأدمغة العربية إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وهو ما من شأنه أن يُعمّقَ من مستوى التخلُّف العربي مقارنةً بما تُنجِزُهُ من إنجازات علمية وتكنولوجية حضاراتٌ أُخرى مثل الحضارة الصينية وحضارة دُوَل شرق آسيويّة أُخرى.
والجديرُ بالذكر هنا أنّ المجتمعاتِ العربيةَ كانت أكثرَ تقدُّماً من الناحية الاقتصادية من اقتصادات شرق آسيا في بداية الخمسينيات، وهذه ظاهرةٌ يجبُ أن تُثيرَ الاهتمام لفهم الأخطاء التي حدثتْ في بلداننا العربية، وتوطيد اتجاهات اقتصادية واجتماعية جديدة تُخرِجُنا من التخبُّط في التخلُّف عن ركب الحداثة بأوجهها كلّها، وهي رؤيةٌ تتقاطعُ، إلى حدٍّ كبير، مع ما يراهُ المُفكّرُ والباحثُ المغربيّ عبد الله العروي، ولا سيّما تأكيده قصور التحليل الاقتصاديّ في فهم الواقع العربيّ، مُتّجهاً بالبحث إلى العوامل الأيديولوجية والثقافية الكامنة وراء إخفاق الحركة التحريريّة العربية التي كان في وسعها أن تصمدَ لو أنها أنجزت الحلقةَ الغائبةَ في مشروعها: الثورة الثقافية.
ومن هنا لا بُدّ من استيعاب مُعطَيات المرحلة الليبرالية وتوطينها، والإقلاع عن نقد التُّراث الليبراليّ، لأن الليبراليةَ حاجةٌ طبيعيةٌ في الفكر العربيّ وضرورةٌ تاريخيةٌ للمجتمع والسياسة والثقافة، والانصراف بدلاً من ذلك إلى النقد بوصفه استراتيجيةً معرفيّة.
بقيَ أن نقول: إنّ حالةَ المراوحة في المكان منذُ قُرونٍ في عالمنا العربيّ، وإخفاقه في عمليات التحوُّل الحضاريّ المطلوبة لإصلاح الحاضر، والاستعداد للمستقبل، إنّ هذا الإخفاق يعودُ على نحوٍ أساسيّ إلى أسباب كثيرة، من أهمّها حالة (النوستالجيا) الفكريّة التي أُصِيبَتْ بها فئةٌ من مثقفينا ومبدعينا، ويجبُ علينا جميعاً أن نُسهِمَ في التخلُّص من استبداد هذه الحالة، لأنّ التخلُّصَ منها خطوةٌ لا بُدّ منها للوصول إلى التواصل الثقافيّ بينَ أبناء الأمة في أمصارها كافة، وهي مرحلةٌ متقدمة عن التعددية كما يقولُ عالمُ الاجتماع علي راتانسي، وهو ما أكّدَهُ اجتماعُ الأمانة العامة للاتحاد العامّ للأدباء والكُتّاب العرب الذي استضافَهُ اتّحادُ الكُتّاب العرب في سورية تحت عنوان: “أدباء من أجل العروبة”، فقد أكّدت اللقاءاتُ والندواتُ والفعاليات الشعرية التي أُقيمَتْ في أثناء الاجتماع، أنّ ما يربطُ بينَ أبناء الأمة ومثقفيها أكبرُ بكثير ممّا يُفرّقهم، كما أنّ الانتماءَ والأصالة والوطنية هي السمةُ الغالبة على كتاباتهم ومنجزهم الإبداعيّ في الأجناس الأدبية المختلفة، لكنَّ المشكلة تكمنُ في التواصل بين أبناء الأمة في مختلف الأمصار العربية، وكذلك في سُوء تخصيصِ الحكوماتِ العربيةِ شيئاً من الدعم للقاءاتٍ وفعالياتٍ كهذه، فمن غير المنطقيّ أن يتسابقَ بعضُ المسؤولين في هذه الدولة أو تلك إلى دَفْعِ ثمنِ بطاقةِ طائرة وإلى التَّكفُّل بنفقات إقامة هذا الفنّان أو تلك المُغنّية فضلاً عن المبالغ المالية الطائلة التي تُغدَق عليه في هذه الدولة أو تلك، في الوقت الذي لا يجدُ فيه المثقفُ أو المُفكّرُ من يدفعُ له ثمنَ بطاقة الطائرة لحضور هذا المؤتمر أو تلك الندوة.
لقد آنَ الأوانُ لإعادة الاعتبار إلى الثقافة والفكر، لأنَّ الأُمّةَ القويّةَ هي الأمّةُ التي تُحسنُ بناءَ ثقافتها وتربيتها، وتحترمُ قادةَ الفكر والرأي والتربية فيها.
بوابة الشرق الأوسط الجديدة