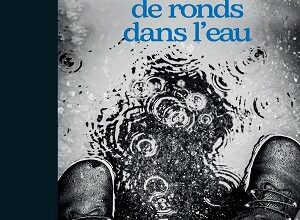جوهر أزمة الحكم في “إسرائيل” والسيناريوهات المتوقعة

ما تزال الانشقاقات والتركيبات الجديدة للأحزاب الإسرائيلية، وكذلك الصراعات الداخلية، إحدى ميزات الخارطة السياسية في “إسرائيل”، ومؤشراً واضحاً على عدم استقرار الحكومات والحكم على حدّ سواء.
منذ 3 عقود تقريباً، تعاني “إسرائيل” من أزمات حكومية وصراعات داخلية اجتماعية وسياسية، نتجت منها بالمجمل أحزاب قطاعية اجتماعية، وأهمها الحريديم، شرقيون وغربيون، وأحزاب المهاجرين الروس وما بقي منهم “يسرائيل بيتينو”، بزعامة أفيغدور ليبرمان، وأخرى للمستوطنين في المناطق المحتلة العام 67، بزعامة نفتالي بينيت، وآخرين، وابتعاد المصوتين العرب عن الأحزاب الصهيونية، أو ربما ترك الأحزاب الصهيونية مُصوّتيها العرب ليقيموا أحزاباً عربية لهم، ومن ثم تحالف العرب في قائمة مشتركة.
إضافةً إلى ذلك، شهدت الأحزاب الصهيونية صراعات داخلية، عنوانها المناصب والمنافع وقدرة هذا المرشح أو ذاك على اجتذاب فئة اجتماعية ما. برز ذلك أكثر ما يمكن داخل حزب “العمل”، وفي الانشقاقات داخل الأحزاب على أساس عرقي وسياسي، وتكوين أحزاب جديدة، وما تزال هذه الانشقاقات والتركيبات الجديدة للأحزاب، وكذلك الصراعات الداخلية، إحدى ميزات الخارطة السياسية في “إسرائيل”، ومؤشراً واضحاً على عدم استقرار الحكومات والحكم على حدّ سواء.
ولكن الأزمة التي تعصف بحكومات نتنياهو في السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى 3 جولات انتخابية خلال سنة واحدة 2019/2020، يمكن اعتبارها مختلفة عن سابقاتها من أزمات بأنها كشفت عن جوهر الأزمة المستمرة، وعمق مجمل الأزمات السابقة، وطبيعة الأزمة المستمرة، باعتبارها أزمة حُكم، وليست حكومية، والمقصود بـ”الحُكم” هو القدرة على إدارة شؤون الدولة، وشكل النظام المطلوب لذلك.
من هي القوى المتصارعة على الحُكم؟
ثمة فريقان أساسيان يتصارعان على الحكم، وهما اليمين العلماني المتطرف المتحالف مع اليمين الديني (الحريديم)، والمستوطنون، وهم يمثّلون في الغالب التيار الصهيوني المتدين، وجميعهم يريدون الاستفراد بالحكم وتغيير طابعه الديموقراطي، مقابل اليمين العلماني الليبرالي المتحالف مع المتدينين الإصلاحيين، والذين يريدون استعادة الحكم الذي فقدوه.
من زاوية أخرى، يمكن أن نرى الصراع بين “إسرائيل” الأولى، المتمثلة بالقوى الغربية وأحزابها التي أقامت الدولة ومؤسساتها الديموقراطية (حتى وإن كانت ديموقراطية إثنية وعنصرية في نظرنا)، والتي تعتمد على هذه المؤسَّسات في اتخاذ قراراتها السياسيّة، وخصوصاً الاستراتيجية، و”إسرائيل” الثانية التي وصلت إلى الحكم بعد الانقلاب السياسي في العام 1978، وهي مدعومة من غالبية اليهود الشرقيين، وغالبية اليهود من التيار الصهيوني المتدين (من المستوطنين)، وهم في أصولهم حزب “مفدال” الذي ترأسه يوسف بورغ لفترة طويلة، وكان حليفاً أساسياً لحزب “العمل” حتى حصول الانقلاب السياسي المذكور، يُضاف إليهم الحريديم الَّذين شكلوا حزبين؛ الأول لليهود الشرقيين والآخر للغربيين، بعد الانقلاب المذكور، وتحالفوا مع الحزب الحاكم لمصلحة جمهورهم الخاص، وفق معايير المصلحة المادية والدينية فقط.
من زاوية ثالثة، يمكن رؤية الصراع بين ثقافتين، الأولى “تقدّس” مؤسسات الدولة، والأخرى “تقدس” الشخص القائد، دينياً كان أو علمانياً، وتسير خلفه ما دام يؤمن لها شعوراً بالقوة والسيطرة بعد تاريخ طويل من الضعف والمهانة.
كيف تتمظهر أزمة الحكم أو النظام؟
لا تتمثل أزمة الحكم في عدم قدرة الحكومة على إدارة شؤونها فحسب، بل بتضارب صلاحياتها أيضاً، بصفتها سلطة تنفيذية، مع صلاحيات السلطة القضائية والتشريعية، وبالتالي عدم القدرة على تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تطمح إليها، وأكثر ما تظهر في عدم القدرة على تشكيل حكومة قادرة ومستقرة.
تكشفت الأزمة الحكومية الحالية في “إسرائيل” عن مستوى متقدم وعميق في أزمة الحكم، وهي أزمة ملازمة لـ”إسرائيل” منذ بداية القرن على الأقل، وهناك من يتحدَّث عنها منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، أي مع اصطدامها باستحقاقات التسوية السياسية البعيدة المدى.
ليس صدفة أن اليمين، وخصوصاً نتنياهو، هو أكثر من تحدث خلال السنوات الماضية عن أزمة “الحكم”، وتحدث أيضاً عن “العظمة” الإسرائيلية، وجعل من “الأنا” مقدّمة لكل إنجاز، لأنه كان، وما يزال، يؤمن عقائدياً بالعلاقة بين القدرة على الحكم و”الأنا” الذاتية والعظمة والقوة والتحكم بالحاضر والمستقبل، نافياً دور المؤسَّسات في قيادة الدولة.
أما العوامل التي تعوّق القدرة على الحكم، كما كشفتها الأزمة الحالية، فتتمثل في جوهرها بالصراع بين القيم الديموقراطية من جهة، والرغبة في تحقيق القدرة على الحكم بأساليب غير ديموقراطية من جهة ثانية، وتتمظهر بما يلي:
– الصراع الديني العلماني الذي ينفجر عند تشكيل كل حكومة أو إجراء انتخابات، ولو كانت انتخابات بلدية. تحالف اليمين الديني (ديني صهيوني وحريديم غير صهاينة) مع اليمين العلماني المتطرف، مقابل تحالف القوى العلمانية الليبرالية/ الديموقراطية مع المتدينين الإصلاحيين.
– الصراع للسيطرة على وزارة الداخلية لصالح المتدينين الحريديم، والمسّ بحقوق الفرد العلماني وغير اليهودي.
– محاولات السيطرة على القضاء، بادّعاء تدخّل جهاز القضاء في التشريعات غير الديموقراطية بالانقلاب على نهج رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي أهرون براك، الذي قضى بعدم التمسّك بحرفية النصّ القانوني، وتغليب القيم المعاصرة على التشريع البرلماني وتفسيره، والتدخل الفاعل للمستشارين القضائيين في الوزارات وفي هيئات حكومية مختلفة، الأمر الذي يعتبره نتنياهو وحلفاؤه تدخلاً للسلطة القضائية في صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية، ويرونه مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
– محاولات التيار الصهيوني المتديّن للسيطرة على الجيش من الداخل، وتصدي العلمانيين الليبراليين لذلك، وهو أمر يحتاج إلى شرح مطول ومقالة خاصَّة.
– الفساد الذي يهدد الديموقراطية، ويهدد الأمن القومي على المستويين القريب والبعيد، وهو فساد منتشر على كل المستويات، ولكنَّ الأخطر هو وصوله إلى دائرة الأمن المغلقة، وما قضيَّة صفقة الغواصات سوى نموذج واحد لذلك.
– قدرة رئيس الحكومة على إدارة حكومته، وخصوصاً في ظل لوائح الاتهام الخطيرة الموجهة إليه، وتأثير ذلك في الأمن القومي، ومطلبه بتشريعات تعطيه صلاحيات إضافية، بحسب نتنياهو. مثلاً، أن يعين وزراء من دون العودة إلى الكنيست للمصادقة على ذلك (تعيين نفتالي بينيت مثلاً)، أو الصلاحية بشن عملية عسكرية يمكن أن تؤدي إلى حرب من دون الرجوع إلى الكابينيت، أو آلية اتخاذ قرارات أمنية بواسطة الهاتف من دون اجتماع المعنيين.
جوهر الصراع بين المعسكرين
للبحث في جوهر الأزمة وكيفية الخروج منها، كلٌّ من طرفه، لا بد من أن نرى: ما هو المشترك بين المعسكرين؟ ما هو الفارق بينهما؟
يتّفق الطرفان على أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لحسم الصراع على طريقة الحكم، ويتفقان أيضاً على تحييد النواب العرب (بتفاوت) من إمكانية حسم تشكيل حكومة، وبالتالي من المشاركة في الحكم، ويتفقان على معاداة حق الشعب الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وعلى ضرورة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وأهمها المستوطنات، إضافة إلى القدس الكبرى، إلى السيادة الإسرائيلية. كما يتفق الطرفان على الأهمية القصوى لتأمين الهيمنة الإسرائيلية المستدامة في الشرق الأوسط ضماناً لبقاء “إسرائيل”.
الخلافات:
– طريقة الحكم بين تعزيز حكم الفرد على حساب المؤسَّسة أو تعزيز حكم المؤسسات وفق المبادئ الديموقراطية.
– هل يسمح للسلطة القضائية العليا بأن تتدخَّل في نتائج عملية التشريع؟
– الموقف من الفساد والفاسدين وإمكانية قيادتهم للدولة إذا ما قدمت ضدهم لوائح اتهام، مع العلم أنّ القانون لا يسمح لوزير بأن يشغل منصبه في حال قُدّمت ضده لائحة اتهام، ولكنه لا يمنع ذلك عن رئيس الحكومة.
– الموقف من محاولات سيطرة القوى الصهيونية الدينية على الجيش.
– مشاركة قوى اليمين الفاشي المُعلن في الحكومة أو عدمها.
– محاولات القوى الدينية المتزمتة (الحريديم) للسيطرة على وزارة الداخلية والمساس بحرية الفرد.
– محاولات المدارس والكليات الدينية المتزمتة (الحريديم) الاستفادة من الأموال الحكومية على حساب دافعي الضرائب أو لا.
– الاختلاف على ضم الأغوار أولاً، كما يريد نتنياهو، أو المنطقة “سي” غرب الجدار الفاصل أولاً، كما يريد غانتس وأشكنازي ويائير لبيد ويعلون.
إذاً، جوهر الخلاف والصراع بين المعسكرين يتمحور في القضايا الداخلية على طبيعة الحكم في الحاضر والمستقبل، ومنه تتفرع كل النقاط الخلافية التي ذكرت أعلاه، وليس على القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية.
التعامل مع أزمة الحكم بين الماضي والحاضر
من إفرازات أزمة الحكم، ارتفاع منسوب السياسة العنصرية، ومنها شرعية الصوت العربي في الكنيست، هل أصوات النواب العرب هي أصوات شرعية في حسم قضايا خلافية في الدولة، وخصوصاً قضايا مصيرية؟ كان هذا السؤال، وما يزال، على الطاولة من جديد، ولكنه غاب ويغيب في ظل موازين القوى التي يغلب فيها أحد الطرفين الصهيونيين بشكل واضح، ويعود ليطفو على السطح عند التوازن بينهما. وعليه، كان المخرج من تلك الأزمة مختلفاً باختلاف الظروف السياسية والقوى الحاكمة أيضاً.
ففي العام 1992، طلب رابين، ولأول مرة، دعم النواب العرب لحكومته (دعماً من خارج الحكومة) لمنع إسقاطها، وللحصول على موافقة برلمانية لاتفاق أوسلو. وفي العام 1994، سنَّ الكنيست، بدعم من حكومة رابين، قانون “حرية الإنسان وكرامته”، الذي أعطى للقوى العلمانية الليبرالية، وكذلك المواطنين العرب، مجالاً أوسع لتحقيق مكاسب مدنية على مستوى الحقوق المدنية الفردية.
لكن اغتيال رابين أوقف هذه المسيرة، كما تراجعت عملية التسوية السلمية بين تمنّع إسرائيلي عن تطبيق الاتفاقية بعد أن استلم نتنياهو رئاسة الحكومة في العام 1996، واندلاع الانتفاضة الثانية في ظلّ حكومة إيهود باراك 1999-2001، وصراعات إسرائيلية داخلية، وانشقاق شارون وأولمرت وليفني من حزب “الليكود” مع شمعون بيرس وآخرين من حزب “العمل”، وإقامة حزب جديد “كاديما”، وفوز شارون برئاسة الحكومة في العام 2001 والعام 2003، وبعده أولمرت، وريثاً لشارون الذي أقعده المرض، من دون انتخاب، حتى فشلت تلك المسيرة، وعاد اليمين المتطرف، برئاسة نتنياهو، إلى الحكم منذ العام 2009 حتى اليوم.
في العام 1992 أيضاً، أقرَّ الكنيست قانون انتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر، باعتباره تجسيداً لبرنامج إصلاحي في نظام الحكم، لكن مقتل رابين واستعادة اليمين المتطرف الحكم أخاف معسكر حزب “العمل” من إمكانية استغلال اليمين المتطرف للصلاحيات الإضافية المعطاة لرئيس الحكومة، فألغي القانون في العام 2003، وعاد الكنيست لانتخاب رئيس الحكومة، كما كان سابقاً.
لتعزيز قوة الحكومة، رُفعت نسبة الحسم لانتخابات الكنيست، ما أدى إلى اتّحاد أحزاب في كتل برلمانية مشتركة، ومنها الأحزاب العربية، لضمان الوصول إلى الكنيست، وبعضها يطمح إلى المشاركة في الحكم أيضاً.
مع عودة اليمين المتطرف إلى الحكم، برئاسة نتنياهو، دأبت حكومته على سنّ قوانين مناقضة للمشروع الإصلاحي الذي انطلق في بداية التسعينيات من القرن الماضي وتوقف مع اغتيال رابين. ومن هذه القوانين قانون القومية، بصفته قانونَ أساسٍ موازياً ومعارضاً لقانون حرية الإنسان وكرامته. أحد (وليس كل) أهداف هذا القانون هو استبعاد النواب العرب من الحسم في القضايا المصيرية، باعتبار أن القضايا المصيرية تخص المواطنين اليهود فقط. كل هذا لم يحل الأزمة، بل فاقمها، لأن التزام المعسكر الآخر بهذا القانون، ضمن حدود الإجماع الصهيوني، يجعله عاجزاً كلياً عن العودة إلى الحكم.
قد يبدو أنَّ مصلحة النواب العرب تتطلّب أن يكونوا مع العلمانيين الليبراليين، بسبب وجود متنفس للحقوق المدنية، ولكن هذا الليبرالي العلماني هو يميني وعنصري يحرمهم من المساواة القومية، فهل يدفع العرب بحقوقهم القومية الجمعية مقابل اكتساب حقوق مدنية فردية في ظل حكومة يمينية ليبرالية وعلمانية؟ وهل يريدهم هذا المعسكر معه، ولو بصفة داعمين من خارج الحكومة؟!
هذا موضوع خلاف داخل القائمة المشتركة نفسها. وقد أثبتت رئاسة المعسكر الليبرالي أنهم يفضلون التصالح مع نتنياهو وتشكيل حكومة إجماع صهيوني على أن يشكلوا حكومة برئاستهم بمشاركة النواب العرب، أو حتى مدعومة منهم من الخارج، كما فعل رابين.
ما هي السيناريوهات القادمة؟
في ظل موازين القوى الحزبية الناتجة عن الانتخابات الأخيرة، تراجع نتنياهو عن مطلبه الأساس بتشكيل “حكومة يمين قوية” قادرة على إجراء تغييرات أساسية في نظام الحكم، وكان هذا هو هدفه عشية انتخابات نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2019 وآذار/مارس 2020 وفشل في ذلك. وقد قبِل بحكومة إجماع صهيوني واسعة تضمّ كلّ القوى اليمينية والدينية المتطرفة، إضافةً إلى حزب “أزرق أبيض”، الذي قاد المعسكر الآخر، ولكن برئاسة نتنياهو أولاً.
في المقابل، تراجع معسكر غانتس عن هدفه الأساس في تشكيل حكومة بديلة لحكومة الليكود برئاسة نتنياهو، واستبعد إنشاء حكومة أقلية تعتمد على دعم النواب العرب، وقبل بحكومة “طوارئ وطنية ضد كورونا”، أي حكومة إجماع صهيوني برئاسة نتنياهو، على أن يكون غانتس رئيس حكومة بديلاً لنتنياهو بعد انتهاء نصف المدة.
في الممارسة، تراجع نتنياهو عن تنفيذ خطة الضم مؤقتاً، وكان أحد أسباب ذلك، وليس السبب الوحيد أو الأساس، هو عدم التوافق الداخلي بين نتنياهو وغانتس في أولوية الضم وتداعياته على السلام مع الأردن وإمكانية نشوب انتفاضة ثالثة، حتى جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة الصراع بين المعسكرين داخل الحكومة الواحدة، لتعطي دعماً جديداً لنتنياهو، ليس فقط ضد الفريق الآخر داخل الحكومة، بل ضد المعارضة البرلمانية المتصاعدة ميدانياً أيضاً، ليحقق نتنياهو إنجازاً كان يحلم به حتى وقت قريب، وهو الوصول إلى عقد اتفاقيات سلام وتطبيع رسمي مع دول عربية وفق مبدأ “السلام مقابل السلام”، بعيداً من مبدأ “الأرض مقابل السلام”، أي من دون دفع ثمن هذا السلام والتطبيع بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.
رغم ذلك، تواصلت الأعمال الاحتجاجية للمعارضة في الشارع الإسرائيلي ضد الفساد الذي يلف نتنياهو وعائلته، وضد نهجه في القفز فوق المؤسَّسات، وتكريس القرار الفردي في الحكم، وفشله في معالجة الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا؛ هذه الأزمة التي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في “إسرائيل”، ومعاناة حوالى 800 ألف مواطن من البطالة والفقر، وخصوصاً في مركز البلاد.
وتميزت هذه الاحتجاجات بنزول متظاهرين من معسكر نتنياهو إلى الشارع، لمواجهة المحتجين بأساليب عنيفة، وتوجيهات وزير الأمن الداخلي لقيادة الشرطة باستخدام العنف ضد المحتجين “وتكسير رؤوسهم”، وهي ظاهرة جديدة في احتجاجات المعارضة الإسرائيلية، الأمر الذي يشير إلى أخطار حقيقية لو فقد اليمين المتطرف سلطته من خلال صناديق الاقتراع، وهو ما حصل في دول أخرى كحلقة عضوية في مسيرة وصول اليمين الفاشي إلى الحكم.
مع استمرار الأزمة جوهرياً، يبدو أن الأمور تتجه نحو انتخابات رابعة، في محاولة جديدة لحل الأزمة من خلال صناديق الاقتراع، ولكن الرأي العام الإسرائيلي لا يريد انتخابات رابعة في ظل جائحة كورونا، فقوى اليمين المتطرف المتحالف مع القوى الدينية لا يمكنها أن تحكم لوحدها باستقرار، بما يضمن قدرتها على تغييرات أساسية في نظام الحكم، والقوى العلمانية الليبرالية أيضاً ليست قادرة على أن تحكم وحدها من دون دعم من النواب العرب.
والأهم من ذلك أن اليمين الليبرالي لو استطاع أن يصل إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، في ظل حكم دونالد ترامب الداعم لليمين الفاشي في “إسرائيل”، فلا يوجد أي ضمانة بأنه قادر على الاستمرار في ذلك، لأن اليمين الفاشي لن يستسلم للهزيمة، وقد ينزل إلى الشارع وينقضّ على الحكم. وهذا السيناريو قائم أيضاً لو خسر اليمين الفاشي الحكم بفعل قرار المحكمة الإسرائيلية بإدانة نتنياهو ومنعه من ممارسة دوره في رئاسة الحكومة.
في ظل هذه الأزمة، وضمن كل السيناريوهات المتوقعة، تبقى الحقوق الوطنية الفلسطينية معلقة، ويخطئ من يعتقد أن غلبة هذا الطرف أو ذلك ستفتح باباً للانفراج السياسي، فأزمة الحكم في “إسرائيل” تتمحور حول قضايا داخلية، ويجتمع الطرفان المتصارعان في السياسة الخارجية إلى حدّ كبير في معاداة حقوق الشعب الفلسطيني. وما دامت لا توجد قوة فلسطينية قادرة على أن تفرض قضيتها على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، فلن توضع هذه القضية على الطاولة الإسرائيلية.
وعليه، ما على الفلسطينيين إلا أن يوحّدوا جهودهم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية من جانب واحد وطرد الاحتلال، من دون أي انتظار لحل أزمة الحكم في “إسرائيل” أو انتظار الفرج من تغيرات في الحكم في الولايات المتحدة، ولكل هدف أدواته المناسبة والتضحيات التي لا بدَّ من تقديمها.
الميادين نت