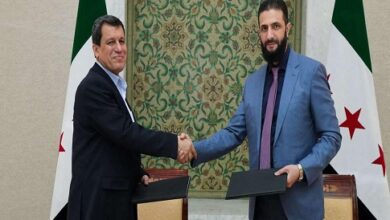حراكُ أيلول الفلسطينيّ وولادة الاحتجاج الاجتماعي
مقدّمة
شهدت مدن الضفّة الغربيّة احتجاجاتٍ عارمة وغير مسبوقة، اندلعت بسبب موجة جديدة من غلاء الأسعار مسّت جميع المواد الاستهلاكيّة، وخاصّةً الوقود. وفي ظرفِ أيّام قليلة، خرج آلاف الفلسطينيّين للاحتجاج في ميادين رام الله ونابلس والخليل وطولكرم وبيت لحم. وأغلق متظاهرون الشوارع بسيّاراتهم الخاصّة وبإشعال الإطارات، مردّدين شعارات تنادي بإسقاط رئيس حكومة الطوارئ في رام الله سلام فيّاض، وأخرى تطالب بإلغاء اتفاقيّة باريس الاقتصاديّة، بينما وُجِّهت الشّعارات ضدّ رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس.
يُعدّ هذا الحراك الاحتجاجيّ الأوّل من نوعه، فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، لم تشهد فلسطين احتجاجات مطلبيّة مهمّة. وعلى الرغم من أنّ الفترة التي أعقبت فوز حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" بانتخابات المجلس التشريعيّ عام 2006 شهدت بعض تظاهرات الموظّفين، إلا أنَّ ذلك الحراك كان مسيّسًا ومدفوعًا من حركة فتح التي استغلّته لرفض نتيجة الانتخابات التشريعيّة في حينه. فالفلسطينيّون لم يستوعبوا التظاهرات يومًا إلا سياسيّة، وهو الأمر الذي يجعل هذا الحراك مهمًّا، خاصّة في ظلِّ حقبة الربيع العربيّ وسقوط أنظمةٍ بثوراتٍ شعبيّة كانت الظروف الاجتماعيّة الاقتصاديّة من أهمّ محرّكاتها.
واندلع هذا الحراك في وقتٍ تواجه فيه حكومة الطّوارئ الفلسطينيّة برئاسة سلام فيّاض والسلطة الفلسطينيّة والحركة الوطنيّة الفلسطينيّة برمّتها أخطر التحدّيات منذ اتّفاق أوسلو. فالحركة الوطنيّة الفلسطينيّة منقسمة على ذاتها، والسلطة الفلسطينيّة وجميع الفصائل، بما فيها فتح وحماس، وصلت إلى طريقٍ مسدود في جميع المجالات. ولا تطرح أيّ منها رؤية، حتّى نظريّة، لكيفيّة الخروج من هذا الوضع. ولا تعرض أيّ منها إستراتيجيّة بخصوص القضيّة الوطنيّة عن كيفيّة إزالة الاحتلال والاستيطان، ولا عن كيفيّة معالجة الأزمة الاقتصاديّة الخانقة، وفي مقدّمتها انتشار الفقر والبطالة وغلاء المعيشة الذي لم تعد شرائح واسعة من المجتمع قادرة على تحمّله.
تحاول هذه الورقة تقديم قراءةٍ تحليليّة عن الحراك الشعبيّ في مدن الضفّة الغربيّة ودلالاته وتداعياته بعد أن تسبّب في ارتباكٍ على مستوى النخبة السياسيّة والثقافيّة؛ وتتناول أيضًا الظروف والعوامل التي سبّبت الأزمة، والسيناريوهات المحتملة في ظلِّ خصوصيّة الوضع الفلسطينيّ المُقيّد بالاحتلال.
خطاب السلطة بعد الانقسام الفلسطينيّ: سلام فيّاض بوصفهِ "معجزة اقتصاديّة"
يصعب في السياق الفلسطينيّ فصل السياسيّ عن الاقتصاديّ والاجتماعيِّ، فالسلطة الفلسطينيّة التي تحكم بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال الإسرائيليّ ما لا يزيد عن 18% من مساحة الضّفة الغربيّة البالغ إجماليّ مساحتها 5800 كم2، لا تسيطر لا على حدود ولا اقتصاد. كما أنّها لا تستطيع حتّى التحكّم في أسعار السلع الأساسيّة في السوق لارتباطها باتفاقيّة باريس الاقتصاديّة التي تقضي بأنَّ أيَّ ارتفاعٍ في أسعار السّلع في السوق الاقتصاديّة الإسرائيليّة لا بدَّ أن يصاحبه ارتفاع في السوق الفلسطينيّة حمايةً للمنتج الإسرائيليّ في ظلّ اختفاء الحدود بين السوقين في حينه. وتُنفَّذ هذه الشروط حتّى بعد أن جرى الفصل بين السوقين عمليًّا، وأصبح الاقتصاد الإسرائيليّ ممرًا إجباريًّا للاقتصاد الفلسطينيّ وقيّمًا عليه.
نشأت عن ذلك مفارقة كبيرة، إذ إنَّ المواطن الفلسطينيّ يشتري السلع الاستهلاكيّة بأسعار السوق الإسرائيليّ مع أنّ معدّل الدخل الشهري للعامل الإسرائيليّ يعادل أربعة أضعاف معدّل الدخل الشهريّ للعامل الفلسطينيّ في الضفّة الغربيّة. وسعر اللتر الواحد من البنزين – على سبيل المثال – في فلسطين المحتلّة يزيد عن دولارين، وهو الأكثر ارتفاعًا في العالم بعد النرويج وتركيا وإسرائيل على التوالي.
لقد صاحب تهلهلَ الوضع الفلسطينيّ الداخليّ، انسدادٌ على المستوى السياسيّ في مشروع المفاوضات الذي عوّلت عليه قيادة منظّمة التحرير الفلسطينيّة، إلى غاية الانتفاضة الثانية. وتمسّكت به القيادة الفلسطينيّة بشكل كاملٍ وحصريّ بعد عرفات. لذلك، تحوّل خطاب السلطة بعد الانتفاضة الثانية إلى التّنمية والخطط الحكوميّة خلف شعارات إنهاء البطالة وتشجيع الاستثمار. ومنذ عام 2007 أصبح الدكتور سلام فيّاض (الذي لم تفز قائمته بأكثر من مقعدين في الانتخابات التشريعيّة) – رئيس وزراء حكومة الطوارئ في رام الله- رمزًا لخطاب المعجزة الاقتصاديّة.
وأيشأطلق فيّاض منذ تبوّئه رئاسة الوزراء عددًا من الخطط والمشاريع الاستثماريّة، والتي روّجت لها وسائل الإعلام المحليّة بوصفها "مشروع مارشال" الذي سوف يؤسّس دولةً واقتصادًا قويًّا يفرض نفسه على المجتمع الدوليّ. فالخطّة بحسب فيّاض هي "البناء من أجل التعجيل في إنهاء الاحتلال، أو البناء على الرغم من الاحتلال لإنهاء الاحتلال، وكذلك إقامة بنية تحتية وبناء مؤسسات ومأسسة آليات الحكم والإدارة كافة"[1]. ولكنَّ محلّلين قد لاحظوا أنَّ جوهر الخطط عكست "بأمانةٍ كبيرة، أجندة السياسات الاقتصاديّة المُعلنة في عقيدة ما اصطلح على تسميته إجماع ما بعد واشنطن"[2]، والتي رضخت لها السلطة الفلسطينيّة ووجدت تطبيقها المباشر في سياسات الحكومة (الأمن العام، وبناء المؤسسات المضبوطة مركزيًّا، وتوفير الخدمات لكسب المشروعية، ونموّ القطاع الخاص)[3].
لقد حذّر عددٌ من الاقتصاديّين من أنَّ كلّ هذه الخطط سيكون بلا جدوى، فلا يمكن للسلطة الفلسطينيّة إنجاز أيّ تقدّم اقتصاديّ -على مستوى التنمية أو على مستوى معيشة المواطنين- وهي لا تملك أدنى المقوّمات؛ لا أرض ولا مياه ولا حدود، عدا عن ارتباطها باتفاقية باريس الاقتصاديّة التي تجعلها "ذيلًا" اقتصاديًّا لتل أبيب بكلِّ ما تعنيه الكلمة من معنى. لقد نصح الكثيرون بأنَّ القضية الفلسطينيّة ليست قضية اقتصاد بل هي قضية سياسيّة، وأنَّ تحييد السياسة والانشغال بالاقتصاد هو تأجيلٌ للأزمة وهروبٌ منها.
ومع ذلك فقد فتح خطاب حكومة رام الله شهية النّاس لوضعٍ معيشيٍّ أفضل داخل حدود الغيتوات، وأملوا في فرص عملٍ جديدةٍ للشباب. ومرّت سنوات من دون حصول شيءٍ سوى ارتفاع مستوى معيشة أوساط معيّنة من السكان. وازدياد ارتباط الاقتصاد الفلسطينيّ بأموال الدعم المشروطة سياسيّا. وحلّ الربيع العربيّ ورأى الفلسطينيّون الشعوب التي تحيط بهم تثور من أجلِ قضايا سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيَّة. وشهدوا أنظمةً تتهاوى وهم يراوحون أماكنهم بلا تقدّم، ثمَّ انكشف للنّاس أنَّ خطط "مارشال فلسطين" تتضمّن تطبيقًا لأوامر البنك الدوليّ لضمان استمرار التمويل الأجنبيّ، وأنّ هذه الأوامر تقضي بإجراءاتٍ تقشفيّة وخفضٍ للموازنة الحكوميّة ورفعٍ للضرائب، في بلدٍ متوسّط يُصنّف معدّل دخل الفرد فيه ضمن الدول الفقيرة، وتفوق أسعار سلعه الاستهلاكيّة الأسعار في بعض الدولِ الأوروبيّة.
ويأتي الحراك الشعبيّ لأيلول / سبتمبر 2012 بعد انقضاء مدّة السنتين التي حدّدها رئيس الحكومة سلام فياض "لبناء مؤسّسات الدولة وإثبات الجدارة" بما في هذه المقولة من سذاجة أو تساذج فلسطينيّ في مقابل تخابث غربيّ وخطاب استعماريّ، وكأن مشكلة الفلسطينيّين هي إثبات الجدارة "للحصول على دولة".
لقد أدّت السياسات الاقتصاديّة للسلطة الفلسطينيّة؛ ورضوخها لأجندات التمويل الأجنبيّ وشروط الاحتلال الإسرائيليّ الاقتصاديّة؛ إلى تعاظم الفجوة في الدخل ومستوى الحياة بين شريحة قليلة مكوّنة من رجال الأعمال وكبار التّجار وكبار الموظّفين في أجهزة السلطة، وموظّفي الوكالات والمؤسّسات الأجنبية من ناحية، وغالبية الشعب الفلسطينيّ في الضفّة الغربيّة من ناحية أخرى، والذين لم يعد دخلهم يكفي لتغطية المتطلّبات الأولية للمعيشة، وبات وضعهم الاقتصاديّ يزداد سوءًا يومًا بعد آخر. وينطبق ذلك على شريحة واسعةٍ من الموظّفين والعاملين في القطاع العامّ وفي القطاع الخاصّ وصغار التجّار والمهنيّين والمزارعين وأصحاب الحوانيت وسائقي السيّارات والعاطلين عن العمل. لقد كان مشهد ثراء النّخبة المعولمة في رام الله مصدر حساسيّةٍ عالية لدى كثيرٍ من النّاس في رام الله ذاتها، وفي مدن فلسطين الأخرى التي لوحظت فيها كثافة الاحتجاج وحدّته خلال موجة التظاهرات.
لقد فشلت السلطة الفلسطينيّة في القيام بمشاريعَ اقتصاديّة حقيقيّة توفّر أماكن عمل في قطاعي الصناعة والزراعة، فلم تحاول الحكومة إقامة مناطق صناعيّة في المدن والبلدات التي تقع تحت ولايتها، ولم تحاول الاستثمار في المجال الزراعيّ ولم تبذل أيّ جهد حقيقيّ للقيام به. وعوضًا عن ذلك، اكتفى تحالف الحكومة مع رجال الأعمال، والعديد من رؤوس السلطة، بالاستثمار في المشاريع التي تدرّ أرباحًا سريعة مثل شركات الاتّصالات والعقارات وشراء الأراضي في المدن والبلدات الفلسطينيّة وفي المنطقة "أ" عمومًا.
وعلى أيِّ حال، لم يكن ردّ فعل الشعب على الأوضاع الاقتصاديّة الاجتماعيَّة أن يكون لولا الثقافة التي أنتجها خطاب السلطة الفلسطينيّة بعد انتفاضة الأقصى، ثقافة القروض البنكيّة والاستهلاك اللائق في بلدٍ يرزح تحت الاحتلال الاستيطانيّ، وتُستباح أرضه يوميًّا في هجمةٍ استيطانيّة غير مسبوقة هي الأقسى منذ النكبة[4].
لقد كان كلّ همِّ القيادة الفلسطينيّة استرجاع الشرعيّة التي سُلبت منها في الانتخابات التشريعيّة السابقة، وإنتاج مقارنةٍ اقتصاديّةٍ يوميّة بين الوضع في الضفّة الغربيّة والوضع في قطاع غزّة الذي تحكمه "حماس". وعلى الرغم من نجاحها في تقليل شعبيّة خصمها المحليّ، إلا أنّها – في الوقت نفسه – أعدمت أيّ خياراتٍ سياسيّة تراهن على الشعب لمقارعة الاحتلال، وتراوحت تحرّكاتها السياسيّة ما بين طاولة المفاوضات والذهاب إلى المحافل الدوليّة لتحصيل اعترافات لا تعني على أرض الواقع شيئًا.
ما لم تدرجه السلطة في حساباتها أنَّ الفخَّ الذي شاركت هي في نصبه لغريمها في غزّة ستقع هي الأخرى فيه، بعد أن اعتلت "حكومة مستوطنين" سدّة الحكم في إسرائيل وضربت حصارًا على السلطة لأنّها لم تقبل التفاوض من دون تجميد الاستيطان، وبعد أن انشغل العالم والعرب بمستجدّات ثورات الشعوب التي أفرزتها حقبة الربيع العربيّ.
محتجّون جدد
لم يكن الشعب الفلسطينيّ بمعزلٍ عن الثورات العربيّة. وفي الحقيقة، كانت مدينة رام الله من أوائل المدن العربيّة التي شهدت تظاهراتٍ تحيّي الشعب التونسيّ عند نجاحه في إسقاط زين العابدين بن علي في كانون الثاني / يناير 2011، وقد زادت حدّة التحمّس للثورات العربيّة مع مليونيّات ميدان التحرير في مصر، حتى أنَّ مجموعةً من الشباب الفلسطينيّ قد قرّرت بعد تنحّي الرئيس المخلوع حسني مبارك تنظيم يومٍ لتظاهراتٍ تُلحق الفلسطينيّين بحقبة الربيع العربيّ. وقد اختير يوم 15 آذار / مارس 2011 لتظاهراتٍ حاشدة تقود عملية التغيير في فلسطين.
خطّط لهذه الفعالية مجموعة من الشباب العابر للأحزاب والفصائل السياسيّة الفلسطينيّة الذين اكتسب بعضهم خبرة التظاهر والتحشيد من المواجهات ضدَّ الجدار الفاصل. وكان منفذ تواصلهم هو الفيسبوك. وقد حاول شباب المجموعة طرح شعاراتٍ سياسيّة مثل المطالبة بعقد انتخابات المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ الذي تهيمن عليه حركة "فتح" والذي يعدّ المجلس التشريعيّ لكلّ الفلسطينيّين في العالم. كما حاول البعض رفع شعارات إنهاء المفاوضات وإسقاط أوسلو ووقف التنسيق الأمنيّ مع إسرائيل، فضلًا عن إنهاء الانقسام[5].
ولكنَّ عددًا من الأسباب حوّل هذه الفعالية إلى احتفالية، كان أهمّها قيام السلطة الفلسطينيّة بتبنّي الدعوة والتركيز على شعار إنهاء الانقسام، وهو في النهاية شعار عامّ يحمّل المسؤولية للجميع باستثناء الاحتلال. وقد منعت قوّات الأمن الفلسطينيّة المتظاهرين من التوجّه إلى الحواجز الإسرائيليّة أو الاحتكاك بجيش الاحتلال، مخافة أن تتحوّل التظاهرات إلى انتفاضةٍ جديدة، وهو خيارٌ كانت السلطة قد حسمت موقفها ضدّه منذ اعتلاء محمود عبّاس رأس المؤسّسة السياسيّة. كما دفعت الوزارات الحكوميّة والمدارس عشرات الآلاف من الموظفّين وطلّاب المدارس إلى المشاركة في هذه التّظاهرات، وهي طريقة اعتادت السلطة الفلسطينيّة عبرها الإجهاز على أيّ تحرّك سياسيّ شعبيّ. لقد كان من السهل جعل أيّ تجمهرٍ يبدو تافهًا أمام حشد الموظّفين والطلّاب الذين يمكن اعتبارهم – عن حقّ – الجيش السياسيّ للسلطة الفلسطينيّة.
وأنتج هذا الحراك المتأثّر بالربيع العربيّ عدّة مجموعات شبابيّة، أهمّها تجمّع "فلسطينيّون من أجل الكرامة". وبرز هذا التجمّع بعد مسيرات التضامن مع جولات إضرابات الأسرى في السجون الإسرائيليّة والتي عُرفت بـ"معارك الأمعاء الخاوية في نهاية عام 2011. وضمَّ التجمّع عدّة حراكات شبابيّة مثل "الحراك الشبابيّ المستقلّ" ومجموعة شباب "بنحب البلد". وساهمت في دمج الجهود الشبابيّة وتركيزها قضايا مثل: الأسرى، المفاوضات، والمجلس الوطنيّ، ومناهضة التطبيع، والاعتقال السياسيّ، والتنسيق الأمنيّ مع إسرائيل.
إلا أنَّ هذه التحرّكات لم تلقَ استجابةً جماهيريّة كافية، فلم يكن الفلسطينيّون -في تلك المرحلة- جاهزين لانتفاضة جديدة، وما زال أغلبهم متعبين من تبعات انتفاضة الأقصى وحرب غزّة والاحتراب الداخليّ، ومنشغلين بأوضاعهم الاقتصاديّة، ليطغى شعورٌ عام بلا جدوى أيِّ تحرّك شعبيّ ذي طابعٍ سياسيّ.
وبدا لفترة أنّ خروج النّاس إلى الميادين المقتصر على إقامة الاحتفاليات المهرجانيّة دليل على أنَّ المجتمع الفلسطينيّ قد فقد تعبئته ضدّ الاحتلال. وتجلّت بقايا ثقافة هذه المرحلة في مفارقةٍ مؤلمة هي تدفّق أكثر من مئة ألف فلسطينيّ في آب / أغسطس 2012 على المجمّعات التجاريّة للمدن الإسرائيليّة في الداخل الفلسطينيّ، وعلى شواطئ الساحل الفلسطينيّ المحتلّ عام 1948، بمجرّد أن وافقت إسرائيل على إصدار التصاريح. ومع أنَّ أغلب المحلّلين نبّهوا إلى أنَّ التساهل الإسرائيليّ كان بهدف المساعدة في دفع الاقتصاد الإسرائيليّ الذي يعاني اليوم من أزمة حقيقيّة، إلا أنّه يشير في الوقت نفسه إلى أنّ هنالك قناعة إسرائيليّة بأنّ فلسطينيّي الضفّة الغربيّة لم يعودوا "خطرًا أمنيّا" على دولة إسرائيل بعد أكثر من اثني عشر عامًا من حملات التأديب والتدجين. فلو كانت هذه الخطوة قبل سنوات معدودة لعُدّت مجازفة مجنونة.
في مطلع شهر أيلول / سبتمبر 2012، حصل تطوّر هو غايةٌ في الأهمية، فقد قرّرت حكومة سلام فيّاض رفع جميع أسعار الموادّ الاستهلاكيّة والمحروقات. وترافق ذلك مع انقطاع رواتب الموظّفين وتجميد التوظيف في القطاع العام. ومع أنَّ الحكومة قامت عبر وسائل الإعلام المحلّية وإعلانات الشوارع بحملة "توعويّة" حول أهمية الضرائب لبناء "الدولة الفلسطينيّة المنشودة"، إلا أنّ السبب الحقيقيّ كان واضحًا وهو ارتفاع الأسعار في إسرائيل للمرّة الثانية خلال شهرين، إذ تلزم اتفاقيّة باريس الاقتصاديّة الحكومة الفلسطينيّة برفع أسعار الموادّ الاستهلاكيّة في حال جرى رفعها في إسرائيل، وألّا يتجاوز الفارق بين السعرين نسبة متّفقًا عليها (هي 15% مثلًا في حالة المحروقات عدا البنزين الذي تتحكّم إسرائيل في مستوى أسعاره بشكلٍ تامّ).
أدّى تزايد تكاليف المعيشة في الأراضي الفلسطينيّة؛ ونقص السيولة الماليّة لدى السلطة الفلسطينيّة بسبب التطرّف الإسرائيليّ وعدم التزام الدول العربيّة بوعودها؛ إلى انجرار البلاد إلى حافة الانفجار. ولكي نوضّح الصورة، فقد ارتفع سعر البنزين منذ عام 2009 من دولار واحدٍ للتر إلى أكثر من دولارين في عام 2012، وارتفع سعر كيلوغرام الخبز إلى دولار، وقس على ذلك. وهو وضعٌ أقلّ ما يمكن وصفه به أنّه لا يُطاق. وقد تزامن ذلك مع ظهور صفحاتٍ على الموقع الاجتماعيِّ "فيسبوك" تهاجم سياسات الفساد في القطاع العام وتنتقد غلاء المعيشة.
في هذا الوقت، خرجت تظاهرات هي الأولى من نوعها، ولكن هذه المرّة لأسباب اقتصاديّة. فقد خرج آلاف المواطنين في معظم المدن الفلسطينيّة يهتفون برحيل رئيس وزراء حكومة الطوارئ سلام فيّاض. وقد لوحظ توظيف التظاهرات لشعارات الثورات العربيّة، وخصوصًا الثورة السورية "يلَّا ارحل يا فيّاض".
ما يميّز الحراك الأخير هو أنّ البلاد شهدت خروج فئاتٍ اجتماعيَّة جديدة غير محسوبةٍ على الطبقة الوسطى الحديثة، كان عمادها في الأساس سائقي سيارات النقل العموميّة وباعة الخضار وصغار التجار وأبناء المخيّمات، وهم أكثر المتضرّرين من العسر الاقتصاديّ. فقد أضرب السائقون، وسدّوا الشوارع وأحرقوا الإطارات، وعطّلوا الحياة العامّة، لتصبح الحالة أشبه بعصيانٍ مدنيٍّ مع حرص قيادات الأمن على عدم التدخّل متعلّمةً من درس الثورات العربيّة. وتعقّد الوضع بعد تصريحات فيّاض التي شدّد فيها على صعوبة حلّ مسألة ارتفاع الأسعار، بل ووصل به الأمر إلى اقتراح مشروعٍ للتنسيق مع دول الخليج وليبيا لتوفير فرص عملٍ للشباب[6]. وهو ما عُدّ تصريحًا غير مسؤول، وتجاوزًا للمبادئ الوطنيّة.
لقد أربك هذا المشهد النخبة السياسيّة والثقافيّة في الضفّة الغربيّة حتّى وصل الأمر إلى أن يفسّر بعض المثقفين النقديّين التحرّك بأنّه صراعُ مواقع بين رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس من جهة، ورئيس حكومة الطوارئ سلام فيّاض المدعوم من الولايات المتّحدة وأوروبا من جهةٍ أخرى. ولكنَّ خطاب الرئيس في 8 أيلول / سبتمبر الذي أكّد فيه دعمه لسياسة الحكومة، بدّد هذه الظنون، وذكّر المراقب أنَّ عصر التناقضات في المؤسسة السياسيّة الحاكمة قد ولّى، فقد ساعدت الهندسة التنظيميّة التي أجرتها قيادة السلطة منذ سيطرة "حماس" على قطاع غزّة، في تسوية مراكز القوى التي كان تعدّدها سمة أساسيّة من سمات المؤسسة الحاكمة في عهد عرفات.
لقد كان مبعث هذا الارتباك نشاط بعض الشخصيات المحسوبة على حركة "فتح" وعلى الأجهزة الأمنيّة والمتضرّرة من محاصصة المواقع وتهميش قيادات تنظيمية لحركة فتح في الحكومة منذ عام 2007. فقد راهن هؤلاء على هذه الاحتجاجات (وأحيانًا بالمشاركة فيها) لتصفية الحساب مع سلام فيّاض وحرقه شعبيّا. ولكن، تبيّن بعد أيامٍ أنّ تلك المحاولة لم يكن مخطّطًا لها من رأس هرم السلطة، فهو قادر على اتّخاذ قرارٍ بعزل فيّاض من دون أن يحتاج إلى الشارع. ويجد هذا التحليل دعمًا له في اتّهام السلطة الفلسطينيّة للتظاهرات بأنّها تخريبيّة وبأنّها من تنظيم حركة "حماس"، والنشاط الأمنيّ الذي سُجّل في المدن الفلسطينيّة لتطويق الاحتجاجات وفضّها أحيانًا عبر إدخال عناصر مدنيّة تحرّف مسارها السلميّ[7]. من الواضح أنّ قياداتٍ "فتحوية" انضمّت إلى التظاهرات للضغط على الرئيس الفلسطينيّ ليتخلّى عن فياض. ولا شكّ في أنّ بعضها مدفوع أيضا بضرورة تجاوز حالة الانسداد.
لقد فات على المرتبكين أنَّهم يشهدون حراكًا سببه اقتصاديّ أوّل مرة، وهو ما لم يتعوّدوه منذ زمنٍ طويل، فنادرًا ما كانت التظاهرة في السياق الفلسطينيّ غير سياسيّة، وحتّى التظاهرات النقابيّة التي ازدادت بعد عام 2006 كانت مسيّسة وتهدف إلى إفشال حكومة "حماس" ونزع الشرعيّة الانتخابيّة منها. كما أنَّ الحائرين بخصوص هذه التحرّكات لم يفطنوا أنَّ احتجاجات أبناء المخيّمات ومحدودي الدخل لا بدَّ أن تأخذ طابعًا يميّزها. وهي بذلك لا تختلف عن احتجاجات الأطراف التي زخرت بها الثورات العربيّة، فهي في النهاية صورةٌ مستجدّة، إذ قاد أغلب التحرّكات الاحتجاجيّة السياسيّة شبابٌ محسوبٌ على الطبقة الوسطى الحديثة التي لا تلتفت في العادة إلى المطالب الاجتماعيّة.
في هذه الأثناء، وبعد تبيّن الصورة، نسّق تجمّع "فلسطينيّون من أجل الكرامة" مع مختلف المجموعات المحليّة في رام الله من أجل تنظيم تظاهرة تتوجّه إلى مقرّ الرئاسة في يوم 11 أيلول / سبتمبر. وقبل انطلاق التظاهرة بساعات، أعلن رئيس حكومة الطوارئ سلام فيّاض عن قرار الرجوع عن رفع الأسعار باستثناء البنزين[8]، وتعويض الخسائر عن طريق الاقتطاع من رواتب كبار الموظّفين في الحكومة. وهو ما عُدّ إعلاميًّا استجابةً لمطالب المتظاهرين.
ولكنَّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة نقلت عن مصادر أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو كان قد وجّه "رسائل عاجلة إلى الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبيّ، طالب فيها بتحويل مبالغَ ماليّة كبيرة لمنع انهيار السلطة (الفلسطينيّة)". كما أفرج بتنسيقٍ مع فيّاض عن 250 مليون شيكل هي دفعةٌ من أموال الضرائب التي علّقتها إسرائيل[9]. وقامت الحكومة الإسرائيليّة بإصدار خمسة آلاف تصريح لعمّال فلسطينيّين للعمل فيها[10]. وهذه دلائل على قلق إسرائيل من الخطر المحدق بالمؤسسة السياسيّة الفلسطينيّة. لقد كان تقييم جهاز الأمن الإسرائيليّ صحيحا، فلا يمكن أن يسمح بتظاهرات اقتصاديّة غير سياسيّة في منطقة محتلّة، لأنّ اللّائمة سوف تقع في النهاية على إسرائيل التي تحاصر السلطة. ومن هنا، ضغطت التقارير الأمنيّة الإسرائيليّة (الأكثر براغماتيّة من المستوطنين وأحزابهم) على الحكومة لتنقذ السلطة. والملفت للانتباه هنا هو قدرة إسرائيل على أن تقرّر لأوروبا متى تدعم السلطة ومتى لا تدعمها.
يتبيّن من خلال متابعة خريطة الاحتجاجات في الضفّة الغربيّة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيِّ وغيرها، أنّ أغلب المدن في الضفة الغربيّة شهدت احتجاجاتٍ كبيرة كان مخزنها في الأساس هو المخيّمات والقرى المجاورة التي تدفّق شبابها لسدّ الشوارع في مشهدٍ أعاد للذاكرة مشاهد الانتفاضة الأولى، باستثناء مدينة رام الله التي بدأ التحرّك فيها مسيّسًا فتحاويًّا ضدَّ فيّاض، ولكنّه تحوّل بعد ذلك تظاهرات قادتها الحراكات الشبابيّة المستقلّة. فقد عزف سكّان الأمعري وقلنديا والجلزون وقدّورة، إضافة إلى أبناء القرى عن المشاركة. وربّما يعود ذلك إلى العمق الاجتماعيِّ للسلطة الفلسطينيّة وللأجهزة الأمنيّة في قرى رام الله ومخيّماتها كمصدر للموظّفين. ولكن هذا لا يمكن إلا أن يكون هدوءًا موقّتا لو استمرّت الأزمة.
السيناريوهات المتوقّعة لمرحلة ما بعد الاحتجاجات
ليس واضحًا حتّى هذه اللحظة إلى أين يقودنا الحراك الاحتجاجي الجديد في مدن الضفّة الغربيّة، ومن الصعوبة التكهّن بنتائج حاسمة، فدوافع التحرّك ما زالت اقتصاديّة، وبوصلته ما زالت تشير إلى السلطة الفلسطينيّة. وكان الرئيس الفلسطينيّ قد صارح مستمعيه في خطاب الثامن من أيلول / سبتمبر 2012 بألا حلّ آنيّ للأزمة الاقتصاديّة الحالية. وفي ضوء هذه المعطيات يمكن توقّع السيناريوهات التالية لما يمكن أن تؤول إليه الأمور:
أولًا: من المرشّح أن يتحوّل الحراك الشعبيّ الفلسطينيّ الذي هو ذو طابعٍ اجتماعيٍّ حاليًّا، إلى حراكٍ سياسيّ يهدّد السلطة الفلسطينيّة وقيادتها مستقبلًا، فليس هنالك من حلٍّ اقتصاديّ لمشاكل الفلسطينيّين. وما يدلّ على هذا المنحى هو أنَّه بمرورِ أيّامٍ على انطلاق أوّل تظاهرة مندّدة بالغلاء، رُفعت شعارات تدعو إلى إسقاط الاتفاقيّات المبرمة مع إسرائيل.
ثانيًا: بإمكان السلطة الفلسطينيّة إحداث تعديلات حقيقيّة في الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال الإسرائيليّ، ولكن هذا يحتاج إلى مواجهةٍ ونضالٍ تُستثمَر فيه الغضبة الشعبيّة للضغط على إسرائيل التي لم تعتد على أن تمنح شيئًا مجّانًا.
ثالثًا: من المحتمل أن يؤدّي هذا الحراك إلى استنتاج القيادة الفلسطينيّة بأنّه لا يمكن لها تأجيل الأزمة السياسيّة والهروب منها برفع شعاراتٍ اقتصاديّة، وهو ما سيسّرع اتّخاذها قرارات سياسيّة بدءًا بتحقيق المصالحة الفلسطينيّة مع "حماس"، وانتهاءً بالتعبئة السياسيّة وتوجيه الغضبة الشعبيّة نحو الاحتلال.
رابعًا: سوف تؤدّي الأزمة الحاليّة على الأرجح إلى تدّخل القوى الدوليّة وإسرائيل لدعم السلطة ماليًّا، خاصّةً بعد أن حرقت التحرّكات الحاليّة سلام فياض شعبيًّا (الذي كان شخصيّة صاعدة بدعمٍ غربيّ)، ووضعته تحت جناح الرئاسة. وقد تستمرّ السلطة الفلسطينيّة في القيام بدورِ المسكّن لمشكلات الشعب الفلسطينيّ، مفضّلة انتظار نتائج الانتخابات الأميركية، ومتحيّنةً الفرصة لإنجاز تسوية سلميّة حينما تسمح الظروف بذلك. وهذا وهم كما يبدو منذ أوسلو. وهم مبنيّ على تحليلٍ خاطئ لسياسة إسرائيل بشأن ما يسمّى "عملية السلام".
يستطيع أيّ أنثروبولوجي غير مهنيّ أن يلاحظ بسهولة العقلية الاستعماريّة الإسرائيليّة في مراقبة الضفّة الغربيّة سلوكيًّا، كأن الفلسطينيّين في ظروف مختبر، فتمنح إسرائيل الدعم للتشجيع على سلوك معيّن، وتمنعه للرّدع عن سلوك معيّن، ثمّ يعاد بعض الدعم للتهدئة حين يثور الناس. لا يعقل أن تقبل حركةٌ وطنيّةٌ ومجتمعٌ مستعمَرٌ يمثّل نموذجًا للنضال ضدّ الاستعمار بمثل هذه المعادلة.
المركز العربي للدراسات والأبحاث