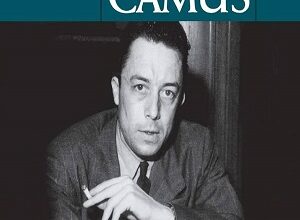كتاب «حرب المئة عام على فلسطين: تاريخ من الاستعمار الاستيطاني والمقاومة، 1917-2017»، للمؤرّخ رشيد خالدي، المُعدّ أساساً لتعريف قرّاء الإنكليزية بتاريخ القضيّة الفلسطينيّة الشامل، نجح في غرضه بلا أدنى شك، في ظلّ الحاجة إليه، نظراً إلى أن الكتب التي تروي قصّة الصراع من منظور مُنصف قليلة وبعضها الجيِّد غارق في التفاصيل (مثل كتاب تشارلز سميث أو كتاب سامي هداوي). ورشيد، الذي كان أستاذي المُشرف في سنوات البكالوريوس والماجستير في «الجامعة الأميركيّة في بيروت»، يُحسن تأريخ الصراع؛ ليس فقط بسبب معرفته العميقة والحميمة بالمراجع، بل لأن عائلته ارتبطت بتاريخ فلسطين وبتعريف القضيّة الفلسطينيّة للغرب.
في كتابه، استخدم رشيد لغة سلسة ومفهومة تصل إلى القارئ العادي وتُصلح لتعيين الكتاب في مادة الصراع العربي – الإسرائيلي في الجامعات، خصوصاً أن سرده لجأ كثيراً إلى الإشارات الشخصيّة البيوغرافية عنه وعن أفراد عائلته، ما يُقرّب القارئ للنصّ أكثر. قصة رشيد عن صيف بيروت 1982 – وهو الذي درس الحصار في كتاب «تحت الحصار» الذي صدر أخيراً في ترجمة عربيّة – تجعل القارئ يدرك مدى وحشيّة جيش العدوّ، إذ نجح في جعل القارئ يشعر بمعاناة الأهل والأطفال من القصف الإسرائيلي العشوائي لبيروت.
أهميّة الكتاب، في خضمّ كتب كثيرة عن فلسطين وتاريخها، تكمن في أن الكاتب تجنّب الوصف الكرونولوجي الرتيب الذي تعاني منه غالبية كتب سرد الصراع، من مثل كتاب سميث أو كتاب مارك تسلر. وضع الخالدي في كتابه ما يظنّ أنه ضروري وأساسي في فهم الصراع، وخصوصاً في بداياته وفي تشكّل الحركة الصهيونيّة. ونحن، الذين نعلّم مادة الصراع العربي – الإسرائيلي وتاريخ القضيّة الفلسطينيّة، دائماً نبحث عن كتاب جديد كي يلخّص قضايا الصراع المتشعّبة ويجعلها مفهومة للطالب الجامعي.
يبدأ الكتاب بذكر مراسلة يوسف ضياء الخالدي في عام 1899 مع ثيودور هرتزل، عبر كبير حاخامات فرنسا، والتي يطري فيها الخالدي على هرتزل وعلى الصهيونيّة. وفيما عرّض هذا الإطراء الخالدي للنقد، استشهد رشيد بباقي الرسالة التي يحذّر يوسف فيها، وبوضوح، من عواقب المشروع الصهيوني، داعياً إلى «ترك فلسطين وشأنها، باسم الله» (ص. 7). هنا، يبدو أن يوسف ضياء وعى خطرَ الصهيونيّة مبكراً، لكن كلامه الدبلوماسي المنمّق تركه عرضةً للنقد من الجمهور العربي مذّاك. وجاء ردُّ هرتزل على رسالة الخالدي مناقضاً تماماً لما كتبه هرتزل في يوميّاته حول «طرد» الفلسطينيّين خفيةً عبر الحدود، وهي اليوميات التي استحضرها رشيد لتبيان حقيقة موقف هرتزل، والتي أكدت أن مقاصد الصهيونية لم تتغيّر كثيراً منذ زمن هرتزل حتى يومنا هذا.
أما القضايا الديموغرافيّة، التي كثيراً ما أزعجت الصهاينة ودعاتهم، فتطرّق إليها الكتاب من خلال ذكر تعداد العرب واليهود عبر السنوات. في الثورة الفلسطينيّة من عام 1936 إلى عام 1939، تعرّض 10% من سكان فلسطين الذكور إلى القتل أو الجرح أو السجن أو النفي (ص. 8). الصهاينة طالما حاولوا تصغير حجم الوجود الفلسطيني (كما ورد في كتاب جون بيترز «منذ القِدَم»)، وأحياناً يزعمون أن العرب في فلسطين لم يكونوا إلا مهاجرين عرباً جدداً من خارج فلسطين. ولا يزال ساسة أميركا يكرّرون مقولات أوائل الصهاينة وأواخرهم، حول عدم وجود شعب فلسطيني، كما ورد على لسان رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، غولدا مائير، التي تكرّس هوليوود فيلماً جديداً لها لا علاقة له بالتاريخ. والمقولة نفسها كرّرها محافظ أركنساس، مايك هكبي، في عام 2015، بقوله إنه «ليس هناك شيء اسمه الفلسطينيّون» (ص. 12).
من فضائل الكتاب أنه يرسم ملامح تكوّن الهويّة الوطنيّة الفلسطينيّة، وهذا عمل بدأه رشيد في كتاب سابق بعنوان «الهوية الفلسطينيّة: بناء وعي وطني حديث». رشيد دحض فكرة أن الشعب الفلسطيني لم يكن يتمتّع بعناصر الوعي الوطني وأكّد أن تشكّل الوعي القومي ضدّ فكرة مضادة لا يختلف عند الفلسطينيّين من التجربة الصهيونيّة (التي تشكّلت كفكرة مضادة لمعاداة السامية). ويعطي رشيد فكرة عن المجتمع الفلسطيني قبل النكبة وينفي الصورة التي رسمها غربيّون عن أنه كان في حالة انحدار أو انحطاط أو بدائية.
يولي رشيد أهميّة فائقة لـ«وعد بلفور»، الذي منح صكّ ولادة للدولة الصهيونيّة. القسم المتعلّق بوعد بلفور من الأفضل والأوفى في الكتاب، ويجب أن يكون بمتناول قرّاء العربيّة. مرّ قرن على «الوعد» المشؤوم ولم تعِره الصحافة والثقافة العربيّتان ما يستحقّ من الشرح والتحليل، خصوصاً أن مضاعفاته لم تنحصر بفلسطين وحدها، كوْنه نتاجَ عقليّة استعماريّة عنصريّة. ويقول رشيد إن ونستون تشرشل ولويد جورج (في عشاء في بيت بلفور في عام 1922) أكّدا لحاييم وايزمان أن صيغة «وطن قومي يهودي عنت دائماً دولة يهودية مستقبليّة» (ص. 19)، وهذا كان مخالفاً للوعود التي أطلقتها بريطانيا للعرب في حينه. ويروي رشيد قصص القمع التي جرت أثناء الثورة الفلسطينيّة (1936 – 1939)، ويذكّر بإعدام الشيخ فرحان السعدي في عام 1937، حين كان عمره واحداً وثمانين عاماً، في حين أن وجود رصاصة في حوزة فلسطيني كانا كافياً لتطبيق عقوبة الإعدام، وتم تنفيذ أكثر من مئة عقوبة إعدام بالإضافة إلى إعدامات ميدانية من قبل الجنود البريطانيّين (ص. 31). لكنني أغالط الخالدي في أن الفلسطينيين كان يمكن لهم أن ينالوا «أفضليّة بسيطة» (ص. 34) لو أنهم وافقوا على الورقة البيضاء في عام 1939، إذ إن هذه الورقة كانت غامضة في وعودها، والعرب كانوا على حق في عدم تصديق الوعد البريطاني، لأن النصف الأول من تاريخ المشرق كان سلسلة من الوعود البريطانية الكاذبة، والتمسّك بالحق الوطني كان يفترض رفض الورقة البيضاء.
وإذ يعتمد رشيد على مصادر في عائلة الخالدي ممّن شاركت في صنع بعض الأحداث أو كانت شاهداً أوليّاً عليها، يذكر من بينها ما سجّله حسين الخالدي، في مذكّراته، من خيبة أمل الشعب الفلسطيني عند تأسيس «الجامعة العربيّة» في عام 1945، نظراً إلى أن الدول الأعضاء قرّرت إزالة أي ذكر لفلسطين في البيان التأسيسي، وأصرّت على انتقاء ممثِّل فلسطين في «الجامعة». ويعتبر حسين الخالدي أن ممثل الفلسطينيّين، موسى العلمي، أصبح ممثلاً للحكومة البريطانيّة بمجرّد أن شغل منصبه في «الجامعة» (ص. 45). كما يروي رشيد موقف ألبرت حوراني، أستاذه المُشرف في جامعة «أوكسفورد»، من «المركز العربي» عندما أدلى بشهادة أمام اللجنة الأنجلوأميركيّة في عام 1946، والتي لا تزال «بياناً قويّ الحجّة» كما وصفها وليد الخالدي في مقالة له. إلا أن أحاديث ألبرت حوراني مع مرور السنوات كشفت عن رؤيته الشديدة الاعتدال، كما أنه كان قريباً من ديفيد بن غوريون وشديد الإعجاب به، فضلاً عن أنه (حوراني) في الشهادة المذكورة تنطّح ليعلن باسم العرب قبول المهاجرين اليهود غير الشرعيّين.
في رواية رشيد، هناك الكثير من الجرائم الإسرائيليّة التي طواها النسيان أو أنها غير مذكورة حتى في المراجع التي تتحدث عن الصراع. من هذه الجرائم ما حدث في تشرين الثاني 1956 في خان يونس ورفح، عندما قتل عدوان إسرائيلي 450 مدنياً فلسطينيّاً، معظمهم في إعدامات ميدانيّة (ص. 63). كما أن التواطؤ الأميركي في حرب 1967 مفصّلٌ في الكتاب، والذي يدعوك إلى التساؤل عن سبب تصديق جمال عبد الناصر للوعود الأميركيّة. وكان ليندون جونسون، الرئيس الأميركي آنذاك، وروبرت ماكنامارا، وزير الدفاع آنذاك، قد تلقيا تأكيدات من مستشاريهم العسكريّين أن العرب لن يباشروا بالعدوان، ليحصل الإسرائيليّون على الضوء الأخضر، كالعادة، من أميركا.
لكنّ هناك نقيصتيْن في الكتاب؛ الأولى، تتعلّق بنقد رشيد لـ«منظمة التحرير» في عدم بلورتها خطة تتوجّه فيها إلى الرأي العام الأميركي والإسرائيلي (ص. 80). هنا أتساءَل: لماذا هذا التعويل على الساحة الأميركية دون غيرها، مع اعتراف رشيد في كتاب آخر له أن سياسات أميركا نحو بلادنا كانت تعتمد على الخداع؟ ولماذا التركيز على الساحة الأميركيّة بالرغم من عدم تحقيق أي إنجاز فلسطيني من سياسة الممالأة والمحاباة التي اتبعها ياسر عرفات معها؟ إن أكثر ما كان يمكن للشعب الفلسطيني أن يناله من أميركا هو «اتفاقية أوسلو» بمسيرتها الإجراميّة. ولماذا لا نتحدّث عن الرأي العام الهندي أو الصيني أو البرازيلي مثلاً؟ إذا نحن وافقنا أن المنطلقات الأساسيّة لموقف الرأي العام الإسرائيلي والأميركي على حدّ سواء تنبع من العنصريّة ومن البغض الديني، فتكون محاولة كسب هذا الرأي العام عقيمة حُكماً. والرأي العام الأميركي، كما يعلم رشيد، لا يؤثّر على صنع السياسة الخارجيّة، لأنه لا يكترث لها. أما محاولة كسب الرأي العام من خلال ممثّليه في الكونغرس، فهذا يحتاج إلى عمل لوبي لم تكُن الدول العربية راغبة أو قادرة على تشكيله بحكم انحياز المؤسّسة الحاكمة ضدّ العرب، وبسبب عدم تكافؤ الفرص بين العرب واليهود هنا.
أما الفصل الذي يتناول تجربة لبنان، فيلخِّص بطريقة مكثّفة سنوات من الجرائم الوحشيّة الإسرائيليّة ضد لبنان والفلسطينيّين على أرضه. والكاتب كان عاش تلك المرحلة ويعرف مراجعها، التي ذكر من بينها جدال أرييل شارون مع «حزب العمل»، حول صبرا وشاتيلا، حين ذكّر عناصر الحزب بأن مجزرة تل الزعتر ارتُكبت بـ«سلاح زوّدناه نحن وقوّات ساعدنا نحن على بنائها» (ص. 86). ويؤكّد رشيد أن قيادة «منظمة التحرير» كانت متأكّدة من حتميّة حصول الاجتياح إلا أنها لم تصغ خطة عسكريّة، ما أدّى إلى هروب قوّات الحاج إسماعيل، الذي عيّنه عرفات قائداً عاماً للقوات في الجنوب. ويشير رشيد إلى وثائق جديدة عن خطط إسرائيليّة مسبقة، من قبل شارون وآخرين، لإرسال قَتَلة من الكتائب إلى المخيّمات الفلسطينية (ص. 104). وهنا، كان يمكن لرشيد أن يستعين بالكتاب الصريح عن العلاقات الإسرائيليّة – الكتائبيّة لجورج فريحة، «مع بشير»، ومن خلاله يتحدث حول الأمر.
أما النقيصة الثانية في الكتاب، فهي تجاهل المؤلّف الكامل لتجربة «حزب الله» في مقاومة إسرائيل. هذه كانت أفعل تجربة في تاريخ الصراع وشهدت في عام 2006 أكبر عمليّة صدّ لاجتياح إسرائيلي منذ عام 1948، وبصورة تفوّقت على أداء كل الجيوش العربيّة. رشيد يحكم على فشل المقاومة العسكرية الفلسطينية، لكن ذلك غير صحيح بدليل ردع المقاومة اللبنانيّة لإسرائيل على مرّ الأعوام، فيما نسق «منظمة التحرير» من المقاومة العسكريّة هو الذي فشل. يعتبر رشيد أن الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى في عام 1987، كانت «أول نصر تام» للفلسطينيّين. لكن ما هي معالم النصر؟ وهل كلُّ ما تحقّق كان تعاطفاً مؤقّتاً من رأي عام غربي لم يستمرّ؟ صحيح أن أهواء الليبراليّين في أميركا تغيّرت نحو الفلسطينيّين، لكن ذلك كان بسبب تنامي التغطية الإعلامية لجرائم إسرائيل، كما أن قيادة الحزب الديموقراطي لم تعكس أبداً – ربما بسبب الصفة العمريّة – أهواء القاعدة الديموقراطيّة. وعلى العكس، أظهر أداء المقاومة الفلسطينيّة في غزة، بما لا يقبل الشكّ، أن تجربتها مُرشّحة للانتقال إلى الساحة الفلسطينيّة.
يختم رشيد كتابه بالإشارة إلى تجربته في تقديم المشورة إلى الوفد الفلسطيني المفاوض في مدريد وفي واشنطن في ما بعد. يقول رشيد – وهو على حق في ذلك – إن «الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون أبداً وسيطاً نزيهاً بسبب الالتزامات التي ارتبطت بها»، ويضيف عن تجربته قائلاً إنه لو كان يعلم عن مدى الارتباط العضوي لأميركا بمصلحة إسرائيل وعن أن إسرائيل تسيطر على موقفها وموقف راعيتها، فإنه «على الأرجح لم يكن ليذهب إلى مدريد أو لقضاء معظم سنتين لاحقتيْن مستغرقاً في مفاوضات واشنطن» (ص 123). ويقدّم رشيد أفضل تفسير لسبب الرفض الصائب من عرفات لمقترحات «كامب ديفيد» في عهد بيل كلينتون. بالنتيجة، فإن القراء العرب، وليس الغربيّون وحدهم، سيستفيدون من هذا الكتاب.