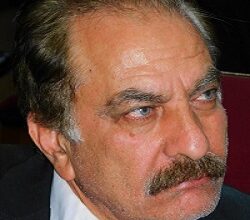حمص بلا «ماكياج»: هكذا ازدهر «ربيع» الطائفيّة بين المجزرة و«أختها»

طابور السّيارات المُنتظرة يبدو بلا بداية أو نهاية. رغم ذلك لا يبدي ركّاب الحافلة أي تذمّر. أحاديثهم القصيرة تتمحور حول مغزى شبه موحّد «ان شالله تنفع الإجراءات الجديدة وتوقف التفجيرات». خلال وقت الانتظار الطويل نسترجع بعضاً من ذكريات «الأيّام السعيدة» لمدينة عادةً ما توصف بـ«قلب سوريا» تبعاً لموقعها الجغرافي.
اليوم، باتت حمص أشبه بـ«قلب مفتوح» لم تُثمر «العمليات الجراحية» عودة العافية إلى نبضه. ترنّ في البال تفاصيل زاخرةٌ بالفرح الغابر، والضّحك الذي طالما ارتبطَ بأبناء «العديّة» وظُرفهم الشّهير. سرعان ما يطغى الأسى على كل التفاصيل مع تذكّر مناجاة الشاعر المهجري حسني غراب لمدينته قبل ما يزيد عن نصف قرن: «أَبعدَ حمصَ لنا دمعٌ يُراق علـى منازل؟ أم بنا من حادثٍ هلعُ؟». والهلعُ يكاد يكون السّمة الأبرز لكلّ ما تلتقيه في أحياء حمص. في بعضها يتمثل الهلع في شكلِ تفجيرٍ لا موعد له، وفي آخر يرتدي زيّ مخاوف لعنة «الديموغرافيا»، وفي الأخيرِ يُطالعُك من بين ركام شوارع سُويّت بأكملها بالأرض ليتفرّق سكّانها ما بين قتيلٍ ومفقودٍ ومُهجّر.
تدمر «بعيدة»
ثمة في حمص توافق على أنّ استعادة تدمر كفيل بإبعاد كابوس «داعش» عشرات الكيلومترات، لكنّ الهواجس الأكبر ما زالت مرتبطة بالتّفجيرات. ورغم تسليم كثيرٍ من الآراء بمسؤوليّة التنظيم عن معظمها (لا سيّما الأخيرة منها) غيرَ أن التّفجيرات كانت موجودة قبل وصول التنظيم إلى «عروس الصحراء». نظرياتٌ ثلاث تتناوب على تفسير لغز العمليات الإرهابيّة. يُسلّم البعض بمسؤولية «داعش» ومن قبله «المعارضة المسلّحة»، أصحاب هذه النّظريّة يربطونها بـ«فشلٍ أمنيّ ذريع». يطوّر البعض «النظريّة» ويسودُ لديهم اقتناعٌ بأنّ الأمر لا يرتبط بالفشل الأمني بقدر ما يرتبطُ بـ«تواطؤٍ وخياناتٍ مقبوضة الثّمن». فيما يتمسّك أصحاب الرأي الأخير بوتر «دود الخل منّو وفيه». على «المذاهب الثّلاثة» لا يتمّ الرّبط بين تدمر والتّفجيرات، حي الوعر يبدو «أصلحَ» لانتزاع هذه المكانة.
التسوية مصدر «هلع» أيضاً!
ثمّة أسباب «أعمق» تكمن وراء تحريك «الغضب» الذي اعتاد كثير من السكّان صبّه على محافظ حمص طلال البرازي. الدوافع المباشرة للغاضبين مرتبطةٌ بالمجازر المتتالية التي دأبت على استهداف أحياء بعينها في شكل تفجيرات، ليجد الشارع في الهتاف ضدّ شخص المحافظ «هدفاً أسهل» من سواه. لكنّ الأحاديث الهامسة (حتى ضمن الوسط الموالي) تربط بين تأليب الشارع ضدّ البرازي وبين دوره في إنجاز تسوية الوعر. «صار معروفاً أنّ إنجاز التسوية تعني قطع رزق تجار الحرب» يقول مجد. كذلك، تشير الأحاديث إلى دور مماثل لعبه البرازي حين عمل على فتح أبواب حمص القديمة أمام أبنائها العائدين (بعد إبرام التسوية الشهيرة) وبشكل سريعٍ «قبلَ أن يُتاح لجماعة التعفيش أن يصولوا ويجولوا».
الطائفيّة بلا «ماكياج»
في حمص اليوم؛ لا ترتدي الطائفيّة أيّ قناع. خمس سنوات من الموت الذي طاول الجميع لم تمنع «ازدهار» الطاعون. على العكس من ذلك، صارت الأمور في كثير من الأحاديث تُسمّى بمسمّياتها الفجّة. لا يقتصر ذلك على كلام البشر، لدى الشوارع أيضاً ما تُدلي به في هذا السّياق، إذ لا يحتاج الأمر إلى تأمّل طويل لتدركَ أنّ الاختلاطَ يقتصر على حدوده الدنيا في معظم الأحياء. لا يبدو استعراض مسارات الأحداث التي شهدتها المدينةُ كافياً لتبرير هذه النتيجة. فمعَ أنّ عامل الانتماء الطّائفي كان حاضراً بقوّة في معظم المناطق السوريّة، غيرَ أنّ المآلات في حمص تختلف بشكل كبير عن نظيرتها في طرطوس أو اللاذقيّة مثلاً (رغم تشابه النّسيج في المحافظات الثلاث). «طبعاً في شي مو مفهوم، ومستحيل يكون اعتباطي»، يقول عاصم. يروي الثلاثيني المتّحدر من إحدى القرى المجاورة قصصاً كثيرة شهدتها المدينة على امتداد السّنوات الخمس، ليختتم بخُلاصة تقود إليها معظم التّفاصيل «اللعبة في حمص كانت مختلفة، وبهدف الوصول إلى النتيجة التي نعيشها اليوم».
الحلقة المُفرغة
محاولات البحث عن لاعب «الكرت» الطائفي ستقودُك إلى اتجاهين متعاكسين «نظرية المستفيد توضحُ كلّ شيء»، يقول عاصم. ويضيف متسائلاً «لماذا استطاعت أجهزة النظام السيطرة على الأمور في الساحل؟». لا ينتظر الشاب، بل يقدَم الإجابة بنفسه «لأن الرّغبة في ضبطها كانت موجودة، أمّا هنا فكانَ الانفلات مصلحة». يوافق فراس على هذا «التحليل»، ويضيف «وُزّع السّلاح على أحياء بأكملها، هل تعتقدون أنّ من وزّعه لم يكن ينشد جرّ أبناء تلك الأحياء إلى حربه هو؟». في المقابل يرى باسل أنّ «هذا كلام يشبه كلام الناشطين الممجوج. الدولة تمكّنت من ضبط الأمور في الساحل لأنّ سلطتَها كانت حاضرة، وهذا ما حصل في كل مكان بقي تحت سيطرة الدّولة». أمّا توزيع السلاح على السكان فهو حسب الشّاب «كذبة كبيرة، النّاس تسلّحوا تلقائيّاً كي يدافعوا عن أنفسهم أمام مدعي السّلمية الذين كانوا سبّاقين إلى القتل والسّحل في الشوارع». هي الحلقةُ المُفرغة ذاتها إذاً.
البذور
سيكون لافتاً أن تحظى بالاستماع إلى صوت أقرب إلى التوازن وسط هذا الاستقطاب. يستفيض مجد (ابن أحد الأحياء المحسوبة على المؤيّدين) في سرد جوانب ممّا عاشته مدينته. شارك بعض الموالين في التصدي للمتظاهرين في الشهور الأولى حتماً. ما زال معظمهم مقتنعاً بأنّه «كان يؤدّي واجبه، ويحاول الدّفاع عن الاستقرار». كما «حضرت الهتافات الدموية في المظاهرات منذ البدايات». أمّا «المجزرة» و«المجزرة المضادّة» فتحتلّان المساحة الأوسع في الحديث. «أوقفَ باصٌ في الحي الفلاني واختُطف بعض ركّابه تبعاً للانتماء الطّائفي»، «رُميت جثث مجموعة من الفتيات المخطوفات عند دوار الرّئيس»، «ردّ أبناء الحي الفلاني بتكسير محلّات أبناء الطائفة الأخرى»، «ارتُكبت مجزرةٌ في الحي الفلاني بعد سحب العشرات من بيوتهم، على الهويّة، وقتلوا بدمٍ بارد»… إلخ. لا تبدو هويّة الطرف الذي ارتكب المجزرة الأولى أكثر من تفصيل، فالثابت أن المجازر تحتفظ بوضاعتها سواء كانت «فعلاً» أم «ردّ فعل». لكن ماذا عن الغد في ظل هذا الاستقطاب؟ ربّما كان جواب هذا السؤال أخطر ما في الأمر.
«أكلّما ذُكرت حمصٌ»؟
في زمن مضى، كانت الحركة الثقافيّة في حمص محطّ إعجاب معظم المتابعين في البلاد، ومثاراً لحسد بعض مثقّفي المدن الأخرى. تبدو التسميات المُعتمدة لكثير من الشوارع مجرّد شاهدٍ على زمنٍ ضائعٍ «قد يعود». نتأمّل النظافة اللافتة في وسط المدينة، بينما نتنقّل بين شوارع «أحمد شوقي»، و«محمود سامي البارودي»، و«أبي تمّام»، و«معروف الرصافي»… اليوم، تحاول بعض الأنشطة الخجولة أن تمدّ رأسها. وتنجح منها «المخصصّة للأطفال تحديداً في استقطاب بعض الجمهور»، وفقاً لأحد مثقّفي المدينة. حديث طويل ذو شجون، يُعيدنا أخيراً إلى شعراء المهجر الحمامصة «عُد بي إلى حمصٍ ولو حشو الكفن» يقول نسيب عريضة، ليتحسّر حسني غراب «دارٌ نحِنُّ إليهـا كلَّما ذُكرَت، كأنَّما هي من أكبـادنا قِطَــعُ».
صحيفة الأخبار اللبنانية