حميد سعيد وجيل “الستّينيّات”: فيض الذاكرة وجمر التمرّد (1)
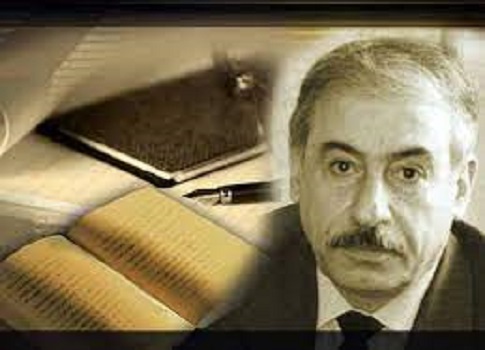
حين هاتفني الصديق سلام الشمّاع طالبًا الكتابة عن تجربة الشاعر المبدع حميد سعيد أو تقديم شهادة عنه، وأردف ذلك بمخاطبة تحريريّة أيضًا، سرّني الأمر لأربعة أسباب أساسية:
أوّلها – أننا ننتمي إلى ذلك الجيل المرهف الحسّاس ذاته والذي شهِد هزائم وانكسارات عديدة، فضلًا عن احترابات وتمترسات، بعضها موضوعي يتعلّق بالاجتهادات الفكرية والمقاربات الجماليّة، وبعضها الآخر أسبابه ذاتيّة أساسها المنافسة لإثبات الأفضليات وادّعاء احتكار الحقيقة في الغالب، لا سيّما حين يهيمن العامل السياسي فيطغى على الوعي الثقافي، ومع ذلك فإن فترة الستّينيّات المحدّدة شهدت خروجًا على المشهد السائد حيث تمّ التعبير عن هموم وتطلّعات وأحلام مشتركة لذلك الجيل الذي دفع ثمنًا باهضًا بشكل عام على الرغم من تعارُض مواقعه، خصوصًا حين ازدرت السياسة الثقافة، وجعلت الأخيرة ملحقة بها “ورأس حاجة” تستعين بها كلّما تقتضي الضرورة وتهملها، بل وتستقوي عليها، حين لا يوجد مثل ذلك الاضطرار.
وثانيها أنّني كنت قد تعرّفت على حميد سعيد كشاعرٍ بدأ اسمه يطرقُ سمعي وقرأتُ له بعض القصائد في فترة صاخبة من الحديث عن القصيدة الجديدة التي تركت بصمة واضحة على الشِّعر الحديث والتي تكرّست لاحقًا من خلال اطّلاعي على تجارب عديدة لأصدقاء عديدين مثل فاضل العزاوي ومؤيّد الراوي وعمران القيسي وصادق الصائغ وفوزي كريم وشريف الربيعي وسامي مهدي وآخرين، إضافةً إلى قراءاتي ومتابعاتي الأخرى، ومنها تردّدي على بعض المقاهي البغداديّة حيث يكثر الجدل الستّيني بألوانه المختلفة.
وكنت خلال السنوات المنصرمة قد تابعت على نحو ملفت تكامليّة جمعت ثنائيّة حميد سعيد والشاعر المبدع سامي مهدي، عبّرا فيها عن تفاعلهما من خلال كتابٍ تبادلا فيه 20 رسالة وجواب، وفيه بوح مكشوف ومُستتر وآراء متباينة في الفكر والثقافة والأدب بعامّة والشِّعر بخاصّة، إضافةً إلى السياسة والإدارة بهمومها البيروقراطية الثقيلة. وكنت قد قرأت بعض هذه الرسائل المتبادلة بينهما في النصف الثاني من التسعينات، ولم أقرأ الكتاب كاملًا وأضع هوامش وملاحظات على ما ورد فيه سوى بعد العام 2003 حيث حصلتُ على نسخة منه من حميد سعيد نفسه حين أهداني إيّاها مشكورًا.
وثالثها – أتذكّر أنّني التقيت حميد سعيد في جلسة مهنيّة ابتدأنا فيها حوارًا مع الاتحاد الوطني لطلبة العراق في العام 1969، حيث كنت مع زميلي لؤي أبو التمّن نمثّل اتحاد الطلبة العام، على الرغم من تخرّجنا من الجامعة، كما أنّ حميد سعيد كان قد امتهن التعليم أيضًا، ولكنّه كان ضمن الطاقم القيادي الأوّل الذي أعلن في تشكيلة الاتحاد الوطني بعد 17 تموز (يوليو) العام 1968، وفي مقالتي عن “كريم الملّا” والموسومة “سرديّة الاختلاف ونبض الائتلاف” – والمنشورة في صحيفة “الزمان” وعنها أخذه “موقع الحوار المتمدن” 8/10/2015، جئت على ذكر ذلك وعلى بعض تفاصيل تلك الفترة التي شهدت نوعًا من العلاقة المباشرة والحوار وتبادل الرأي.
ورابعها – إنّ الكتابة عن شاعر ستّيني ستمنحني الفرصة للحديث عن جيل الستّينيّات وإنْ كنّا من موقعين فكريّين مختلفَين، وهو موضوع ظلّ مؤجّلًا في أدراج مكتبتي لعامين ونيّف، وكنت قد هممتُ بالكتابة عنه بمناسبة مرور 50 عامًا على أحداث باريس (أيار/مايو/1968) وهي أحداث سبقتها وأعقبتها أحداث عراقيّة بذات التوجّه والرغبة في التغيير، إضافة إلى وقائع عربيّة وعالميّة شديدة الارتباط بموضوعنا سأحاول الإتيان عليها، مثل عدوان (5 حزيران/يونيو 1967) والاجتياح السوفييتي لتشيكوسلوفاكيا (21 آب/أغسطس 1968)، إضافة إلى الانتفاضة الفرنسية (أيّار/مايو 1968) وامتدادات حركة الاحتجاج “زمنيًّا” من أجل التغيير والتجديد للعديد من بلدان أمريكا اللاتينية، وهي محور الحديث عن الحركة الشبابية الجديدة المرتبطة بوعيٍ جديد وثقافة جديدة، وقد سبق لي أن توقفت عندها في الحديث عن بعض ملامح تجربتي الفكرية والثقافية والسياسية في ديوان الكوفة (الكوفة كاليري) بلندن العام 1994 والتي صدرت لاحقًا بكرّاس بعنوان “بعيدًا عن أعين الرقيب – بين الثقافة والسياسة” دار كنوز الأدبية، بيروت، 1995.
وإذا كان “الجيل الستّيني” موحّدًا أو شبه موحّد أو قريبًا من الائتلاف والتواصل والقبول بالآخر في الفترة التي أشرت إليها، إلّا أنّه بسبب المنافسة الشديدة وفيما بعد الاحتراب السياسي انقسم إلى “معسكرين” بلغة الصديق حسن العلوي في تناوله ظاهرة الجواهري الكبير، أي بين معسكر “الموجة الصاخبة” وبين معسكر “الروح الحيّة”، مع أنّني أميل إلى اعتبارهما “فريقين” أو “منتديين” باستخدام لغة الثقافة بدلًا من لغة الحرب، وإن كان ثمّة “انفرادات للجيل”، لكن الأساس ظلَّ منمّطًا بين اتّجاهين تجاذبا فائتلفا، ثمّ اختلفا فتنافرا لدرجة العداء.
وبغضّ النظر عن تصوّرات كل فريق، ولا أقصد الشعريّة فحسب، بل الفلسفيّة التي تقف خلف كل ثقافة، فضلًا عن القُرب أو البُعد عن السلطة، فثمّة اختلافات أخذت تتراكم وتتعمّق باختلاف المواقع، إضافة إلى مآخذ يحسبها كل فريق على الآخر، فحسب فريق “الموجة الصاخبة” يعتبر سامي مهدي فريقه “أكثر حصانة من الآخرين تجاه الأفكار وأكثر حصافة في التعامل معها”، وذلك بسبب تأثّره بالحداثة الغربية وبُعده عن التراث، أمّا فريق “الروح الحيّة” فإنّه يعتبر فريق “الموجة الصاخبة” لم يتمكن من استلهام مفاهيم الحداثة بما تعني من حرّية وعقلانيّة ومدنيّة لكونه ظلّ مشدودًا للتراث بما فيه سقف المحافظة حسب فاضل العزّاوي.
حميد سعيد والستّينيّات
يتعب البحرُ.. ولا
تتعب ماريسا التي
تصعد من ساحلها البارد نحو النار
يا عرّافةً علَّمها الموت سجايا
الحلم الفضّي
بقدر ما ظلّ الشاعر حميد سعيد يكرّر أنّه لم يكن منشغلًا بموضوع الانتساب إلى جيل الستّينيّات الشعري، إلّا أنه لا ينفي تأكيده أنّ هذا الجيل الذي ينتمي إليه “زمانيًّا”، إنّما كان متميّزًا اجتمعت فيه سِمات خاصّة متفرّدة في الائتلاف والاختلاف وفي الوصل والفصل، سواء بتحرّره من الوصاية والأبويّة أم بعفويّته وحساسيّته وفردانيّته أم محاولات اقترابه الجمالي من الحداثة بوسائل جديدة وطُرق تعبير مختلفة لأنواع الثقافة وأجناس الأدب والفن والكتابة وكل ما يتعلّق بالإبداع، ارتباطًا بعمق الوعي بأهميّة ذلك.
قد تكون الذروة الحقيقيّة لتبلور الجيل الستّيني هي الفترة التي تنحصر بين أواخر العام 1963 والعام 1969 أو مطلع العام 1970 حتى وإن سبقته أو لحقته زمنيًّا فترات إرهاص وتجريب وتحدّيات وتجلّيات، لكنّ هذه الفترة المحددّة كانت الأكثر تعبيرًا عن حرّية الاختيار وانعكاسًا تلقائيًّا لتجريبيّة الإبداع، ليس على الصعيد الشّعري فحسب، بل على الصعيد الفكري والثقافي وفي الحقول المختلفة من المسرح والسينما والرسم والنحت والموسيقى والغناء وأنواع الكتابة وغيرها.
وأستطيع القول إنّ كل ذلك كان قد حدث بطريقة مفتوحةٍ وخارج الأيديولوجيّات “الضيّقة”، مترافقًا بإجراء مراجعات نقديّة للفترة السابقة وولاءاتها السياسيّة القديمة، خصوصًا على المستوى الشخصي، وإن كانت تلك المحاولات أقرب إلى إرهاصات لم تُستكمل، إذ سرعان ما انقطع حبل سرّتها وتشتّتت بعض قراءاتها النقدية الأولى، ولو قدّر لهذه الفترة أن تمتد لسنوات أطول لكنّا قد شهدنا نوعًا جديدًا من الأدب بعامّة والشِّعر بخاصّة وأجواء ثقافية أكثر انفتاحًا وأقلّ أيديولوجيّة وأعمق إبداعًا وأفصح نقدًا وأوسع حرّية، ولا شك أنّ حميد سعيد لم يكن خارج دائرة المجموعة المتميّزة التي انشغلت بكلّ ما وقع من حولها وما حدث في داخلها وما جرى إزاءها.
جيل الستّينيّات – الفضاء المفتوح
باعتقادي أنّ جيل الستّينيّات يمثّل فضاءً مفتوحًا حيث تلبّسه قلق خاص، نابع عن رغبة شديدة في إنتاج إبداع مختلف عمّا سبقه، وقد ترافق ذلك مع نزوع جديد بعضه تعويضي عن الهزيمة السياسية والشخصية، في إطار جدلٍ فكري للمدارس السائدة وتمرّد غير مسبوق على بعض أُطرها الأخلاقية، في منحى وجوديّ ارتفع رصيده على صعيد نظري وفي بعض الممارسات التي نُسبت إليها بطريقة العيش والتمرّد على ما هو سائد، إضافة إلى معايير قيميّة إبداعيّة تجاوزت ما هو سياسي إلى ما هو ثقافي وإبداعي.
يمكنني القول إنه على الرغم من الحضور اللافت للجيل الستّيني، إلّا أنّه لا يمكن حصره بتيّار سياسي واحد أو مدرسة فكرية واحدة، أو إنسابه إلى رؤية جماليّة واحدة، وذلك بمراجعة التجربة بعيدًا عن دائرة الاصطفاف المسبقة والانحيازات التاريخيّة. ومع تقدير هذا الجيل وتفاعله مع ما قبله من أجيال، ولا سيّما جيل الريادة الأول في تجربته الشعريّة أو التشكيليّة أو الموسيقيّة أو المسرحيّة أو السينمائيّة أو الكتابيّة، وما حقّقه من منجز على هذا الصعيد، إلّا أنّه كان حريصًا على تقديم تجربته الخاصة برؤاه المبتكرة وصوته المتميّز وبأدواته الجديدة.
لقد كان لدى الجيل الستّيني ميلٌ شديد إلى التجريب والاجتهاد، ونفور من الاقتباس أو التقليد مع اختلاف المنطلقات لكلّ تجربة من تجاربه ولكلّ فصلٍ من فصول الثقافة وحساسية كل مثقف من مثقّفيه، وكمقاربة لاستعادة الحديث عن جيل الستّينيّات كنت قد أعددت مخطوطة لم تُنشر بعد، وهي بعنوان (“انفرادات” جيل الستّينيّات: “الموجة الصاخبة” و”الروح الحيّة” زاوية نظر أخرى)، اعتبرته فيها أشدّ حساسية جماليّة على مستوى التفكير الذاتي والوعي الموضوعي مما سبقه، والأمر لديه كان يقع خارج دائرة التنظير، ومثلما عاش جيل الستّينيّات هذا الواقع في العراق، فقد كانت تجربته في سوريا ومصر وفلسطين ولبنان وبعض بلدان شمال أفريقيا العربية، ناهيك عن تجارب كونيّة مقاربة لذلك، ممّا جعله بعيدًا عن الإيمانيّة التبشيريّة أو الاستسلام إلى تنظيرات جاهزة أو كليشيهات شائعة، حيث ارتفعت لديه نبرة النقد وازدادت العقلانيّة شحنةً إيجابيّة لا سيّما بفيض الأسئلة في الذات والموضوع، مع الأخذ بنظر الاعتبار المتغيّرات الجماليّة العامّة في إطار المشترك الإنساني الذي يقرّب الجوامع ويقلّل من الفوارق ويلاحظ الخصوصية والتميّز في ظلّ بيئات اجتماعية ومحلّية مختلفة، إضافة إلى تعدّد الأصوات، حيث كان المكوّن الجمالي والإبداعي أكثر تأثيرًا من المكوّن الفكري والأيديولوجي.
لقد أضحت المقاهي الستّينية، حلقات أدبيّة وشعريّة وفنّية وثقافيّة مفتوحة، تختلط فيها المدارس الفكريّة والسياسيّة على نحو عجيب ليس في بغداد وحدها، بل في العديد من المدن العراقية العربية والكردية في آن، وكان روّادها إضافة إلى نُخب مختلفة من المثقفين والإعلاميّين المُبدعين بعض طلبة الجامعات، والذي تقارب أعمارهم العشرين عامًا أو ما يزيد عنه بقليل، باستثناءات محدودة، وقد بلغت هذه “المنتديات” حضورًا لافتًا بعد عدوان الخامس من حزيران (يونيو) العام 1967.
ولتوثيق تلك الفترة يمكن القول إنّ مجلّة “الطليعة” المصرية كان لها قصب السبق حين فتحت ملفًّا خاصًا عن الحركة الستّينية الأدبية والثقافية، وفعلت الشيء نفسه مجلة ” الطريق” اللبنانية، وذلك في العام 1969، وكان محمد دكروب قد كتب دراسة عن “الأدب الستّيني” قدّمها إلى مؤتمر اتحاد الأدباء العرب المنعقد في دمشق العام 1971، وأصدر غالي شكري كتابًا بعنوان ” ذكريات الجيل الضائع” قصد به ” جيل الستّينيّات” بالدرجة الأساسية في العام 1972.
وساهمت “مجلة شعر” التي أصدرها أدونيس مع يوسف الخال العام 1957 ومن بعدها “مجلة مواقف” التي أصدرها أدونيس أيضًا في العام 1969، في نشر النتاج الستّيني الجديد على نحو كبير ومتميّز، وعبّرتا في الوقت نفسه عن “الموجة الجديدة” في الشعر بشكل خاص والأدب والكتابة بشكل عام، تلك التي عُرفت فيها الستّينيّات بروحها الحيّة.
وأعتقد أن فاضل العزاوي هو أوّل من لفت الانتباه إلى الظاهرة الستّينية “عراقيًا” وحاول التنظير لها، حين ألقى محاضرة عن “جيل الستّينيّات” في اتحاد الأدباء ببغداد العام 1974، بعد أن كان الحديث عنها عربيًا. أما “فلسطينيًا” فقد كان غسان كنفاني السبّاق إلى ذلك حين كتب عن أدباء الأرض المحتلّة وعرّفنا بشعراء المقاومة، وخصوصًا بعد العام 1967، وجاء على ذكر محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زيّاد، والروائي إميل حبيبي والكاتب المسرحي توفيق فياض، وهؤلاء معظمهم ينتمون إلى “جيل الستّينيّات” حتى وإن كان بعضه أبعد زمنيًا.
وكان ذروة صعود الحركة الستّينية على المستوى العالمي في العام 1968، وخصوصًا في فرنسا، التي فاض الحديث عنها بعد ذلك في عدد من البلدان الأوروبية وبعض بلدان أمريكا اللاتينية، ارتباطًا بحركة الاحتجاج العارمة التي شهدتها والتي سنأتي على ذكرها.
مصطلح “التجييل”
بقدر ما كان مصطلح “جيل الستّينيّات” دليلًا على التميّز أو التمايز في الوسط الأدبي والثقافي، فإنه كان مصدر التباس أحيانًا وربّما إبهام وغموض، فلم يُذكر إلّا وثار الجدل حول معناه ومضمونه ودلالته، سواء من الذين نسبوا أنفسهم إليه أو من الذين عارضوه وشكّكوا في أغراضه، ناهيك عن بعض التساؤلات المشروعة عن عملية “التجييل”، فإذا كان هناك جيل ستّيني، فهل هناك جيل خمسيني أو أربعيني، وبعد ذلك سبعيني وهكذا؟ بحيث ينصرف الاعتقاد إلى أن كل عقد من الزمان يمثّل جَدّة أو افتراقًا أو تمايزًا لجيل يختلف عن الجيل الذي سبقه لدرجة “القطيعة” أحيانًا.
ليس هذا فحسب، بل إن المصطلح تعرّض “عراقيًا” حسب فاضل العزاوي للاتهام من جانب جهات سياسية مختلفة، بحيث تم وضعه رديفًا لليأس والهزيمة ومعارضة الاتجاهات الثورية وتقليد الغرب والتنكّر للتراث، والأمر سيّان، سواء باسم “الواقعية الاشتراكية” أو “القيم القومية”، وبتقديري إن السبب الأساسي هو أن الأحزاب الآيديولوجية والشمولية صَعُبَ عليها قيام اتجاهات ثقافية وأدبية خارج سيطرتها.
إن محاولة البحث عن رؤية جديدة وأدب جديد وتجاوز ما هو سائد كان الهمّ الأساسي لنخبة وجدت نفسها خارج السياقات الفكرية والأدبية القائمة التي لم تعد تعبّر عن تطلعاتها، وأخذ مثل هذا الهاجس يتولّد لدى عدد من الأدباء والفنانين والنقاد والكتّاب والسياسيين من مختلف الاتجاهات والمدارس الفكرية، على الرغم من أنّهم لا يمثلون تيارًا واحدًا أو حتى حركة فكرية متجانسة، ناهيك عن تاريخ موحّد، لكن الرغبة في تجاوز القائم والبحث عن وسائل جديدة للتعبير، سواء بالكتابة أو باللوحة أو بالقصيدة أو باللحن والأغنية بالاحتجاج المباشر والرفض للقوالب والكليشيهات، كان هو الدافع في ولوج فضاء الحداثة الجديد والرغبة الطليعيّة والمتمايزة عن الجيل الذي سبقه.
لم يكن إذًا نشوء “جيل الستّينيّات” اعتباطًا، بل ظهر وتبلور وعيه في خضمّ معاناة شديدة وقاسية ومفارقات بعضها متناقضًا وحادًّا، حيث اجتمعت فيه أحيانًا عوامل النجاح مثلما صاحبتها عوامل الإخفاق، كما تبادل فيه اللّاعبون الأدوار بين الحرّية والعسف، بما فيه منظور كل “جماعة ثقافية وفكرية وسياسية”، ولهذا ترى الاختلاف قائمًا وشديدًا في الكثير من الأحيان في تقييم المراحل أو الفترات الزمنية على تداخلاتها وتناقضاتها، ولكن محصّلتها الأساسية كانت شعور عام بالخذلان والقنوط وتبدّد الأحلام.
وهكذا انطلقت ظاهرة الستّينيّات ردًّا على ما ساد من ظروف موضوعية وذاتية عربيًا ودوليًا كحساسية ثقافية وأدبية جديدة جرى التعبير عنها بأشكال متنوّعة في الكتابة والفن والأدب بأنواعه المختلفة، إضافة إلى العلوم والاكتشافات العلمية، وسرعان ما أثّرت تلك الأوضاع على الجوانب السياسية والثقافية والأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية والقانونية والموقف من المرأة ونظام التربية والتعليم وكل ما يتعلّق بالأخلاق والسلوك بتمايز أو تميّز اختلف عمّا سبقه، بل كان ناقدًا له، إضافة لما تلاه من حركيّة فكرية وثقافية وسياسية.
وإذا كان ذلك قد حصل في الستّينيّات فهل يا ترى انتهت الستّينيّات أم انتهى مفعولها أم ما زالت تأثيراتها قائمة؟ وماذا حلّ بجيلها؟ أوليس ما يدركنا ويمتدّ إلى ما بعده هو من صُنعها؟ أم ثمّة في الأمر مبالغة وتضخيمًا لواقع الحال؟ ومهما كانت التقييمات فما زال البعض يعيش نستولوجيا تلكم السنوات التي ظلّت تسكنه أو يستحضرها في حنين وشوق خاصّين، بل ويتعرّف من خلال كتابات لصيقة بها على جوانب لم يولِها اهتمامًا كافيًا أو لم يتوقّف عندها طويلًا في تلك الفترة.
نشرت في جريدة الزمان (العراقية) على حلقتين في 24 – 25 نيسان / إبريل 2022.




