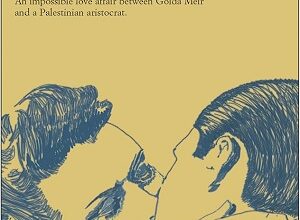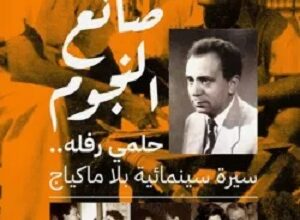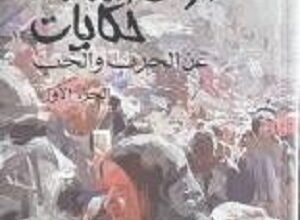خاطرات سعيد توفيق تطرح أسئلة الحياة والوجود

أسئلة الوجود في الحياة، والحياة في الوجود، بمختلف تجليات مستوياتها العميق، أسئلة تمتد من الطفولة إلى الشباب وانتهاء بخبرات مراحل الحياة العلمية والعملية وتشابكاتهما مع الواقع المحيط إنسانيا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا.. إلخ، هذه الأسئلة تشكل المحور الرئيسي والجوهري لتأملات أستاذ الفلسفة والناقد والمترجم د.سعيد توفيق في كتابه “الخاطرات.. سيرة ذاتية فلسفية”، فأسئلته تمتد إلى كل التفاصيل لتقبض بجوهر معاناتنا في فهم قضايانا ومشكلاتنا وهمومنا ذات العلاقة بالحياة والحب والموت والصداقة والروح والجسد والفن والكتابة و..، ويطرحها ويعالجها بأسلوب أدبي بسيط وعميق في آن واحد وبعيد تماما عن تعقيدات الفلسفة ومصطلحاتها. لنستعيد حوارنا مع وجودنا الحي في مواجهة ما يجري حولنا ومعنا.
ويوصف توفيق في مقدمته لتلك الخاطرات الصادرة عن مؤسسة بتانة “ليس هذا الكلام الذي أقوله هنا بنصوص فلسفية خالصة، ولا هو بنصوص أدبية خالصة، وإنما هو كلام يقع في منطقة بين هذا وذاك، إنه التفلسف الذي يريد أن يعبر عن نفسه بطريقة أخرى غير طرائقه المألوفة التي كثيرا ما تتسم بالوعورة والجفاف، حتى أنها تبدو أحيانا عسيرة على فهم من لا يعرفون مسالكها ودروبها، لم يألفوا مصطلحاتها وعلاماتها. الكلام الذي أقوله هنا يعبر عن كثير من التفلسف بلغة غير لغة الفلسفة الشائعة، فهو يقول من خلال لغة الحكي وتأمل الذكريات والأحداث والمواقف الشخصية، حتى حينما يريد أن يعبر عن أعمق المواقف الفلسفية؛ أعني أنه يتأمل العام والمجرد من خلال الخاص والمشخص؛ وهذا يجعله على حدود فن المقال الأدبي الذي يلجأ إلى أسلوب الحكي، بناء على أن حياتنا في مجملها هي سلسلة من حكايات لا تنتهي. وربما تكون الحياة نفسها مجرد كبرى في عقل الله الذي سماه ديكارت المهندس الأكبر. غير أن ديكارت كان يتأمل الكون الفيزيقي والرياضي المجرد الذي يهندسه الله، لكنني أتامل هنا الكون كما يحيا فيه الإنسان من خلال تجربة حية معيشة توجد في إطار زماني مكاني ما: تجربة الحياة والوجود”.
ويضيف “تركت نفسي لما يمليه عليها تأمل التجربة التي قد تستثار بفعل خبرات نمر بها، ولكنها تأبى أن تتركنا، بل تحفر في نفوسنا أخاديد عميقة يصعب محوها، وإن تحيلنا على إغفالها في زحمة الحياة وعتمتها، أعني غشاها السميك الذي كثيرا ما يحول دون فهم حقيقة شيء من خلال تفاصيل لا تحصى، ومن ثم فإن التأملات الواردة هنا لا تشبه شيئا من تأملات ديكارت العقلانية الباردة التي تتصور أن الحقيقة فكرة مكتملة جاهزة يمكن بلوغها من خلال منهج عقلاني مصطنع، وإنما هي تشبه تأملات الوجوديين وفلاسفة الوجود والحياة على اختلاف شاكلتهم، فيها شيء من روح شوبنهاور وهيدجر وسارتر وميرلوبونتي وباشلار وغيرهم، ولكنها لا تتماهى مع أي منهم في الوقت ذاته، لأنها وليدة التجربة المعيشة التي علمونا أن ننصت لها على الدوام باعتبارها تجربة متجددة تجدد الحياة ذاتها، وما علينا سوى أن نقتنص شيئا من معناها كما يتجلى في سياقها الحي المعيش، إن كنا موجودات إنسانية حقا، جديرة بها أن تتساءل عن معنى حياتها ووجودها”.
يتساءل توفيق: ما غاية الحياة؟ ويقول “ذلك سؤال من أصعب الأسئلة على الاطلاق؛ وربما كان آخرها ومآلها؛ لأنه سؤال جامع لغيره من الأسئلة الكبرى: ما معنى الحياة ذاتها.. ما معنى الوجود ذاته؟ وما الغاية من وجودنا؟ أم أن وجودنا محض مصادفة وعبث بلا غاية؟ إننا لا يمكن أن نسأل هنا: لماذا كنا أصلا؟ ولم لم نكن؟ فذلك سؤال يجيب عنه الإيمان وحده، لا التفكر الخالص أو التأمل الفلسفي، فكل ما نعرفه أننا موجودون.. إننا نحيا ونعيش هذا الوجود. فما معنى الحياة؟ وما غايتنا منها؟”.
ويشير “الحياة في أبسط معانيها هي التواجد الذي يتواصل من خلال التكاثر والنماء وما يعين عليهما؛ ومن ثم فإن كل أشكال الفناء والموت أو ما يؤدي إليهما هي عدو الحياة، من قبيل الحرب، والإبادة والدمار والتناهي الطبيعي بفعل الزمن في آخر الأمر. ومع ذلك، فإننا نعرف يقينا ـ من خلال ما نشاهده في تأملنا لمجمل وجودنا ـ أن الحياة والموت صنوان لا يفترقان: من الحياة يولد الموت، ومن الموت تولد الحياة، وهكذا إلى حيث لا نهاية نعرفها. في كل أشكال الحياة هناك إرادة تكمن فيها.. إنها إرادة الحياة التي قال بها شوبنهاور وأطلعنا على صورها التي تحصى. ولكن هذه الإرادة ـ إرادة الحياة ـ لا يمكن أن توجد بدون صراع مع عدوها الأبدي، وهو الموت. وهكذا فإن الحياة صراع وكفاح أبدي في مواجهة الموت.
ويستدرك توفيق “لكن السؤال الذي يبقى ملحا علينا هو: وما موقعنا من هذه الحياة؟ هل نحن نحيا ـ أو ينبغي أن نحيا ـ كغيرنا من الموجودات الحية؟ أم أن هناك غاية أسمى لحياتنا؟”. ويقول “تشهد التجربة بأن غالبية البشر يحيون كما تحيا رغم فنا الأفراد. يتجه البشر إلى تلك الغاية دون وعي، كما لو كانت هناك إرادة لا واعية فيهم تدفعهم إلى ذلك دفعا. تخيل معي كيف يمكن أن يكون هذا العالم، لو كان بدون نساء على سبيل المثل؟ تخيل معظم الأشخاص الذين تعرفهم، بناء على هذا الافتراض! يتدافع الرجال للحصول على المجد والقوة والجاه والثروة من أجل النساء في نهاية المطاف، وتتدافع النساء من أجل الحصول عما جناه الرجال من أجلهن. لا ينجو من هذا التدافع العبثي إلا من أدرك ووعى أنه إنسان، جدير بأن يحيا على المستوى الذي يليق بإنسانيته التي وهبت له كموجود بشري. إنسان جدير بحياته التي وهبت له؛ فالإنسان قد وهب الحياة ليبقى، ليس باعتباره نوعا فحسب، وإنما باعتباره فردا خلق ليبدع أو يصنع شيئا يبقيه بعد مماته، فبهذا وحده يتواصل النوع البشري ويبقى على وجوده الجدير به، ويحقق معناه أو غايته، وبدونه ينحدر إلى رتبة القطيع والحيوانات وربما انحدر إلى رتبة الكائنات غير الحية”.
ويوضح “تمضي الحياة وتمرق بنا، كزمان يطوي الأمكنة بما تنطوي عليه من مشاهد ومواقف وأحداث، وأمام هذا الزمان المكاني الذي يمضي ويفارقنا في كل لحظة، نشعر أننا نؤول إلى الزوال، وأن وجودنا الزماني يفلت من بين أيدينا باستمرار. ولا سبيل إلى مقاومة هذا الزوال إلا من خلال الإبداع الحقيقي الذي يسعى إلى إبقاء اللحظة الزمانية وتثبيتها إلى الأبد! وهكذا فإن الإبداع ينطوي على الاحتفاء بالحياة في مواجهة الموت والزوال. ترى ألهذا كان إبداع المصريين القدماء في غمار انشغالهم بالموت، هو حالة وجودية عميقة تحاول استبقاء الحياة في صورة أخرى بعد زوالها؟”.
يرى توفيق أن ظواهر الأخلاق ظلت مسألة محيرة بالنسبة لي؛ فهي من الكثرة والتنوع بحيث احتار أمري في الإحاطة بها، رغم أنني من حياتي الأكاديمية في كثير من الجامعات العربية. أذكر دائما يوما كنت أدرس فيه للطلبة نظرية من النظريات العديدة في الفضائل والقيم الأخلاقية، فسألتني طالبة نابهة سؤالا توقفت أمامه طويلا؛ إذا كانت الفضائل والقيم الأخلاقية أكثر قيمة من غيرها من القيم الأخلاقية، أي تعلو عليها بوصفها قيمة أولى تفترضها سائر القيم؟ توقفت وتأملت وقلت: أمهليني إلى الغد، كي يمكن أن أجد أنا أولا إجابة أرضى عنها مبدئيا. أمضيت اليوم كله بليله أتلمس إجابة، حتى لمعت في ذهني كلمة واحدة “العدالة”.. تلك القيمة الأخلاقية الكبرى التي تعلو على سائر القيم، وتلك هي الإلهة “ماعت” عند المصريين القدماء التي تحكم الكون، ويخضغ لها كل ما فيه”.
ويتابع إن حياة البشر في مجملها صراع بين العدل والظلم؛ فكل امرئ يكافح من أجل تحقيق ما يراه جديرا به، أي بإمكاناته، وبفعله الذي يستحق عنه ما يليق به، وبحقه الذي سلب منه ولم يلق عنه عوضا. إنه يكافح الظلم الذي وقع عليه. وكما يقع الظلم على الأفراد من قبل غيرهم، فإنه يقع عليهم من قبل من لهم سلطان عليهم، وخاصة حكوماتهم ورؤسائهم وولاة أمورهم عموما إن كانوا ظالمين. ولكن أكثر الشعوب والأمم ـ في كل زمان ومكان ـ يقع عليها أيضا ظلم من جانب أمم أخرى أشد بأسا ولكن الشعوب والأمم التي تأبى أن تبقى في موقف المستضعف المظلوم، هي وحدها الشعوب التي تنهض من أجل رفع الظلم والأذى عنها. وهذا الدافع الأخلاقي النفسي هو مبدأ تحررها ومستهل نهضتها، فلولا هذا التدافع بين الناس ـ أفرادا وجماعات ـ في مسالك الخير والشر أو العدالة والظلم ما كان الوجود على حاله التي هو عليها “وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا”.