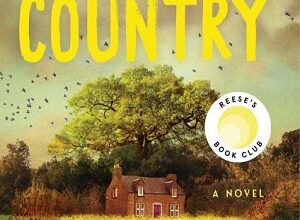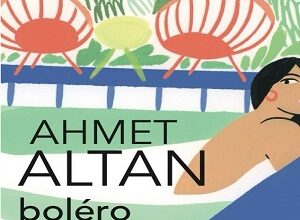«تاريخ البلدان يبدأ من السيرة الذاتية لكل أسرة». هذه الجملة التي لم ينطلق منها راهيم حساوي في روايته الجديدة «النشيد الأولمبي» (نوفل) بل وردت في المنتصف، كفيلة باختصار طبيعة النص الماثل أمامنا.
سيكون مملاً ورتيباً لو قلنا إنّ الجملة هاته تشير إلى أنّنا إزاء نص يقوم على تعالق بين الخاص والعام حيث الذاتي يتماهى مع العموميّ، كأن الدخول إلى السرديات الصغيرة هو المدخل السري لفهم أحوال وشؤون «الأسرة الكبيرة» أي الوطن، والسلطات، والهياكل الاجتماعية. كل هذا صحيح، بل يكاد يكون الطبقة السميكة والمرئية لرواية راهيم حساوي الجديدة، لكن ألا يحضر معنا، فور قراءتنا لهذه الجملة، استهلال تولستوي الشهير في روايته «الحرب والسلم»: «كل العائلات السعيدة تتشابه، لكن لكل عائلة تعيسة طريقتها الخاصة في التعاسة»؟
تجري أحداث رواية حساوي في زمن الحرب والسلم. في سوريا، وتحديداً في اللاذقية ودمشق. حيث الحرب تنهش الأحياء ولا تترك شيئاً على المائدة سوى الموتى والصحون الفارغة. في سوريا المنكوبة، هناك مجموعة من الشبان والفتيات «الطيبين» كأهل تلك البلاد. وقد بقوا في بلدهم ولم يهاجروا رغم الحرب والخواء الهائل الذي يعتريهم والذي يبسط نفسه على المدن. كل واحد من هؤلاء يعيش تعاسته بطريقته الخاصة؛ وبفضل المصادفة. سيلتقون ببعضهم البعض وسيصبحون أصدقاء مقربين. وسيتشاركون تعاستهم، وأحلامهم، وجوعهم أيضا. وسينجحون في نهاية المطاف في تحويل الحياة، حياتهم، إلى مسرحيةٍ بهيّة.
رواية راهيم حساوي : رواية درامية تتعمد تحدّي موضوعها الدراميّ
ينطلق راهيم حساوي من الدراما المترامية في الواقع السوري، ويدلف إلى يوميات أصدقاء يرزحون تحت وطأة الحرب، ويسرد محاولاتهم الحثيثة للخروج من سياقهم المفجع الذي لم يختاروه بل حلّ عليهم بكامل ثقله وبرودته. لا وجود لحبكةٍ رئيسية تأسر السرد وتدفع الراوي نحو تصعيد الإيقاع السردي وتبديل مسارات أبطاله. الحبكة ببساطة هي الواقع السوري الذي تأخذه الرواية كفضاء عام، كعنصر بنّاء: إنها الحرب. بالتالي، لا سرّ سوف يتبدّى، ولا حكمة سوف تتضح ولا عبرة إيديولوجية تنتظرنا، لا شيء سوف ينكشف لنا سوى مصير هؤلاء الذين أصرّوا على خلق مصيرهم. يسرد حساوي، ببطء شديدٍ آسر، وبجملٍ طويلةٍ متينةٍ، سيَر تعساءٍ استطاعوا التغلب على تعاستهم. إنها رواية درامية تتعمد تحدّي موضوعها الدراميّ، إنها سيرة أصدقاء تعساء يحاولون محو تعاستهم عبر ملاعبة الخيال، وعبر التلاعب بمفردات الحرب، لذلك من غير المفاجئ أنْ تنتظرنا في الخاتمة نهاية سعيدة.
إنها رواية عن النجاة. حكاية رحلةٍ خاضتها مجموعة من الأصدقاء في مكانٍ واحد، أي في سوريا التي أبوا أن يرحلوا عنها، لكنهم أرادوا الانفكاك عن سياقها الدراميّ. أرادوا النفاد من سطوة الحرب؛ إنها رحلة بحثٍ عن زمنٍ مختلفٍ، عن مستقبلٍ مرجوّ فيه سلمٌ وأملٌ يغيبان عن حاضر أبطال الرواية. ففي «النشيد الأولمبي»، تهيمن الحرب على المكان. هي زمنٌ مستمر ومتدفق، بينما السلم مشروع فردي قيد الإنجاز. السلم زمنٌ مفقود في مكانٍ شديد الخراب، لكن أبطال الرواية يسعون إلى إيجاده، إلى ابتداعه، ويأبى، السلم، أن يحضر إلا في أماكن مشيّدة بجدران: في مقهى «زهرة عباد الشمس»، في «بوتيك جوجو»، ودائماً في منزل علياء. الكلمة الأدق من منزلٍ هي البيت: بيت علياء. لأن بيت علياء هو الأولمبياد. عندما نقرأ تاريخ البلدان، تاريخ الإغريق مثلاً، نجد أنه خلال الألعاب الأولمبية (واسم الملعب الأولمبياد) كان يتم تأجيل جميع النزاعات بين دول المدن المشاركة حتى انتهاء الألعاب.
بيت علياء ذاك الملاذ المهيب الذي يحمي من فيه ومن يدخل إليه من هيبة العسكر،
لقد شكل بيت علياء حصناً منيعاً، ملاذاً آمناً حيث جدرانه تفصل خارجه عن داخله: كان بيتها يفصل بين مدينةٍ صارت قبراً وبين مدينةٍ فاضلة يسعى سكانها، والأصح زوارها، أنْ يبتكروها عبر اللعب. لقد كان بيتها أشبه بالأولمبياد، لقد كان ذاك الملاذ المهيب الذي يحمي من فيه ومن يدخل إليه من هيبة العسكر، ومازوشية رجال الأمن، ومن الأثر الذي نقشته الحرب على الوجوه وعلى الصخور. كان بيتها مطبخاً سحرياً يقضي على الجوع العارم رغم تقشف مكنوناته وتعاسة قصصه. وحده بيت علياء يستدعي السلم، لا يؤجّله، إنّما يستحضره كأعجوبة.
وعندما نقرأ في «النشيد الأولمبي» عن السير الذاتية للأسر، فنحن نقرأ تاريخ الحرب، وتاريخ البؤساء أيضاً. النفحة التولستوية جليّة في رواية حساوي: سيرة الأسر طافحة ببؤس ضارٍ عرفته روسيا لقرون. إنها سيَر متلفَة، خرّبها الفقدان، والموت أيض.ا و«الغلاء الذي لا يسمح لأحد أن يفرّط ببيضة واحدة لرمي ممثل فاشل». حال الأسر هذا، هو حال سوريا. بدلاً من قطعة الخبز التي تشبه الهراوة أكثر من كونها خبزة. مع خلفية مضرجة باللون البني، وهي لوحة تعبيرية تمثل الضنك الذي عرفته المنازل الروسية في القرنين الثامن والتاسع عشر، هناك ثلاث بيضات والقليل من الخضار في مطبخ علياء التي سألت والدها إذا كان يفضل أن يقلى البيض أم يسلق.
على الإنسان أن «يكون شاهداً على الحياة، لا أن تكون الحياة شاهدة عليه».
هذه هي اللوحة التي يرسمها حساوي في المقطع الأول من الرواية. لكن أولاد هذه الأسر، وهم أبطال رواية حساوي، ولو لم ينأوا عن البؤس المدقع الذي أغرق أسرهم، ولو أنهم ورثوا من أسرهم الخوف من التلاشي وتجارب الإخفاق ومشاعر الحداد، غير أنهم عازمون على المضي قدماً، إذ على الإنسان أن «يكون شاهداً على الحياة، لا أن تكون الحياة شاهدة عليه».
الأولاد مصممون على طبخ مصائرهم مثلما سبق ونجحوا في تحضيرهم السلم في بيت علياء. إنهم جائعون إلى ابتكار مصائرهم عوَضاً عن انتظار الطبق حتى ينضج. أبطال راهيم حساوي ليسوا أبطالاً إغريقيين، لن نجد أحداً منهم يذعن لقدره أو يتباهى بقوته وبفضائله،. مثلما لن نجد أحداً منهم يريد تطهير العالم من براثن الشر. لن نجد في أبطال حساوي سوى جروحٍ غائرة، وذكريات لادغة تكاد تسبب لهم أوراماً، والحب تجاه أشياء لا يملكونها. حزن علياء الطويل على والدها الحزين، وعلى الموت الملتبس الذي أصاب شقيقها. ومع ذلك، فهي تواظب على التفتيش عن السكينة والهدوء. بديع المعروف بعلاقته المضطربة بوالده، الذي أخفق في امتحان الدخول إلى المعهد لكنه يواصل حلمه في أن يكون مسرحياً. لوكاس الطيار الروسي محطم مثل طائرة حربية تم إسقاطها، بيد أنه يفتش عن مغامرة تنتشله من وحدته وتكون مدوّية أكثر من صوت القنبلة.
أبطال راهيم حساوي هم لاعبو أولمبياد من الطراز الرفيع.
أبطال راهيم حساوي ليسوا أبطالاً إغريقيين ولا يشبهون هرقل أو أيّاً من أبطال الإغريق بشيء، لكنهم لاعبو أولمبياد من الطراز الرفيع. ذاك أنهم أشخاصٌ تشتعل فيهم الرغبات: رغبة الخروج من الموقف الذي أغرسوا فيه. يمتازون بموهبة اللعب: ملاعبة الخيال والتلاعب بالكلمات. إنهم يعلمون أنّ العيش في خضم الحرب لهو أشبه بملحمةٍ لكنها ملحمة لا تعنيهم، فلا أحد منهم يريد إحراز البطولات أكثر مما يريد القبض على الصوت الذي يطارده داخل رأسه. إنهم يعتكفون عن الانصياع لفكرة الحتمية التي تبدو عليها الحرب: يرفضون أنْ يكون النقص الذي يعتريهم، أي حبّهم تجاه الأشياء التي لا يملكونها، عطباً مزمناً، أي زمناً مستمراً، فنراهم ينحون صوب هذا النقص بغية ملئه ثم طمسه. كأن راهيم حساوي يكتب سيرة أولاد تلك الأسر- وهم في الحقيقة جيلٌ كاملٌ- الذين يريدون كتابة سيرتهم الذاتية خارج سيرة البلد الذي يعيشون فيه. لهؤلاء شهية جارفة تجاه الحياة، على عكس الحرب التي قتلت كل شيء بمن فيهم الأحياء.
هناك جوع طافحٌ غير مرئيِّ في رواية حساوي. لا نسمع أصوات البطون، والمعدة لا تخرخر. لا أحد يبوح بجوعه، ليس خجلاً أو كتماناً. بل لأنّ الجوع يمتد من الرغبات الجوانية، بأشكالها كافة، وصولاً إلى اشتهاء الخضار وانتقائها من محل الخضرجي. في «النشيد الأولمبي»، يفصح الجائع عن جوعه عبر اللعب، بل يكاد الجائع يأكل جوعه باللعب. هكذا نجد معجم حساوي زاخراً بالطعام والشراب، مثلما نجد مقاطع طويلة تمجّد اللعب وتنظّر له. ثمة خواء رهيبٌ خلّفته الحرب وراءها، ووحدهم الأموات في «النشيد الأولمبي» شعروا بالتخمة ربما لأنهم مدفونون تحت التراب.
في اللعب وحده يحيا الإنسان.
أبطال حساوي جائعون إلى الحياة، إلى السلم، إلى مستقبلٍ تنحته أياديهم، وهم لا يرومون الشبع إلا عندما يجدون ما يحبونه. وإذا ما وجدوا هذا الحب، فلن «يدعوه يقتلهم» مثلما كتب بوكوفسكي («جد ما تحبه ودعه يقتلك») بل بمجرد أنهم وجدوه سيكتفون بذلك. عند حساوي، ليس الشبع هو الغاية الأخيرة بل المضغ. فالحرب تقطّع الأوصال، وتشعِر ناسها بالتهاوي. لذلك جلّ ما يريده أبطاله هو تحسس ذاك الذي اشتهوه بعدما بات بين أسنانهم. ذاك الذي كان ناقصاً بالنسبة إليهم ولم يعد كذلك لأنهم نجحوا في إيجاده.
إنه اللعب إذاً «فكرة الألعاب ليست مجرد تمرير للوقت بل تحمل في طياتها الكثير من رغبات الإنسان». اللعب بما هو تكثيف للرغبات، يتحول مع حساوي من أسلوب تعبيرٍ إلى أسلوب عيش، لأنه في الحالتين، يتيح الخلاص. لم يكن أبطال حساوي الأولمبيون لينجحوا في البقاء على قيد الحياة وتحمل كل هذا الجوع لولا اللعب. ولو قدّر لهم أن يكتبوا نشيدهم الأولمبي لكان عنوانه: في اللعب وحده يحيا الإنسان.
صحيفة الأخبار اللبنانية