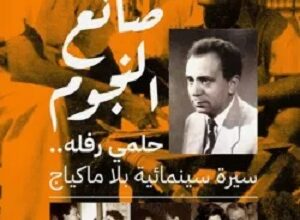سبع قصص وأربع روايات قصيرة لتشيخوف لأول مرة بالعربية

يبدو أن التوق إلى ترجمة القاص والمسرحي الروسي أنطوان تشيخوف لن تنتهي، حيث لايزال هذا الكاتب الذي امتد أثر كتاباته قصة ورواية ومسرحية باق حتى الآن على كتابات مختلف الأجيال غربيا وعربيا، تلك الكتابة التي أنجزت تطورا متميزا في القصة القصيرة والمسرح بشكل خاص.
وقد اختار وترجم السوري ياسر زمو مجموعة من القصص القصيرة والروايات القصيرة التي تترجم لأول للعربية، في كتابين أولهما “أنطوان تشيخوف.. قصص مختارة” ويضم سبع قصص قصيرة، والأخر “أنطوان تشيخوف.. روايات مختارة” ويضم أربع رويات قصيرة، وقد صدر الكتابان عن دار خطوط وظلال الأردنية.
لا تختلف القصص والروايات المترجمة في الكتابين في عمقها وثراء دلالاتها وتماسها الإنساني عن مجمل ما قدمه من أعمال، لقد بدأ تشيخوف وفقا لنقاده ومؤرخو سيرته نشاطه الأدبي كاتب منمنمات فكاهية، وارتقت موهبته الفذة بهذا الصنف الأدبي شكلاً ومضموناً حتى أوصلته إلى قمة الإبداع الفني، كما في أقاصيص موت موظف (1883)، والحرباء (1884)، ووحشة (1886).
وكتب في غضون السنوات الخمس الأولى من نشاطه الإبداعي نحو (400) أقصوصة ومُلحة وأُسخورة (خاطرة نقدية ساخرة) صوّر فيها شخصيات تنتمي إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، وسلّط الضوء على طباع أبطاله، فاضحاً صغار النفس، وضيق الأفق، وبلادة الحس والذهن، وساخراً من التفاهة والنفاق والجبن والقسوة، وكل ما يحرف الإنسان عن إنسانيته ويشوّه حياة المجتمع.
ومنذ النصف الثاني من ثمانينات القرن التاسع عشر شرع تشيخوف بتناول موضوعات وظواهر اجتماعية تتسم بالعمق والأهمية والشمول في أقاصيص مثل الأعداء والشحاذ، والقبلة. وكتب قصصاً طويلة ذات طابع وجداني نفسي ومحتوى اجتماعي فلسفي كانت مرحلة انعطاف في مسيرته الإبداعية ومنها: الأضواء، وحكاية مملة.
يقول أستاذ الأدب الإنكليزي سعدي عبداللطيف، في الدراسة التي أعدها وترجمها لاستاذ الأدب الروسي والموسيقى في جامعة درهام في المملكة المتحدة روزاموند بارتلت، ونشرت على موقع الحوار المتمدن “قصص تشيخوف تربك، منذ البداية ذاتها، قارئها. واحد من أوائل التقييمات في اللغة الأنكليزية لنثر تشيخوف جاء من قلم الصحافي والمغامر الواسع المعرفة والذي أصبح بعدئذ بروفسورا في فقه اللغة التاريخي المقارن في جامعة خاركوف”.
وصف أميل ديلون في عام 1891 تشيخوف في صحيفة أدبية تصدر في لندن بأنه “رسام الصور المنمنمة الذي يغوص بشجاعة في اعماق محيط الحياة الانسانية ويعرض – مزقا وأعشابا بحرية”.
كما كتب اف. جي. ديلون، (“الأدب الروسي الحديث” ريفيو اوف ريفيوز، تموز – كانون الأول1981)، واستشهد بالوصف كتاب فيكتور ايملجانو، “تشيخوف: التراث النقدي، لندن 1981”.
وحدث بعد عدة عقود تشبيه جزئي له علاقة بالبحر لكن أقل اطراء أعلنته الشاعرة الروسية آنا آخماتوفا والتي شجبت عالم تشيخوف باعتباره “كئيبا بانتظام” قائلة “بحر من الطين وقعت في شراكه مخلوقات انسانية تعيسة لاعون لها”.
وكان ديلون يكتب عندما كان تشيخوف ما يزال في بداية مهنته ككاتب رئيسي. وراود ديلون احساس أن أمام الطبيب الشاب معظم أعماله العظيمة التي لم يكتبها بعد، ومع ذلك ما أثار أعجابه “بصيرة تشيخوف الثاقبة”، و”هدوءه الأملس وموضوعيته الفنية”. وكما لاحظ، عن حق، إنها خاصية “من المحزن ان زملاءه يفتقدونها”. وهذا تقييم حاد الذكاء”.
ويضيف أن تشيخوف ذاته، أعترف بأنه ميال الى امتلاك الأحساس بالرثاء عندما يعزف ضيوفه على البيانو طول اليوم في الغرفة المجاورة للغرفة التي خصصها لمحاولاته للكتابة القصصية.
ومناظر الطبيعة الروسية المتشحة بالكآبة والتي يجدها معظم الناس مثيرة للحزن هي التي كانت تلهم أعماله، ولم يكن بالأمر الغريب، أيضا، ان يكتشف تشيخوف الجمال في تلك المساحات الفسيحة الرتيبة للسهوب. وفوق كل ذلك، كان تشيخوف يعرف طوال حياة النضوج القصيرة انه سائر في طريق الموت سريعا وقبل الأوان، بعدما بدأت علامات مرض السل تظهر وهو لما يبلغ ال 24 من العمر.
ومهما حاول، وبشجاعة في التستر على هذا المصاب، إلا ان تأثير هذا الإدراك على المسحة العامة لكتاباته لا يمكن التنبؤ به، فالنغمة الجادة في أعماله تبدأ، تحديدا، في هذه المرحلة. لكن بعد رحيل تشيخوف، بدأ قراءه الأذكياء ملاحظة ان هناك الكثير من تشيخوف يحلق أعلى من مجرد المسحة الرثائية. وكما يفترض انه قال مرة لمكسيم غوركي “أن تعيش من أجل أن تموت أمر ليس مضحكا تماما، لكن أن تعيش وأنت تعرف أنك في طريقك إلى الموت قبل الأوان أمر مطلق الغباء ليس إلا”.
ويوضح أن وعي تشيخوف الدائم بعبث الحالة الإنسانية ضمنت أن هناك، على الأقل، مستوى واحد من التهكم في كتاباته. أما تصنيف ذلك على اعتباره “تشاؤميا” فهو، لذلك أمر مختزل وزائد عن الحاجة على حد سواء، كما لاحظ الناقد الانكليزي ويليم جيرهاردي في كتابه، أنطون تشيخوف: دراسة نقدية – لندن 1923، وتم الاستشهاد بها من قبل رينيه ويليك ـ “مقدمة الى تشيخوف: وجهات نظر جديدة، 1984” ـ في دراسته النقدية عن تشيخوف لعام 1932 والتي تعتبر من اولى الدراسات بين جميع اللغات: فالحياة بالنسبة لتشيخوف “ليست مرعبة ولا بهيجة، لكنها فريدة، غريبة، سريعة الزوال، جميلة وبغيضة”.
مقتطف من قصة “عن الحب“
في اليوم التالي على الفطور قدموا لنا فطائر شهية للغاية، وجراد البحر، وشرائح من لحم الضأن. وبينما كنا نأكل طعامنا، صعد الطاهي نيكانور إلى الدور العلوي ليسأل الضيوف ما يشتهون تناوله على العشاء. كان رجلاً متوسط القامة، بوجه منتفخ وعينين صغرتين، حليقاً تماماً، وبدا كأن شاربيه لم يحلقا، وإنما تم نتفها نتفاً.
أخبرنا آلخين أن بيلاجيا الحسناء واقعة في حب هذا الطباخ. وبسبب إفراطه في الشرب وطابعه العنيف، لم ترغب في الزواج منه، لكنها كانت مستعدة للعيش معه دون زواج. وكان هو رجلاً متديناً، ولم يسمح له إيمانه بالعيش في الخطيئة، فأصر على زواجها منه ولم يوافق على أي شيء آخر، وكان عندما يسكر من فرط الشرب يرشقها بالسباب، بل يضربها. وفي كل مرة يثمل فيها تختبئ في الدور العلوي وتنتحب، ويبقى آلخين والخدم في مثل تلك الأوقات في البيت ليكونوا مستعدين للدفاع عنها في حال دعت الحاجة.
وبدأنا نتحدث عن الحب.
وقال آلخين:
ـ كيف يولد الحب؟ ولماذا لم تحب بيلاجيا شخصا يلائم روحها ومظهرها؟ ولم وقعت في حب نيكانور ذلك الفنطيس القبيح؟ ـ جميعنا هنا يسميه الفنطيس ـ ولأن السعادة الشخصية مهمة في الحب، كل هذا يظـل غامضاً وبوسع المرء تفسر الأمر كما يشاء. حتى يومنا هذا قيلت حقيقة واحدة لا خلاف فيها عن الحب “الحب لغز كبير”.
وكل ما كتبوه عن الحب أو تحدثوا عنه لم يكن شافياً، بل مجرد طرح للأسئلة التي ظلت بدون جواب. إن التفسر الذي يبدو أنه يناسب حالة واحدة لا يعد مناسبا لعشر حالات أخرى، وأفضل شي في رأيي هو تفسر كل حالة لوحدها، دون محاولة للتعميم. ينبغي علينا، كما يقول الأطباء، تشخيص كل حالة على حدة.
وأقر بوركين:
ـ صحيح تماما
ـ نحن الروس، أبناء الطبقة المثقفة، مدمنون على هذه القضايا التي بقيت بدون إجابة. عادة ما يكون الحب شاعرياً ومزيناً، بالورود والعنادل، بينما نحن الروس نزين حبنا بمثل هذه الأسئلة المشؤومة، وفوق ذلك نختار أكثرها ضجرا. في موسكو عندما كنت طالبا، عشت مع خليلة شاطرتني حياتي، سيدة لطيفة، وفي كل مرة أطوقها بذراعي كانت تفكر ما إذا سأسمح لها بشهر من تدبير البيت، وكم هو ثمن رطل لحم البقر. ولذلك حين نقع في الحب فإننا لا نتعب أبداً من التساؤل في سريرة أنفسنا: أتراه صادقا أم صادقا أم غير صادق؟ معقولا أم غبيا؟ وما الذي سيؤول إليه هذا وما إلى ذلك. ليست أعلم ما إذا كان الحب أمرا حسنا أم لا، لكنه طريق غير مرض، ولا راحة فيه، فإنني على دراية بذلك.
بدا وكأنه يريد أن يحكي قصة ما. إن الناس الذين يعيشون العزلة دائماً ما لديهم شيء في قلوبهم يتلهفون للحديث عنه. في المدينة يزور العزاب الحمامات والمطاعم بقصد التحدث فقط، وفي بعض الأوقات يحكون للحضور والنوادل قصصاً مسلية ومشوقة، بينما في القرية عادة ما يكشفون عن عواطفهم أمام ضيوفهم. والآن بوسعنا من النافذة أن نرى سماء رمادية وأشجارا غمرتها الأمطار، في طقس مثل هذا ليس ثمة مكان تذهب إليه، وليس عندنا ما نفعله إلا حكاية القصص والإنصات.
وطفق آلخين يقول:لقد عشت في سوفينو وكنت أعمل في الزراعة منذ وقت طويل، منذ أن تخرجت من الجامعة. أنا سيد بليد في العمل اليدوي، رجل مكتب بالميول، لكن كان في رقبتي دين كبير على التركة عندما جئت إلى هنا، وبما أن على والدي بعض الديون لكونه أنفق الكثير على تعليمي، قررت ألا أسافر وأشتغل حتى أسدد الدين. وعزمت على ذلك وشرعت في العمل، والصراحة، ليس دون أن أشعر بشيء من القرف. الأرض هنا لا تثمر بالكثير، وإن كنت لا تريد الخسارة في الزراعة فعليك إحضار عمالة أقنان أو مياومين، ولا فرق في الأمر تقريباً، أو عليك أن تشتغل على مزرعتك على طريقة الفلاحين؛ أي أن تعمل بنفسك في الحقول ومع عائلتك.
لا يوجد حل وسط. لكن لم أكن في تلك الأيام على دراية بمثل هذه التفاصيل التافهة. لم أترك تربة من الأرض إلا وقلبتها، وجمعت كل الفلاحين والفلاحات من القرى المجاورة، وسار عملي على قدم وساق بشكل محموم. أنا نفسي حرثت، وزرعت، وحصدت، وكنت أشعر بالضجر والقرف، كقطة ريفية يدفعها الجوع أن تأكل الخيار في حوش المطبخ؛ جسدي تفتق، ونمت وأنا أمشي. خيل إليّ في البداية أنه بوسعي التوفيق ببساطة بين عيشة الكدح هذه وآمالي الثقافية؛ لذا كان من الجدير حسب ظني أن أحافظ على نظام ظاهري معين في الحياة. وقمت بعمل دور علوي لي هنا في أحسن الغرف، وأمرتهم أن يحضروا لي إلى هناك القهوة والخمرة بعد الغداء والعشاء، وحين آوي إلى الفراش أقرأ صحيفة “بشير أوروبا” في كل ليلة. ولكن ذات يوم جاء كاهننا، الأب إيفان، وشرب كل الخمرة في جلسة واحدة، وبشير أوروبا صارت بين يديه.
وكالعادة إبان فصل الصيف، خاصة وقت البيدر، لم أكن أظفر بالرقود عى سريري مطلقاً، وكنت أنام على الزحافة في المخزن أو في مكان ما في كوخ الغابة، أي قراءة هناك؟ وشيئاً فشيئاً نزلت إلى الدور السفلي، وصرت أتناول الطعام في مطبخ الخدم، ولم يبق من رفاهيتي السالفة إلا الخدم الذين كانوا يخدمون والدي والذي يوجع قلبي طردهم.