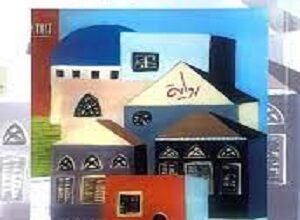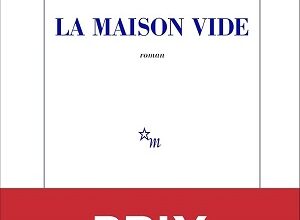عبد الفتاح كيليطو منقّباً في «لغة آدم»

هل حقاً لا يتساءل أحد اليوم عن لسان آدم؟ قد يبدو هذا التساؤل «ساذجاً» اليوم، وهو الذي كان طَرحُ القدماء له يكتسي طابع الجديّة والخطورة؟
في كتابه «لغة آدم» (أعادت منشورات Africamoude في الرباط إصداره أخيراً) تجشّم عبد الفتاح كيليطو (1949) عناء البحث المتشعّب ومشقّة التقصّي المضني ليقدّم إضاءات حول هذا الموضوع الشائك الذي يتقاطع مع مباحث فقه اللغة والتاريخ والفلسفة وعلم الكلام، معتنياً أساساً بمظهره الأدبي انطلاقاً من أقدم قصيدة في العالم منسوبة إلى آدم. إنّه إذن ليس موضوعاً ساذجاً البتّة. كيف اهتدى كيليطو إلى النبش في الزمن الأوّل؟ أثناء مطالعته للمؤلفات القديمة، عاين وجود مخزون هائل من «النصوص الهامشية التي لا يأخذها أحد مأخذ الجدّ» (ص. 7)، ومن هذه النصوص أقوال وأشعار تشرح أزمنة البدء. والباحث المغربي، بحسّه النقدي اليقظ وبمنهجيته الغنيّة المرنة، وبمعرفته الرصينة المرحة تعامل معها بشغف واهتمام بالغَين، فكانت دروسه الأربعة التي ألقاها في «الكوليج دو فرانس» عام 1990.
الطعام والكلام
كان تذوّق آدم وحواء بلسانهما للثمرة المحرّمة ـــ ثمرة معرفة الخير والشرّ ــــ إيذاناً بحدوث انشقاق ليس في لسان الحيّة (إبليس كان بين أنيابها بحسب المفسّرين المسلمين) التي أغوتهما، وإنّما أيضاً في لسان آدم، لأنّ معرفته أضحت مزدوجةً. في مشهد الخطيئة الأصلية، اقترن تذوّق الطّعام بتذوّق الكلام: الثمرة واللّسان المشقوق. سيورد كيليطو، عن هذا التلازم، مثالين آخرين: الصبيّان اللذان أراد ملك مصر، بحسب هيرودوت، أن يعرف أيّ كلمة أولى ستباغت لسانهما، كانت كلمة «الخبز».
ترافقت المطالبة بالطعام المطبوخ مع الكلام، وجسّدت انشقاقاً عن مرحلة الرضاعة والطعام النيء التي كانت تصاحبها أصوات مبهمة. الأمر نفسه تكرّر، وإن بصورة مختلفة، في قصّة «حيّ بن يقظان»: بعد محاولات آسَالْ المتكرّرة وغير المجدية للتواصل مع حيّ، «أشار إليه ليأكل زاداً كان قد حمله معه، ثمّ شرع يعلّمه الكلام» (ص. 13). الطعام والكلام مرّة أخرى. تحريك اللسان لتذوّق الطّعام هو الفعل ذاته للّسان نفسِه حين يتحرّك للنطق بالكلام. كان على آدم أن يأكل الثمرة حتى يُطرد من الجنّة ويهبط الأرضَ وتنشأ الدنيا وتبزغ اللغة المشطورة: «قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ». (سورة الأعراف). لعلّ التجلّي البسيط لهذه العداوة أن تكون بين كلمة طيّبة تشبه شجرة طيّبة، وبين كلمة خبيثة تماثل شجرة خبيثة كما وردت الصورة في سورة إبراهيم. هذا الاقتران بين الكلمة والشجرة دال ويوحي بأنّ اللّسان مزدوج عضوياً ولغوياً، «ولا يمكن أن يكون إلا مزدوجاً» (ص. 9).
المسكن واللسان
كيف تعدّدت ألسنة البشر، أو بالأحرى كيف تَبَلْبَلَتْ؟ يطرح كيليطو، بعد استقصاءٍ مُضْنٍ، مشاهد ثلاثة لبابل أو لباب الإله: كان البشر يريدون بناء مدينة وبرجٍ «رأسه في السّماء» (ص. 16)، ويبتغون إقامة اسم لهم حتى «لا يتشتّتوا على وجه الأرض»، كما وردت القصة في سِفْرِ التَّكوين. جوبِهَ الطموح لبلوغ السماء واحتلال المقام الإلهي بعقاب كارثي: نزل الربّ وبلبل لغتهم حتى «لا يفهم بعضهم لغة بعض» (ص. 16)، بل شتّتهم على وجه الأرض، وتبدّدت ــــ تبعاً لذلك ـــ أمنيتهم الأصلية بالبقاء مجتمعين. الأصل في اللسان التعدّد. في هذا السّياق، وبحذاقته المعهودة، أبصر كيليطو خيطاً رفيعاً يربط بين مشهد بابل ومشهد الفردوس: ما إخراج آدم وحواء من الجنّة سوى عقاب على انتهاك محرَّمَيْن: أكل الفاكهة يعادل المعرفة الإلهية، والطموح للأكل من شجرة الحياة يساوي الخلود. ما وجه الشبه بين المشهدين؟ اللّسان.
يقدّم كيليطو مشهداً آخر مأخوذاً من القرآن، يتعلّق بشخصية نمرود (وإنْ لم يَرِدْ اسمه في النص القرآني) الذي بنى الصّرح وشاء أن يكون إلهاً: «إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت» (سورة البقرة). كان العقاب أن أرسل الله ريحاً عاتية دمّرت الصرح والبيوت. ومن فزعهم تكلّم الناس «بثلاثة وسبعين لساناً» (ص. 18). تخرّب المسكن الواحد واللسان الوحيد. من الوحدة إلى التعدّد، من الاجتماع إلى التشتّت، هكذا كان مبتدأ اللسان ومنتهاه. لكنّ المشهد الثالث يعرض صورة مخالفة شيئاً ما، لأنّها تُحِلُّ محلّ العقاب ما يشبه «الاحتفال». فقد ذكر ياقوت الحموي في «معجم البلدان» أنّ الله جمَع الخلائق إلى بابل بأن أرسل ريحاً أتت بهم من كلّ جهات الأرض، فوزّع عليهم مساكنهم ولغاتهم (يعرب بن قحطان قصَد البيت الحرام وكان أوّل من تكلّم بالعربية). هذا المشهد الأخير يشي بشيء مضمر هو ما تنبّه إليه كيليطو بالعودة إلى «لسان العرب» لابن منظور؛ ذلك أنّ المخالفة بين ألسنة بني آدم هي آية من الله، كالمخالفة في الألوان وكخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والانتشار في الأرض، وليست لعنة. اللّسان في الأصل ألسنة، والمسكن في الأصل مساكن، سواء وقع التشتّت بعد الاجتماع أو حصل الاجتماع بين تشتُّتَيْن. هل لنا أن نتساءل عن لسان آدم؟ آدم مات قبل بابل، لكنّ السّؤال عن لسانه «لا يمكن أن يكون إلا سؤالاً ما بعد بابلي» يقول كيليطو.
الفردوس والمنفى
بأيّ لسان كان آدم يتكلّم في الجنّة؟ «إنّ الله سبحانه علّم آدم أسماء جميع المخلوقات، بجميع اللغات [..] فكان آدم وولده يتكلّمون بها» (ص. 22)، هذا ما يقوله ابن جنّي. وحتى بعد الهبوط إلى الأرض، لم يفقدوا، من بين ما فقدوا، ميزة التعدّد اللساني؛ «فكلّ الألسنة كانت مقدّسة، لأنّ الله هو الذي علّمَها» (ص. 23). لكن مشيئةً ما اقتضت أن يتفرّق بنو آدم في الأرض، فصار لكلّ ابن لغة غالبة عليه في فضاء مخصوص به، مع اضمحلال ما سواها من اللغات. «كلّ واحد نسي كلّ الألسنة، ما عدا واحد»، يقول كيليطو. أدّى هذا الوضع، في نظره، إلى حدوث انقلابين: حدث، ما قبل بابل، الانتقال من التعدّد في الألسنة (في إطار وحدة ما) إلى اللّسان الوحيد. أمّا ما بعد بابل، فوقع الانتقال من وحدة اللّسان إلى تعدّده (لكن في إطار تشتُّتٍ ما). هل ثمّة فارق جوهري؟ أمّا الانقلاب الثاني فيتمثّل في الانتقال من لغة الفردوس الإلهية إلى لغة الأمّ الأرضية، حين صارت لكلّ جماعة لسانها، ثمّ يقول كيليطو في عبارة مفعمة بحنين غامض: «يجد الإنسان نفسه، وهو المتعدّد اللّسان في البدء، في آخر الأمر وحيد اللّسان» (ص. 24)، لكن ما يعزّيه أنّ فكرة التعدّد اللساني الأصلي موفّقة ومرضية للجميع لأنّها «تطمئن كلّ واحد إلى مشروعية لسانه، وإلى انغراس لغته في الزمان الأول وفي فضاء الفردوس» (ص. 24).
لكن ما الذي أفضى به إلى الاهتمام بقصيدة آدم، برثائه لهابيل عند مقتله؟ في البدء، نلمح مشهداً مأساوياً نراقب فيه تحوّل أحوال الأرض، عقب الموت، من الخصب إلى الجدب، من حالة فردوسية إلى حالة الاختلاط والتبدّد. ألا يذكّر هذا بالانتقال من وضع اللسان الواحد إلى وضع الألسنة المشتّتة بعد بابل؟ كأنّ حصول كارثة تُصاحبه كارثة أخرى؛ من الخطيئة الأولى، إلى الجريمة الأولى، إلى اللّسان الأول! هذا تحديداً ما سيتعرّض له آدم إثر معصية الله. سيُحرم، عند طرده من الجنّة، من اللغة العربية التي كان يتكلّمها، لتُعطى له اللغة السريانية كلغة المنفى على الأرض. حياة اللغة الثانية تعادل موت اللغة الأولى. هذا يطرح سؤالاً بالغ الخطورة: كيف قال آدم مرثيته لولده هابيل بالعربية، وهي اللغة التي انمحت تماماً من كيانه؟ بعد بحث متشعّب في المصادر القديمة، يقدّم كيليطو الإجابة: لا يمكن لآدم أن يكون شاعراً لأنّه نبيّ، ومقام النبوّة يتنافى مع مقام الشعر، ثمّ إنّ آدم ألّف «أنشودته الجنائزية» نثراً مسجوعاً بالسريانية، مع التشديد على أن تتناقلها ذريّته بعده بلا انقطاع إلى أن انتهت إلى شخصية ملكية مهيبة هي يعرب بن قحطان. هذا الأخير كان «أوّل من ركب الخيل وتكلّم العربية وقال الشعر» (ص. 39). توصيف ذكره الثعلبي في «قصص الأنبياء» يمسّ جزئية مهمّة: أعاد يعرب الارتباط مرّة أخرى بلسان الجنّة (العربية) كما أعاد آدم الارتباط بها بعد التوبة والأوبة، مع فارق أنّ آدم نسي السريانية كليّاً، بينما يعرب ظلّ محتفظاً بها، فـ «هو أوّل مزدوج اللغة في تاريخ البشرية»، يقول كيليطو. خوّلت له هذه الازدواجية أن يترجم مرثية آدم من السريانية إلى العربية، وهو، بهذا الصّنيع، يعدّ أيضاً «أوّل مترجِم» (ص. 40).
كأنّ امتلاك لسان مزدوج هو، في العمق، عمل من صميم الترجمة، ثمّ إنّه عبّر بالمرثية من النثر إلى الشعر، مبرزاً معادلة خطيرة: العربية والشعر مقترنان بقران مقدّس (وهذا ما صار يمثّل ثابتاً من ثوابت نقّاد الشعر العرب القدماء). هل في العودة إلى لسان الفردوس رغبة في التخلّص أو على الأقلّ التخفّف من لغة المنفى؟ الشعر «نظم وانتظام»، بينما النثر «تشتت وانتشار». أليس في هذا المسعى حنين إلى البشر الأوّلين الذين كانوا يقطنون بيتاً واحداً وينطقون بلغة واحدة، وتوق إلى الانفلات من «البشرية اللاحقة، المتبدّدة جغرافياً ولسانياً» كما يقول كيليطو؟ إذا كان الشعر، بصورة ما، جزءاً من لسان الفردوس، فإنّ النثر، بشكل ما، هو لسان المنفى المتشكّل أيضاً من الترجمة واللغة المزدوجة. أيّ ثروة امتلكها بنو آدم منذ الزمن الأول!
لسان كيليطو
في بحثه المضني عن قصيدة آدم، يميّز كيليطو بين ثلاث فئات: من أوردت المرثية من دون التصريح برأي، ومن تقبّلتها بقدر من الارتياب من دون إصدار حكم أدبي، ومن استخفّت وسخرت منها لرداءتها الشعرية، وليس لأنّها منسوبة إلى نبيّ. أمّا كيليطو، وهو المنتمي إلى زمننا الحديث المتأخّر، فدافع عن أنشودة آدم الحزينة بأكثر من حجّة: إذا كان الانتقاص من قيمتها يعود إلى احتمال تعرّضها للانتحال (إمّا لانعدام المهارة أو لحذق كبير)، فإنّ عدداً وافراً من الأشعار المنحولة، في الأدب العربي، قد تحظى «بقيمة فنية كبرى» (ص. 50).
مسألة الانتحال ذات قيمة ثانوية قياساً إلى «حقيقة الفن». ثمّ إنّ عزل القصيدة عن سياقها والنّظر إليها بذاتها هو طمس لشرط جليّ: «إنّها جزء من محكي، وعنصر في مجموع، وحدث في قصّة» (ص. 51). تبقى الحجة الثالثة ذات مظهر احتفالي: يقدّم كيليطو الشكر للمؤلّف المجهول لأنّه «صنع، في خاتمة المطاف، الأبيات التي كان لا بدّ أن يقولها آدم» (ص. 52). ليس لحدث تراجيدي كالجريمة الأولى أن يحدث من دون أن يلهِم شعراً، وواضع هذه المرثية ـــ «محفّزاً بدافع اللعب أو بفتنة القناع» يقول كيليطو، قد نظم الأبيات التي كان آدم سيقولها لو كان شاعراً.
ما يتبقّى من هذه الدراسة التي حافظت وتحافظ، شأن كتابات كيليطو الأخرى، على طراوتها وعنفوانها، رغم مرور هذا الزمن على كتابتها ونشرها؟ فلينطقْ وليكتبْ من يشاء بأيّ لغة يشاء. إذا كان اختلاف الألسن (بما يعنيه كذلك من تباين في النطق في الأصوات والتلفّظ بالكلمات) منغرساً في الزمن الأوّل فيما يشبه التكلّم بجميع اللّغات، فلا معنى لتحوُّل مسألة اللغة إلى سجال يستثير الخصومة والعداء في ما يشبه «لن تتكلّم لغتي». والترجمة؟ هذه الهبة الإلهية العظيمة: «وعلّم آدم الأسماء كلّها» (سورة البقرة). آدم وولده كانوا يعرفون جميع الألسنة. ابن جني يقول إنّ الله علّم آدم أسماء جميع المخلوقات، بجميع اللّغات. وكيليطو يقول إنّ «من الجائز لهم أن يستخدموا عدداً منها في خطاب واحد» (ص. 22)، بل يستطيعون اللّجوء إلى اللّسان الذي يتلاءم مع المزاج واللحظة الزمنية والحاجة والرغبة. ألا يكونون، في انتقالهم من لسان إلى آخر، مترجِمين بالقوّة؟ ألا يجوز القول: في البدء، كانت الترجمة!
صحيفة الأخبار اللبنانية