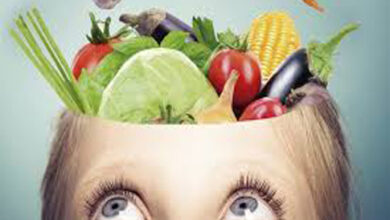عراق الإسلام السياسي المقاتل (طارق الدليمي)
طارق الدليمي
«إن الشرق الذي أيقظتم ينتظر لحظة ترجمة أفكاركم الصائبة حول تحالف الأمم الشرقية وحق كل فرد وكل أمة كبيرة كانت أم صغيرة مثقفة أم متخلفة بالحياة والاستقلال، إلى واقع حي». (رسالة الشيخ مهدي الخالصي إلى لينين ـ حنا بطاطو – الكتاب الثاني ـ ص 386)
من الجلي أن الرجل، الشيخ مهدي الخالصي، قد سبق عصره وتجاوز التقليد التاريخي لرجل الدين ودوره في السياسة. ويبدو أنه من خلال هذه الرسالة قد تراجع عن بيعته للملك فيصل الأول وسحب اعترافه بميلاد الدولة العراقية الجديدة بعد بقاء الاحتلال البريطاني بشكله الانتدابي المعروف. هل يمكن أن نعثر على هذا النموذج الآن في الحياة السياسية ـ الدينية في العراق بعد الاحتلال الاميركي في العام 2003. دأبت بعض الدراسات الاستشراقية ومنها بعض المؤسسات التحليلية الاستعمارية على تصنيف رجال الدين، وخاصة الشيعة، إلى نمطين في سلوكهما السياسي إزاء القضايا الهامة التي تواجه الناس والوطن. الأول: المرجعية الهادئة، والتي تنأى عن العمل السياسي المباشر ويقتصر نشاطها في الحقول الدينية والاجتماعية. والثاني: المرجعية الفعالة، والتي تنخرط مباشرة في النشاط السياسي ولها دور مركزي في النشاط اليومي وفي بناء القوى السياسية المعينة في الأطوار المختلفة. ولا شك بأن العراق بعد الاحتلال الأخير قد شهد النماذج المتعددة من رجال الدين ومؤسساتهم ولم تتأطر مواقفهم ضمن الجدول الحديدي الذي طرحته المراكز الغربية وغايتها الواضحة في التمويه على تصنيفاته الحقيقية بين نمط من رجال الدين يتعاون مع الاحتلال وآخرين يقاتلون الاحتلال بكل الوسائل المشروعة والمتاحة.
لكن الإسلام السياسي في العراق قد زاد في سوء الحشف كيلة. فقد ظهرت على المسرح السياسي مدارس مختلفة وتيارات متنوعة مارست النشاط اليومي وأخذت مساحات واسعة من مساحتي «التعاون» و«المناهضة». ولم تتمكن من الناحية الفكرية أو العملية أن تطور دعواتها السياسية ونشاطاتها المتفاوتة إلى كتل جماهيرية متجانسة ومتماسكة تنتشر في كل أرجاء البلاد وتضم الأغلبية الساحقة من «مسلمي» الوطن. فهذا الشكل من التحرك الديني ـ السياسي الجماهيري قد نما من خلال الاستقطاب «الطوائفي» في جوهره بالرغم من جهوده الساذجة لارتداء القميص الوطني وأحيانا حتى المزايدة في المواقف القومية في المحيط العربي للعراق. واللافت للانتباه أن الاستقطاب في هذا الميدان قد حصل بصورة متشابهة في الحالتين: الطوائفية «السنية السياسية» والطوائفية «الشيعية السياسية»، بالرغم من وجود فروقات هائلة جدا بين الحالة الاجتماعية للقواعد الجماهيرية لدى الفريقين وطريقة العلاقة ومضمونها بين هذه القواعد وقياداتها السياسية ـ الدينية الميدانية. لكن السمة «المتناظرة» بين النمطين يمكن اختزالها في الدور الكبير للحشود الضخمة في المدن أساساً قبل الريف في الحالة الشيعية وللتشكيلات السياسية، السلمية أو المسلحة، في الريف قبل المدينة لدى النموذج السني السياسي. في الأول يمثله «التيار الصدري ـ جيش المهدي» خير تعبير، وفي الثاني نعثر عليه شاخصا عند «هيئة علماء المسلمين ـ كتائب ثورة العشرين» ودوره التاريخي في الغرب العراقي ـ الأنبار. ومع أن «الأمر الواقع» كان ضاغطا إلى درجة لا تصدق، لم يتمكن النموذجان من أن يلتقيا على صعيد واحد، بل حتى يمكن القول، بدون مبالغة، إنهما لم يدّعيا التعايش السياسي اليومي. والحال أن التفسير «التاريخي» للواقع الراهن بأثر رجعي من الماضي لا يصلح أكثر من التفسير «الحالي» للواقع السابق بأثر تقدمي في الحاضر. لكن الأكيد يمكن الحديث أن التيار الاسلامي بمجمله يحمل كل من طرفيه وبطريقة مركبة تاريخية ناره الخاصة في جوفه الديني والسياسي.
يعتقد المؤرخ «دودس» في كتابه «اليونان اللامعقول»: «أنه من النادر أن تقوم بنية جديدة من المعتقدات بمحو البنية السابقة محواً تاماً. فالذي يحدث هو إما أن يواصل القديم الحياة كعنصر في الجديد، عنصر قد يظل مخفياً وفي حالة من اللاوعي شبه تامة. وإما أن يعيش الاثنان القديم والجديد جنباً إلى جنب متعارضين غير قابلين للوفاق من الناحية المنطقية، ولكنهما يظلان مع ذلك في العصر نفسه من طرف أشخاص مختلفين وأحياناً من طرف الشخص الواحد». لقد وحّد الأفغاني في فترة مبكرة الإسلام الإصلاحي ولفترة محددة وبعده وحد الخميني الإسلام الثوري ولفترة محددة أيضا. ولكن هنا تبدو العناصر الفاصلة في البنية التاريخية لهذين الطرفين ذات جذور ثلاثية الأبعاد وساطعة وحاسمة أيضا. الأول: شيخ القبيلة. الثاني: رجل الدين. الثالث: مثقف السياسة. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن هؤلاء جميعا قد مارسوا التجارة عبر التاريخ، فإن النتائج ستكون منسجمة مع المقدمات، وضمن سياق تاريخي حيوي في التطور الاقتصادي والتقدم الفكري. ولكن من الصعب جدا في هذه التركيبة إعطاء الأولوية لأحد العناصر السائدة في القيادة العامة. إن التوازن الدقيق هنا بين هذه العناصر هو المسؤول مباشرة عن «النأي أو الهزيمة» أكثر مما يتحمل من صلاحية كاملة من أجل الانتصار والبناء.
بيد أن مكر التاريخ لا يكفي، لا سيما أن القيادة ـ الكاريزما لا يمكنها أن تتكرر ضمن بساطة وسذاجة تطور الأمنيات الجامحة عند الحشود وهي تبحث دورياً عن بطل ما ينفذ رغباتها المكبوتة. يقول المفكر الاميركي «وينوود ريد»: بينما الفرد الانساني هو لغز لا يمكن حله لكنه في انخراط المجموع الاجتماعي يصبح حقيقة رياضية راسخة. من هنا فإن الدور المركزي «للتشيع السياسي» لم يتمكن من إنجاز النقلة التاريخية الجبارة التي قام بها علي بن أبي طالب حين سأله عبد الرحمن بن عوف لرئاسة الدولة الاسلامية بعد عمر بن الخطاب: هل أنت يا علي مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال: اللهم لا. ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. فالتفت إلى عثمان فقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم. كذلك لم يتمكن الدور المركزي «للتسنن السياسي» من إعادة الصورة الافتراضية «للسقيفة» حين قررت أن النبوة والخلافة لا يجتمعان في بيت واحد. ولن ننسى أن العراق الآن في حالة احتلال والوضع «التاريخي» في تلك الفترة كان يعيش على أطراف امبراطوريات عالمية توشك على التهاوي. هنا تتحدد بوضوح الأزمة العميقة للإسلام السياسي في العراق. ذلك أن الوعي التاريخي هو الذي يقرر النتائج على صعيد التطبيق في حالة واحدة فريدة حين يحصل التطابق المدهش بين تحول النص السياسي إلى تاريخ من خلال السلطة السياسية وقدرة هذه السلطة على تحويل التاريخ إلى نص سياسي في التوجيه والإرشاد والإبداع الإنساني. وغني عن البيان أن الحلقة المفقودة بين الإسلام التاريخي في الحقبة الخراجية، أو ما قبل الرأسمالية، والاسلام السياسي السابق في المرحلة الاستعمارية، حين كان إصلاحيا ضمن الليبرالية الصاعدة، والاسلام السياسي الحالي في المرحلة الامبريالية حيث يطمح لأن يكون حركيا، لا يمكن العثور عليها عن طريق الوعي السياسي الحالي بأدواته المعرفية التاريخية الأولى. من هنا فإن وحدة البنيتين الاجتماعية والسياسية هي الوحيدة القادرة على إنجاز الوعي الضروري لفهم الانتقال من مرحلة التاريخ السابق «في ذاته» التي شيدت دولة شبه دينية إلى مرحلة التاريخ الحالي «لذاته» والذي يهدف إلى بناء دولة شبه سياسية في ظروف مرحلة العولمة الرأسمالية الزاحفة والمنتشرة.
والحالة الكالحة التي وصل إليها الاسلام السياسي العراقي في مواجهة الاحتلال وبعيدا عن الأدوات الكفاحية التي بادر إلى استخدامها، هو ضياعه للبوصلة الأساسية في تحديد الآلية المركزية التي تحكمت في بناء وتطور حكومة «الاحتلال» في مرحلتين متميزيتين ساعد الإسلام السياسي على ولادتهما من دون أن يقدر على مواجهتهما بفعالية ونجاح. الأولى: في طور الاحتلال المباشر، حكومة ضعيفة لا يمكن إسقاطها. الثانية: في طور الاحتلال بدون احتلال، حكومة قوية لا يمكنها الانتصار. إن هذا الجدل عمليا، ومن النواحي الفكرية والسياسية والجغرافية ـ التاريخية، يعني في الأساس عجز التيارات المختلفة للإسلام السياسي من التوصل إلى حدود معينة بينها وبين الاحتلال في حالتي الصراع أو المفاوضة وضمن استعمال أساليب النضال السلمية أو المسلحة في المجرى العام للأحداث. في هذا المضمار تلجأ مدارس التحليل الاحتلالية إلى رسم الحد الفاصل بين الاحتلال برغباته في إعادة بناء «الدولة ـ الأمة» بصورة كاذبة وبين الإسلام السياسي في جنوحه إلى الإبقاء على «الحكومة» بصورة صادقة وعرقلة تطورها إلى الصيغة الوطنية. ذلك أن التناقض بين الحلين الاحتلالي والاسلامي السياسي لا يشمل أبدا الأفق التاريخي القادم. بل هو يعتني فقط بآلية استمرار «التعايش» أو «المناهضة» وهي دائما مؤقتة ولكنها مستمرة بالمعنى الزمني بين مؤسسة الاحتلال أو من ينوب عنها، والمؤسسة الدينية إن كانت هادئة أو فعالة. وهنا لا فروقات هائلة وملموسة بين «التشيع السياسي» و«التسنن السياسي» على صعد المقاربة أو الفتوى أو اجتراح الحلول المتينة لمشاكل المشهد السياسي الثابت أو المتغير.
يعتقد أحد المحللين في «إدارة الانظمة العالمية» وهي تابعة للمؤسسة الاميركية السياسية أن التناقض بين الموقف الاحتلالي الرامي إلى الوصول إلى تثبيت «الهوية الاجتماعية» للعراق المحتل وموقف المؤسسة الدينية الهادف إلى الحفاظ على «الهوية الاسلامية» للعراق المحتل هو العنصر الرئيسي في الصراع الذي جرى في السنوات الأولى للغزو والاحتلال. وأن الجهاز السياسي لسلطة الائتلاف المؤقتة ومن خلال مجلس الحكم قد تمكن بألمعية من أن يتوصل إلى مقايضة كاملة بين الطرفين انتهت إلى كتابة الدستور ـ 2005 والمستند عمليا الى الدستور المؤقت ـ 2004، والمباشرة فورا في تشكيل الوزارة الاولى للمعارضة، القادمة من وراء الحدود، بقيادة الممثل المهم، «حزب الدعوة»، للاسلام السياسي الشيعي في العراق. من الطبيعي جدا أن لا نتوقع من هذا الخبير ولا يفسر لنا جهابذة الاسلام السياسي أن «الهوية الوطنية» للعراق المحتل أرضا وشعبا قد ضاعت هنا في هذه المقايضة الرخيصة والتي لم تصمد عمليا أكثر من شهور معدودة. إذ أدار الاسلام السياسي الظهر لرغبات المؤسسة الدينية وقلب ظهر المجن لقواعده الشعبية والحشود التي أوصلته إلى قبة البرلمان في الانتخابات المتلاحقة. وكان المنتصر الوحيد فعليا هو الاحتلال والفساد وذروته الفساد السياسي للجميع. فلا الاحتلال كان يريد فعلا بناء الهوية الاجتماعية وإنما كان يريد بناء مؤسسات فدرالية تشكل بمجموعها «حكومة وكالة» للشركات العالمية، ومعظمها أميركية، النفطية وغيرها. ولا المؤسسة الدينية كانت قادرة على بناء الهوية الاسلامية للبلاد في ظروف الاستقطاب والاحتراب الطوائفي الدموي والاحتقان الاجتماعي المتفاقم مع وجود عامل آخر قوي ومميز ومؤثر وهو العامل المضاف تاريخيا «العرقي الكردي» والذي امتنعت وما زالت المؤسسة الدينية عن أن تعطي رأيا لازبا في حالته السياسية ومستقبل العلاقة معه.
إن البلاد الآن تمر بفترة انتقالية جديدة أتقن الاحتلال في صوغ مضمونها وفي تحديد هويتها المؤقتة. الانتظار المحموم والمشوب بالقذائف والتفجيرات وبناء الأسوار داخل المدن وما بينها إلى حين إجراء الانتخابات العامة في نيسان المقبل. ولأن اليد الخفية في السياسة هي التي تقود اليد الخفية في السوق مع التشابك اليومي لليد الخفية في الطوائفية السياسية المتحكمة برقاب الجميع، فلا يمكن لأحدهم التكهن إلى أين تسير التطورات ولا يستطيع أحد أن يحقق الحسم في كل الأحوال. لذلك، وبالعكس من كل اللغط المتفشي والعنجهيات المبتذلة في الاعلام اليومي المهيج والذي لخصه قديما الشاعر «كشاجم» بقوله: ولكن ذوي الاقلام في كل ساعة سيوفهم ليست تجف من الدم، فإن تداعيات هذا الصراخ ليس إلا صدى للإخفاق الكبير للاسلام السياسي الذي جاء من وراء الحدود كما عبر عن ذلك أحد قادة الاسلام السياسي المقاتل وهو يطلق النداء الغامض في محتواه، فهل هو الهزيمة التي تقود إلى النأي أم النأي لتحاشي الهزيمة.