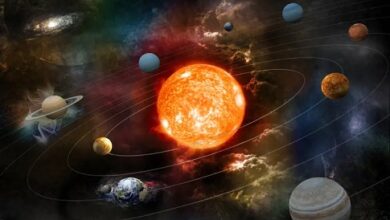عودة بايدن إلى المنطقة.. هل انتصرت إيران؟ وكيف؟

يعرف الرئيس بايدن وفريقه الدبلوماسي والعسكري أن لا حلّ للأزمة السورية المعقدة إلا بالاتفاق مع طهران؛ شريك تركيا وروسيا في أستانا وسوتشي، كما بات الأميركيون يعرفون أنّ التواجد الإيراني في سوريا هو المعادلة الأصعب.
جاء إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن (الخميس) وقف الدعم الأميركي للعدوان السعودي الإماراتي على اليمن، وتعيين تيم ليندركينغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، ومطالبته بعد يوم واحد الكونغرس بإلغاء تصنيف جماعة “أنصار الله” منظمة إرهابية، ليحدد ملامح المرحلة القادمة لسياسات واشنطن في المنطقة الممتدّة من الشمال الأفريقي إلى أفغانستان وباكستان المجاورتين لإيران.
لم يعد الموضوع يحتاج إلى منجّم كي يقول لنا إن هذه المرحلة لن تكون ضد إيران، ما لم يقل أيضاً إنها انتصار لدبلوماسيتها طيلة السنوات الأربع الماضية، فعلى الرغم من كلّ ما فعله الرئيس السابق ترامب ضدها مباشرة أو من خلال سياساته في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وأخيراً اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بقيت طهران صامدة ضد كل هذه الهجمات الخبيثة، وأهمها اتفاقيات التطبيع بين تل أبيب وكل من الإمارات والبحرين على الضفة الغربية من الخليج، ومعهما سلطنة عمان التي زارها نتنياهو، والسعودية معقل التآمر التاريخيّ.
ويرى الكثيرون في الصمود الإيراني مبرراً أساسياً لسياسات الرئيس بايدن الجديدة في المنطقة. هذا بالطبع إن كان صادقاً في أحاديثه عن “مرحلة جديدة من الدبلوماسية الأميركية”، فالفريق الذي اختاره ليساعده في تطبيق هذه السياسة هو الأكثر دراية بالإمكانيات التي تملكها طهران، والتي قد تساعد واشنطن في مساعيها لحلحلة كل الأمور.
ويفسر ذلك قرار الرئيس بايدن وقف الدعم الأميركي للعدوان السعودي والإماراتي على اليمن، كما يفسر ترؤسه (الجمعة) أول اجتماع لمجلس الأمن القومي، تم خلاله مناقشة مستقبل الاتفاق النووي الإيراني بوصفه أولوية، وهو ما يعني مناقشة كل مشاكل المنطقة بالتنسيق مع حلفائه الأوروبيين.
بمعنى آخر، إن الحوار الأميركي المحتمل مع إيران هو سلّة متكاملة تضم خليطاً من المواضيع والقضايا التي لا يمكن للرئيس بايدن أن يحسمها إلا بالاتفاق مع طهران، إذا كان جاداً وصادقاً في نياته التي يتحدث عنها، فالعودة الأميركية والأوروبية إلى الاتفاق النووي، رغم مناورات باريس الخبيثة، ستساعد واشنطن لمعالجة أهم مشكلتين معقدتين بالنسبة إليها، وهما العراق وأفغانستان، فلا حل لمشاكلهما إلا بالتنسيق والتعاون مع الجارة إيران.
كما يعرف الرئيس بايدن وفريقه الدبلوماسي والعسكري أن لا حلّ للأزمة السورية المعقدة إلا بالاتفاق مع طهران؛ شريك تركيا وروسيا في أستانا وسوتشي، فبعد الحديث المطوّل (الخميس) بين الوزيرين لافروف وبلينكن حول سوريا وليبيا وأمور أخرى، بات الأميركيون يعرفون أنّ التواجد الإيراني في سوريا هو المعادلة الأصعب، لا بالنسبة إلى حساباتهم الخاصة بهذا البلد العربي فحسب، بل المنطقة عموماً، فالدعم الإيراني لحزب الله في لبنان عبر سوريا هو الهم الأكبر بالنسبة إلى “إسرائيل” التي لم يتّصل بايدن برئيس وزرائها نتنياهو حتى الآن، كما لم يرد على محاولات إردوغان ونتنياهو الاتصال به.
ويفسر ذلك عدم اتصال الوزير بلينكن حتى الآن بنظيره التركي جاويش أوغلو. وقد أصدرت وزارته بياناً شديد اللهجة ضد انتقادات واشنطن لأنقرة بسبب معاملتها السيئة لطلبة جامعة البوسفور في إسطنبول. ويتذكّر الجميع هنا مواقف بلينكن ورئيسه بايدن السلبية تجاه الرئيس إردوغان وتركيا التي حمّلها بايدن في تشرين الأول/أكتوبر 2014، ومعها الإمارات والسعودية، “مسؤولية المجموعات الإرهابية في سوريا، وفي مقدمتها داعش والنصرة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتذكر الأوساط السياسية مساعي الرئيس أوباما، في أول زيارة خارجية له إلى تركيا في 6 نيسان/أبريل 2009، لتسويق تجربة العدالة والتنمية وزعيمها إردوغان في الجغرافيا العربية والإسلامية عبر ما يسمى بمشروع “الشرق الأوسط الكبير”. وقد انتهى الأمر بالنسبة لواشنطن بالدور الذي أدته أنقرة في سنوات “الربيع العربي” في سوريا والمنطقة عموماً، وهو ما اعتبره أوباما ونائبه بايدن آنذاك خيبة أمل كبرى بالنسبة إليهما بعد امتداد “داعش” في المنطقة، كما لم يخفِ الأخير عدم ارتياحه إلى سياسات الرئيس إردوغان الداخلية، ووصفها بأنها “استبدادية ويجب وضع حد نهائي لها عبر دعم المعارضة”.
قد تكون العودة إلى الاتفاق النووي والعمل على حل مشاكل المنطقة عبر البوابة الإيرانية أسلوباً أميركياً آخر للانتقام من إردوغان وتواجده العسكري في سوريا والصومال وقطر وليبيا، وهو ما لن يكون سهلاً، وخصوصاً بعد فوز المقربين من أنقرة في انتخابات السلطة الانتقالية في ليبيا.
وجاءت اتهامات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لأميركا (الخميس) “بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016 والانقلابات السابقة” لتزيد الطين بلة في مستقبل الحوار التركي الأميركي. ويبدو أنه سيبقى مؤجلاً إلى أن يبصر الرئيس بايدن النور في نهاية النفق المظلم، فيخرج منه وينجح في إغلاق ملفات المنطقة جميعاً، بما فيها مستقبل الخلافات الخليجية مع إيران بانعكاساتها على “إسرائيل”؛ الحليف الاستراتيجي والتقليدي لأميركا.
إن واشنطن التي سكتت، ولأسباب عديدة، عن النووي الباكستاني (المسلم السني)، لا تريد للنووي الإيراني (المسلم الشيعي) أن يبقى مصدر قلق بالنسبة إلى “إسرائيل”، وخصوصاً مع استمرار تحالف أنظمة الخليج مع تل أبيب، على الأقل في هذا الموضوع.
وقد يدفع ذلك – ويجب أن يدفع – الرئيس بايدن إلى النظر للأمور نظرة شمولية، تعني أن المصالحة مع إيران صفقة متكاملة لن تحقق أهدافها إلا بالتوصل إلى حلول نهائية لكل الأزمات، وهو الاحتمال الذي سيجعل الأخيرة بوابة أميركا الجديدة إلى المنطقة، بعد أن جربت في الماضي آل سعود وباقي أنظمة الخليج ومن تحالف معها من الدول العربية والإسلامية، ومنها باكستان وتركيا.
هذا بالطبع إن كان الرئيس بايدن جاداً في أحاديثه، ويريد أن يترك بصماته في مستقبل الولايات المتحدة الأميركية، التي لا حلول لمشاكلها الداخلية إلا بنهج عقلاني جديد يتطلب المزيد من الحوار الإيجابي والبناء مع جميع الأطراف، وبشكل خاص تلك التي تملك المزيد من الأوراق القوية، وهي في هذه الحالة إيران فقط، بعد أن سقطت كل الأوراق مع الأطراف الأخرى!
إذا كان هذا الوصف دقيقاً، فالأيام القليلة القادمة ستحمل في طياتها الكثير من المفاجآت للجميع، ما دامت “إسرائيل” منشغلة بانتخاباتها، وإردوغان قلقاً من الموقف الأميركي المحتمل ضده وضد تركيا، وآل سعود لا ينامون الليل، خوفاً من أن يروا في منامهم ما فعلوه بجمال خاشقجي، وما دام بايدن قد أحال ملف جريمته إلى الكونغرس.
ويبقى الرهان على قوة التكتيك والاستراتيجية الإيرانية في مواجهة السيناريوهات المحتملة، التي تبدو مؤشراتها حتى الآن على الأقل إيجابية. وسيساعد ذلك القيادة الإيرانية لاستغلال هذا الظرف وتحويله إلى مكاسب عملية تعوضها، ومعها حلفاؤها في المنطقة، كل معاناتهم طيلة السنوات العشر الأخيرة بأدق تفاصيلها ومعطياتها الخطيرة التي كانت واشنطن سبباً مباشراً أو غير مباشر فيها في عهد أوباما وترامب.
والسؤال هنا: هل يفكّر الرئيس بايدن في إغلاق ملفات الماضي؟ وهل سيسمح النظام الأميركي التقليدي له بذلك حتى تتفرغ واشنطن لقضايا أكبر داخلياً وخارجياً، أو أن كل ما نراه ليس إلا تكتيكاً أميركياً تقليدياً اعتدنا عليه منذ الحرب العالمية الثانية؟
جوابي مع المعطيات الملموسة: هناك تفاؤل حذر، وما على طهران ودمشق وحلفائهما إقليمياً ودولياً إلا أن تتعامل مع الأمور بمزيد من الحنكة والذكاء السياسيين، وأن ترى الصورة من جميع زواياها، حتى يتسنى لها تحقيق الكم الأكبر من المكاسب، وهي ليست بعيدة المنال بالحكمة والفراسة!
الميادين نت