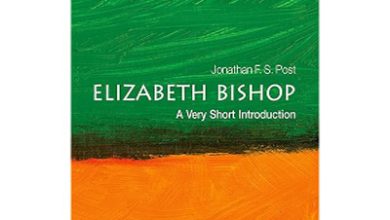غزة ومآلات مصر السيسي

كشف العدوان الاسرائيلي على غزة عن بعض مآلات الثورة المضادة في مصر بعد إجهاض التحولات الثورية، في نقلها من مسار ثوري لتغيير منظومة الدولة الجيو ـ سياسية والاقتصادية ـ الاجتماعية، إلى مسار تجديد النظام في الاصلاحات الدستورية والاحتراب على السلطة. فهذا المسار الذي بدأه «الأخوان المسلمون» تحت تأثير أساطير نيوليبرالية أشاعتها مصالح واستراتيجيات الدول الغربية المستفيدة من التبعية بما يسمى «الديموقراطية الانتقالية» على ضوء تجارب ما يُعرف بتاريخ الثورات الدستورية التي قامت بها أجنحة من السلطة ضد أخرى، هو على نسق «الثورات الملوّنة» التي آلت إلى تفتيت جغرافيتها السياسية وتغيير وجوه السلطة. ولم يمشِ أيُ منها على وقع الدستور الذي قيل فيه ما قاله أبو نواس في الخمر، إلاّ بمقدار ما استخدمه «الأخوان المسلمون» وخصومهم أداة احتراب بين الطبقة السياسية تعبيراً عن مصالح شرائحها في سلطة الحكم ومنظومة دولة التبعية. فمسار اصلاحات السلطة تلك أدّى إلى نتائجها هذه، من فوضى أمنية وسياسية ماحقة تدلّ على خراب المجتمعات وانهيار الدول.
موجة التبشير بـ«الديموقراطية الانتقالية»، التي حملت قوى الثورة المضادة إلى مشارف غايتها في إجهاض موجة التغيير الثوري، انحسرت بعدما ذاب ثلجها وبان مرج حرثته مآثرها في تعميم الموت والتشظي الوحشي. وعلى هذا الخراب العظيم تحاول سلطة السيسي تجديد النظام من الحقل الاقليمي والدولي إلى «الداخل» بالرغم من حرصها على النفخ في مشاعر شعبوية وطنية مهلهلَة تروج بين نخب تقف على رأسها، فترى طبائع الأمور مقلوبة رأساً على عقب. فمقاومة العدوان على غزة، كحدث مفصلي في متغيرات المنطقة، بيّنت آليات تجديد النظام المصري في انقسام حلف الاعتدال الاميركي إلى محورين، على إثر تحوّل الاستراتيجية الأميركية من الأطلسي إلى الهادئ. المحور الأوّل الذي ضمّه «مؤتمر باريس من أجل غزة»، جمع واشنطن والاتحاد الاوروبي وتركيا وقطر (وتمثيلهما الأخوان المسلمين)، مقابل محور آخر وصفه نتنياهو بأنه «صداقات قويّة لإسرائيل»، جمع مصر والسعودية والامارات على العداء لحركة «حماس» وحركة «الأخوان»، في سياق تشعبات الاستراتيجية الأميركية.
لا يختلف الجمع ممن ضمّ مجلسيهما في «استراتيجية السلام» التي استعادتها السعودية بدعوة اسرائيل أثناء مفاوضات القاهرة إلى قبول «مبادرة السلام العربية»، مفرّغة من انسحاب اسرائيل من الجولان ومزارع شبعا، ومن دون حق العودة. ولا يختلفان في أي أمر على مستوى منظومة النموذج الاميركي المعولم الناظمة للتبعية الجيو ـ سياسية والاقتصادية… (السوق الحرة والتجارة والاستثمار، استراتيجية السلام والمفاوضات…) إنما يختلفان على تبعات ما يسميه البعض الانحدار الاميركي، وهو نتاج انكشاف زيف القوّة الحربية الاميركية التي كانت تبدو فائض قوّة افتراضية في استراتيجية ردع من دون مواجهة وقتال في أغلب الأحيان. لكنها ظهرت بحجمها الفعلي في العراق وأفغانستان مقابل ارادة القتال، وبموازاة تطوير المقاومات العسكرية مؤهلات قتالية عالية، وخططا على أرقى مستويات التكتيك العسكري كما أبدعت مقاومة «حزب الله» والمقاومة الفلسطينية في غزة. فما يعتقده البعض انحدارا أو تقهقرا أميركياً على هذا الصعيد، هو إعادة تموضع حربي، فرضه تنامي المقاومات المسلّحة، أفضى إلى انكفاء الادارة الاميركية عن التدخل العسكري المباشَر من أجل القفز من الأطلسي إلى الهادئ. (راجع تقرير 16 وكالة مخابرات أميركية العام 2013 «الاتجاهات العالمية، 2030») وهو تغيير شديد الأهمية في استراتيجية السيطرة الأميركية التي تعتمد أساساً على وهم القوة الافتراضية للردع في ترويج عظمة نموذجها الفكري ــ السياسي ــ الاقتصادي. لكنه تغيير ذو حدّين: حدّه الأول هو عدم احتضان حلفائها الضعفاء في إدارة معظم أزماتهم الخاصة، ما يتيح لهم فرصة يبدون فيها «متحررين» من الوصاية الاميركية. والحدّ الثاني هو التراجع الاميركي عن التدخّل في ضبط إيقاعات الفوضى السياسية والأمنية العارمة التي تخرج عن سيطرة سلطات الحكم، بل الافادة منها في حدود استخدامها للضغط على أعدائها الأقوياء في روسيا والصين، وعلى خصومها في الشرق الأوسط والقوقاز، سلاحاً يهدّد باهتراء أرضيتهم وسحل بنيتهم في جذورها.
الحلف السعودي ـ المصري الذي يتباين مع الإدارة الاميركية في «انكفائها» عن الاعتداء على إيران وضرب النظام السوري، أو عن محاربة «الأخوان المسلمين»، أخذ في غزة الجانب الاسرائيلي في عدوانه «على حماس» كحلقة من حلقات الصراع البيني على السلطة والنفوذ الاقليمي مع تركيا الاطلسية وقطر و«الأخوان». فأزمات تجديد النظام في مصر على وجه الخصوص، تدفع السيسي ومن خلفه السعودية إلى شق عصا الطاعة في الخروج على ما يعتقده كثيرون «ضعف أوباما» الذي ترى إدارته أن تنفيس الاحتقان باجراءات «تتيح الثقة وتبعث على الأمل»، من شأنه «تدعيم الاستقرار» في المنطقة مع اسرائيل أساسا. في هذا السياق تسعى الادارة الاميركية إلى مقاربة «النزاع» في غزة من الجانب الاقتصادي «الإنساني» الذي لا يختلف عليه أيُّ من حلفائها في المحورين، وحتى حركة «حماس» في تحالفها مع تركيا وقطر. في هذا السبيل يأخذ «المجتمع الدولي» على عاتقه «الإغاثة الانسانية» كما تأخذ «الدول المانحة» ما يسمى «إعادة إعمار غزة» مدخلاً «لتهدئة طويلة» تُفضي إلى نزع سلاح المقاومة وتسهيل أعمال مشاريع الغاز على الشاطئ، المرتبطة بمشاريع خطوط الغاز وأعمال الشركات في المنطقة. وبناء عليه، تقترح الادارة الاميركية «تخفيف الحصار عن غزة» بإنشاء مرفأ عائم على الشواطئ القبرصية تحت إشراف ومراقبة «دولية» في اتجاه يؤدي إلى شكل من أشكال الإدارة الذاتية ضمن اطار الاستراتيجية الأميركية لتقسيم الجغرافيا السياسية الاقليمية إلى «كيانات» بحسب انجازاتها العراقية. وهي استراتيجية أبعد ما تكون عن الرغبات الشيطانية في التفتيت والتشرذم كما يظن المسحورون بالنموذج الاقتصادي الاميركي المعولم ولا يأخذون عليه غير ما يعتقدونه شيطانيا في نتائجه الجيو ـ سياسية. لكن هذه النتائج هي حصيلة النموذج النيوليبرالي الذي بات ثقافة عليا تسحر حتى أشدّ المعادين لأميركا (عدا الدواعش للمفارقة). فمن ضمن حرصها على النموذج، تسعى الادارة الاميركية إلى إعادة صياغة حدود الجغرافيا السياسية التي صنعتها بنفسها في «إزالة الاستعمار»، مع مسار النموذج بصفتها قائدته وملهمة أفكاره وإدارته، بينما يعاند الذين يمسكون بذيل النموذج، في تصديق أنفسهم «دعاة سيادة وأصحاب قرار» في بلدان كمصر التي حطمها نموذج الانفتاح الاقتصادي ـ السياسي في بداية عهده، فتركها للزحف النيوليبرالي و«استراتيجية السلام» قعقعاً صفصفاً.
السيسي الذي يخسر ورقة غزة في المفاوضات، يشرئب عنقه من تحت إبط «الانكفاء» الأميركي عن التدخّل المباشر لمصلحته في حسم أزمة السلطة مع «الأخوان المسلمين»، لكنه يرمي دولة مصر ومصيرها تحت أقدام النموذج الاميركي الذي يعود إليه في آخر المطاف إمساك كل دب برسنه. فالوصايا التي يظنها السيسي «إبداعاً» لتلاميذ مصريين من مريدي خبراء البنك الدولي ومؤسسات حرية الرأسمال المعولم، هي آليات تجديد نظام التبعية التي تمطر على أميركا أنّى هطلت غيومه. فالسيسي يبدأ من حيث بدأ مرسي وغيره في شدّ الأحزمة والتضحية بجيل أو جيلَين، مقابل تسهيل أعمال ونفوذ الفلول في مصر، وفي امتداداتهم الاقليمية والدولية. والمشاريع التي يحلم بمآثرها «لمصر» المستقبل (مشاريع السويس، إعادة استثمار مشروع توشكا وتسهيل وضع يد «المستثمرين» على حوالي 4 ملايين فدان جديدة…) هي نفسها المشاريع التي بشّر بها «الأخوان المسلمون» «لنهضتهم»، ولم يضرب فيها ضربة واحدة خبراؤه أم خبراؤهم، بل صنعها خبراء وتلاميذ «منظمة التجارة العالمية» في تسعينيات القرن الماضي، وأعدّوا لها الخرائط والقوانين والشركات المساهمة في إطار منظومة جيو ــ سياسية واقتصادية ــ اجتماعية تحكمها شروط التبعية للسوق الدولية، سواء «بمساعدات» قطر أيام محمد مرسي أو «بمساعدات» السعودية والامارات يوم السيسي.
يبدو جديد السيسي هو التوجه نحو روسيا لملء بعض فراغ «الانكفاء» الاميركي. وهو أمر يُشكل على كثيرين من المتأثرين بحنين العودة إلى الحرب الباردة وصراع القطبين. لكن روسيا بوتين ليست في هذا الوارد مطلقاً، وجلّ ما تطمح إليه هو توسّع نفوذها ومصالحها القومية في المنافسة على الأسواق التي تتيحها السوق الدولية وحرية التجارة والاستثمار، بمعايير وقيَم النموذج النيوليبرالي نفسه. ولا تختلف روسيا عن أميركا في هذا النموذج المعولم سوى في المراهنة على أن النموذج يتيح «التعددية القطبية» بالعودة إلى أسس الأمم المتحدة بعد الحرب الثانية في احترام «سيادة الدول» واستقلالها السياسي، وهو ما لم ينجح به بوتين في أوكرانيا وليس من المتوقع أن ينجح في عديد من دول «الرابطة المستقلة» حيث تؤدي الاسباب نفسها إلى النتائج عينها. وفي حقيقة الأمر تأمل روسيا ـ بوتين العودة إلى «الصحوة الارثوذكسية» في إحياء أحلام بطرس الأكبر بشأن «روما الثالثة» في مواجهة حضارية دينية بين الجزيرة العالمية (الغرب) والأرض الكونية (الشرق) بحسب فيلسوف الجيوـ سياسية الاوراسية ألكسندر دوغين. (ألكسندر دوغين، نبيُّ الأوراسية، منشورات آفاتار، باريس، 2006). في هذا الإطار تدعم العلاقات الروسية ـ المصرية التحالف السعودي ـ المصري في سرّاء المال والأعمال ومشاريع وضع اليد على ما تبقى من الثروة العامة والثروات الطبيعية، مقابل توفير حطب وقود لحماية أمن الخليج «مسافة السكّة». لكن مصر تحصد في أول المطاف وآخره ضرّاء التحالف مع السعودية سواء بأزمات تفسّخ نظاميهما من شدّة الاهتراء، أم بأزمات موات المشاريع الجيو ـ سياسية في المنطقة التي يحاول «الدواعش» ملأها بالذبح والأرض المحروقة. وفي المدى المنظور ليس مستبعداً وصول «الدواعش» إلى أرضهم الخصبة في السعودية وإلى حليفتها مصر من ليبيا وسيناء، ومن السودان بعد قليل إذا استمرت معجزات عمر البشير في شرذمة السودان.
مقاومة غزة المنتصرة على العدوان الاسرائيلي، قدّمت لمصر فرصة ذهبية تحفظ فيها ماء وجه «الوطنية المصرية» في حفظ الحد الأدنى من أمنها القومي. لكن القيادة المصرية أبت إلاّ أن تكون غزة الصغيرة المحاصرَة، أكبر وأهم في استراتيجيات المنطقة الجيو ـ سياسية من أم الدنيا الدائخة في رائحة أحشائها، بحجم طموحات أغلبية نخبتها التي يعدُها السيسي بسطوع نور الكهرباء بعد جيل أو جيلَين.
بعض المتبهورين باكتشاف زيف القوّة الحربية الاميركية الافتراضية، منخورون حتى العظم بسحر نموذجها الجيوــ سياسي والاقتصادي ــ الاجتماعي، حيث قوّة أميركا الافتراضية التي تغذّي بفتات الفتات أصحاب المصالح الصغيرة الضيّقة، وجمهورمستهلكي الأفكار والسلع من كل حدب وصوب.
صحيفة السفير اللبنانية