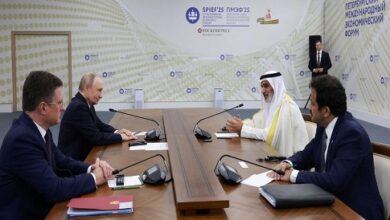فلسفة طه حسين الثقافيّة

إذا قلنا عن أديب مفكّر من طراز طه حسين إنّه اختطّ في ما كَتب طريقَ إعادة تكوين الوعي الثقافي والفكري في مجتمعه، فإنّ البداية، كما رآها، كانت من الثقافة، التي بثّ فيها روحاً جديدة، وأقامها على رؤية تجديديّة جَعَل خصوصيّتها، بالنسبة إليه، في أمرَين/ مسارَين: بناء الذّات المجتمعيّة بوعي ثقافي جديد يستمدّ مقوّماته من الثقافة المُعاصِرة (التي تمّ تعيينها من قِبله في ثقافة الغرب الأوروبي)، وحفز هذه الذّات إلى ما ينبغي أن يكون لها من تكوينٍ ينهض على أُسس هذه الثقافة.
وكما نقَّلَتْه، وانتقلت به رحلةُ البحث عن ثقافة جديدة بين التراث الفكري العربي (متمثِّلاً بابن خلدون)، والأدب المُنتَج في سياقات هذا التراث (بدءاً من جاهليّته التي شكَّك بوجودها الفعلي والتاريخي)، وصولاً إلى التراثَين اليوناني والإغريقي، ثمّ إلى الثقافة الأوروبيّة الحديثة.. فإنّ هذه “الرحلة الثقافيّة” المديدة ستُحدِّد معالِم “الشخصيّة الثقافيّة” التي أرادها لعصره لينهض بفعلها المُكتنِز بروح التغيير والتجديد، عاملاً على توظيف ذلك توظيفاً مستقبليّاً. فاستكمال النَّظرة الثقافية، التي عمل على بلورتها، لا تتمّ بمصدرٍ واحد، وإنّما ينبغي، وتحقيقاً لغناها، أن تقوم على “تعدّد الموارِد”، واجتماعها في فسحة حوار وتلاقح، لا أن تسير على طريق التقاطع. وهذا هو ما بلغه ذاتاً، وعمل على أن يجعل الواقع يبلغه.
ومع أنّه كتب في التراث العربي، وفي التاريخ العربي، فإنّ جهده الفكري انصبَّ على الحديث الأدبي والفكري، ووجَد في “الحديث الأوروبي” غايةَ ما يُرتجى، وما ينبغي أن ننصرف إليه بكلّ ما لنا من رغبة في تكوين بُنية عقليّة عصريّة، فإن لم نأخذ عنهم أخذاً مباشراً علينا أن “نفعل مثل ما فعلوا”.
في كتابه “قادة الفكر” نجده يركِّز على الإنسان عقلاً، ووجوداً فاعِلاً، وحركة وجود قائمة على ما للإنسان من عقلٍ ينبغي إحكام بنائه وتوجّهاته. ومن خلال هذا كان أن دعا إلى تفتّح المَدارك، وتنظيم قوى العقل وإحكام توجّهاته، وتحرير الذّات من العوائق الخارجية والعِلل الداخلية. فمِن خلال هذا يتمّ رسم الخطّ الإيجابي لما نتطلّع إليه من مسارٍ يتيح لنا النهوض بتاريخ جديد، تطوّراً وتحضّراً.. فالإنسان، بحسب ما رأى، هو العامل الفاعِل والمُحرّك لعمليّة التطوّر، فهو “سيّد قَدَرِه”..
هذه “الحقيقة” التي أراد لعصره العربي أن يستوعبها مُعتمِداً على “الآخر الأوروبي”، جعلت من ” ثقافة الآخر”، عنده، مصدر تفرّد وتفوّق.. فنَظر إلى “ثقافة الآخر” هذه كونها الحقيقة الإنسانية التي يُمكن لنا، إذا ما اعتمدناها، أن “نؤلّف” حضارتنا الجديدة. فقد أراد أن يأخذ مجتمعه، كما أخذ نفسه، بمنهج التطوّر والتحوّل هذا، داعياً إلى فَهم عقلانيّ لعمليّة التطوّر الحضاري، بما له من سنن وقوانين ينبغي أن تُقام، وتُراعى، في عملية البناء المجتمعي الجديد الذي عاد من فرنسا ينشده، وكان يرى أنّه لن يتمّ لنا ما لم نتبنَّ منظور “الآخر” فيه.
التيّار القومي والمواجَهة الفكريّة
جاءَت إثارة مثل هذه الموضوعات من قِبل طه حسين في وقتٍ كانت الفكرة القومية العربية تتحرّك في مستوى من التبلور والارتقاء، ويجري البحث عمّا لها من روابط تاريخية بكلٍّ من الماضي والعصر الحاضر.. وقد استجلى روّادها من المفكّرين العرب ظواهر التحديث والتجديد من خلال عملية استجلاء ثلاثيّة التكوين: فهناك الواقع وما يعيش من مشكلات التأخّر، وهناك التراث وما ينبغي القيام به من قراءة جديدة لمعطياته على أساسٍ نقديّ، وهناك التاريخ المُعاصِر الذي اضطلعت الحركة القومية العربية بالتأسيس له، وبنظرة موضوعية أعلَتْ من شأن الذّات العربية في ما لها من بُعد حضاري، مُستجليةً، في ضوء هذا، خصائص الوجود الجديد في ما ينبغي أن يكون له/ ويكون به من حقائق تاريخية، ما جعل من “الدعوة القومية” عملية فكرية جديدة كانت الانطلاقة الفعلية نحو “حداثة مترصّنة” قد بدأت منها، وأصبحت “الأمّة القومية” معها، في ما لها من وحدة أساس، مآل التكوين الفعلي لهذا الفكر الذي سيُعرف بتسميته: الفكر القومي العربي، بكلّ ما يحمل من روح التجديد.. هذا كلّه تمّ في حقبة هَيمَنة استعماريّة شاملة لوجود الأمّة بأقطارها كافّة.
في هذا السياق سيتمّ التأكيد على التجديد في مواجهة التقليد، وعلى التقدّم إنهاءً لحقبة التأخّر.. وسيأخذ الموضوع بُعداً ثُنائيّاً للصراع الثقافي والسياسي: فمن طَرَف كان الاستعمار مُهيمِناً على مقدّرات الواقع، ومن طرفٍ آخر كان التخلّف، والنزعات التقليدية، ما جَعَل عمليّة التفاعل مع العصر تأخذ أبعاد الصراع.
هنا سيكون طه حسين، وبعض مجايليه، مع “بُعد آخر” للتطوّر، لا ينبع من القدرة الذاتية الخالصة للإنسان العربي، وإنّما عمد إلى أن يشفع هذه “القدرة” بالاستجابة الإيجابية لأطروحة “الآخر الغربي” بمعزل عن أيّ موقف نقدي، بخلاف الفكر القومي الذي أخذ هذا “الفكر الوافد” ببُعدٍ نقديّ غير معزول عن حالة الصراع القائمة على أرض الواقع بين العرب والغرب.
بهذا، وبسواه ممّا هو قائم على المُماثَلة، سيكون طه حسين، وبعض الأسماء من جيله، أقرب إلى مفهوم “التغريب” الذي أخذوا به أنفسهم، وأطروحاتهم الفكرية والثقافية، ما جعل “النتائج” التي خرج/ خرجوا بها، وفي جانب غير يسيرٍ منها، “نتائج مُستعارَة”.
كان طه حسين يطمح في/ ويعمل على نقل مجتمعه (المصري – بحسب تخصيصه) إلى حالة من التماهي، ثقافيّاً ومجتمعيّاً، مع الآخر الغربي، ووضْعه، ثقافيّاً، في السياقات التي اتّخذتها الثقافة في الغرب الأوربي، فكان أن أخذ نفسه وفكره، وما كَتَب، بما يمكن أن نُطلق عليه “نزعة الحداثة- التماثل”، في محاولةٍ منه لأن يجعل من مصر قطب حضورٍ فكريّ وثقافيّ جديد تؤثِّر به/ ومن خلاله “في جيرانها من العرب”، على حدّ ما جاء في كتابه “مستقبل الثقافة في مصر” (1938).
التمسك بالدَّور الفكري
وإذا كان طه حسين قد واجَه التاريخ العربي بالرؤية النقديّة نفسها، بما لها من جوهر تحليلي مُحتكِم للعقل، فما ذلك إلّا لأنّه كان يريد لنفسه أن يكون صاحب “دَور فكري” في عصره، ومؤسِّساً لمستقبلٍ يَبني توجّهاته على ما حمل إليه من “رؤية جديدة”. ولعلّ هذا ما جَعل عديد قارئيه ودارسي فكره النقدي يجدون فيه ” فكر ارتقاء”. فلحريّة الفكر التي نادى بها قيَمها التي تعلو بها لتجعل منها “جوهر وجود”، وكأنّه هنا يتوافق و”هيدجر” الذي ذهب في القول باستحالة التمييز بين الحرّية نشاطاً إراديّاً والإنسان وجوداً واقعياً.
هنا يُثار سؤال على جانبٍ كبير من الأهمّية: ما الفلسفة التي أخذ بها طه حسين نفسه وفكره في أطروحاته/ توجّهاته هذه، فساعدته على امتلاك وجوده الذّاتي في ما قدّم من أطروحات تعيَّن فيها وعيه مثقّفاً وأديباً ومفكّراً، وابتنى منها رؤية ثقافية على هذا النحو من الوضوح والتكامل؟
حين نصف طه حسين بالمثقّف الحداثي إنّما نبني هذه الصفة على ما أراد أن يصنع من قطيعة ليس مع الماضي وحده وإنّما مع الفكر العربي. وهو إذ اتّخذ طريق العقلنة مسلكاً لفكره وتفكيره إنّما كان يحذو حذو الغربيّين في عصر أنوارهم، فنظر فيه نظرة المُكتسِب لأهمّ ما يحمل من رؤية لبناء ثقافة جديدة. وفي هذا كان أن جرّد مصر من هويّتها العربية، فنَسبَها، ثقافةً، إلى كونها دولة متوسّطية، تنتمي إلى اليونان والإغريق في القديم، وإلى أوروبا في الحديث. وأمام هذا لا غرابة في أن يشتقّ مصطلح التحديث من خلال مقاربة الانتماء التاريخي (المُفترَضة) هذه. فمصر الثقافية كما كانت.. ينبغي أن تكون: نتاجاً لهذه السيرورة التاريخية المُفترَضة من قبله، في ما يرى لها من تاريخ.
فهل يعني هذا أنّه جَعَل للحداثة (التي تبنّى فكرها وأخذ بمنطقها) استمراريّة تاريخيّة قائِمة على مثل هذا “الترابط المُفترَض”، وبما كان يريد لمجتمعه المصري أن يأخذ التطوّر بمنطق الحداثة الأوروبية وبرؤيتها للمستقبل؟ ما يعني أنّ على العقل المصري، إذا ما أراد النهضة والتقدّم والتطوّر، أن يربط أفق تطلّعه بالأفق الأوروبي. فكان، بذلك، أن أوجَد “التطوّر التابِع” لا “التطوّر المُبتدَع” ذاتيّاً.
غير أنّه، من جانب آخر، أراد أن يجعل للعقل سلطته على التراث الأدبي والتاريخي العربي وهو يضعهما موضع قراءة جديدة. وقد عمد إلى صياغة قوانينه النقدية صياغةً عقلية.. فالعقل عنده هو وسيلة التحليل، وملتقى القبول أو الرفض، وقد كان هذا أمراً مهمّاً في المرحلة التي ظهر فيها، إذ كانت مرحلة تحوّل حقيقي. وسيعتمد في هذا، وبعض الأسماء إلى جانبه، “المعارف المُكتسَبة” بما قدَّمت من “مُثل نقدية”، وتصوّرات، سيعمل على تكريسها في واقعه الثقافي من خلال التواصل الحيّ، والمُتفاعِل معها، جاعلاً منها “قواعد فكر” في ما وجد لها من إسهام في عملية التقدّم المعرفي..
فإذا ما عدنا بهذا “التوجّه العقلي” منه إلى أصوله سنجده يُعيدنا إلى “ديكارت” الذي أخذ عنه “مبدأ الشكّ” فطبّقه على “الشعر الجاهلي”. فديكارت يرى أنّ “المبادئ العقلية لمّا كانت سرمدية وضرورية فإنّها فطرية”. ويضيف: “يكفي أن أوجّه انتباهي كي أدرك ما لا نهاية له من الخصائص المتعلّقة بالأعداد، والأشكال، والحركات، وأشياء أخرى متشابهة تظهر حقيقتها بيّنة، وتتّفق تماماً مع طبيعتي بحيث إنّني حين أبدأ في اكتشافها لا يبدو لي أنّني أتعلّم شيئاً جديداً، بل بالأحرى ما كنتُ أعرفه من قبل، أعني أنّني أُدرك أشياء كانت من قبل في عقلي وإن كنتُ لم أوجّه بعدُ فكري نحوه”.
كاتب وناقد عراقي
نشرة أفق (تصدر عن مؤسسة الفكر العربي)