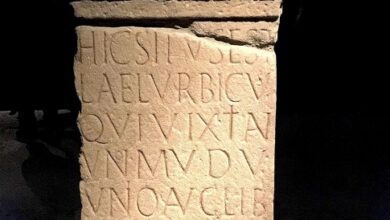فينوس خوري غاتا في الجحيم الأفريقي

«لم يكن يرى سوى الأم التي كانت تغسل شعرها ثم تجدله أمام العين الزجاجية التي كانت تلاحق ذراعيها العاريتين والمرفوعتين لتثبيت ضفائرها على قمة رأسها. تصوير تحت أنظار الجيران المستنكِرة. لم يكن يرى غيرها وغير شعرها المطلي بالطين الأحمر. حين استقرت العلبة السوداء على صدره، كان على الأم تجنّب الابتسام، الدخول إلى منزلها، إغلاق بابها، ومدّ حصيرتها». هذا المقطع نقرأه في مطلع رواية الكاتبة والشاعرة اللبنانية فينوس خوري غاتا، «وداع المرأة الحمراء»، ولا نستحضره هنا لتشكيله خير مدخل لولوجها فحسب، بل لجمعه أيضاً معظم خصائص نصّها الشعري بامتياز.
الأم في هذه الرواية، التي صدرت حديثاً عن دار «مركور دو فرانس» الباريسية، هي امرأة أفريقية فقيرة وجميلة تعيش في واحة على أطراف الصحراء مع زوجها وأمّها وطفليها التوأمين، زينة وزيت. ولتبديد مللها ومرارة معيشها، تستسلم يومياً لطقسٍ مثير يقوم على دعك الطين الأحمر بيديها ثم طلي شعرها وجسدها به من أجل منحهما لوناً أحمر. وفي أحد الأيام، يحضر إلى الواحة رجل أبيض من أجل التقاط صور في الصحراء. وما أن يراها حتى يُفتن بها ويبدأ بتصويرها بطريقة استحواذية. للمرة الأولى في حياتها، تشعر هذه المرأة بأنها حيّة، ولذلك لا نفاجأ حين تغادر يوماً عائلتها وتلحق بالمصوّر إلى أوروبا من أجل عيش قدرٍ آخر، كما لا نفاجأ بحالة الذهول التي سيقع فيها سكّان الواحة إثر فعلتها.
ولأن الزوج مغرمٌ بزوجته، لا يتردد في الرحيل مع طفليه خلفها من أجل العثور عليها والعودة بها إلى دارهم. سفرٌ يتطلّب منهم ستة أشهر من أجل عبور الصحراء، وثلاثة أشهر إضافية لبلوغ إشبيلية في إسبانيا. وفور وصولهم، يكتشفون أن صور الأم تكسو معظم جدران المدينة بعدما أصبحت عارضة أزياء شهيرة. ولأنها تَمثُل شبه عارية في هذه الصور، يمضي زوجها لياليه الأولى محاولاً تغطية جسدها بالطلاء. وعند الصباح، يتقفّى أثر ذلك المصوّر من أجل العثور عليها. وحين يجده، يتبيّن له أن زوجته غادرت عشيقها من أجل العيش مع فيلسوف انطلق في وضع كتابٍ ضخم عنها، مصوّراً إيّاها فيه كسليلة ملكة سبأ.
وبينما تنعم الأم بشهرتها في إشبيلية، يختبر الأب وطفليه ظروف حياة المهاجرين الأفارقة القاسية، أي الجوع والقلق والنوم في الحدائق العامة، من دون أن ننسى استحالة التواصل مع أبناء المدينة بسبب عدم إتقانهم اللغة الإسبانية، وأيضاً بسبب لون بشرتهم ووضعهم المزري. ومع ذلك، يتمكنون من البقاء على قيد الحياة بفضل احتضان مجموعة من المهاجرين لهم، ويكافحون بشتّى الوسائل المتاحة لهم من أجل البقاء في المدينة التي تعيش فيها الأم. وفي أحد المساءات، وبينما كان زيت وزينة يكسوان بالرسوم جسد أمّهما العاري في الصور، توقفهما الشرطة وترميهما في السجن.
ومع أن الأم تحضر إلى المخفر وتتمكن من إطلاق سراحهما، لكن العائلة لن تلتئم لأن للأم مشاريع أخرى. ولذلك، ترسل طفليها إلى مدرسة داخلية للأيتام يفرّان بسرعة منها لتفضيلهما العيش في الشارع مع والدهما. هكذا تنطلق زينة في التسوّل أمام إحدى الكنائس، ويبدأ أخوها زيت بنشل المارة، بينما نرى والدهما سعيداً باعتنائه بكلابٍ أربعة مقابل أجرٍ بائس. لكن مع مرور الوقت، تقع زينة في حالة تصوّف مرضية فتبتعد من أخيها الذي يصبح بين ليلة وضحاها رسّام غرافيتي معروفاً تحتل رسومه تدريجاً مكان صور أمّه على جدران المدينة، قبل أن تحتضنه صاحبة غاليري وتدفعه في اتجاه الرسم على القماش، فيصبح فناناً مهماً وينجز لوحات تباع بأسعار عالية.
أما الأم، فتختبر التقهقر بعد زمن الشهرة وتصبح مجرّد ماثلة في إعلانات لمساحيق تنظيف. ولا عجب في ذلك، فموضة عارضات الأزياء الشقراوات القادمات من أوروبا الشرقية لن تلبث أن تحل مكان موضة عارضات الأزياء الإفريقيات. وفي واحدة من محاولاتها اليائسة صعود سلّم الشهرة من جديد، تذهب هذه المرأة إلى حد إحداث نُدَبٍ على وجهها لمنح نفسها صورة المرأة الإفريقية الأصيلة، لكن فشلها يقودها إلى حالة اكتئاب مُهلِكة.
وتشدّنا هذه الرواية أولاً بجانبها الحلمي وواقعيتها السحرية، وبالتالي بتجنّب فينوس أي بؤسوية في سرد قصّتها، على رغم طابع هذه القصة التراجيدي. وفي هذا السياق، نراها ترافق شخصياتها من الواحة إلى شوارع إشبيلية بطرافة مليئة بالرقّة، وتضفي هذه الرقّة على بعض شخصياتها، كالوالد الذي يعبر الصحراء والبحر مع طفليه للعثور على زوجته، وحين يجدها، لا يحاول استعادتها أو تعنيفها أو الحكم سلباً عليها، على رغم فعلتها، بل يعتني بالمصوّر الذي خطفها منه، حين يتبيّن له أن هذا الأخير فقد بصره، ويفتخر بما أنجزته حبيبته حين يستنتج الموقع الاجتماعي الراقي الذي بلغته.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى خادمة الفيلسوف الإسبانية التي ستحاول عبثاً إنقاذ الطفل زيت من حياة الشارع، حتى حين يحاول نشلها، وتبدأ بالأكل مكان خدّامها وحبيبته حين يتوقّفان عن تناول الطعام «لاقتناعها بأنها تغذّيهما عبر جسدها». ولا ننسى الإفريقي باوباب الذي سيحتضن الزوج وطفليه لدى وصولهم إلى إشبيلية ويعمل ما في وسعه لمساعدتهم، على رغم وضعه المماثل لهم.
وحتى المواضيع العديدة التي تتناولها فينوس في هذه الرواية، وتثري حبكتها، تبدو مقارَبة بحساسية كبيرة، بعيداً عن البرهنات السوسيولوجية الثقيلة، كالأمومة الضائعة، والبحث عن الشهرة، والمنفى، وخصوصاً معاناة المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين تنجح الكاتبة في تصوير صعوبات حياتهم من الداخل عبر مُعاش زينة وزيت ووالدهما وشخصيات أخرى غيرها.
حياة لا يتسلط عليها شبح الجوع والبرد وانعدام الراحة والأمان فحسب، بل أيضاً ذلك الرعب الثابت من رجال الشرطة الذين «يظهرون فجأةً فيلكمون ويركلون ويكبّلون ويجرّون إلى المخافر، قبل الترحيل من البلاد، لرفضهم كل ما تكتظ به الأرصفة، بشراً كان أو نفايات». حياة لعل العنصر الإيجابي الوحيد فيها هو ذلك التعاضد المؤثّر بين ضحاياها الذي تبرع فينوس في وصفه ويجعل واقعهم اليومي أقل قسوة.
ولا تنسى الشاعرة في نصّها فضح عنصرية المجتمعات الغربية تجاه المهاجر الإفريقي، التي تتجلّى في النظرة المقيتة التي يلقيها الفيلسوف الإسباني على طفلَي عشيقته. عنصرية لا تمنع هذه المجتمعات الخبيثة من استخدام صورة هذا المهاجر لغايات تجارية، ومن منطلق عرقي، كما حصل مع الأم لدى وصولها إلى إسبانيا، وما سيحصل مع ابنها زيت بعد ذلك.
لكن أكثر ما يفتننا في هذه الرواية هو المهارات السردية والكتابية المدهشة التي توظّفها فينوس فيها، وبالتالي ذلك النثر الرشيق والمشدود على ذاته، حيث الجُمَل قصيرة وصاعقة، والكلمات معدودة وموزونة بميزان صائغٍ. نثرٌ مشبعٌ بصورٍ شعرية مبتكَرة تلطّف مضمونه القاتم وتمدّه بألوانٍ وحيوية نادرة.
صحيفة الحياة اللندنية