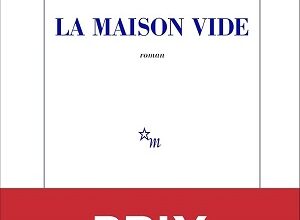كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة

مع مرور اثنين وأربعين عاماً على اندلاع الحرب الأهلية وما خلّفته من دمار في الحجر والبشر والنفوس، يستذكر اللبنانيون في ما يستذكرون مقتل الفيلسوف اللبناني كمال يوسف الحاج الذي قضى حياته دفاعاً عن لبنان والقضية الفلسطينية، واللغة العربية. ولئن صرعته نزعته القومية اللبنانية، نظير ما صُرع العديد من رجالات الدولة والفكر والفقه والصحافة اللبنانيين، فإنّ أعماله الفكرية – بل الفلسفية على ما يؤثر تسميتها – الباقية تردّ له الاعتبار، وتنفث في ذكراه ما يطيّب أثره ويشيع منها ما ينفع في تجنّب الأجيال الآتية ويلات الحروب والمنازعات من غير طائل.
ومن هنا، رأينا أن نلقي الضوء على كتاب المفكّر الراحل وعنوانه «في فلسفة اللغة» فنوجز البحث الذي أجريناه عن الكتاب، ونبرز المحاور الكبرى التي دارت عليها فصول الكتاب، محاولاً ربطه في سياقه التاريخي والسياسي القريب والبعيد. اللافت الأوّل في كتاب «في فلسفة اللغة» الذي كان باكورة أعماله (1957) أنّ كمال يوسف الحاج يرى الى اللغة من منظار الفلسفة المثالية، الأفلاطونية المستحدثة، ممثّلة بفكر برغسون الذي نقل له كتابه «بحث في معطيات الوعي المباشرة» الى اللغة العربية، عندما كان في باريس يعدّ أطروحة الدكتوراه عن فلسفة برغسون المثالية، على ما وصفنا.
وبناء عليه، نجد المفكّر حريصاً كلّ الحرص على ربط اللغة بمحمولات- ووظائف- إنسانية جوهرية. اللغة في نظره بعد أنطولوجي –إنسانيّ، لكونها تترجم بحقّ عن وجدان الإنسان بالصميم، وأنها تالياً شرطٌ بل مظهر من مظاهر الوجودية الحديثة. ومن هذا المنطلق الفلسفي نظر الحاج الى اللغة العربية (الفصحى طبعاً)، باعتبارها حاملة الرؤية المشتركة بين سائر الناطقين بها، وعنى بهؤلاء اللبنانيين قبل غيرهم، مثلما عدّها، أي اللغة العربية الفصحى، اللغة-الأمّ– وهذا مصطلح انفرد بنحته من بين مجموع الكتّاب والبحّاثة العرب أوائل القرن العشرين– وعاء وجدان الأمة وكلّ فرد منها، لا يجوز إشراك لغة أخرى معها. ومن هذا القبيل كان دفاعه المستميت عن اللغة العربية، لغة وحيدة لتعليم الآداب والعلوم كافة، ولغة للإبداع يستحيل أن تُجاريها لغة استعارها الأديب، أو اتّخذها مزيدة عن لغته الأم، فكان مقصّرًا بها عن بلوغ الذرى الإبداعية.
لقد عارض الفيلسوف الحاج بشدّة كلّ الدعوات الى الثنائية اللغوية، ولا سيّما الجمع بين العربية والفرنسية واعتبارهما لغتي-أمّ، على حدّ ما سوّغ له ميشال شيحا، رفيق دربه في الإيمان بلبنان.
ولو قيّض للمفكّر كمال يوسف الحاج بعض الاقتدار في مجال التعليم لكان تابع مهمّة عزيزة على نخبة من كتّاب النهضة الأوائل، أواسط القرن التاسع عشر، شأن المرسل فاندايك وبطرس البستاني وجرجي زيدان (عهد افتتاح الكلية الإنجيلية السورية، في بيروت، أي الجامعة الأميركية)، وعمل علــــى ترجمة كل العلوم الى اللغـــة العــــربية وتعليمـها بها.
اللافت الثاني في كتاب «في فلسفة اللغة» أنّ الفيلسوف آثر البقاء خارج عالم اللغة المادي، منصرفًا الى درس تعالقات اللغة الفكرية والفلسفية الماورائية والاجتماعية، وما يؤيّد رؤيته الفلسفية المثالية التي تعتبر في ما تعتبره، أنّ الفكر الإنساني سابق اللغة، وأنّ اللغة تسعى–عبثاً – الى اللحاق بالفكر الخلّاق. وأنّ علم اللغة الحديث، أو ما يدعوه البعض بالألسنية، والذي تلمّس صعوده في أربعينات القرن العشرين في باريس إبان إعداده أطروحته، إنّما كان مخيّبًا لمن عقدوا الآمال عليه وعلى «العلوم» بعامة، فما جنوا من «الجبرية العلمية المزعومة» شيئاً. والأحرى أنّ كمال يوسف الحاج كان أنِفًا من الدخول الى عالم اللغة المادي، الذي رسمت الألسنية له مساراته وبناه، من أجل أن ينصرف، متخففاً من ثقل «الصوت والشكل والتركيب»، الى مطارحاته الفكرية الكبرى، عنيت وجودية اللغة، وأنطولوجيتها، أي انغراسها في أبعاد الإنسان الفكرية والاجتماعية والروحية.
النقطة الثالثة هي إلماح الكاتب الى أنّ اللغة العربية «الفصحى»، لا العامية، هي «اللغة القومية» من دون أن يعني هذا إيثاره صفة «العربية» تُطلق على القومية، أي مجرّدة من محمولها السياسي الشائع الذي لطالما اندرجت فيه العبارة في الخطاب السياسي العربي.
ولئن وردت كلمة «اللغة القومية» بحدود العشر مرات في كتابه، فإنها وردت لديه لإثبات أنّ اللغة التي ينبغي أن تكون تعبيراً وجودياً وأنطولوجياً عن أبعاد الإنسان المتكلّم بها، هي اللغة-الأم التي وُلد بها المرء. وبالتالي كان الحاج يصادر على الخطاب العربي الصفة نفسها، ويعتقد أنها دالّة على انتماء – سياسي – لم يكن صريحاً كفاية، كما بات عليه في كتبه المتأخرة، ولا سيما كتابه «القومية اللبنانية».
وفي ما خصّ كلمة «الأمّة»، التي ورد ذكرها، في الكتاب، إحدى عشرة مرة للدلالة على ارتباط اللغة، بعامة، بوطن جامع، وعلى الصورة التي ارتضاها الأوروبيون لأنفسهم، في أن تكون «تعبّر عن وجدان شعب» كامل الصفات، موحّد الإرادة. إلّا أن كلمة «الأمة»، لم ترد مرتبطة بنسبتها «العربية».وفي المقابل، ورد اسم «لبنان» سبعاً أو ثماني مرّات في سياق ردّه على دعوة مواطنه ميشال شيحا الى الثنائية اللغوية، بقوله إنّ على لبنان أن يكون «عربيّ اللسان حتّى يحظى حقيقةً بوحدة شعبه».
وفي المحصّلة الأخيرة، يمكن القول إنّ الفيلسوف اللبناني كمال يوسف الحاج، أول رعيل الشهداء في سبيل لبنان الوطن و «الأمة»، لم يناقش البعد السياسي الذي تنطوي عليه اللغة العربية، ولا كان صريحاً في الكشف عن لبنانويته – وقد رافع عنها ودافع في كتب لاحقة مثل «القومية اللبنانية» و «فلسفة الميثاق الوطني»- وإنما شاء أن يستنطق قدرات اللغة العربية وحدودها القصوى، برأينا، وأن يناقش أدوارها العميقة (الإنسانية، الأنطولوجية، الوجودية، الوجدانية) التي لا تقوى نظرة العلوم اللغوية الحديثة على سبر أغوارها وتبيّن معالمها. ربما من أجل الانصراف الى الكتابة الإبداعية – في الفلسفة – أو في الأدب، نظير ما قام به جرجي زيدان وانصرافه الى كتابة الروايات التاريخية والموسوعات عن التمدن الإسلامي، مباشرة بعد إنجاز كتابه الأول «فلسفة اللغة العربية، والألفاظ العربية»(1886). وأياً يكن من أمر، فإنّ من العدل أن يعاود البلد النظر في إرثه الفكري والفلسفي، لعلّ ناسه يتعظون ويعرفون مستقبلهم، ويعملون على إحيائه بأحسن صورة.
صحيفة الحياة اللندنية