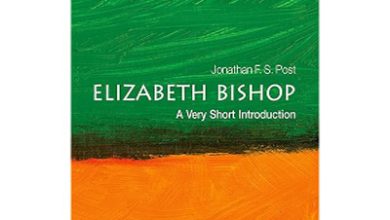لا تصل إلى هدفها !

الحياة… إجازة من… الموت!
_____________________________________
الأمل… عنيد
عند الشعراء… مكابرة
عند سميح القاسم…واجب وطني !
هذا انطباع مكتوب لحظة سماعي بوفاة سميح القاسم. وأضيف إليه أن صورة سميح القاسم التي لبسها وتوفي بها لا تقترب من شكل شبابه المتفجر بالحماسة والمقاومة،والآراء، والشعر، والسفر… إلخ.
وفي الحقيقة … لا يليق بأي شاعر هذه الكمية من الكيمياء التي تجعله أصلع، أصفر، مجعلكاً، متهالكاً، يريد أن يبتسم فتظهر الإبتسامة منفصلة عن تاريخ الشخص، ووسامته… عدائية ولا معنى لها.
ولسوء حظي أنني رأيت عدداً من الشعراء والكتاب، في لحظة الكيمياء الغبية هذه، والتي، في الحقيقة، لا أجد لها مبرراً، لا من الأطباء كواصفين لجرعة الاحتمالات، ولا من المرضى، وخصوصاً الشعراء، كطلاب يتامى للقمة حياة زيادة عن الحصص المقررة!
الموت ينبغي أن نحترمه، ليس بالاستسلام له، وإنما بالسماح له، في شهامة المهزوم، بأن يركز رايته على قمتنا المفضلة عندما تنحسم المعركة، ويتضح النصر له.
كان الشاعر محمد الماغوط يمد ساقيه على الطاولة. ويشرب ويأكل ويسمع صباح وفيروز ووديع الصافي، ولا يزيح قبعته الشهيرة عن رأسه. ولا يصدق، أبداً، أن الموت سيكسب المعركة معه. رغم كل علامات الكيمياء سيئة الذكر…وتلك الإبتسامة…إبتسامة الكيمياء السرطانية.
التي لا تصل إلى هدفها !
والشاعر ممدوح عدوان…يحدّق بمرآته ويضحك… فلا تصل الإبتسامة الكيميائية حتى إلى صاحبها، فينكرها ويأتي إلى الجلسة، ونحن نخفي حزننا، ويبدو أنه سيكابر ويطمئننا…فيبتسم…
ولا تصل الإبتسامة إلى هدفها.
الشاعر محمد عمران…كان يلثغ بالسين…وعندما طوّرت الكيمياء شكله النهائي، صار يلثغ بحرف آخر: الشين ( الجار اللدود للسين)… ويبتسم لنا، في نوع من الرواقية الأسيانة، ولكننا لا نتلقى شيئاً…لقد حذفت الكيمياء السين أيضاً مع الإبتسامة …
التي لا تصل إلى هدفها.
الروائي هاني الراهب… ” أريد وقتاً للكتابة،”… ولم يعرف أن الجسد هو الكاتب!
الكاتب مسعود بوبو…اختصرها قائلاً “شبعنا. يكفي” ولكنه ذهب إلى باريس وعاد في تابوت.
القاص سعيد حورانية …عندما زرناه آخر مرة، قال: تعالوا دائماً…فأنتم تطيلون عمري! ولكن يبدو، عملياً، وفي حالة الإبتسامة التي لا تصل إلى هدفها، نحن من يقصّر الأعمار !
أنسي الحاج…
فاتح المدرس…
رأيت إبتسامتيهما، الحاج (في الجريدة) وفاتح في سهرة أخيرة: لا أحد ينجو من خسائر إبتسامة الماضي، ومن ارتباك براءتها في الحاضر وعند الاحتضار.
…………….
وفي كل حالات هذا المرض الذي ينطوي على صفات أكثر من الخبث، والدهاء، من هذه الصفات: الجشع، لأنه يأخذ الشخص وأمواله إن كان غنياً ، وخبز ورثائه إن كان فقيراً.
لست أدري لماذا علي أن أكتب عن سميح القاسم كل هذه المقدمة لأصل إلى أسفي الواضح، وأنا أراه ميتاً يتكلم. عجوزاً أصفر، قوياً دون قوة… يخرمش وجه الموت الفتي بإبتسامته…
التي لا تصل إلى هدفها.
كان سميح القاسم ومجمود درويش يظهران معاً، وكل لوحده. إنهما توأمان. وإنهما رمزا معافاة قضية جرت خسارتها بوضوح، ولكن استعادتها قيد الأمل. وهكذا ظلاّ، ورفاقاً آخرين، يصوغان هذا الأمل بمختلف أشكال تجلياته. ولكن بعناد من سيربح، في النهاية،القضيه ـ ضد موت القضايا، وطمس القضايا، والمقامرة بالقضايا!
ليست مزايا القاسم قليلة، إن حسبنا هذا التراث من القول المقاوم. واللغة الضامنة لما سيحدث، والشعر، الذي لا بد أن يسهم بفعاليته التعبوية، في صياغة الوجدان العام. كما أنه ليس مفهوماً أن يبقى القاسم في منطقة واحدة من الصياغات الشعرية غير الآبهة بالتطور. وهو قد أعفى نفسه من المساءلة بقوله: ” أنا مؤلف مارشات أكثر مني موسيقي”.
……………….
أخيراً…
أقترح على الشعراء ألا يلجأوا إلى التسول، في لحظات العمر الأخيرة، وخصوصاً من هذا الوغد، حاذف الإبتسامات، ومشوه الضحكات…الكيماوي ، الذي لايجعل
الابتسامه لا تصل الى هدفها ….
وخصوصاً، أيضاً، لأنه لا جدوى من الساعات والأيام المضافة إلى … ذاكرة النسيان!