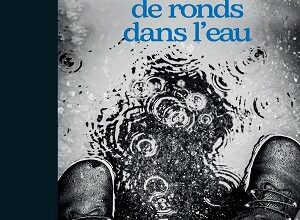مائة عام على «المؤتمر السوري العام»| سوراقية: شتات عمران أم مجتمع طبيعي؟

يتداول إعلاميون وناشطون وأيديولوجيون، منذ اندلاع الحرب ضد سورية، ما يسمّونه في أدبياتهم «سوراقية» أو «بلاد المشرق»، كمتحد طبيعي اجتماعي واحد (*). غير أن صغار الجغرافيين والمؤرخين المتعلمين في المدارس الأجنبية والمتحزبين لقوى سياسية، محليّة أو أجنبية، تحكمها الأهواء والمطامح السياسية الصغيرة، يصرّون على اعتبار سوراقية بوصفها منطقتين منفصلتين، الواحدة عن الأخرى، لا منطقة واحدة: الأولى هي «بلاد الشام» والثانية هي «العراق»، مع أنهما، بالنسبة إلى جغرافيين آخرين غير متحيّزين إلا لعلمهم واختصاصهم، تنتميان إلى بيئة طبيعية واحدة اسمها سورية (الاسم القديم للبلاد) أو الهلال الخصيب (الاسم الذي أطلقه العالم البريطاني بريستند على المنطقة الممتدة بين طوروس شمالاً وصحراء سيناء والبحر الأحمر جنوباً) أو سوراقية (كما سمّاها أنطون سعاده، محوّراً اسم سورية ليشمل العراق أيضاً). ويجهد كثيرون، مخلصين، في البحث عن «المشترك» و«الجامع» و«الموحّد» بين الدويلات القائمة في هذه المنطقة، لإيمانهم بأن سورية/ سوراقية أو (بلاد الشام والعراق، كما يصرّ الجاهلون بحقائق التاريخ والجغرافية، على تسميتها) تبقى لهم مجتمعاً واحداً.
حجة هؤلاء الوحدويين الملتزمين قضايا أمّتهم، أن ما يظهر لأولئك الغفلة الواغلين على العلم والسياسة، من منازعات داخلية وداخلية – خارجية، على الأرض السورية، ومن تدهور أو انحطاط ثقافي واقتصادي واجتماعي، على أنه/ أنها وقائع موضوعية، إنما هو/ هي، في الحقيقة، مظاهر برّانية زائلة لا تلبث أن تتلاشى ما إن تُسقط القوى الناهضة في الأمة (وقد بدأت) رهانها على أنظمة شرّعت التجزئة السياسية التي افتعلتها تفاهمات سايكس – بيكو المجرمة (1916)، وامتهنت الخضوع للأجنبي، وتتنكب بنفسها مسؤولية النهوض بالمصير القومي. إن في بلاد الشام والعراق (سوراقية)، يؤكد هؤلاء، وحدة قومية فعلية في الحياة الاجتماعية والمصالح النفسية والاقتصادية وفي المصير القومي العام لا يمكن عوارض الحدود السياسية المصطنعة تقطيعها وتجزئتها. كذلك إن ترابط القرى والمدن والأوردة الزراعية فيها لا يسمح مطلقاً بالتفكير في تجزئة الأمة الواحدة إلى أمم والشعب الواحد إلى شعوب تحت أية صيغة من الصيغ أو أية ذريعة من الذرائع. الأمر الذي تجد فيه هذه الإشكالية، موضوع البحث، مبرراتها النظرية والمنهجية.
في هذه الورقة المخصّصة لاحتفالية مئة عام على «المؤتمر السوري العام» (1919) و«معركة ميسلون الخالدة» (1920) كأهم حدثين، بعد اتفاقية سايكس – بيكو ووعد بلفور، في تاريخ سورية الحديث، سأنطلق من فرضية أن سوراقية أو بلاد المشرق السوري التي تشتمل على «هاتين» المنطقتين وتضم لبنان وفلسطين والأردن والشام والعراق والكويت، والأراضي المغتصبة من قبل آل سعود في الشرق («الأخبار»، 21 كانون الثاني 2016) وبني عثمان في الشمال («الأخبار»، 19 شباط 2016) والفرس في الشرق (الأحواز/ عربستان) والمصريين في الجنوب (سيناء) شكلت، على الدوام، وحدة جغرافية – زراعية – اقتصادية – استراتيجية، على الرغم من التجزئة السياسية التي فككت، ولا تزال تفكك أوصالها، والتمزق الاجتماعي (الطائفي والإتني) الذي قصم، ولا يزال يقصم ظهرها، والتخلف الاقتصادي والثقافي الذي استبدّ، ولا يزال يستبد بها منذ عقود.
سأحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي ما انفكت تقضّ مضاجع كثيرين من أبناء البلاد، ألا وهي: هل سوراقية أو بلاد المشرق السوري فسيفساء عصبيات وأعراق، أم متحد اجتماعي متجانس؟ بقايا شعوب منحطة أم شعب واحد؟ مجتمع اصطناعي أم مجتمع طبيعي؟ شتات عمران كما يراها ويتنبأ لها الجهلة والمرتبطون بالخارج، أم وحدة حياة كما ينظر إليها أبناؤها المتمسكون بحقائق الجغرافية والتاريخ؟ وهل يصحّ الرهان على القوى الحيّة المتيقظة فتُحقّق هذه القوى، اليوم، ما عجزت عن تحقيقه في الفترة الماضية، من وحدة اتجاه ومصير، في إطار وحدة سياسية جامعة، مستفيدة من التطورات الإيجابية الجارية، قومياً وإقليمياً ودولياً، فضلاً عن «التطورات الخفية» التي عادة ما تقود إليها العوامل الاضطرارية، الاقتصادية و… غيرها، دون أن يكون للنظام أو الأنظمة السياسية القائمة أي فضل في إحداثها؟
في التسمية
سأبدأ في تعريف اسم «سوراقية» الذي سأستخدمه، هنا، مرادفاً لاسم سورية، كما سأعرّف بمصطلح «المتحد» الذي دخل معجم اللغة العربية، لأول مرة، عام 1938. سوراقية مصطلح جديد يُستخدم كثيراً في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، كما سبقت الإشارة، نحته أنطون سعاده (1936) بإدغام اسم العراق بسورية، ليؤكد انتماء العراق أو ما بين النهرين إلى سورية/ الوطن الأم واعتباره جزءاً متمماً لها. ولسعاده، في هذا الصدد، تصريح واضح يعود إلى عام 1936، إذ قال جواباً عن سؤال في محل العراق من القضية القومية وصلته بسورية: «إن العراق، أو منطقة ما بين النهرين، هو جزء متمم للأمة السورية والوطن السوري، وكان يُشكل جزءاً من الدولة السورية الموحّدة في العهد السلوقي ويجب أن يعود إلى الوحدة القومية التي تشمله، حتى لو اقتضى الأمر تعديل اسم سورية وجعله سوراقية»(1). وفي عام 1938، ثبّت سعاده رأيه المذكور في خطابه في نادي «همبلط» في برلين التي زارها بناءً على دعوة تلقاها من أعضاء حزبه فيها، قائلاً: «إن سياسة سورية القومية الاجتماعية تسعى لإزالة الصحراء الداخلية [البادية السورية] بين سورية الأم والعراق وتحويلها إلى مزارع وبساتين تسمح بإنشاء القرى والمدن وترابط العمران فيتم الاتحاد الاجتماعي، الذي إذا لم يسبقه الاتحاد السياسي، فلا غنى له عن اللحاق به. فيمكن حينئذ إنشاء سورية الكبرى أو «سوراقية»، إذا لم يكن بدّ من تحوير الاسم»(2). وتجدر الإشارة، هنا، إلى أن سعاده كان قد أجرى هذا التنقيح قبل تثبيته في كتيّب «التعاليم» عام 1947 في أحاديث وخطب بعضها دوّن وبعضها لم يدوّن، خصوصاً ما تعلق بمنطقة ما بين النهرين، التي كانت داخلة، منذ تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، ضمن تحديد الوطن السوري، ولكن حدودها وتخومها لم تكن معيّنة كلها، لأن بعضها كان لا يزال تحت التحقيق التاريخي والإتني والجغرافي(3).
وإذا كانت «سوراقية» هي سورية الطبيعية، فإن هذه الأخيرة ليست «سورية الكبرى» ولا «الهلال الخصيب»، المصطلحين اللذين عبّرا، في حينه، عن مشروعين سياسيين معينين، واستُخدِما كثيراً في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، للتشويش على التسمية الصحيحة لهذه البلاد التي عُرفت في التاريخ باسم سورية، والتي تبقى متحداً جغرافياً واحداً مهما نشأ فيها من دول، ولا يُغيّر شيئاً من حقيقتها استبدال تسمية جديدة باسمها الذي عرفها به التاريخ، ولذلك رفض سعاده رفضاً قاطعاً التسمية المستحدثة لسورية وصرّح، بحزم، قائلاً: «نحن سوريون لا هللخصبيون!».
المتحد أو المتحد الاجتماعي مصطلح جديد وضعه سعاده بالعربية في كتابه «نشوء الأمم» (1938) كترجمة للكلمات التالية، بالفرنسية والإنكليزية والألمانية، Community Gemeinschaft، Communaute، وهو يعني كل مساحة تشتمل على حياة مشتركة لجماعة من الناس وتكون متميّزة عن المساحات الأخرى. القرية متحد، والمدينة متحد، والمنطقة متحد، والقطر متحد، ولكل متحد خصائص تميّزه عمّا سواه. وتفيد هذه اللفظة بالتجانس والتلاحم اللذين يميزان الواقع الاجتماعي للجماعة المشتركة في حياة واحدة. وشرط المتحد ليس أن يكون مجموعاً عددياً من ناس مشتركين في صفات النوع الإنساني العامة فحسب، بل مجموعاً متحداً في الحياة متشابهاً أفراده في العقول والأجسام تشابهاً جوهرياً. ذلك أن الاشتراك في الحياة يولّد اشتراكاً في العقلية والصفات كالعادات والتقاليد واللهجات والأزياء وما شاكل. وعليه، فإن كل متحد مهما كثرت صفاته أو قلّت، ومهما تعدّدت مصالحه، هو متحد قائم بنفسه. كل قرية متحد، سبقت الإشارة، ولا يعكس… إلخ. والقطر الذي هو متحد الأمة أو المتحد القومي هو أكمل وأوفى متحد. أما المصالح، فتنشأ في المجتمع، لا خارجه، والصفات تتكون من حياة جماعة مشتركة. وكل جماعة لها حدود، حتى البدو الرحّل لهم حدود لرحلتهم، فهم يتنقلون أبداً ضمن نطاق تجري حياتهم ضمنه، فإن خرجوا منه إلى بيئة جديدة خرجت حياتهم عن محورها. ولو كانت بيوت أهل دمشق قائمة إلى جانب بيروت من جهة صيدا والشويفات مثلاً، وملتحمة ببيوت هذه المدينة، فهل كان يجوز حينئذ التحدّث عن مدينتين متميزتين، عن متحدين؟(4) «الاشتراك في الحياة الواحدة» هذا هو، باختصار، معنى المتحد. والأمة هي أتم متحد، يقول سعاده.
تعدّد التسميات بتعدد الترجمات
إن التفسير الوحيد للتسميات المتعدّدة التي أعطيت، تباعاً، للبلاد السورية يعود إلى تنوع الترجمات الأجنبية لحوادث تاريخها القومي، تنوّع مردّه إلى الفتوحات الخارجية الكبرى التي قطعت مجرى وحدة البلاد وأدّت إلى انعدام السيادة القومية. فقد قصر بعض المؤرخين الأجانب ومن والاهم من مؤرخي البلاد تعريف «سورية» على سورية الغربية، سورية البيزنطية، أو ما بات يُعرف بـ«بلاد الشام» الممتدة من جبال طوروس ونهر الفرات في الشمال إلى قناة السويس وصحراء سيناء في الجنوب، فأخرج هؤلاء المؤرخون الآشوريين والكلدان وتاريخ بابل ونينوى (أي العراق) من تاريخ سورية. وجميع هؤلاء المؤرخين لم يُدركوا حقيقة وحدة البلاد السورية ولا تطورات نشوئها، وقد جاراهم أكثر المشتغلين بالتاريخ من السوريين المتعلمين من التواريخ الأجنبية بلا تحقيق، فالتبست الحقيقة وضاعت معها القضية السورية الحقيقية.
وإذا تصفّحنا كتب التاريخ في العالم وجدنا أنه لا يوجد، إلا في ما ندر، تعريف واحد لمساحة واحدة تُسمّى «سورية». فبعد انهيار الإمبراطورية الرومانية، سقطت سورية بالكامل تحت السيطرة البيزنطية – الفارسية، حيث بسطت الدولة البيزنطية سيادتها على سورية الغريبة كلها من كيليكية وأنطاكية شمالاً حتى حدود مصر جنوباً، واقتصر اسمها على هذا القسم. وبسطت الدولة الفارسية سيادتها على سورية الشرقية كلها (أي منطقة ما بين النهرين أو أراضي آشور وبابل القديمة) وأطلق عليها اسم «أيراك» (بالكاف الفارسية) الذي عرّبه العرب، لاحقاً، فصار العراق.
وفي العصر الحديث، بسطت الدولتان الاستعماريتان، فرنسا وبريطانيا، سيادتهما على سورية وجرت تجزئتها حسب المصالح والأغراض السياسية لهاتين الدولتين الاستعماريتين، وحصلت التسميات: فلسطين، شرقي الأردن، لبنان، سورية (الشام)، كيليكية، والعراق. فتقلّص اسم سورية إلى منطقة الشام المحدودة، ولا يزال.
إن اقتسام البيزنطيين والفرس البلاد، في ما بينهم، وإقامة الحواجز بين شطري الأمة، الغربي والشرقي، عرقل كثيراً حركة النمو القومي ودورة الحياة الاجتماعية الاقتصادية الواحدة، ونتج من ذلك إبهام في حقيقة وجود الأمة والوطن، حتى انتبه سعاده إلى هذه الثغرة وراح، في أبحاثه وتحقيقاته، يزيل هذا الإبهام، واضعاً النقاط على الحروف. فكان عليه، كالأركيولوجي الذي يبحث في طبقات الأرض، أن ينقب في أطمار التاريخ وطبقاته، منتقلاً من نقطة إلى نقطة، ومن كتاب إلى كتاب، ومن لغة إلى لغة، إلى أن وصل إلى هذه الحقيقة المهمة التي تجعل من المنطقة الممتدة بين طوروس والسويس وبين البحر المتوسط وجزيرة العرب بلاداً واحدة والشعوب التي انتشرت فيها أصولاً مشتركة لأمة واحدة لا يمكن أن تخطئها بصيرة العالم الاجتماعي والسياسي(5).
في تحامل المؤرخين
إنه لمن المؤسف جداً، أن تاريخ هذه البلاد، خصوصاً بعد الفتوحات الكبرى التي تعرّضت لها وعانت من ويلاتها الكثير – فتوحات الفرس والإغريق والرومان والعرب والفرنجة – كان يكتبه مؤرخو المدرسة الإغريقية – الرومانية للتاريخ: تلك المدرسة التي رمت إلى تشويه حقيقة السوريين الاجتماعية والنفسية والحطّ من شأنهم والتشنيع بكل ما هو سوري، وأولئك المؤرخون الذين كتبوا بروح العداء لسورية والسوريين وبعدم إنصاف للحضارة والثقافة السوريتين. وقد شهد على هذا الظلم اللاحق بسورية وتاريخها مؤرخون غربيون كبار يأتي في طليعتهم المؤرخ الإيطالي المشهور شيزر كنتو (Cesare Cantu 1804-1895) في مؤلفه «التاريخ العالمي» (1842).
إن معظم التواريخ الأجنبية والمؤرخين الأجانب لم ينظروا إلى سورية من وجهة حقيقة الأمة وحقيقة الوطن، بل من وجهة النظر السياسية الأجنبية الخاضعة لمصالح دولهم الاستعمارية. والمصادر التاريخية الأجنبية كانت تُطلق المصطلحات السياسية بلا تحقيق للوضع الطبيعي والاجتماعي.
إذا اعتمدنا فوليبيو (Polype) مرجعاً لدرس الحروب بين قرطاجة وروما المعروفة بـ«الحروب البونية» حسب التعابير الأجنبية، كنا مضطرّين، بحسب روايته، كما اضطرّ عدد من «مؤرّخينا» الببغائيين، إلى التسليم بانحطاط السوريين الكنعانيين أو البونيين وتفوّق الرومان عليهم، مع أن «الحقيقة كانت عكس ما رمى فوليبيو إلى إظهاره، لأن الرومان دُهشوا للآثار الفنية التي حملها جيش سيبيو (Scipion) من بين أنقاض عاصمة الإمبراطورية السورية الغربية، قرطاضة العظيمة»(6).
إن فوليبيو الإغريقي الذي ورث حقد اليونان على الكنعانيين رمى إلى تشويه القيم السورية ورفع قيمة الرومان وتقليل أهمية الأفعال التي قام بها السوريون الكنعانيون في السلم والحرب. فهو قد صوّر حملة هاني بعل إلى إيطالية وعبوره جبال البيرينه ثم جبال الألب الشاهقة تصويراً يحطّ كثيراً من قيمة تلك الحملة العسكرية النادرة المثيل، نافياً أن تكون شيئاً خارقاً للعادة لأن بعض القبائل المتوحشة عبرت في ارتحالها جبال الألب، مساوياً بين ارتحال قبائل همجية تضرب في الأرض على غير هدى، بلا هدف، وحملة عسكرية منظّمة خُطّطت بعناية فائقة وبجرأة عديمة المثيل في التاريخ وبعزيمة كأنها القضاء والقدر(7).
مما لا شك فيه، أن هذا الإبهام في حدود سورية أو سوراقية أو المشرق السوري يعود بالأكثر إلى انهيار السيادة القومية، لأجيال طويلة، وانقطاع استمرار التاريخ القومي بعامل الغزوات الخارجية، وإلى انعدام مصادرنا التاريخية التي يجب اعتمادها، وحدها، في كتابة تاريخنا القومي، وعدم التعويل كثيراً على المصادر الأجنبية التي، غالباً، ما تكون متحيّزة.
التجويف الصحراوي وأسباب عمقه
أدّى هجوم الصحراء العربية من الشرق باتجاه الهلال الخصيب، بعامل تناقص السكان وتقلّص العمران وقطع الغابات وتجريد مناطق واسعة من البلاد من أحراجها، بسبب الحروب والغزوات، إلى زيادة الطين بلّة. الأمر الذي دفع المؤرخين الأجانب – ومن خلفهم المشككين في إمكانية وحدة البلاد من السوريين أنفسهم – إلى اعتبار التجويف الصحراوي (البادية) بين الشام والعراق حاجزاً طبيعياً لا يمكن تخطيه في أي مشروع وحدوي مستقبلي. فالبقعة الكبيرة الممتدة ما بين نهري الفرات والأردن المعروفة بالصحراء السورية أو بادية الشام التي تشكل ثلث مساحة سورية الجغرافية تقريباً، تبدو كأنها لسان من الصحراء العربية يخترق البلاد السورية من الشرق إلى الغرب، ولكنها ليست صحراء بكامل معنى الكلمة. إنها، بالأحرى، قفر من النبات والعمران وقد ساعد انحطاط الثقافة والتمدن جفاف الصحراء العربية على التمدّد إلى هذه البقعة السورية الخالية من الأنهر، فأقفرت أرضها وتعرّت تربتها وصارت شبه صحراء. ولكن هذه البقعة ليست صحراء كالصحراء العربية، فهذه الأخيرة صحراء رملية، تتوسطها صحراء النفوذ وتمتدّ إلى الربع الخالي، فهي ليست ترابية ولا تصلح للفلح والزراعة. أما الصحراء السورية فهي بادية ترابية، صالحة للفلح والزراعة واستعادة الخضرة، ولم تكن في غابر عهدها جرداء كما تبدو، اليوم. وإن وسائل الرّي من دجلة والفرات، متى تحققت، تفتح مجال إمكانات زراعية عظيمة لهذه البقعة المقفرة. وإذا أمكن تحريج المناطق المحيطة بها تعدّل الإقليم، وارتفعت كثافة الرطوبة في الهواء، وزادت الأمطار، وأمكن تحويل مساحات جرداء إلى مزارع وبساتين تسمح بإنشاء القرى والمدن وترابط العمران.
في الثروات الطبيعية
تمتلك سورية/ سوراقية ثروات طبيعية هائلة، كالنفط والمياه، ولكنها بسبب سوء استخدامها وتنظيمها وتوزيعها من جهة، وانعدام حمايتها من أطماع وتعديات الأمم المجاورة من جهة ثانية، لم توظف، إلا لماماً، في مشاريع التنمية القومية أو حتى التنمية المحلية داخل كل دولة، على حدة. فالنفط، مثلاً، حكر على عائلات حاكمة/ الكويت، مثلاً، أو أنظمة سياسية/ العراق، تتصرّف به تصرفاً كيفياً، من دون أي اعتبار للمصلحة القومية العليا، فضلاً عن أنه سلاح ثمين لم تستخدمه الأمة في جميع قضاياها الكبرى، خصوصاً في فلسطين.
ونظراً لكون النفط ثروة قومية عامة، فهو، إذاً، ملك قومي عام للمجتمع القومي كله في سوراقية كلها وليس لواضعي اليد على أرضه فقط، فالسوريون الآخرون هم، أيضاً، شركاء، قومياً، في هذه الثروة. ولذلك فإن عائداته هي، حكماً، عائدات قومية عامة يعود للشعب السوري كله حق الانتفاع منها، لا للعراقيين أو الكويتيين – أو بعض فئاتهم- وحدهم. وعليه، فإن المصلحة القومية العليا تقتضي الدفاع عن هذه الثروة وتنظيمها بإعادة توزيعها توزيعاً عادلاً بين الدول المالكة للنفط والمحرومة إياه، بالسواء.
إلى جانب النفط، هناك الثروة المائية. وهي، أيضاً، ثروة قومية عامة، تنطبق عليها القاعدة نفسها، ويحكمها المنطق نفسه. فالأنهار السورية، وما بينها من جداول وبحيرات، تشكل ثروة مائية هائلة، ولكنها غير مستغلة تماماً بسبب الهدر وسوء الاستخدام وانعدام التخطيط، فضلاً عن عمليات السطو التي تلحق بها جرّاء الاستيطان اليهودي في الجنوب والاحتلالين: التركي في الشمال الغربي، والإيراني في الشمال الشرقي. وعلى الرغم من وجود هذه الثروة المائية الكبيرة، فإن مساحات شاسعة من الأراضي السورية تصحّرت، ومساحات أخرى أقفرت وتعرّت تربتها وصارت شبه صحراء.
في الحروب الداخلية
أدّى فقد سورية سيادتها على نفسها ووطنها بعامل الفتوحات الخارجية إلى تجزئة البلاد وإطلاق تسميات مجزّئة عليها، كما سبقت الإشارة. وزاد الطين بلة نشوب ما يُمكن تسميته، أحياناً، «الحروب الداخلية» بين ممالك الأمة الواحدة وإماراتها. هكذا، كان العدو الخارجي يستفيد من حالة الانقسام الداخلي ليثبّت وجوده ومصالحه على حساب وجودنا ومصالحنا، ولكن العمران ودورة الحياة الاقتصادية الاجتماعية الواحدة استمرتا – على الرغم من ذلك – في سيرهما الحثيث. الأمر الذي جعل مطلب السيادة والوحدة القومية ممكناً، على الدوام.
شهدت البلاد السورية، في فترات كثيرة من تاريخها، نزاعات محلية صنّفها بعض المؤرخين في خانة الحروب التي تجري عادة بين شعوب متجاورة متخاصمة بهدف التوسع والغلبة، فيما أطلق عليها سعاده صفة «الحروب الداخلية» التي هي نزاع على السلطة بين قبائل الأمة الآخذة في التشكل. فالدول الآشورية والكلدانية والحثية والكنعانية التي نشأت في هذه البلاد، نشأت ابتغاء بسط السلطان لإحدى هذه الفئات على بقية البلاد ولإيجاد تمركز لها، وليس بدافع انفصال الحياة وانعزال البيئة واختلاف في الحياة واتجاهها(8). وكما حدث في سورية تنازع داخلي سبق وحدتها السياسية، حدث مثل ذلك في تاريخ أمم أخرى. فإذا أخذنا إيطاليا، مثلاً، وجدنا أنه نشأ فيها نزاع بين المدن اللاتينية وبين روما وأخذت روما منها اللسان اللاتيني، ثم أخذت تسيطر على باقي القبائل هناك. حدث الأمر نفسه في بلاد الإغريق في النزاع الذي استمر طويلاً بين أثينا وأسبرطة وطيبة للسيطرة على اليونان. وهكذا استمرّت الحروب إلى أن توحدت هذه الشعوب في وحدة حياة ووحدة مصير. وكما أن الحروب في إيطالية أو في اليونان أو في بلاد العرب كانت حروباً داخلية بين قبائل/ أصول الأمة الواحدة، كذلك الحروب بين القبائل السورية كانت حروباً داخلية عائدة، في جملة أسبابها، إلى البيئة الجغرافية المتّسعة والمتنوعة حيث أدّت صعوبة المواصلات وضعف كثافة السكان إلى أن يقوم كل جزء منها بمجهود سياسي خاص به وإن يكن يشمل في القصد بقية الأجزاء(9). إن الشعوب المديترانية (المتوسطية) والآرية التي استوطنت هذه البلاد وكونت المزيج السوري، نزع كل شعب منها إلى إقامة الدولة ومنافسة أشقائه في النفوذ والملك وفي السعي لضم بقية الأجزاء تحت سلطانه، فنشأت الدول السورية الأولى القديمة التي نشب بينها ــ كما أسلفنا ــ نزاع داخلي ولكنها كانت تتحد أو تتحالف ضدّ الأخطار الخارجية، وكانت في فترات طويلة من التاريخ تُطيع حكومة أو دولة سورية واحدة(10).
المحالفات الداخلية ضدّ الخارج
كانت المنازعات الداخلية بين الممالك السورية استثناءً، فيما كانت المحالفات ضد القوى الخارجية هي القاعدة الناظمة للحياة السياسية في البلاد السورية كلها، على امتداد تاريخها. وهذه المحالفات ضد الدول القائمة في الجوار كانت تعبيراً عن شعور الدول السورية باشتراكها في التركيب الدموي واشتراكها في الأرض، وفي ترابطها في وحدة مصير الشعب والوطن. وإذا كان بعض هذه المحالفات قد حدث ضد بعض الدول السورية الطامحة إلى توحيد البلاد كلها تحت سلطانها ورايتها، لم يكن لهذه المحالفات الشمول القومي، بل كانت نوعاً من تحالف الأمراء ضد الملكية المطلقة الشاملة(11).
إن تاريخ الدول السورية كلها يدل على اتجاه واحد: الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الهلال السوري الخصيب. هذه الحقيقة تجعلنا نفهم الحروب بين هذه الدول للسيطرة على جميع البلاد فهماً جديداً يخالف الفهم المستمدّ من التحديدات غير الصحيحة. فهذه الحروب، سبقت الإشارة، حروب داخلية. هي نزاع على السلطة بين جماعات الأمة الآخذة في التكون والتي استكملت، في ما بعد، تكونها.
شتات عمران أم متحد اجتماعي؟
سبق أن ذكرنا في مطلع هذه المقالة، أن سورية/ سوراقية، أو بلاد المشرق هي وحدة جغرافية – زراعية – اقتصادية – استراتيجية. فالأرض بيئة طبيعية واحدة تقوم عليها وحدة شعبية وأنحاؤها يُكمل بعضها بعضاً. ووحدة الأرض الزراعية هي أساس وحدة الحضارة السورية (الشامية – العراقية). إنها وحدة متشابكة بالأنهر السورية: دجلة والفرات (وروافدهما الكثيرة) وسيحون وشيحون والعاصي والأردن واليرموك والليطاني، وما بينها من جداول وبحيرات وبرك.
وعلى الرغم من الضربات المتلاحقة التي جرت في حقبات تاريخية كان آخرها الاحتلال والإفقار العثماني، تبعتها ضربة الدول الأوروبية المنتصرة في الحرب الكبرى (1914- 1918) بإعطاء فلسطين لليهود، ما أدّى إلى تقطيع شرايين الحياة في الأمة، فإن دورة الحياة الاقتصادية الاجتماعية بين مناطقها، خصوصاً في المحطات الصعبة من تاريخها، لم تنقطع، يوماً، الأمر الذي يؤكد، من دون أدنى شكّ، أن وحدة الحياة والمصير المتجسّدة في التطورات الخفية التي تقود إليها العوامل الاقتصادية الاضطرارية للحياة القومية تربط المجتمع القومي كله في بلاد المشرق السوري بأمتن الروابط وأعمقها.
إنّ سرّ بقاء سورية (ومن ضمنها العراق) وحدة خاصة وأمة ممتازة، مع كل ما مرّ عليها من غزوات، يقول سعاده، هو «في هذه البقعة الجغرافية البديعة، وهذه البيئة الطبيعية المتنوعة الإمكانيات من سهول وجبال وأودية وبحر وساحل، هذا الوطن الممتاز لهذه الأمة الممتازة»(12).
هذه العبارة المكثفة تدلّ على أمرين:
الأول: تنبّه الشعوب أو الجماعات السورية والدول التي نشأت في سورية لوحدة الأرض ووحدة الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية فيها، وسعي جميع هذه الدول إلى تحقيق وحدة الدولة في هذه البلاد. وقد رأينا، في ما سبق، أن الحروب التي كانت تنشب بين هذه الدول كانت حروباً داخلية أو منازعات على الحكم بين عائلات تنزع إلى الملك وتستند إلى عصبية خاصة في نهوضها إلى السيطرة.
الثاني: أهمية البيئة في طبيعتها ومواردها وإمكاناتها التي لها شأن خطير في تغذية حيوية الأمة ونشاطها. وسبق أن أشرنا إلى الأنهر التي تتفجّر من قوس الجبال الشمالية، في المنحنى الكبير بين البختياري وطوروس، خصوصاً النهرين العظيمين دجلة والفرات. ونشير أيضاً إلى نهري جيحون وسيحون اللذين يرويان الأراضي الخصبة في سهول كيليكية. كذلك نشير أيضاً وأيضاً إلى الأنهار المنحدرة من جبال لبنان، وإلى نهر العاصي الذي يروي سهول الغرب السوري الشمالية ماراً بحمص وحماة إلى أنطاكية العظمى، والأردن الذي يسقي الجنوب في اتجاهه نحو البحر الميّت.
تلك هي، باختصار، عوامل وحدة الحياة والمصير التي ترمز إلى حيوية الأمة الظاهرة في إنتاج رجالها الفكري والعملي، وفي مآثرها الثقافية، كاختراع الأحرف الهجائية التي هي أعظم ثورة فكرية ثقافية حدثت في العالم، وإنشاء الشرائع التمدنية الأولى، ناهيك بآثار الاستعمار والثقافة السورية المادية – الروحية والطابع العمراني الذي نشرته سورية في البحر السوري المعروف في الجغرافية بالمتوسط، وبما خلّده سوريون عظام، من أعلام الفكر والثقافة، قديماً وحديثاً. أضف إلى ذلك قوادها ومحاربيها الخالدين»(13).
يبقى أن نشير إلى أنه رغماً من تسييس قضيتها، في الماضي، في مشاريع استعمارية مشبوهة وفاشلة، كمشروع سورية الكبرى أو مشروع الهلال الخصيب، والتي أعدّتها قوى استعمارية وقوى محلية عميلة لها، تبقى سورية أو سوراقية منطقة جغرافية واحدة ومتحد اجتماعي واحد مهما نشأ فيها من دول، ولا يغيّر شيئاً من حقيقتها استبدال تسمية استعمارية جديدة أو تسمية تفرض فرضاً بعامل الحرب الدائرة عليها وفوق أراضيها، فكما ذهبت تسمية «اللوفان» أو (Levant) إلى النسيان، برحيل الاستعمار الفرنسي، كذلك ستذهب أية تسمية برحيل مطلقيها، إقليميين كانوا أو دوليين، والتاريخ أقوى شاهد!
الهوامش:
(*) للمزيد من الشروحات حول هذه الفكرة، راجع:
- ناهض حتّر، ربيع زائف، مركز التقدّم الأردني، عمان 2013.
- أنيس النقاش، الكونفدرالية المشرقية، دار أمواج – بيسان، بيروت 2015.
- صفية سعاده، سوراقيا بديلاً من سايكس – بيكو، دار سعاده ط1، بيروت 2015.
- بالإضافة إلى عشرات المقالات التي نُشرت في جريدة «الأخبار» البيروتية على امتداد الأعوام الأخيرة: 2013، 2014، 2015 و2016.
(1)- سعاده، الأعمال الكاملة، م7، مقدمة كتاب التعاليم، ط4 (1947)، مؤسسة سعاده للثقافة، ط1، بيروت 2001، ص 312.
(2)- سعاده، الأعمال الكاملة، م3، مؤسسة سعاده للثقافة، ط1، بيروت 2001، ص 455.
(3)- سعاده، الأعمال الكاملة، م7، مقدمة كتاب التعاليم، ط4 (1947)، المرجع المذكور، ص 312.
(4)- انظر: سعاده، نشوء الأمم، الفصل السابع، الصفحات 158، 159، 167، 168، مؤسسة سعاده للثقافة، طبعة جديدة، بيروت 2014.
(5)- سعاده، الأعمال الكاملة، م8، مؤسسة سعاده للثقافة، المرجع المذكور، ص 54.
(6)- سعاده، المرجع المذكور، ص 68.
(7)- سعاده، المرجع المذكور، ص 69.
(8)- سعاده، المرجع المذكور، ص 54.
(9)- سعاده، المرجع المذكور، ص 55.
(10)- سعاده، المرجع المذكور، ص 57.
(11)- سعاده، المرجع المذكور، ص 65.
(12)- سعاده، المرجع المذكور، ص 64.
(13)- سعاده، المرجع المذكور، ص 77.
صحيفة الأخبار اللبنانية