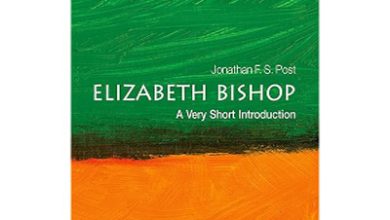متحف البرجوازية الصغيرة

أحمد عاكف لم يكن صورة نجيب محفوظ عن نفسه. بطل خارج من متحف البرجوازية الصغيرة ليعيد تمثيل تضحيتها الكبرى لتعيش العائلة والأخلاق الحميدة.
أحمد عاكف هو نعي نجيب محفوظ لبرجوازية تحتضر في «خان الخليلي»، التي لم يكتبها نجيب محفوظ كعادته مع رواياته للسينما.
عاطف سالم المخرج، عندما اختار فريق الفيلم، لم يجد سوى عماد حمدي، الذي جسّد فكرة الاحتضار النبيل للبرجوازي القديم، وصنع منه «صورة» قريبة لمزيج نجيب محفوظ من التعاطف والسخرية.
هذه لعبة نجيب محفوظ المتورطة، يسخر ويتعاطف، يلعن ويكشف التناقضات، يلمس الخطوط الفاصلة بمهارة حسية، لا ذهنية فقط، وهذا ما جعله مهماً للسينما التي دخلت الى معركة «الواقعية واكتشاف الذات بثقلها وإمكانياتها في نقل «الصورة»، بما لا يستطيعه الأدب.
نجيب محفوظ لم يكتب عن أبطاله من خيال غرفة مغلقة، لكنه ساكن مدينة، يمشي في شوارعها، يعبر جسورها، وله رحلة يوميّة، لها علامات ارتبطت به إلى آخر حياته.
نجيب محفوظ برجوازي صغير، يلعب في مساحة وسط، هي اختراع أهل الشرق، الظرفاء لبرجوازيتهم، بين المادة والروح، الرأسمالي والعامل.
اللعب في دراما مجتمع صنع تاريخه برجوازيون صغار من جمال عبد الناصر الى حسن البنا، اختار موقع الوسط بين حوافٍ حادة، إنها برجوازية لها ملامح خاصة.
ولد نجيب محفوظ في بيت لم يعرف بعد الكهرباء. تسرّبت تفاصيل العالم الى وعيه على الإضاءة الشحيحة لمصابيح الكيروسين المنتشرة في بيوت «المستورين» من الطبقة التي ستكون بعد سنوات قليلة طليعة البرجوازية الصغيرة في مصر.
عرف أول بطولة خارج حدود البيت والأب مع سعد زغلول، الزعيم المقبل من بيئة متواضعة ليعبر عن أمل البلاد في الحرية والاستقلال.. وعن آمال الفئات المهمّشة في العبور إلى أماكن اجتماعية جديدة. وهنا كانت ثورة زعيم «الوفد» في العام 1919 على بعد سنوات من ميلاد نجيب محفوظ، لكنها كانت الأقرب إلى تركيبته الخاصة الجامعة للمتناقضات في سلام شخصي واجتماعي فريد.
هو متمرّد لكن ليس إلى آخر مدى.. ومخلص للتقاليد القديمة لكن ليس إلى حدود الجمود. وبين التوق المنضبط إلى الجديد والهرب غير المنفلت من القديم اكتشف نجيب محفوظ «مكانه المريح» في الحياة والثقافة.
ولد نجيب في لحظات انتقال المجتمع إلى عصر جديد. ترك مصر القديمة، حيث كان يعيش في حي الحسين، إلى حي العباسية، فردوس الطبقة الوسطى الجديد وأحد مصانع وعيها وملاعب وجدانها، وهو ابن الجامعة الوطنية والثقافة الجديدة وابن المقاهي التي تتكوّن فيها حساسية مختلفة للمجتمع غير تلك التي تمرّدت عليها رغبة الأدب في اكتشاف ذات «قومية».
لم يكن نجيب محفوظ أسير ازدواجية التعليم المدني والأزهري، كما طه حسين، ولا موزعاً بين عشقين مثل توفيق الحكيم الممزق ثقافياً بين الشرق والغرب. كان نجيب الحالة الوليدة لمثقف مصر الحديث الذي يشحن وجوده الاجتماعي من ثورة التغيير وبدايات مراحل جديدة في تاريخ مصر. هكذا كانت «فاطمة» تصطحب ابنها «نجيب» إلى جولاتها الخاصة بين العباسية والجمالية.. وفي ضوء وعي الطفولة المندهش، يذهب معها بحثاً عن «البركة» في كنيسة «مار جرجس»، بعد أن يتمسَّح في ضريح «الحسين» أو عن المتعة الغامضة في مشاهدة «مساخيط» الفراعنة حيث تقضي أوقاتاً طويلة في حجرة «المومياوات» في المتحف المصري.
ثقافة غريبة على سيدة لا تعرف القراءة والكتابة. كانت «مخزن ثقافة» شعبية قديمة، ولم تدخل السينما غير مرة واحدة وكان فيلم «ظهور الإسلام»، وذلك عندما أقنعها الناس بأن الفرجة على الفيلم تساوي أداء فريضة الحج.
أما الأب، فكان يرتدي في الشتاء مثل الأفندية بدلة إفرنجية وفوقها معطف، وفي الصيف يرتدي الزي الأزهري (الجبة والقفطان). وفي كل الأحوال كان الطربوش غطاء الرأس المميز للطبقة الصاعدة من الموظفين والمتعلّمين. أما في حياته فكان نموذجاً للزوج المثالي، منضبطاً في مواعيده المنزلية، متسامحاً، ينام بعد العشاء، ولا يعرف سهرات العربدة التي سجلها محفوظ في ثلاثيته الشهيرة، أي أنه لم يشبه «السيد» أحمد عبد الجواد إلا في ولعه بالمغني وفن تلاوة القرآن.
لم ير نجيب أباه في حياة الوظيفة الحكومية، لكنه ذاق الاستقرار الذي حققته للعائلة. والأهم أنه بدأ يعي العالم، و«الموظف الميري» هو زهوة المجتمع. الأب كان يحلم له بوظيفة أكبر، وكيل نيابة أو طبيب، بينما صدم أساتذته في المدرسة عندما التحق بكلية الآداب قسم الفلسفة، وهو المتفوّق في مواد العلوم والرياضيات، بينما لا يحصد في المواد الأدبية سوى درجات متوسطة. أي أنه كان لا بد أن يكون حسب انتظارات العائلة موظفاً كبيراً في «هوجة» الموظفين الصاعدة في الثلاثينيات والأربعينيات، أو عالماً فذاً، كما توقع له الأساتذة، أو موسيقياً كما خطط هو بنفسه عندما التحق بمعهد الموسيقى العربية، وذلك وقت أن كان طالباً في السنة الثالثة في كلية الآداب. وكما حكى لرجاء النقاش: «درست فيه لمدة عام كامل.. ويبدو لي الآن أنني لو كنت وجدت توجيهاً سليماً من أحد، لتغيّر مسار حياتي واخترت طريق الموسيقى وليس الأدب».
نجيب محفوظ كان حائراً بين أصناف تشبع موهبة لا يعرف تفاصيلها، إعادة بناء الواقع من خلال حكايات وتمثيلات، تشبه الأشباح الصامتة وصورها في ظلام سينما الكلوب؟ تطبع بصماتها على الروح مثل الموسيقى؟ أم تحفر حكاياتها على الورق؟
صحيفة السفير اللبنانية