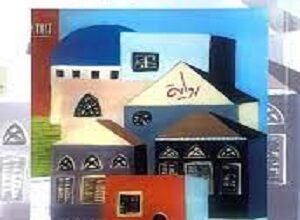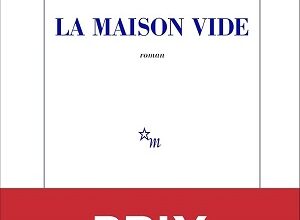رواية فرانسيسكو مونتانيا إبانيس تحكي طفولة مسحوقة في واقع قاسٍ بلا حنان حيث يتحول الجوع إلى معركة وجودية، ويصبح الاحتضان شكلًا من النجاة.
في روايته “لا تأكل صغار الضفادع”، ينقل الكاتب الكولومبي فرانسيسكو مونتانيا إبانيس القارئ إلى عالم قاسٍ لا مكان فيه للطفولة كما نعرفها. ورغم أن الرواية صُنفت ضمن أدب اليافعين، إلا أنها تتجاوز التصنيفات التقليدية لتطرح أسئلة أخلاقية وإنسانية عميقة، عن الفقد، والمسؤولية المبكرة، والتهميش الاجتماعي، والجوع، والحنين إلى حنان مفقود. إنها مرثية جماعية عن جيلٍ تُرك وحيدًا في وجه الخراب.
منذ الصفحات الأولى، ترسم الرواية مشهدًا صادمًا: خمسة أطفال يعيشون في غرفة واحدة بعد أن غادرهم الأب، وغابت الأم. يتحول الفراش إلى رمز للتقشف، والطاولة إلى مكان للطبخ والمذاكرة، والدرج إلى سرير للصغيرة “مانويلا”. يتحول “هيكتور” الطفل إلى أبٍ بديل، و”ماريا” إلى أمٍ مرهقة، أما “ديفيد” و”روبرت” فيتأرجحان بين الجوع والمشاجرات اليومية. وسط هذا كله، تختفي الطفولة وتبدأ المعركة من أجل البقاء.
تحمل الرواية التي ترجمتها عن الانجليزية مريم خالد وصدرت عن دار العربي عنوانًا دالًا ومفزعًا في آن: لا يبدو العنوان مجرد تحذير طريف، بل يتكشف لاحقًا كصرخة رمزية: لا تقتل البراءة، لا تلتهم الطفولة، لا تهين الإنسان في أضعف لحظاته. في أحد أكثر المشاهد رمزية، يبتلع أحد الأطفال ضفدعًا صغيرًا وسط صدمة الطفلة التي ترافقه، وتقول لاحقًا: “لم أتعلم شيئًا في ذلك اليوم سوى أنني تقيأت كل ما أكلته في الأيام السابقة”. الجوع، حين يتجاوز الحدود، يتحول إلى اغتيال للإنسانية.
في خط سردي موازٍ، نتعرف على “نينا”، فتاة أدخلت حديثًا إلى دار رعاية، بعد سجن والديها. تتعرض لعنف المتنمرين، وينقذها فتى غامض يُعرف بــ “الخالد” لأنه لا يتحدث، بل يصوب بيده وكأنه يحمل مسدسًا. هو ديفيد نفسه، أحد إخوة مانويلا وهيكتور. تنشأ بين نينا وديفيد علاقة غير لفظية، تتجسد في تبادل النظرات، واللقاء عند البركة. ديفيد الجائع أبديًّا، لا يقول سوى “أنا جائع”، وجوعه هنا يتجاوز الطعام: إنه جوعٌ للأمان، للانتماء، للحنان. ونينا، التي تحاول استعادته من صمته، ترى فيه مرآة وحدتها الخاصة.
الرواية لا تخلو من حضور نسائي مؤثر: الأم الغائبة، التي لا يُعرف مصيرها، تشكل شبحًا طاغيًا. الأخت الكبرى “ماريا” تحاول أن تملأ هذا الفراغ برعاية إخوتها رغم سنها الصغيرة. الطبيبة النفسية “مارسيلا”، على الضفة الأخرى، تمثل بارقة أمل، امرأة تستمع، لا تحكم، وتفسح في قلبها مساحة لمن لا صوت لهم.
أما الشابة التي تدعو “هيكتور” للهروب وسرقة الخزنة، فتقدم وجهًا آخر: التمرد على الواقع، لا لإصلاحه، بل للهروب منه. وقرار هيكتور بعدم الهرب معها، واختياره البقاء مع إخوته، يمثّل لحظة نضوج مؤلمة، لكن نبيلة. هذه الشابة لا تقدمها الرواية باسم صريح، لكنها تظهر كرمز لإغواء الحلم السهل والهرب من الواقع.
تعتمد الرواية على بنية سردية غير خطية، مشاهد تتوالى كلوحات داخلية، لا تسرد الوقائع بقدر ما تلتقط مشاعرها: الخوف، الغضب، الذل، التوق للدفء. هذه البنية تُقحم القارئ في داخل وعي الشخصيات، فيعيش معهم الجوع لا كمعلومة، بل كارتعاشة.
ولا يستخدم مونتانيا لغة صاخبة، بل ينسج نصًا رقيقًا، شفافًا، بقدر ما هو موجع. فالكلمات البسيطة تحمل على عاتقها كل الثقل العاطفي للعالم الذي تصفه.
الرواية، في مشهدها الختامي، لا تنحاز إلى نهايات مغلقة أو حلول مريحة. لا يظهر الأب كما يتمنى الأطفال، ولا تنبعث الأم من الغياب الطويل. الموت والفقد لا يُلغيان، والجوع لا يُشبع بالكامل، لكن شيئًا عميقًا يتبدّل. ليس في الحدث، بل في الإيقاع الداخلي للنص، وفي نبرة السرد التي تهدأ، كأن العاصفة هدأت داخل الشخصيات نفسها.
يعود “هيكتور” و”ماريا” إلى الغرفة، بعد بحث يائس عن الأخ الهارب “روبرت”، ولا يجدان إلا “ديفيد” و”مانويلا” نائمين، يحتضنان بعضهما بعضًا فوق بطانية قديمة. يتوقفان لحظة، يحدقان في هذا المشهد الهش: طفلان في حضن بعضهما، كأن العالم رغم كل قسوته، لم يسلب منهما القدرة على المودة. تستعد ماريا لإعداد الطعام، يهمس هيكتور قائلاً:
“أظن أننا نُبلي جيدًا، ألا تظنين ذلك؟”
فترد ـ وسط دموعٍ مكتومة ـ “لا أعرف. ربما.”
إنها ليست إجابة متفائلة، لكنها أيضًا ليست يائسة. هي إجابة من يعرف أن الظروف لم تتغير، لكن الإرادة تغيرت. كأن الأخوين قرّرا، دون إعلان، أن هذه هي العائلة الوحيدة المتبقية، وأن الحفاظ عليها، حتى بفتات الخبز وصحن حساء وموزة، أكثر قيمة من أي يوتوبيا زائفة.
نكتشف هنا أن الرواية لم تكن تبحث عن ذروة درامية، بل عن توازن هش وسط الخراب. المكان نفسه ـ الغرفة الضيقة ـ لم يتبدل، لكنه لم يعد محض جدار وسقف. صار مع الوقت يحمل آثار الصبر، والحنان، والانكسار، والمحاولات الصغيرة للبقاء. كأن الرواية تخبرنا أن البقاء نفسه، في بعض الظروف، شكل من أشكال البطولة.
الطفولة لا تُستعاد، لكنها تُخترع من جديد في حضن الآخر. والأخوّة لا تعني الدم فقط، بل القدرة على تقاسم الصمت، والنوم في العراء، وتقشير البطاطس في ضوء خافت.
في النهاية، “لا تأكل صغار الضفادع” عمل عميق، يطرح سؤالًا وجوديًّا: من يلتفت إلى من لا حول لهم ولا قوة؟ من يصغي إلى جوع الطفولة حين يكون أكبر من الطعام؟ إنها صرخة ضد سحق البراءة، ومرآة قاتمة لمجتمعات تترك الأضعف في العراء. ومع ذلك، فهي رواية عن الحب، عن المحاولة، عن الأمل الممكن في أقسى الظروف.
ميدل إيست أونلاين