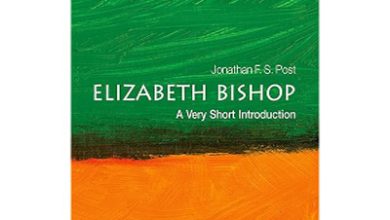مصر ليست «مُرْسِي ستان» (ربيع بركات)
ربيع بركات
في ثورة «الخامس والعشرين من يناير» العام 2011، قدر «مركز غالوب للاستطلاعات» نسبة المصريين الذين شاركوا بأحد عشر في المئة، ما ساعد على نجاح الثورة خلال زمن قياسي، كان غياب الشارع المضاد. اليوم، لم نعد أمام شارع متحرك وآخر مستكين، بل إزاء شارعين متقابلين لكل منهما ديناميته الخاصة. لكن هذا، وإن كان يعني أن ختام الشهر الحالي، موعد التظاهرات المليونية ضد «الإخوان»، لن يشهد نهاية فصل الجماعة في السلطة، إلا أنه يمهد لأرجحية اصطدام، لا إمكانية لمعرفة حجمه ولا مداه أو مدته. والمؤسسة العسكرية المصرية، التي تنظر إلى الصراع من زاوية الحفاظ على الأمن القومي، حذرت من الأمر صراحة: إما التوافق أو خطر الفوضى.
منذ مدة ومؤسسة الرئاسة المصرية تكتفي بالدعوة إلى الحوار من دون الإقدام على طرح مبادرة جدية، وتستخدم شبكات الإعلام الرسمي لتنفيس التعبئة المضادة. غير أن محاولات الاحتواء تلك لم تتجاوز المبادرات الكلامية حتى الآن. ولا يظهر أن هناك رغبة حقيقية في إعادة النظر بكيفية إدارة العملية السياسية الراهنة. فالرئيس يدير الدفة، كما لو كانت البلاد تسير على نهج تبادلي للسلطة منذ عقود، لا كمن يشرف على تأسيس الجمهورية الثانية. ومن دون تقدير دقيق لحساسية المرحلة، يتابع سيره على صفيح سياسي ساخن في ما يعزل المشاكل الاقتصادية عن جذورها. ويبالغ فريقه بإبراز الجهد الهادف إلى كسب ثقة صندوق النقد الدولي حتى يفوز بقرض موعود، فيُلاك كلام كثير عن أربعة مليارات وثمانمئة مليون دولار ما زالت معلقة، على شرط خفض دعم الدولة لسلع حيوية، اعتاد المصريون على نيلها بحد أدنى من التكلفة.
وفي ظل فشل سياسة الاحتواء، قررت السلطة الاندفاع في مبادرات «هجومية»، فردت جماعة «الإخوان» في الداخل على الداعين إلى تعجيل الانتخابات (أو إسقاط الرئيس المنتخب) بتظاهرة استباقية، وضعتها تحت لافتة «لا للعنف». وفي مفارقة لافتة، أشركت معها القوى التي احتكرت ممارسة العنف على مدى العقود الماضية. مناورة الرئيس بدت مكشوفة. أراد وجماعة «الإخوان» التعويض عن خسارة حزب «النور» السلفي كحليف موضوعي في المعركة ضد التيارات المدنية فاتجه صوب الجماعات التي تعبر عن إرث السلفية الجهادية. وارتجل تعييناً لأحد قادة «الجماعة الإسلامية» محافظاً للأقصر، التي شهدت مجزرة السياح على يد الجماعة نفسها قبل عقد ونصف العقد، قبل أن يعود الأخير ويقدم استقالته تحت ضغط السياسة والإعلام، في الداخل والخارج. فالخطوة تلك كانت، كما قالت صحيفة (وول ستريت جورنال)، «مروعة في رمزيتها». وما وصفته (الإيكونوميست) بعيد هذا التعيين بتحويل مصر إلى «مرسي ستان»، عبّر تماماً عن تحول نظرة الغرب حيال القيادة المصرية الجديدة وبداية تشكيكه بـ«حكمتها».
غير أن الرئاسة أصرت على استثمار الخارج لتعويض الخسائر في رصيدها الداخلي. وفي هذا السياق جاء قطع العلاقات مع دمشق. وقد بدا الرئيس المصري هنا كمن اتخذ قراراً يؤدي التراجع عنه إلى خسارة معنوية، ويثبت المضي فيه خسارة جيوسياسية نتيجتها كما قال محمد حسنين هيكل انسحاب مصر التام من المشرق العربي. وإذ شكلت الخطوة تناقضاً صارخاً مع إعلان الرئيس من الكرملين عن تطابق رؤيته مع نظيره الروسي حيال الأزمة السورية قبل أسابيع، لم يكن الحال أفضل على جبهة الخليج. وآخر الجراح سببه الكلام الحاد للقيادي في الجماعة عصام العريان تجاه دولة الإمارات على خلفية محاكمتها عناصر إخوانية، ورفعه سقف الكلام إلى حد القول إن الجماعة قادرة على حماية الخليج من مستقبل يصبح أهله فيه «عبيداً للفرس». وفي حين استدرج الكلام التصعيدي ردوداً داخلية قاسية، بينها ما ورد على لسان الناطق باسم «حزب النور» الذي حذر فيه من اضطرار «الشعب المصري بأسره ولعدة أجيال قادمة (…) لتحمل تكلفة معارك جماعة «الإخوان المسلمين» التي لا تنتهي داخلياً وخارجياً»، برز كلام البرادعي (في حواره مع «الحياة») حول توجس دول الخليج من «الإخوان» ومن احتمالات «تصدير الثورة». وظهر كدليل إضافي على تداخل المحلي بالإقليمي وغياب رؤية الرئيس و«الإخوان» حيال الأمرين معاً.
لقد برزت قبل أشهر في مؤتمر نظمه مركز «بروكينغز» للدراسات وجهة نظر أثناء النقاش حول مستقبل مصر، مفادها أن فهم الديموقراطية لدى السلطات المصرية لا يتجاوز اعتبارها تعبيراً عن حكم الأغلبية. ولا يبدو تقييم كهذا مجرد ترف نخبوي تعبر عنه منظمات بحثية فقط، بل ثمة سلوكيات ومواقف للسلطة عززته طوال العام السابق. منها، اختصار لجنة صياغة الدستور بمن حاز الأكثرية داخل البرلمان، وخرق مبدأ فصل السلطات في نزاع الرئاسة مع السلطة القضائية حول شرعية لجنة الدستور نفسها. الإشكالية هنا تكمن في العجز عن الفصل بين حقبتين مختلفتين، واحدة ثورية والثانية تأسيسية. إذ في تهمة الالتحاق بالنظام السابق تمديد لصلاحية خطاب الثورة وهروب من موجبات ما بعدها. كما أنها تأتي توازياً مع استسهال الجماعة الاتصال بوجوه المعارضة التي لم تتحدَّ نظام مبارك، في الوقت الذي تستبعد نهائياً تلك التي خاصمته (اجتماع خيرت الشاطر مع عمرو موسى واختياره من دون حمدين صباحي ومحمد البرادعي من قادة «جبهة الإنقاذ» مثال على ذلك).
ويبدو أن في تعاطي الرئيس مرسي مع الأزمات المتراكمة أكثر من هروب إلى الأمام. فالرئيس مرسي يتابع عبوره مساراً يفتقد إلى الحد الأدنى من الوضوح، اللهم عدا ما تمليه أدبيات «الإخوان المسلمين» من مراحل، وهم المتهمون من جانب الخصوم بالعمل على «تثبيت السلطة» أو «الأخونة» أو ما تسميه أدبياتهم بـ«التمكين». وأهداف الرئيس تتبخر بالضبط لأنه أحرق، وما زال يحرق، مراحل ضرورية بسرعة مذهلة. ولأنه بإصرار متهافت يضع قمة نصب عينيه قبل أن يتجاوز ما قبلها. وهو إذ يحاول عبر نبرة خطابية إكساب سياسته هيبة مفقودة، يجهد عبر الحشد الارتجالي لجمهور الجماعة وغلاة السلفيين إلى تجسير الهوة بين المكابرة الدعائية والواقعية السياسية.
عنوان الأزمة في مصر بعد عام على الرئاسة وعامين ونيف على الثورة واضح. والمناورة، مهما كانت مُحكمة، لا تفيد في طمسه. مصر تعيش مرحلة انتقالية منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وثمة حاجة ماسة لإدارة المرحلة عن طريق تأمين نصاب عريض من التوافق، بدلاً من الاعتماد على تكتيكات ركيكة تستهدف قنص الخصوم واقتناص الفرص. أما خلاف ذلك، فنتيجته نزاع سياسي واهتراء أمني متنامٍ. وقبل هذا وذاك، مزيد من قدرة الخارج على «مد الصوابع» إلى الداخل (كما يحلو للرئيس أن يقول) وغموض أكبر في تحديد النظرة حيال هذا الخارج وتحدياته.
صحيفة السفير اللبنانية