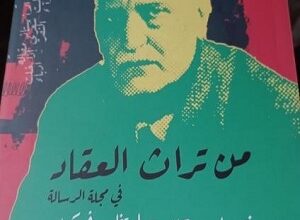من سالونيك إلى إسطنبول فالشام… كيف تقول وداعًا؟

التوق إلى الماضي يضفي قيمًا فكرية واجتماعية تدفع المرء إلى أن يمدّ طرفه ويستقي منه حكمًا وعِبَراً، كحال محاسن مطر شبارو التي تنقّلت، في روايتها «كيف تقول وداعًا» (الدار العربية للعلوم ناشرون)، برشاقة من حقبة إلى أخرى ومن بقعة من بقاع الأرض إلى سواها. فمن سالونيك اليونانية إلى إسطنبول التركية، ومن بلاد الشام إلى مكة والحجاز اصطحبتنا الكاتبة معها في رحلة تنشّقنا فيها عبق التاريخ وعصوراً غبرت كانت خلالها الجغرافيا تتبدّل والأنظمة تتوالى من احتلال إلى آخر ومن ظلم إلى آخر.
جاءت البداية من سالونيك، على رغم أن شبارو تحصر أحداث روايتها جغرافيًا بين إسطنبول ودمشق مرورًا بالحجاز وبيروت. إلا أنّها أبت سوى أن تبدأها من اليونان، من حيث جاءت نعيمة، ملقية الضوء على الظلم الذي ألحقه الصرب بسكان سالونيك من المسلمين، إذ أمهلوهم ثلاثة أيام للرحيل وإلا لكان مصيرهم الموت. وفي تركيا، أسكنت شبارو العائلة عامًا كاملًا في قونية حيث لم يوفق الأب بعمل، فانتقلت إلى مدينة (أسكي شهر) ومنها إلى إسطنبول.
وهنا نجحت شابرو في تسليط الضوء على آفة إنسانية تتكرر في أكثر من مكان وزمان، إنّها الطائفية في سالونيك والعنصرية التركية في الشام، بحيث علّق جمال باشا، الذي لُقِّب بالسفّاح، المشانق في بيروت ودمشق غير آبهٍ بالتدخلات التي سعت إلى الحؤول دون تلك الإعدامات مما آل إلى انتقام مضرّج بالدماء لاحقًا في الشام.
ولم تنسَ شبارو المجاعة التي عاشها سكان بلاد الشام، خلال الحرب العالمية الأولى، بسبب ظلم جمال باشا السفّاح لهم حيث قالت على لسان أحد الرجال: «كثير منهم يحملون معهم علبة (توتن) تبغ معدنية صغيرة فارغة، يبولون فيها ويخبئونها معهم ويشربونها عند اشتداد عطشهم لكيلا يموتوا عطشًا» (ص251).
وفي تفاصيل الحكاية أنّه وبعد أن مات أبوا نعيمة، عاشت مع أختها وراحتا تشتغلان بحياكة الصوف لتعيشا، إلى أن ابتسم لهما الحظ ووجدتا جرّة مليئة بالليرات الذهبية وبالغوازي أرباع الليرات الذهبية مخبّأة في حديقة المنزل. تزوّجت نعيمة من حقي أفندي الذي يعمل في مكتب البريد ورزقت منه بابنة اسمتها حكمت. ويظهر جليًّا ولع شبارو بالمدن المشرقية، بحيث أسكنت حكمت وأبويها في مكة شتاءً وفي الطائف صيفًا، إذ رفعت حقي أفندي في وظيفته إلى ناظر على الحجاج في مكّة. ثم عادت بنعيمة وحكمت إلى إسطنبول على أن يلحقهما حقي أفندي بعد حين، إلا أن حقي مات بداء الكوليرا على متن السفينة المسافرة إلى إسطنبول.
ألقت شبارو الضوء على عادات وتقاليد المجتمعات المختلفة التي تتحدّث عنها روايتها، بحيث أعجِب ابن جميل بك – عم حكمت – بها لكن جميل بك رفض زواجهما قائلًا: «ماذا! الأتراك لا يتزوجون من أبناء عمومتهم. أنا لا أوافق على هذا الزواج» (ص 19). كما أوردت الكثير من التفاصيل عن يوميات الحياة في الشام وما يعتريها من ظلم للنساء واقتناص لحقوقهن: «النساء هنا لا تكتب ولا تقرأ ولا تدرس، والمرأة محكومة ومقيّدة من قبل الرجل»، تقول حكمت (ص 118). إلا أنّ شبارو لم تغفل الحديث بإسهاب عن العادات والتقاليد الشامية الجميلة، وعن غنى هذه الأرض المقدسة وعراقة تاريخها، بحيث تتنشّق الأصالة في عبق نباتات الشام وخيرات أرضها.
وكانت حكمت قد وصلت إلى الشام بعد زواجها من اليوزباشي حسين حسني، الذي أرغمها عمها جميل بك على القبول به، ففي عام 1910، استدعي حسين حسني يوزباشي إلى حرب اليمن. فأوصل حكمت وابنتهما قدرية إلى الشام بعد أن عرجوا على ابنة اخته في بيروت ومكثوا هناك بضعة أيام. في اليمن، مرض حسني وعاد إلى دمشق، حيث أرادت حكمت أن تسكن في حيّ ساروجة، الذي يعجّ بالأتراك، فيما لم يرغب حسني بترك منزله وحصل الطلاق. في إسطنبول، تبيّن أن حكمت التي حاولت الإجهاض في الشام، لم تفقد الجنين فأنجبت ابنتها الثانية وعادت إلى التدريس.
ومع اندلاع شرارة الحرب العالمية الأولى حلّ الهلع في كل مكان من إسطنبول إلى الشام: «في إسطنبول بدأ شبح الحرب العالمية الأولى يتحول إلى خوفٍ ورعبٍ وقتل، ثم بدأ يتحول إلى جوع، فاختفت كل المأكولات الكمالية، وبدأ النقص يصيب المأكولات الضرورية. بدأ يصيب الرغيف… رغيف الخبز» (ص 214). «أما في الشام فصدى أخبار الحرب كانت قد وصلت أيضًا. ولأن الخريف كان قد دخل بيوت الناس وجعلها باردة، فقد هجر أهل الشام أرض الديار ودخلوا الغرف العليا والمربعات» (ص 212).
ويظهر جليًّا حرص شبارو على إظهار آثار هذه الحرب في كل مكان. فلما توفي حسني عادت بحكمت وابنتيها وأمها إلى الشام، كي تلقي الضوء على واقع الحال هناك من خلال يوميات حكمت في الشام. هذا وتزوجت هذه الأخيرة ثانية من ابن أخت حسني، خليل، فأنجبت منه ومكثت في الشام، وفي عام 1916، راح انتشار الجوع والفقر يزداد وتوقفت الأمطار عن الهطول وانتشر الجفاف وأجدبت الأرض، ونكّل جمال باشا السفّاح بسكان الشام، فعمّت الاعتقالات في دمشق وبيروت، وسادت الإعدامات شنقًا كما أسلفنا. «لم تنسَ قدرية طوال حياتها هؤلاء الرجال المعلقين، الذين عرفت في ما بعد أنهم كانوا أبطال سورية» (ص 246).
غادرت حكمت إلى إسطنبول نزولًا عند رغبة والدتها ورغمًا عن خليل مصطحبة أولادها. فلحق بهم خليل. ولكن حريقًا كبيرًا شبّ هناك، وكانت الخسائر كبيرة واعتبِر هذا الحريق من أكبر الكوارث التي حلّت بالمدنية. وبحلول عام 1919، انتشرت المجاعة وأجبر خليل، على أثرها، زوجته حكمت على القبول بالعودة إلى الشام. وفي هذه الأثناء كانت قد هبّت رياح التغيير في دمشق، فتغيّر مظهر النساء ولم يعد الحجاب إلزاميًا وبدا المجتمع أكثر تحرّرًا تيمّنًا بما كان يحدث في مصر.
أما حكمت فقضت نحبها بعد أن أصيبت بفالج. ولعلّ ضيق الحال والفوضى السائدة في ذلك الوقت والوحشية هي العوامل التي أرادت شبارو إلقاء الضوء عليها من خلال حادثة سرقة قبر حكمت: «تابع الشيخ كلامه: «لقد سرقه حارس المقبرة، إنه يعرف ساكني هذه القبور، يعرفهم واحدًا واحدًا، وإذا لاحظ أن قبرًا قد أطال مكوثه من دون أن يرى عليه عِرقَ آسٍ أو أي عرقٍ أخضر، يأتي ويضربُ شاهِدَةَ هذا القبر برِجلِهِ، فتقعُ (…). فإذا مضت سنة ولم يمدّ أحدٌ يده ليساعدَها على النهوض من مكانها، حملها ورمى بها بعيدًا، وهدمَ القبر وسوّى أرضه ليبيعَه لِغريب»» (ص 420).
نجحت الكاتبة في إلقاء الضوء على تفاصيل مرحلة تاريخية بأكملها مؤرّخة حيثياتها، جاعلةً من هذه الرواية مرجعًا في بعض الأحيان، بخاصة إنّها عملت على إحياء التراث المحكي للشعوب موضوع روايتها، وهذا يُحسَب لها.
صحيفة الحياة