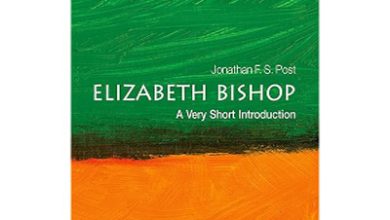مَنْ يقع في شرك الفتنة الصعيدية… لا ينجُ (عمار علي حسن)
عمار علي حسن
منذ أن أبدع أناتول فرانس روايته الذائعة الصــــيت «تاييس» عن حكاية غانية الإسكندرية القديمة التـــي أفسدت شبابها فسعى القديس بافنوس لهدايتــــها حتـــى لا تفسد عليه عمله، وكثير من الأدبـــاء يحلو لهم أن يهــــتكوا أسرار العالم البتولي المغلق للرهبان والكهــــنة، محاولين الإجابة عن أسئلة تشتعل دوماً فــــي أذهــــان الكثيرين عن حال هذا العالم ومآله، لا سيما ما يتعلق بالصراع النفسي والقيمي بين «الهدايـــة» و «الغواية» أو بين «العفة» و «الشهوة»، والذي طالما فتح نوافذ عريضة لإبداع أعمال فنية جذابة.
على هذا المنوال نسج روبير الفارس روايته الجديدة «جومر»، التي لا تسلم نفسها لقارئها بسهولة، إذ إن ما فيها من اقتباس واقتطاف من مختلف النصوص المسيحية والموروث الشعبي المصري، وما بها من صور جمالية مكثفة ولغة شاعرية مقتصدة وغموض ملغز وتركيب وبناء متماوج، يتطلب ممن يطالعها أن يكون في يقظة تامة طيلة الوقت، حتى يفك رموزها المتتابعة، ويفضح المسكوت عنه في ثنايا سطورها، وإلا فاته الكثير من الفهم والتذوق.
لا ينشغل الفارس بالتشويق قدر انشغاله بالتجريب، وبناء اللوحات الفنية المتلاحقة، التي تطول أحياناً وتقصر أحياناً، لكنها تتقدم نحو هدف يرومه كاتب ينتقل من خبرة القصة القصيرة، التي أتقنها وفق ما تبرهن عليه مجموعته القصصية «عيب إحنا في كنيسة»، إلى مجال الرواية، الأكثر رحابة واحتياجاً لجهد كبير على مستوى الشكل والمضمون، بذل منه على قدر استطاعته في روايته الأولى «البتول»، وهنا يكمله، في تقطع وعناء. وهو يكشفه في الكلمة التي قدم بها «جومر» ويقول في بعضها: «كنت أسرق الوقت لألتقي بأوراق متفرقة تصرخ من الإهمال الطويل… تركتها وحيدة مدسوسة في ظلام مكتبتي وكأنها خطيئة غير مكتملة، وشهوة مبتورة الذراع، ومن حين إلى آخر أحن إليها، وأبحث عن لحظة دفء في حضن جومر، أو يستوقفني تساؤل مطرود من ذلك العالم المأهول بأشباح التراث القبطي الثقيل، والذي يصارع واقعاً ساخناً بين تلك الصفحات التي اكتملت بعد عناء رهيب».
ولكن يبقى للكاتب أنه يقتحم بشجاعة موضوعاً شائكاً، ويطأ بثقة مناطق غير مأهولة ترتبط بالعالم الاجتماعي للأقباط من زاوية علاقتهم بالثقافة العامة السائدة، وبالمؤسسات الدينية بتراتبيتها الإدارية وتسلسلها الروحي. وهو هنا لا يصف ما يرى أو يعرض ما يعرف فحسب، أمام قارئ ليس لديه معرفة عميقة بأحوال هذا العالم وأسراره، لكنه ينتقد المتواجد، ويحرك الثابت والجامد، ويهز بعض اليقين مستخدماً ما أهدته إليه تجربته الذاتية، ويوظف شخصيات روايته في تحقيق هذا الهدف، على رغم اختلاف خلفياتهم الثقافية والطبقية.
وكما قال القديس بافنوس بعد أن وقع في غرام الغانية التي ذهب لهدايتها: «أيها الأحمق الباحث عن السعادة الخالدة في غير شفاه تاييس»، يبدأ روبير الفارس بمفتتح مشابه ينسبه إلى من وصفه بأنه أحد الرهبان القدامي، حيث يقول: «ليست أحلامي بعيدة عني، ولست أبحث عنها تحت هذه الشمس بعينين لحميتين. الذين يزعمون أن باستطاعتهم أن يجدوا غبطتهم خارجاً عنهم، يسيرون نحو الفناء، ويضيعون في المرئيات والزمنيات التي لا تلمس أفكارهم المتضورة جوعاً إلى الصور».
هنا تظهر «جومر»، وهي فتاة يصف الكاتب جمالها بأنه «لا يطاق… ملمسها من جلد القمر المسلوخ وسر عينيها أقوى من سر أثناسيوس»، لتلعب الدور نفسه في زماننا، وهو ما تفضحه تساؤلات خطيبها جرجس: «كيف أسير معها في الشارع وسوف أكون كاهناً وقوراً أرتدي حلة خشنة سوداء ولحية برية، كما أنها لا تفقه في أمور الدين شيئاً، وتحفظ أغاني العالم، وتعشق السينما. هل أتزوجها وأقهرها؟ أم تراني أرتاد هذه الأماكن معها». ويدخل جرجس في صراع نفسي شديد بين رغبته في أن يقتدي بالراهب المناضل «مار جرجس» وبين عشق جومر التي يقول عنها: «سخونة عينيها لم يحتملها جوفي».
ولأن الرواية كُتبت متقطعة في السنوات التي انشغلت فيها مصر بتمرد بعض زوجات الكهنة على أزواجهن وإسلام بعضهن، فقد تأثر الكاتب بهذا السياق، الذي لا ينكر هو تفاعله معه ويصفه بأنه «واقع ساخن»، ولهذا سارت جومر في الطريق ذاته فأسلمت وسميت زينب عبد الكريم، لتتخلص من قهر جرجس، ثم عادت إلى المسيحية مرة أخرى، لكنهم وجدوها مقتولة في الدير، وثبت أن قاتلها هو القديس «ابن مارينا».
وليست جومر فقط التي تعزف على وتر غواية الجميلات للرهبان في هذه الرواية، بل يفاجئنا الكاتب بالعودة إلى عصر الرومان ليروي حكاية شبيهة عن «مينا» الذي رغب في الذهاب إلى فاتنة الصعيد «باتريشيا» ليعظها بالتوبة، لكن «مارينا» حذرته قائلة: «لن تعود ثانية. كل من ذهب إليها لا يعود» ثم تحكي له لتعظه: «كانت لي بنت عم تدعى أودسا تفوقني كثيراً في الجمال والدلال والأنوثة. وعلى رغم أن كثيرين من الرجال كانوا يتوقون لرؤية وجهها إلا أن زوجها أصيب بسهم باتريشيا، وكاد أن يجن بسبب ما سمع عنها. وذهب إليه البطريرك الجالس على عرش مار مرقس وأخذ يعظه ويعده بالملكوت حيث ما لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، إلا أنه قال إن باتريشيا هي الملكوت، وبالفعل شد الرحال إليها، ووضع كل كنوزه تحت قدميها ثم عاش عبداً يسقى البهائم في حظيرتها».
ويعود الكاتب أبعد من هذا إلى عهد الفراعنة ليروي لنا حكاية غواية أخرى بطلتها «نفرت» مع كهنة آمون، ثم يقفل راجعاً إلى زماننا ليروي حكاية مضادة تماماً عن شاب يعمل رساماً اسمه «نادر» تغويه شابة زوجة ناطور عجوز فيقع معها في الخطيئة، لكنه يلوم نفسه ويسترجع دوماً الترانيم التي حفظها في مدارس الأحد ليتطهر بها: «ربي أنت تعلم أن شهوات العالم تخدعني. طهر قلبي، طهر فكري. اسمع صراخي وارحمني». وينجح في النهاية في الانتصار على شهوته، محتمياً بحبه العفيف لمريم، وهنا يقول: «اقتربت منها وكان جسدها ما زال ساخناً، رددت كلمات من الترنيمة القديمة وأخذتني كلمة حبي إلى مريم ولا أدري لماذا اشتهيت أن أرسم الآن أيقونة قديس، أي قديس، ولكني تراجعت، فنجاستي تحول دون ذلك».
إنها المفارقة التي أراد الكاتب أن يضعها أمام أعيننا عن الواعظين الساعين إلى الغواية، واللاهين العائدين إلى الهداية، فالتقط حكايات من أزمنة متباعدة ليمزجها في هذا النص السردي العذب المختلف.