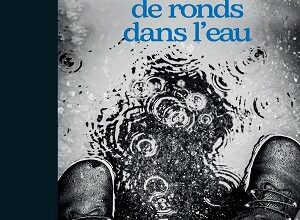هواء في الهواء

الحاجبان اللذان كانا يقفان خلف كرسي السلطان في العصور القديمة، ويهويّان عليه بمروحتين طويلتين من الريش، كانا من واجبهما الوظيفي آنذاك، أن لا يشعرا بالتعب أو الضيق أو الحر. وكان عليهما أن لا يتوقفا عن فعل التهوية إلا بمشيئة السلطان وأمر منه بل كان لزوما عليهما أن يحافظا على وجهين محايدين في المجلس فلا يضحكان لنكتة عابرة مثلا، أو يطربان لأغنية تُنشد له وحده في حضرته.
ذاك الحاجبان ” الكومبارس” كثيرا ما كنت أشفق عليهما في المسلسلات التاريخية فهما يشبهان المروحة الكهربائية التي أشفق عليها الآن بدوري بعد أن كانت في ثمانينات القرن الماضي، سيدة الصيف، وجوهرة التاج في قاموس الرفاهية، وقد صارت اليوم من “سقط المتاع”، ولا يلوذ إليها إلا الفقير المدقع أو المضطر من العمال في المساحات التي لا تتوفر فيها أجهزة التكييف.
كان لهذه الآلة اللطيفة بمختلف أشكالها وأحجامها عز لا يوصف، فهي التي كانت تتصدر البيوت، ولا يجلس إلى جانبها إلا الضيف المبجّل في صالون المنزل أو المعلم صاحب المتجر أو المدير في الدوائر الحكومية، بينما يسترق الآخرون بضع النسمات منها عن بعيد.
اجتاحتنا المكيفات اليوم لتبريد الهواء الذي كانت المروحة تكتفي بتحريكه، وتساوى في ” التكييف” الأغنياء والفقراء على حد سواء، وذلك بفعل الاحتباس الحراري الذي لم يعد يفرّق بين السلطان وحاجبه بل أن الأخير قد أصبح يقف خلف مليكه ويستفيد من نفس الهواء المبرّد دون حاجة إلى مروحة طويلة بين يديه.
كانت المروحة من أنفس المقتنيات التي يعود بها العمال التونسيون من ليبيا، والمصريون من العراق ودول الخليج، لكني لم ألحظ في طفولتي مثلا، أن العمال التونسيين في فرنسا كانوا يعودون لعائلاتهم ومعهم المراوح.. كانوا يعودون محملين بالأثواب والأحذية الشتوية، وكذلك السخانات، وحتى المشروبات الكحولية المقاومة للبرد.
الآن فهمت، وبعد موجات الحر التي تجتاح أوروبا كل عام وعلى نحو مفاجئ، “الخطأ الجسيم” الذي ارتكبته هذه المجتمعات في كونها لم تول المروحة و” مشتقاتها التبريدية” حق قدرها، واحتاطت من الشتاء أكثر من الصيف على مدى عقود طويلة ثم فاجأهم الحر دون أن يعدوا له شيئا في منازلهم المصممة لمقاومة برد الشتاء وحده.
أما المراوح اليدوية فباتت مجرد اكسسوارات في مستودعات المسارح، تحاكي مرحلة ماري أنطوانيت ، أو حتى داي الجزائر حين لطم بها قنصل فرنسا بدايات القرن 19.. وكان دخول الاستعمار.