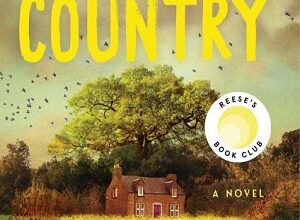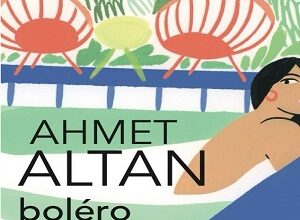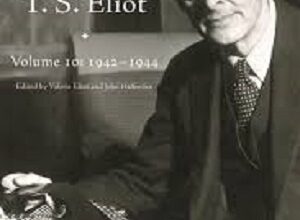يقول الشاعر جلال الدين الرومي: «أتعرف أين تلك المفاتيح التي تفتح كل الأبواب؟ إنها معلقة على صدر العشق»، هكذا يمثل له الحلّ كمتصوّف لكل ما يغلق أبواب الروح والحياة.
يقول الشاعر جلال الدين الرومي: «أتعرف أين تلك المفاتيح التي تفتح كل الأبواب؟ إنها معلقة على صدر العشق»، هكذا يمثل له الحلّ كمتصوّف لكل ما يغلق أبواب الروح والحياة. وفي ديوانه «عظمة أخرى لكلب القبيلة»، يقول الشاعر العراقي سركون بولص: «يمكنك أن ترمي مفتاحك في البحر، طالما القفل ليس في الباب، ولا الباب في البيت ولا البيت هناك».
في رواية «وارثة المفاتيح» (منشورات الربيع)، لا يبدو المفتاح مجرد أداة عبور أو حلٍّ جاهزٍ لبوابة مغلقة، بل يتحوّل إلى استعارة مركزية لعالمٍ داخلي متشظٍ، تتعدد أبوابه ولا تقود بالضرورة إلى وطنٍ واحد. منذ الصفحات الأولى، توحي الرواية بأن فكرة الحلّ نفسها قد تكون وهماً، وأن العوالم التي نظنها قابلة للالتقاء داخل مفهوم الوطن، قد تكون في حقيقتها عوالم متنافرة، متجاورة فقط، لا يجمعها سوى الإحساس العميق بالفقد.
بين الذاتي والجماعي
تطرح سوسن جميل حسن سرداً يغامر في المسافة الرمادية بين الذاتي والجماعي، بين الخاص والعام. لا تأتي الحرب بوصفها حدثاً طارئاً أو انفجاراً مفاجئاً، بل بوصفها خلاصة لمسار طويل من الصراعات الداخلية، ومعركة لم تُحسم مع التشظي. كأن الحرب، بهذا المعنى، ليست سوى الامتداد العنيف لفشل سابق في الانتصار على تصدّع الأرواح، وعلى انقسام البيوت من الداخل، قبل أن تنقسم الجغرافيا.
تذهب الرواية إلى حكاية عائلة سورية، لكنها لا تقدّمها بوصفها نموذجاً تمثيلياً مباشراً، بل كعالم مصغّر يعكس بنية عالم أكبر وأكثر رعباً. الراوية، بصوت الراوي العليم، تعلي من شأن التفاصيل اليومية والهامشية، لا لأنها صغيرة، بل لأنها المكان الحقيقي الذي تتكوّن فيه المآسي الكبرى.
في هذا العالم، تمرّ «القضية الكبرى » – السياسة، الحرب، القمع – وكأنها مرادف غير معلن لمعاني الالتزام والأخلاق، وتنعكس في الخيارات الفردية وفي المواقف الشخصية، لا في الشعارات والخطب. شخصية «فرضية » تقف في قلب هذا التوتر.
امرأة تحلم بالثراء، بعالم المال والجسد والرجل، في بيئة يحكمها منطق الأمن والشرطة. حلمها ليس شاذاً بحد ذاته، لكنه يتحول إلى مأزق أخلاقي وإنساني حين يصبح المال غاية تبرّر أي وسيلة، ولو كان الثمن الجسد ذاته. تدفع فرضية ثمن هذا الخيار لاحقاً، لا فقط على المستوى الشخصي، بل في علاقتها بحفيدها الذي يُقبض عليه، كأن الرواية تقول إن الأسئلة التي لم تُجب عنها الحياة، تعود لاحقاً في صورة عقاب قاسٍ أو مواجهة مؤجلة. لا أحد في هذه العائلة يخرج من السرد دون أن يعثر – أو يفشل في العثور – على «مفتاح » قدره الخاص.
غيداء، التي تقطع مع الماضي بشكل نهائي وترفض التواصل مع أختها، تمثل خيار القطيعة الجذرية. مرضها في بلدها ليس مجرد حالة جسدية، بل تعبير عن صدمة أخلاقية عميقة، بعد اكتشافها علاقة أمها برجل آخر، وكأن الجسد هنا أيضاً يتحول إلى ساحة صراع للمعنى والخيانة والفقد. في المقابل، تأتي سمرا بوصفها النقيض: الشخصية التي تحافظ على خيوط التواصل مع الجميع، والتي ستغدو لاحقاً «وارثة المفاتيح» ليس لأنها تملك الحل، بل لأنها الوحيدة التي لم تكسر الجسور بالكامل.
أما بقية أفراد العائلة، فتتوزع مصائرهم بين الانتحار، والخطف، والجنون. رضية، التي ينتهي بها المطاف إلى الجنون، تبدو كأنها التجسيد الأكثر مأساوية لعجز الفرد عن مقاومة الوحوش المتعددة: وحش السلطة المتمثل بـ «الباشا»، ووحش الحرب الذي يأتي لاحقاً ليكمل ما بدأه الأول. رضية خُدعت، كما خُدع كثيرون من سكان البلاد المهمشة والمهملة، في عالمٍ يبيع كل شيء، من الأحلام إلى الأجساد.
في عالم سوسن جميل حسن الفني، لا تُمحى السياسة، لكنها لا تُقدَّم أيضاً في صورتها الخطابية المباشرة. الحرب السورية لا تُشرح، ولا تُفصَّل، بل تُستكشف جذورها الخفية: سياسة البيت، العلاقات المشروخة، التربية القائمة على القمع أو الصمت، والعجز عن خلق تناغم داخلي.
كأن الرواية تقول إن السياسة التي تقود إلى العتمة الكبرى، تبدأ من الداخل، من بيوت لم تُدر بعدالة، ومن ذوات لم تُصالح نفسها.
يحضر الفن في الرواية حضوراً لافتاً: أسماء الفنانين، الموديلات التي يُرسم بها الجسد، والماركات العالمية مثل «كوكو شانيل» و«كريستيان ديور ». هذا الحضور ليس ترفاً جمالياً، بل إشارة نقدية إلى عالم حديث صُمّم ليُباع، حيث تتحول الجماليات نفسها إلى سلعة، ويغدو الجسد جزءاً من اقتصاد عالمي لا يعترف إلا بالقيمة السوقية. هنا، يتقاطع عالم الفن مع عالم التجارة، ومع منطق الاستهلاك الذي يطال البشر قبل الأشياء.
بعيداً عن الوعظ
ومع ذلك، لا تسقط الرواية في فخ الإدانة المباشرة أو الوعظ. إنها تقترح، بهدوء مؤلم، العودة إلى العوالم الداخلية، إلى تفكيك مفاتيحها، لا لقطع الصلة معها، بل لفهمها. في الوقت نفسه، لا تتخلى عن القضية الجماعية، بل تعيد تعريفها: الفرد، في النهاية، ليس هامشاً في التاريخ، بل عازف أساسي في سمفونية الكون الكبرى.
ومن دون تناغم هذا العازف مع ذاته، ستظل الموسيقى مختلة، مهما عظمت الشعارات، ومهما كثرت المفاتيح. وهكذا تقدم الرواية نوعاً من الاقتراح، وهو الاستماع إلى السردية نفسها وهي تجري في مكان آخر، ولكنه مصغّر يحدث للجميع، وفي أي بيت حين تتدمر الجهود ويكبر ذلك الشرخ الذي كان صغيراً ليصبح بمثابة واد عميق بين الأجيال، وتحاول التوغل أكثر عبره لفهمه ومعرفة أسبابه.
صحيفة الأخبار اللبنانية