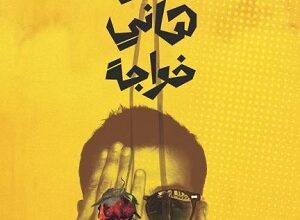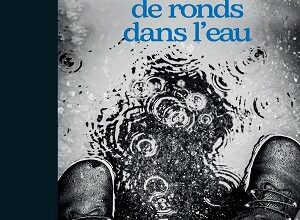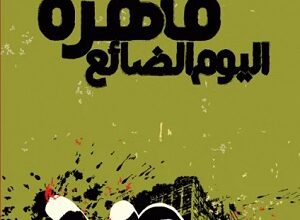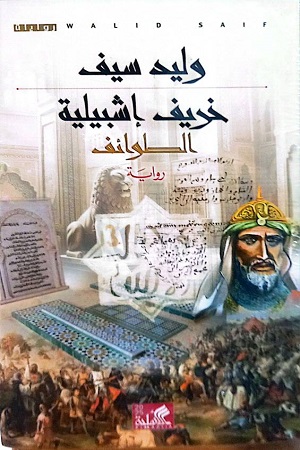
يسعى الكاتب الأردني وليد سيف في روايته الأخيرة “خريف إشبيلية: الطوائف” إلى صنع حبكة تملأ الفراغات، وتكسر جمود السردية التاريخية لواحدة من أكثر الحقب حساسية خلال الوجود الإسلامي في أوروبا، وهي ما عرف بعصر ملوك الطوائف، الذي بدأ عام 422هـ (1031 م)، عندما أعلن الوزير أبو الحزم بن جهور سقوط الدولة الأموية في الأندلس، مما دفع أمراء المسلمين في ظل هذا الفراغ السياسي إلى إنشاء دويلات منفصلة، وتأسيس أسر حاكمة كل في منطقته.
اصطناع خليفة مزور
تبدأ أحداث الرواية، الصادرة عن “الدار الأهلية” بعمان، بعام 427هـ (1036 م) بتقديم شخصية خلف الحصري، صانع الحصر الذي يعرفه كل سكان بلدة قلعة رباح، لما اشتهر به من تركيبته الغريبة التي تجمع بين سلاطة اللسان والفطنة مع مظهر خادع بالحماقة، وهو الذي لا يتورع عن الاستهزاء حتى بزبائنه غير عابئ بالعواقب.
تنتقل الرواية إلى مؤسس سلالة بني عباد في الأندلس، القاضي أبي القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد صاحب إشبيلية، بمشهد يجمعه مع حاكم إمارة قرمونة، الذي استنجد به بعد أن خلعه من عرشه، يحيى بن علي الحمودي، العدو المشترك لهما، وقد كان ابن عباد يخشى أن يمتد شره إلى عقر داره وقد ادعى لنفسه نسبا في آل البيت. وتتصاعد الأحداث عندما يبايع الحصري بالخلافة في الأندلس على أنه هشام بن الحكم (المؤيد بالله) الذي قتل عام 403هـ (1012م). إذ استغل القاضي ابن عباد شبه خلف الحصري بآخر خلفاء الأمويين في الأندلس وغموض غيبته، فأتى به إلى إشبيلية، واستعان ببعض عبيد المؤيد الذين شهدوا أنه هو، وألبسه كسوة الخلافة، وأمر مناديا أن يصيح: “يا أهل إشبيلية اشكروا الله على ما أنعم به عليكم. هذا مولاكم أمير المؤمنين هشام قد صرفه الله إليكم، ونقل الخلافة ببلدكم لمكانه فيكم، ونقلها من قرطبة إليكم، فاشكروا الله على ذلك”، فتسابق الناس لرؤية الخليفة، فجعل بينه وبينهم سترا، يكلمهم من ورائه، وقال إن الخليفة الغائب العائد ولاه حجابته، وأشهد عليه شهودا ومن أبى أن يشهد حل به البلاء. وأخرجه يوم جمعة، فخطب وصلى بالناس. وكتب ابن عباد إلى ملوك الأندلس يحضهم على طاعة هشام، وقاتل في سبيله، فدانت له المدن.
دامت هذه الحال أكثر من عشرين عاما، يخطب للخليفة المزور على المنابر ويدعى بأمير المؤمنين وحجابه من آل عباد يحكمون البلاد باسمه إلى أن توفي في أيام المعتضد، الذي أخفى موته إلى أن استتب له الأمر عام 451هـ (1059 م)، لكن اختار وليد سيف أن يجعل موت الحصري بالسم على يدي المعتضد بعد حوار متخيل يكاد يلامس الواقع.
“خريف اشبيلية“
عود إلى إلهامات التاريخ
ليست هذه المرة الأولى التي يطرق فيها وليد سيف أبواب التاريخ في الأندلس، لأنه كان يدرك أنها ستفتح له عن كنز من الأحداث التي برع في توظيفها بإسقاطات إبداعية على الحاضر لا تخفى. وبداية زيارته لشبه الجزيرة الإيبيرية كانت “درامية” مع “المعتمد بن عباد”، المسلسل الذي كتبه عام 1981، ثم مع شخصية الحاجب المنصور في مسلسل “الصعود إلى القمة” 1985، ثم ثلاثيته الشهيرة مع حاتم علي مخرجا: “صقر قريش” 2002، و”ربيع قرطبة” في العام التالي، وأخيرا “ملوك الطوائف” في 2005.
وهذه المرة السادسة التي يحول فيها سيف مسلسلا له، وهو هنا “ملوك الطوائف” إلى عمل روائي، فقبله صدرت رواية “الشاعر والملك” عام 2022 المبنية على مسلسل “طرفة بن العبد”، والتجربة الأولى في هذا السياق كانت مع “مواعيد قرطبة” 2021، النسخة الروائية لمسلسل “ربيع قرطبة”، ثم رواية “النار والعنقاء” في جزءين المبنية على مسلسل “صقر قريش”، وكان عمل على استكمال هذا المشروع مع مسلسل “التغريبة الفلسطينية” بروايتي “أيام البلاد” و”حكايا المخيم” عام 2022. وكما هو معروف فإن الرائج هو العكس، أي تحويل الأعمال الأدبية الناجحة إلى أعمال درامية، فيكون سيف بهذا من رواد هذا الاتجاه عربيا، لأنه يرى أن “الشكل الروائي يتيح، من خلال شروطه ومقتضياته، للكاتب والقارئ، من العناصر السردية والوصف الخارجي والداخلي والتأملات النفسية والفلسفية، ما تقيده محددات الصناعة السينمائية والتلفزيونية، وما يمتد على وسع خيال الكاتب”.
واقع أغرب من الخيال
قصة شخصية الحصري التي التقطها وليد سيف بذكاء من كتب التاريخ، تذكرنا بأجواء عصر الزيني بركات، محتسب القاهرة في أواخر عهد المماليك، التي أعاد الكاتب المصري جمال الغيطاني إحياءها في روايته التي نشرت عام 1974 بهذا الاسم، ثم حولت إلى مسلسل لاقى شهرة واسعة عام 1996.
ربما اعتقد كثر ممن تابعوا المسلسل أو قرأوا الرواية، أن الحصري شخصية من وحي خيال المؤلف لغرابتها، لكن الواقع أغرب من الخيال إذا علمنا أنه كان من ضمن أربعة معاصرين بويعوا للخلافة في حكايات عبثية مشابهة. فتحت عنوان “فضيحة لم يقع في العالم إلى يومنا مثلها”، كتب ابن حزم: “اجتمع عندنا بالأندلس في صقع واحد خلفاء أربعة، كل واحد منهم يخطب له بالخلافة بموضعه، وتلك فضيحة لم ير مثلها، أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام كلهم يتسمى بالخلافة، وإمارة المؤمنين، وهم: خلف الحصري بإشبيلية على أنه هشام، من بعد اثنتين وعشرين سنة من موت هشام، وشهد له خصيان ونسوان، فخطب له على منابر الأندلس، وسفكت الدماء من أجله، وحمد بن القاسم خليفة بالجزيرة، ومحمد بن إدريس خليفة بمالقة، وإدريس بن يحيى على بيشتر”.
يبرع وليد سيف على مدى 670 صفحة في إعادة تحريك عشرات الشخصيات “الواقعية” في الرواية وصراعاتها، متنقلا بها بحذر ضمن محددات الأحداث الكبرى التي أثبتتها كتب التاريخ، ومن أجمل ما أجراه على لسان الحصري مخاطبا حاشيته بعد أن أخبروه أنهم سيحكمون باسمه: “ما أشبه الليلة بالبارحة! قديما حجبني المنصور بن أبي عامر وحاز الحكم باسمي. والآن ها أنتم تفعلون الشيء نفسه بعد أن كبرت سني”. وهو ما أعاده على لسان القاضي ابن جهور صاحب قرطبة عندما وصله خبر هذا المدعي: “مسكين ذلك الخليفة المنكود… لم يكفه أن يحكم بعض الناس باسمه حيا، دون أن يكون له من الحكم نصيب، حتى يحكموا باسمه الآن ميتا. فهو الحاضر الغائب أبدا”.
يموت أبو القاسم بن عباد فتؤول شؤون الملك إلى ولده عباد الذي يلقب بالمعتضد، وأول ما بدأ به عهده، التخلص من الحصري وإقصاء رجال أبيه الذين عاهدوا معه أول أمره أن يكون الحكم شركة بين الجماعة، فعلم الناس أن هذا زمن قد انقضى، وأن أصل العادة قد عاد.. الاستبداد والطغيان.
تتحرك فصول الرواية، زمانيا ومكانيا، في ممالك الأندلس وصراعاتها وكواليسها. يقول المعتضد مخاطبا الشاعر ابن زيدون: “قد قلت حقا يا أبا الوليد… كذب ونفاق وارتزاق… وكلنا، نحن الملوك، نعلم ذلك، وكلنا مع ذلك نطلبه ونثيب عليه. حسبنا منه أنه يجعلنا محل الخوف والرجاء. وهل الملك إلا هذين”.
المعتمد… رعي الجمال ولا رعي الخنازير
يبدأ فصل جديد برحيل الطاغية المعتضد وصعود ابنه محمد المعتمد بن عباد، الذي تشكل حكايته أكثر من نصف الرواية. وسع ملكه فاستولى على بلنسية ومرسية وقرطبة، وأصبح من أقوى ملوك الطوائف، فأخذ الأمراء الآخرون يجلبون إليه الهدايا ويدفعون له الضرائب. في هذه المرحلة يفرد وليد سيف حيزا معتبرا لشخصيتي ابن زيدون وابن عمار الذي ساهم في توسيع ملك بني عباد سواء بالمشورة أو التنفيذ، لكن الميكافيلية غلبت عليه فلم يتورع عن سلوك أي طريق للوصول إلى أطماعه حتى استقل بحكم مرسية، فكانت نهايته رغم دهائه على يد المعتمد نفسه.
هؤلاء الذين كانوا بالأمس يواطئون المرابطين على ملكهم ويرجون بواره… تكتوي قلوبهم للمشهد الفاجع، كانوا يبغضونهم ويتهمونهم لما كانوا فيه من الترف والعز، والآن يبكونهم لزوال ذلك العز
تدور الأحداث، ويزداد خطر أذفونش (ألفونسو السادس) ملك قشتالة، الذي بعد توطيد ملكه أخذ يتجه بأنظاره نحو الممالك الإسلامية المجاورة طمعا بإسقاطها، فتحرك بقواته حتى تمكن من ضم طليطلة إلى مملكته عام 478هـ (1085 م). استشعر المعتمد هذا الخطر، فما كان منه إلا اللجوء مرغما إلى المرابطين وقائدهم ابن تاشفين في المغرب، وهو الذي كان يخشى أطماعهم في ملكه، حسم المعتمد أمره بعد أن أطلق مقولته الشهيرة: “رعي الجمال عند ابن تاشفين، ولا رعي الخنازير عند أذفونش”. عبر المرابطون البحر إلى الأندلس واشتبكوا مع قوات ألفونسو في معركة الزلاقة التي انتهت بنصر ساحق للمسلمين بعد أن ظنوا أنهم يشهدون آخر أيام الأندلس.
الخطيئة القاتلة
يرجع ابن تاشفين إلى معقله في المغرب، لكنه لا يلبث عام 483هـ (1090 م) أن يعود إلى الأندلس في سبيل ضمها تحت سلطانه، وكانت البداية باستيلائه على غرناطة. تحققت هواجس المعتمد فأمر بتحصين إشبيلية وأن يتأهب الجند لأي طارئ، ولكن الشيطان أطغاه في آخر الأمر وتغلب خوفه على ملكه على كل اعتبار آخر، فارتكب الوصمة التي سيلاحقه بها التاريخ، كتب إلى ألفونسو يستعينه إذا دعت الحاجة.
وقعت الرسالة في يد ابن تاشفين فكان المحتوم “منذ اليوم تبدأ ألوان الدنيا بالتغير إلى صفرة أوراق الخريف مقدمة لسقوطها! وذلك الحلم المخيف الذي رآه المعتضد في منامه في زمن بعيد، قد بدأ تأويله. والمعتمد يعرفه (…) كان ما يزال مستلقيا في ثيابه الخفيفة، حين طرق عليه ولده عبد الجبار الباب، واندفع إلى الداخل لاهثا يعلمه أن المرابطين تمكنوا أخيرا من اقتحام المدينة (…) كان يعلم أنه قد قضي الأمر، وما يلبث فوج آخر أعظم أن يصل القصر، فلا يجدي معه أن يلبس لهم عدة الحرب. وهو أخوف على زوجته وبناته من دهماء رعيته الذين لا بد أن يغتنموا الفرصة لمداهمة القصر ونهب ما فيه”.
أخذ الناس يرقبون مشهد ضياع ذلك الملك، يصورهم وليد سيف بمشاعر متناقضة: “هؤلاء الذين كانوا بالأمس يواطئون المرابطين على ملكهم ويرجون بواره… تكتوي قلوبهم للمشهد الفاجع… كانوا يبغضونهم ويتهمونهم لما كانوا فيه من الترف والعز، والآن يبكونهم لزوال ذلك العز”.
في واحد من أكثر المقاطع التي خطها وليد سيف إبداعا في الرواية، يأتي ما آلت إليه حال ابنة المعتمد بن عباد، بثينة، التي بيعت في سوق النخاسة ولكنها تزوجت من سيدها رحمة بعزيز قوم ذل، فكان حالها خيرا من زائدة زوجة ابنه المأمون، التي كتب عليها أن تلجأ إلى ألد أعداء المعتمد والد زوجها، “هي منذ اليوم عشيقته ومحظيته الأولى. وستلد له ولده الأمير سانشو، وسينعم عليها أفونسو بلقب الكونتيسة.. الكونتيسة ماريا”.
تسدل ستارة الرواية على المعتمد في منفاه مدينة أغمات في المغرب يجتر أحزانه ويطيل النظر إلى سلاسله التي لم تزل عنه إلا مرة واحدة حين سمح له بالخروج ليوسد زوجته أم الربيع التراب، تلك الحبيبة التي نشلها ذات عشق من الرق. ولم يمض وقت طويل حتى طاف صوت المنادي في الطرقات: يا أهل أغمات، صلاة الغريب في المسجد الجامع. ولكم من الله عظيم الأجر والثواب… صلاة الغريب على المعتمد بن عباد آجركم الله.
بين ذاكرة القلم والكاميرا
إن كان سيف صرح في سياق مشروعه بـ”قلمنة الدراما” أن القراءة توسع الآفاق أكثر من الكاميرا التي تحجر على خيال المتلقي بمحدداتها، فيبدو أنه يستبطن سببا آخر يتعلق بالذاكرة القصيرة للدراما وخاصة التلفزيونية، بعكس الرواية التي لا تسري عليها أحكام المزاج العام، فكم من عمل تلفزيوني ملأ الدنيا وشغل الناس في وقت عرضه إلا أنه ما لبث أن تسرب إليه النسيان وتحول إلى تاريخ على رفوف ذاكرة من تابعوه، وما كان له أن يحقق ذات النجاح الأول إذا كتب له أن يعاد عرضه إلا باستثناءات قليلة لا يقاس عليها.
والملاحظ أن مشروع وليد سيف بتحويل مسلسلاته إلى أعمال أدبية، يتم في زمن قياسي، وكان أشار في أحد لقاءاته إلى سهولة تحويل النص التلفزيوني إلى عمل أدبي روائي، كونه بالأصل يكتب المسلسلات بلغة روائية أدبية، قبل تحويلها إلى سيناريو وحوار. ولفت إلى أن بعض الأعمال التلفزيونية التي أسقطت أجزاء من القصص والحكايات لغايات درامية، سيجدها القارئ في الروايات، وهو ما يبدو واضحا في كثير من المواضع في رواية “خريف إشبيلية”، خاصة في حوارات الشخصيات. بل إن سيف لم يقاوم إغراء عرض حقائق التاريخ، فأضاف لاحقة في خاتمة الرواية تلخص ما جرى بعد وفاة المعتمد بتحول المرابطين من “منقذين” إلى “متغلبين” ككل من سبقوهم، مما دفع الناس للثورة عليهم وزوال دولتهم بصعود دولة الموحدين، وصولا في النهاية إلى انحصار دولة الإسلام في الأندلس جنوبا تحت حكم بني الأحمر في مملكة غرناطة الصغيرة.
وهذا يذكر بقيام مجموعة “إم بي سي” بإطلاق تطبيق عام 2012 في موازاة عرض مسلسل “عمر” الذي كتبه سيف، يتيح للراغبين المزيد من المعلومات والأحداث التي لم تطرق في العمل الدرامي، كتفاصيل حياة الخليفة الراشدي الثاني، والوقائع التاريخية التي مرت في عهده وخلال فترة خلافته.
مجلة المجلة اللندنية