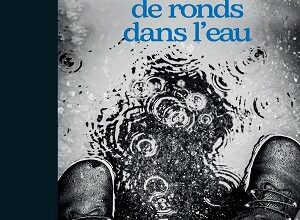“مفتون أنا بالكتب التي تنشر بعد الوفاة، إذ أصبحت رائجة في الفترة الأخيرة”، بهذه العبارة يفتتح الكاتب الإسباني إنريكه فيلا ماتاس روايته “ماك ونكسته” (ترجمة حسين نهابة، دار المدى)، والأمر لا يقف عند هذا الحد من الاهتمام بالكتب الصادرة بعد موت أصحابها من طرف الشخصية المحورية المدعو ماك، بل يبحث عن أحدها غير المكتمل كتابة، كي يقوم بتدويره، وتلفيقه، ونسبه إلى نفسه.
مع ذلك، يحسب لماك أنه يشرع في كتابة يومياته، بالتوازي مع قرصنته لرواية هي لجاره سانشيث، هذا الذي يقطن في المقابل معه في شقة كان يسكنها سابقا أشهر كتاب القصص القصيرة في أربعينات برشلونة المدعو خوسيه مايوركي، أما سانشيث فسمعه ماك ذات مرة وهو يحكي بعجرفة عن روايته “والتر ونكسته” المليئة بالترهات، بالتفاهات الصفيقة، بالتناقضات والاختلالات، عن سيرة محرك دمى، نسيها تماما لأنها من أرشيف حياته السوداوية حينما كان مدمنا، نسيها الى درجة أنه يعتقد بأنه آخر من كتبها.
استنادا إلى ذلك سيقرر ماك الجلوس في غرفته بحي كويوتي في برشلونة، منصتا الى الموسيقى، والصيف في أعز توقده كيما يبدأ الكتابة بجسارة، حتى أن اسمه ماك أُطلق عليه تيمنا بمشهد شهير من فيلم “عزيزتي كلمنتين” (1946)، لجون فورد.
ينتقل ماك من احتراف المشاريع العقارية إلى الإفلاس والبدء بالكتابة، فهو مهووس بقراءة القصص القصيرة، مقابل عدم ميله الى الرواية، والسبب أن هذه الأخيرة أحد أشكال الموت وفق رولان بارت، لأنها تحول الحياة إلى قدر، وإن قدر له وكتب رواية، فحتما سيروق له فقدانها مثلما يفقد تفاحة. لكن كيف يكون معنى الكتابة، هو الامتناع عن الكتابة نفسها؟ هذه المفارقة التي يرددها ماك، وهو ما يحاول تبريره، بأنه لو شرع في الكتابة منذ صغره لصار متعفنا بالموهبة الأدبية الآن، في حين يمنحه شعور المبتدئ المتعة وهي لحظته المثالية التي تبدأ عند الساعة الثانية عشرة من صباح 29 يونيو/ حزيران.
أمام شعوره الفادح بالخواء واللاجدوى والتفاهة، يحارب ماك الفراغ بكتابة يومياته، وبالتوازي يشرع في إعادة كتابة رواية قديمة لجاره، الكاتب سانشيث تحت عنوان “والتر ونكسته”، ضمن سيرة نصوص متشظية يحاول رتق ثقوبها بخيط يؤهلها لكي تنجو من تفككها، ويقود نثر ضياعها إلى نسق متماسك، فهو لا يصحح وينقح فحسب، بل يكتبها من جديد، وبذا يكون عمله محض مشروع مركب: كتابة اليوميات من جهة أولى، وتحرير وكتابة ثانية لرواية كاتب آخر، سابق، هو جاره سانشيث مع التأكيد اللاسع: الجيران هم الجحيم.
مع التقدم في تمارين الكتابة، تغدو الرواية مزدوجة، إذ هي محض رواية داخل رواية، وكتابة عن الكتابة، مع التركيز على خرائطية القراءة، كسفر ملحمي في النصوص العالمية، دون إغفال مسألة تمجيد التكرار: “التكرار هو قوتي يقول ماك”.
ويحتد السؤال: هل ما يكتبه ماك يعد ملكية خاصة به، أم هو محض تدوير؟ بصيغة أخرى أكثر لذوعية: هل ما يكتبه ماك محض سرقة مشينة، أم هو مجدد خلاق؟
تتحول الرواية المعادة كتابتها إلى أداة وجودية وجمالية للتفكير الجذري، للتفلسف، لاستغوار الذات، لاكتشاف الهوية، لتقييم الفن والكتابة ومعنى الخلق الأدبي والتخييل والواقع ونقيضه، وسرعان ما تتحول يوميات ماك نفسها إلى نص دامغ، تتشابك فيه ذاته ككاتب مبتدئ، مع حياته المنشطرة، مع وعيه الفني، ورؤاه وهواجسه الجمالية وحساسيته الفكرية وأفكاره الخاصة وقلقه الوجودي، كل هذا في مهب متلازمة الوجه والقناع، الوجه والمرآة، الكاتب وشبحه، وصولا إلى مسألة أكثر شمولية، هي قضية الفشل في الأدب، الفشل الذي قد يقودك أحيانا إلى أن تصير مبدعا بقدرة قادر، لذا فالعنوان الحقيقي للرواية يغدو “ماك وعكسه”، وليس ماك ونكسته، كما تفصح عن ذلك حفريات النص، وتأملاته الحارقة.
اليوميات في الرواية
يوميات تبدأ من برشلونة وتنتهي في عدن، مرورا بمراكش، تحديدا حكايات ساحة جامع الفنا، وجنوب تونس، تحديدا واحة الدوز. وتتماهى اليوميات مع رواية “ماك ونكسته”، إذ هي ليست مجرد أداة تحتويها الرواية لصالح روائيتها، بل تندمغ في تشكيل النص، حتى يصعب الفصل بينهما، أيهما اليوميات، وأيهما الرواية.
في مسعاه لمجابهة الفراغ المستفحل، بحثا عن معنى لذاته، سيشرع ماك في كتابة يومياته، كفعل وجودي يروم به استكشاف ذاته، في منحى آخر، هو التجاسر على الكتابة أخيرا، حلمه المؤجل منذ الطفولة، مع أن اليوميات المعلنة في البداية هي محض كتابة تؤرخ فيما تؤرخه، لملاحظات موازية عن إعادة كتاباته لرواية “والتر ونكسته”، لكنها لا تقف عند حد الملاحظات، بل تترف بحميم عيش ماك، بوقائع حياته المتعاقبة يوما عن يوم، وكذلك تتحول إلى مشغل نقدي، ومحترف تأملي، ومختبر جمالي، يخوض بحرية وشجاعة في معنى الكتابة وحدودها، وفي الابتكار والتقليد، والأصل السردي والزيف، والتجريب والسرقة، والكاتب الحقيقي وشبحه، والمتن البكر وحاشيته الملفقة.
ولا تتبع اليوميات ترتيبا زمنيا خطيا، تقليديا بالأحرى، بل تراهن على بنية سردية غير أفقية، من التكرار والتشظي، والتناغم والانقطاع في آن، ما يجعل الرواية أشبه بدوامة، محض اشتباكات تتقدم عبر التكرار الوظيفي، لكن مع تسارع حلزوني في إيقاعها.
لماذا الرهان على اليوميات؟
لأن استراتيجيا الرواية هي الكتابة من قعر الانتكاسة، الكتابة كمقاومة لفداحة الفراغ، أكثر التصاقا بانهيار الذات، كشهادة صادقة عن توتر وانشطار، بل عن سقوط مدو.
أسلوب اليوميات هنا، يتطابق مع الحالة المشوشة لماك، الذي يفجر قيعان دوامته بقدر هائل من الاعتراف اللامهادن، وباليوميات يحاول الدنو من معناه المفتقد، من ملامح هويته الملتبسة، استعادة من يكونه ككائن في مهب طقس أحواله السيء.
منطلق الرواية إذن، كان ما يستطيعه الفشل أمام المقدرة الابداعية، بصيغة أخرى الكتابة أو الجمال الذي ينجز من رمادية الفشل، من هاوية الهامش، من حضيض السقوط، ولا اعتباط أن تكون اليوميات الشكل الأصدق كأداة فنية لذلك.
هذا الصدق نسبي في كل الأحوال، لأن اليوميات تجنح في مداوراتها إلى نصوص ملتوية، أفعوانية، متقلبة، تستثمر ما أمكن استفحال العثرات إلى بلاغة جديدة، مؤسسة على واقعية مختلقة في ناحية دامغة من نواحيها المتعددة، المتشعبة.
باليوميات يتوسل ماك استجماع حطامه، والافصاح عن نفسه الممرغة في الهامش، في الظل، والسقوط، ليقدم وثيقة أمينة عن حقيقته المأسوية، ومن خلال خرائطها الحميمة، يعيد كتابة رواية ليست له، اعتقدها بداية أنها محض سرقة، لكن في النهاية، هي كتابة على كتابة، وهذا شكل من أشكال الكتابة أيضا، أكثر من ذلك تولد الرواية الجامعة، “ماك ونكسته”، في المجمل، ولولا اليوميات ما كانت للرواية ذاتها أن تقوم، إذ أن اليوميات هي ما يمنح الشكل المطابق فنيا، مجازيا، لحالة هامشيته، أو فراغه، هشاشته وسقوطه.
الكتابة من العدم
ما الذي يسبغ على الكتابة معناها، جذريتها، أحقيتها وجدواها، قيمتها السامقة، أن نكتب من عدم؟ أم أن نكتب وفق عملية التدوير، احتكاما إلى طروس سابقة، وما تعنيه الكتابة إن لم تكن قدرة هائلة على التحويل، بل تجاوزا؟
أسئلة ينبري لها ماك، في عمله على إعادة كتابة رواية سانشيث، تنقيحها وتحريرها من جديد، وبذلك تغدو تجربة فادحة القلق، لكل كتابة متشابكة، تبحث في معنى الكتابة ذاتها، بين أن تكتب فعلا وبين أن تعيد الكتابة. هل هما يتطابقان؟ هل هناك كتابة من عدم أصلا، أو ليس العدم هو محض وهم، إذ أن كتابتنا لا تعدو أن تكون تدويرا لمجمل ما قرأناه، ما نسينا أننا قرأناه، أو ما ندعي نسيانه في آن؟
عن التخييل إذن، عن هوية الإبداع، عن الذات وأبدالها، عن الفن ونقيضه، عن توتر الوقائع بين الواقعية والتخييل، بين الحقيقة والوهم، تغامر الرواية جماليا بتفكيك المسألة من منظورين: الفشل من جهة، والسرقة كفعل إبداعي.
وإذ تستند إلى اليوميات فهي تقوض الحدود بين ما هو حميمي وما هو فكري، بين الذاتي والجمالي، وبقدر ما هي سيرة تحيل على ذات ماك، فإنها تحيل في الآن ذاته على خلفيته المعرفية والثقافية والفلسفية.
وهذا التشابك يجعل منها رواية “الميتاسرد” في نزوع لحوار روائي ذكي مع تاريخ الأدب، قصة تلو أخرى، تشحذ اليوميات تعليقات جارحة في صلب التفكير فيها، في صلب الاستمتاع بها، وكلها يرسم تضاعيف شخصية ماك، في مرايا النص الممهورة بالتداخل، في تشعبات النص المنذور للعلب السردية التي تضم الواحدة منها الأخرى في إضمارات متعاقبة، في استطرادات لاعجة، زد على ذلك جنوح الرواية في إيقاعها إلى التشظي، محض مجزوءات مقدارها 54 مجزوءة، توهمك بعدم التماسك في حبكتها، لكنها ذات تقاطعات ضمنية، يوحدها نسق مضمر.
لعبة التخوم هي ما تنزع إليه الرواية إذ تضيء العلاقة الملتبسة بين اليومي والمتخيل، ولكنها في أبدع اهتمامها هي الأقرب إلى القارئ وفعل القراءة، مع أنها تستغور فعل الكتابة، وما عساه يكون الكاتب؟
أكثر من ذلك من يكتب؟ ماك أم سانشيث؟ وقياسا إلى ذلك، إعادة الكتابة هي أيضا كتابة، وما من وجود لعمل أصلي خالص، أو مقدس بصورة ما، وما من كتابة إلا وهي تتاخم نصوصا أخرى سابقة، في حوار لامتناه، ولعل الرواية بذلك، تحتفي بصنف الكتاب الذين لم يقدر لهم أن يصيروا كذلك.
مجلة المجلة اللندنية