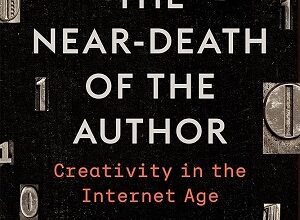“22 درجة مئوية” رواية الهروب من الواقع

عن دار “ابن رشد” بالقاهرة، صدرت حديثاً رواية “22 درجة مئوية.. من سيرة الآنسة ألف والسّيد المعتوه ميم”، لكاتب السيناريو والصحافي المصري محمد عبدالرحيم، وجاءت الرواية، التي صدرت قبل عدّة سنوات في طبعة محدودة عن دار “هامش” بفرنسا، في 164 صفحة من القطع المتوسط.
نقرأ في أحد مقاطع العمل: “استفقتُ على صوت رجل يناديني: أستاذ.. يا أستاذ.. فالتفتُ لأجد سيارة ميكروباص خالية إلا من السائق ورجل يجاوره، هو الذي ناداني ووجدتُ يده تمتد إليّ بعلبة عصير، فشكرته، ولكنّه أصرّ، فانكسفت، وأخذتها منه وأنا خجلان جداً، وانطلقت العربة لأرى على زجاجها الخلفي حروفاً متراصة بالإنجليزية في شكل قوس، وقد سقط أحدها، فاستنبطه وفق مشيئتي حتى يكتمل القوس، وكنتُ على وشك اللحاق بالعربة لأعيد العلبة، لكن القوس الذي ابتعد عني في سخرية جَمّدني مكاني، ونظرتُ لأجد علبة العصير تحتل يدي التي كانت فارغة، فتحتُ سوستة الشنطة ووضعتُ العلبة بداخلها فوق علبة السجائر، فشعرتُ بوطأة الثقل على كتفي”.
وربّما لأن محمد عبدالرحيم درس بالمعهد العالي للسينما بالقاهرة، وحصل على درجة الماجستير في علوم السينما من أكاديمية الفنون عام 2016، عن رسالة بعنوان “تقنيّات السّرد في الفيلم الوثائقي”، فسوف نلحظ على الفور قوّة الحسّ المشهدي العالي في الطّريقة السّردية التي اختار الكاتب أن يقف فيها بين برزخي الشِّعر والرّواية، دون أن يغلّب أحدهما على الآخر، كما لن يخفى على عيون القارئ اللغة الفصحى التي ترصّعها الكلمات الدّارجة من حين إلى آخر، بما يصعب معه استبدالها بمفردات أخرى فصيحة، وهو ما نجده في المجتزأ التّالي: “ألتقي بمَن يتبارون معي في العفونة، ونتحدّث حول أبخرة الشاي ورائحة القهوة والدخان، داخل جُدران مقاهٍ مَجْذومة ومُظِلمة اسْوَدّت من روائح أرواحنا، وتآكلت كراسيها تحت وطأة ثرثراتنا التي لا تنتهي، عن الكادحين والفقراء وأبناء السبيل وخلل الكون وحال البلد، أيّة بلد؟! و”الحرامية اللي واكلينها والعة”، ونحن نرفع من أصواتنا لنُغطّي حقدنا، لأن أحداً لم يُشِر إلينا حتى نأكل معه.
إنها مجرّد إشارة بسيطة يكمُن فيها كل شيء. وقد نُفاجأ ونحن نبكي ونحتشد داخل غُرف غطّتها صور تفوق حجم أصحابها مئات المرّات، فتخرُج أصواتنا المَبْحُوْحَة مُردِدَة نشيداً وطنياً، تسقط مُفرداته حينما تنفتح أفواهنا عن آخرها إذا لمَحْنا نهداً استغل طُغيان الإيقاع فارتعَش، أو مؤخرة انحَشَرَتْ بيننا وبادَلت أعضاءنا المُنتبهة السلام الحماسي، الذي يفوق حماس النغمات التي صاغها فنان الشعب المسطول”.
على هذا النحو، ينتهج الكاتب أسلوباً تجريبياً يتجاوز التصنيف، ما بين الأسلوبين الشِّعري والنثري، والنصوص المنفصلة التي تتجاور لتشكّل صورة وحالة عامة لأجواء المتن الكامل للرواية، بل إننا نجد أيضاً مجتزأ من الرواية كتب بالفرنسية، دون الاهتمام حتى بترجمته. وعلى الرغم من أن النصوص الشعرية في النص كانت لها الغلبة على السرد، إلا أن خيط الحكاية يظل واضحاً، مستدعياً كذلك فترة الأربعينيات في مصر من خلال أسماء بعض أعلامها في الحركتين السوريالية والشيوعية، كما في هذا المقطع: “فكرتُ في “هنري كورييل” ودوره في دخول الشيوعية مصر، رغم كُرهي للشيوعيين ورائحتهم العفِنة، إلا أنني أحبُ “كورييل”، وأريد أن أبحث عن سبب خلافه مع “جورج حنين”، وأعتقِد أنه ليس خلافاً فكريّاً كما يدّعي أصحاب العقول المَرْخيّة، بل أن هناك امرأة، قبلما يهيم “حنين” بـ”بولا”، وربما تكون “بولا”، “بولا” المُسْلِمَة حفيدة أمير الشّعراء.
نعم .. سبب الخلاف امرأة، سبب وجيه يَصْلح لانفصام عقول جَبّارة، لا تهتم لأفكار ساذجة وغامضة تكاد تقارب الوهم، كالوطن والوطنية، ربّما هناك آخرون أدركوا وهْم هذه الكلمات، وتصرّفوا معها وفق ثقافاتهم المتواضعة، التي لا تكاد تقارب شياطين الأربعينيات. وهذا ما يُفسر ذباب السجون الذي فاق ذباب المقاهي، يُفسر انبهارهم بزعيمهم، الذي غَشَيَهُم نياماً، فاستفاقوا ووحوشه اللزجة تسد مؤخراتهم، فانبَهَروا لقدرته وفحولته وقد دَخَلهُم جميعاً في الوقت نفسه، فأدرَكوا العَدْل وأغلقوا سراويلهم، حيث لا يفضّونها إلا في وجوهنا لنَشْهَدْهم مُناضلين”.