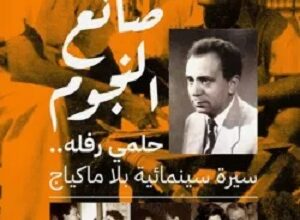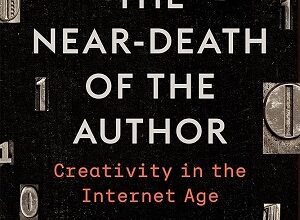رواية جديدة تغوص في أعماق نجيب محفوظ

رواية “الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ” للشاعر والروائي المصري أحمد فضل شبلول تدور أحداثها في الغرفة رقم 612 بمستشفى الشرطة بالعجوزة، حيث قام صاحب نوبل – أثناء مرضه الأخير – باستدعاء الكاتب الشبح، ليملي عليه بعض وقائع حياته، وبعض تفسيرات أعماله الروائية وبعض ما قيل عنها بأقلام النقاد والقراء، ابتداء من أول عمل صدر له وهو “رادوبيس” وانتهاء بكتابه “أحلام فترة النقاهة” بالإضافة إلى شرح علاقاته بالكتاب الآخرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب.
وتكشف الرواية أن أم كلثوم كانت لديها النية لتقديم “أوبرا” عن إحدى روايات محفوظ الفرعونية، فأهداها رواية “رادوبيس” وكانت تفكر في أن يغني أمامها محمد قنديل. ولكنها شُغلت في موضوعات أخرى، ثم رحلت في 3 فبراير عام 1975.
وتتناول رواية شبلول ما رواه محفوظ عن روايته “بداية ونهاية” والتي كان ينوي كتابة قصة كوميدية عن مجموعة من الناس كان يبغضهم، هم أبطال القصة، عرفهم في صباه، وكانوا مجردين من الحياء، ويستولون على مصروفه، مستغلين بؤسهم أو يحتالون عليه بشتى الطرق ليدفع لهم ثمن تذكرة الترام، كان يعلم أنهم يستغلون عاطفته للاستحواذ عليه وعلى ماله القليل، ولذلك فكر في كتابة قصة كوميدية يسخر منهم، ويكشف عن روحهم الاستغلالية التي تبرر نفسها بالفقر، ولكن عندما بدأ الكتابة، أعمل عقله، وبدأت ينظر إليهم بأكثر من زاوية، وكانت النتيجة أنه كتب مأساة، ومعنى هذا أن النظرة الموضوعية تقضي حتى على الميول الشخصية.
وتوضح الرواية أن النظام في حياة محفوظ هو الأساس الذي ساعده على النجاح. وقد حدث نوع من التكيف بين جهازه العصبي والرغبة في الكتابة، فتأتي الرغبة في الكتابة في وقتها تماما، وهو جالس على مكتبه في التوقيت المحدد، تماما مثل فنجان القهوة (ينقر) على دماغك أو السيجارة.
وكان محفوظ عند كتابة كل عمل جديد، يحس أنه كاتب مبتدئ، إلى أن أصبحت عملية الكتابة نفسها شيئا يمارسه دون التفكير فيه، كالمشي مثلا.
وتوضح الرواية أن صاحب نوبل لم يأخذ أجرا على روايته الأولى “عبث الأقدار” عند طباعتها في دار “المجلة الجديدة” التي يمتلكها سلامة موسى الذي رفض له ثلاث روايات من قبل، منها رواية بعنوان “أحلام القرية”، ورواية عن لعب الكرة، وإنما أخذ 500 نسخة، وضعها على عربة حنطور وأنزلها عند أول مكتبة صادفها، وكان اسمها مكتبة “الوفد”. عرض الكتب على صاحبها.
وقال له إنني لا أعرف ماذا أفعل بها، فرأف الرجل بحاله، وقبل أن يأخذ الكتب ويبيع النسخة بقرش صاغ واحد، وأنه لن يعطيه حقه إلا كلما بيعت نسخة.
وظل صاحب “الثلاثية” يمر على المكتبة شهورا طويلة متصورا أنني سيستلم بضعة قروش ثمن ما تم بيعه من الكتاب، لكن هذا لم يحدث.
بلغ عدد الشخصيات الحقيقية في رواية “الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ” أكثر من 400 شخصية، فضلا عن الشخصيات الروائية المحفوظية التي يمتلئ بها العمل، وكانت أكثر الشخصيات الحقيقية دورانًا في رواية شبلول هي: جمال عبدالناصر وأنور السادات وتوفيق الحكيم وأم كلثوم وسعد زغلول ومحمد سلماوي.
وتعرض الرواية – الصادرة عن دار غرب للنشر والتوزيع بالقاهرة – لأهم حدثين في حياة نجيب محفوظ وهما: جائزة نوبل التي حصل عليها عام 1988، ومحاولة اغتياله عام 1994، وأصداء هذين الحدثين محليا وعربيا وعالميا.
ويرى الكاتب أن من لا يعرف شيئا عن نجيب محفوظ، سيعرف من خلال الرواية كل شيء عنه، خلال 95 عامًا عاشها صاحب “الثلاثية” (1911 – 2006).
وقعت الرواية في 362 صفحة، وجاءت في 32 فصلا، وهي تعتبر العمل الروائي السادس في مسيرة الكاتب، بعد “رئيس التحرير أهواء السيرة الذاتية” و”الماء العاشق” و”اللون العاشق” و”الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد” و”الحجر العاشق”.
من أجواء الرواية:
أقول وأنا مستريح الضمير، قبل أن تصعد الروح إلى خالقها: أحسست أنني أديت عملي على أكمل وجه، وأنني وفقت فيه، وأنني مهدت الطريق لغيري من المبدعين، إضافة إلى إحساسي بالرضا عما حصلت عليه، وعمّا قدمته في ميدان الأدب الذي أحببته وأخلصت له. وأنني كتبت كل ما أريد كتابته، لكني لم اقرأ كل ما أريد قراءته، فلا بأس. لم يتبق شيء لم أكتبه. ولا أحب أن أترك شيئا بعدي أنا غير راض عنه. لذا (نِفْسي في موتة كويسة على قد نيّتي).
وحين أفكر في الخدمات التي قدمها لي من كوَّنوني ثقافيا أشعر أنني مَدينٌ لهم بأكثر من ديون مصر، لذلك عندما أقدم رواية لي للطباعة أسأل نفسي ماذا قدمت فيها؟ هل اللغة؟ إن اللغة موجودة من أيام الجاهلية.
هل هو الفكر؟ إن الدنيا مليئة بالأفكار.
هل هي المذاهب؟ لقد أنشأها ناس دفعوا ثمنها غاليا.
هل هو الفن؟ إنه موجود في كل مكان.
إذن ما الذي أكون قد فعلته لأستحق أن يوضع اسمي على رواية لي؟
لو كنت أعلم علم اليقين بأنني سأمارس الكتابة في العالم الآخر، وأُنجز ما لم أستطع إنجازه من أعمال، كنت سأرتاح نفسيا. ولأني مرتاح بالفعل نفسيا، فيبدو أن ذلك سوف يتحقق هناك. وأحمد الله أن لي قبرًا في بداية طريق الفيوم، لأنني سمعت أن القبور تبحث عن أراضٍ شاغرة لتقيم عليها شواهدها. (المقابر لا تنتحب .. إنها قد تحب).
دعني أقول لك بكل صراحة: الآن لا أشعر بالقمة ولا بالهاوية. ولا بالآلام أو الأحزان. وحيث إن الزمن الدنيوي يوشك أن ينتهي بالنسبة لي، فسأبتعد عن الفلسفة فلا مجال هنا للحديث عن الزمن الرياضي والزمن النفسي، والزمن الروائي. الزمن بالنسبة للفرد هو هادم لذاته ومفني شبابه وصحته والقاضي على أصدقائه وأحبابه.
إني أرتفع فوق أي رغبة، وتترامى الدنيا تحت أقدامي حفنةً من تراب، لا أسأل صحة ولا سلاما، ولا أمانا ولا جاها ولا عمرا، ولتأت النهاية في هذه اللحظة، فهي أمنية الأماني.
الموت هو النهاية، وأنا أحب الموت، أنتظره، ولا أخشاه، وإنه لأهون من شرور كثيرة تشوه وجه الحياة، بل إنه طبيعي كالحياة. ولا أريد أن أقول إنه “لا شيء” كما قال أبيقور. ها هو يلوح أمامي، وأنظر له نظرة علمية، كتجديد الشجرة. وأرى زهورا بيضاء تملأ الحجرة. من فضلكم ضعوها على قبري.