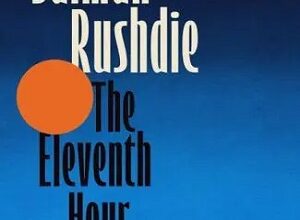تحولات السياسة والاجتماع في الرواية

تتناول رواية «مراسم عزاء العائلة» للكاتب المصري أحمد طوسون، بعض التحولات السياسة والاجتماع في النصف الثاني من القرن العشرين، ويروي أحداثها “جمال” الذي يكشف الكاتب عن اسمه بعد مئة صفحة من صفحات الرواية، وقد عاش جمال بعض أحداث الرواية، بينما يروي بعضها الآخر عن أبيه وأمه وبعض أقاربه.
في البداية يتَّخذ الكاتب من أسرة جمال نموذجًا للترابط الاجتماعي، موضحًا في الوقت ذاته الفقر المُدْقع الذي تعيش فيه هذه الأسرة؛ وهذا التوصيف الدقيق له فائدته في بيان التحولات الاجتماعية كما سيتضح في السطور اللاحقة إن شاء الله، يقول الراوي “أبى كان يجلس فوق كرسيِّه المنجَّد بالقطيفة البُنِّيَّة الباهتة التي تآكلت عند المسندَيْن، والذي أصبح مع السنين حِكرًا له وحده.. يشرب الشاي رغم تعليمات الطبيب له بعدم تناوله، يتصفَّح جريدة قديمة اعتاد أن يتصفحها كل يوم في مثل هذا الوقت من المساء وكأنها ما زالت تحمل الجديد من الأخبار؛ أمي كعادتها في حركة مستمرة بين صالة المعيشة والمطبخ وباقي الحجرات، ترفع أشياء وتضع أخرى وتعيد ترتيبها، أحيانًا صامتة وأحيانًا تنطق جملة أو أكثر، وأبى لا يجيب عليها، كأنه لا يسمعها، يكتفي بِرفع نظَّارته عن عينيه ومراقبة الأشياء الصغيرة تنتقل إلى أماكنها الجديدة، ثم يسترخي في مقعده ويعيد نظارته إلى عينيه ثانية؛ إخوتي يجلسون فوق الكليم الذي اشتريناه هذا الشهر ووضعناه فوق السجادة التي اهترأت، يلعبون الكوتشينة دون ضجيج تنفيذًا لأوامر أبي”.
وفي موضِعٍ آخر يتكلم عن أمِّه فيقول “تقول أمي: إنّ كل الأولاد والبنات الذين يلعبون معها كان لهم إخوة، إلا هي، السنون لم تداوِ شعورها بالوحدة، كلما غضبت منَّا أو من أبي؛ نسمعها تقول: إنها مقطوعة من شجرة، حتى البيت تهدَّمت حيطانه وأصبح خرابًا ولم يجد من يعمره بعد وفاة أبيها، كلما جاءت السيرة نحسُّ ألمًا حقيقيًّا يعشِّش في قلبها ويطلُّ من عينيها لا يريد أن يفارقها، لكنها في أحيانٍ كثيرة تتلقَّفنا بين أحضانها وتقول: إننا كل حياتها.. الأخ والأخت والأب والأم وكل الدنيا”.
هذه الأسرة قد ورثت الترابط والتماسك، وحفظت تراث أسلافها؛ فالشيخ عبدالوهاب – جدُّ جمال لأمِّه – قد باع الفَدَّانَين اللذين كان يملكهما من أجل الإنفاق على ابن أخيه في الكلية الحربية تحقيقًا لرغبة شقيقه المتوفَّى، الذي كان يرغب قبل وفاته في إلحاق ابنه بهذه الكلية، لكن الابنة الوحيدة للشيخ عبدالوهاب لم تلقَ من أبناء عمِّها وفاء أو تقديرًا، لذلك نراها تقول “لكنهم ينسون فضل الشيخ عبد الوهاب عليهم”.
التحول الاجتماعي بين أبناء العم
أبناء عم والدة جمال الذين رأوا المعاملة الحسنة من عمِّهم، الذي كان يجمعهم حوله ويقوم بأمورهم، ويبَرُّ أخاه – المتوفَّى – فيهم؛ قد تحوَّلوا عن هذه القِيَم والمكارم التي رأوها من عمهم، يقول الكاتب على لسان جمال متحدثًا عن خالته نجاة وهي ابنة عم أمِّه “مع كل إجازة تأتي خالتي نجاة لزيارتنا، وأولادها لا يأتون معها؛ يذهبون ليقضوا بضعة أيام في الإسكندرية أو رأس البر ولا يفكرون في زيارة أهلهم.. أمي تقول: إنهم لا يعرفون أهلهم.. أبي يقول: إنهم معذورون؛ تربَّوا في بلاد غريبة ولم يختلطوا بأحد”.
وفي عزاء زوج خالته نجاة نجد صورة سيئة تنمُّ عن التَّحوُّل الاجتماعي الكبير الذي سيطر على نجاة وأولادها؛ فالأم لم تبلغ ابنها الأكبر بوفاة أبيه؛ حتى لا يتعب نفسه في السفر، وإذا كان حضوره لن يغيِّر شيئًا كما تقول أمه؛ فأين البرُّ بالأب والقيام بمراسم دفنه وعزائه؟ ولم يقف السَّخف عند ذلك الحدِّ؛ بل إنها وبقيَّة أولادها أساؤوا استقبال الناس الذين أتعبوا أنفسهم وحضروا من محافظةٍ بعيدة في الصعيد مجاملة لابن عمِّهم إبراهيم الذي هو ابن أخت نجاة، جاؤوا يقدِّمون لها ولأولادها واجب العزاء، فأساؤوا استقبالهم وطردوهم بنظراتهم، فعادوا إلى بلدهم قبل أن ينفضوا أيديهم من تعب السفر.
التحول الاجتماعي بين الإخوة
لم يقف التحول الاجتماعي عند هذا الحدَّ من جانب نجاة وأولادها؛ فإنَّ مساوئهم لا تنتهي، كما أنها ليست وليدة لحظتهم؛ لكنها أقدم من ذلك؛ فإن أبناء العمِّ هؤلاء لم يحسنوا المعاملة فيما بينهم؛ فقد جَنَوا على أخيهم مسعد وتركوه فريسة لأخته نجاة، بينما كان التعاطف معه مِن قِبَل الغرباء الذين لا تربطهم به علاقة اجتماعية “اشتغل مسعد عند مصوِّرٍ يوناني في حي الحسين، وشرب المهنة على يديه، حتى اندلعت ثورة 1952، فرحل المصوِّر اليوناني عن مصر لعدم رغبته في العيش في بلدٍ يحكمها العسكر، وعاد مسعد يعمل بالتصوير في بلدته، ثم اشتغل في عمل الأختام، وبعد عامين اشترى الحجرة التي كان يعيش فيها وقطعة الأرض التي بجوارها، وغرس فيها نخلتين وبعض الأزهار، وكانت نجاة قد طُردت هي وزوجها فوزي من بيت أبيه، فلم يجدا مكانًا يعيشان فيه إلا عند مسعد؛ ترك لهما الحجرة التي ينام فيها وبنى كوخًا من الخشب لنفسه، ثم سافر فوزي إلى ليبيا، وأرسل إلى نجاة لتشتري أرضًا وتبنى بيتًا، فاستغلَّت طِيبة مسعد، وقالت له: إنها تريد أن تهدم الحجرة وتبنى بيتًا كبيرًا بالطُّوب الأحمر والإسمنت المسلح؛ وأظهرت له مسكنَتَها وأوهمته أنها ستبنى بيتًا كبيرًا من ثلاثة أدوار، وأن الدور الأول كله له.. واستطاعت أن تخدعه، وإخوتهما يرون ذلك ولا يتكلم منهم أحد، كل واحد منهم لا يفكر إلا في مصلحته”.
فمن المفارقات في قصة مسعد أن الخواجة اليوناني صاحب أستوديو التصوير الذي عمل فيه مسعد، كان كريمًا معه وعلَّمه فنون العمل ولم يبخل عليه، كما أن الرجل الذي باع الحجرة والأرض لمسعد، لم يلحَّ عليه وتركه يدفع حين يتاح له المال، وهذه الأرض هي التي استولت عليها شقيقة مسعد بالحيلة والمكر، ثم تمادت في خداعه، وباعت هذا البيت الذي هو بيته، وأخبرته أن المشتري سيستلمه بعد أسبوع، ثم “مدَّت يدها في حقيبتها الملقاة على أريكة إلى جوارها وأخرجت مظروفًا ووضعته أمامه، المظروف فيه خمسمئة جنيه، قالت له: ادفعها مقدَّمًا لأيّ حجرة واسكن فيها.. أخذ المظروف وخرج دون أن ينطق، ولم يكلِّف أحد منهم نفسه ويقول له: مع السلامة”.
هكذا المكر والخبث وقطيعة الرَّحِم، حتى إنه في عزاء فوزي زوج نجاة “حضر مسعد ليشاركهم في مراسم العزاء لكنه انصرف لعدم مبالاتهم به”، فهو كريم معهم حتى النهاية، وهم على النقيض من ذلك، حتى إنه حين مات؛ فإن (الغريب) الذي أخبرهم بموته، لم يجد لديهم مقبرةً يدفنون فيها مسعدًا، فدفنه ذلك الرجل في مقبرة عائلته، وكان متعجِّبًا من عدم حضور أحدٍ من إخوة مسعد؛ فأحدهم مضطر إلى السفر للخارج لتوقيع عقد مهم، وأخته عليَّة مريضة، ولو حضروا لن يكلِّفهم العزاء شيئًا؛ فإن مسعدًا ترك مع (الغريب) مبلغًا من المال ليتصرف به إن مات.
ويعرض الكاتب مثالًا آخر لقطيعة الرَّحِم وسوء الخُلُق؛ فحين وصلوا إلى البيت الذي كان يقيم فيه مسعد – وهو بيت ذلك الغريب الذي أخبرهم بوفاة مسعد، وكان مسعد قد استأجر منه حجرة يسكن فيها – حدَّثهم الغريب عن أحد السكان في بيته “الحاج محمود يعيش أيضًا وحيدًا، كل واحد من أولاده في بلد، ولم يَعُدْ أحد يسأل عنه، منذ عامين أكرمه الله وحجَّ بيت الله هو وزوجته – رحمها الله – لكنه مسكين؛ المرض ثَقُل عليه ولم يَعُدْ يستطيع الحركة”، وكأنَّ الرجل يخبرهم أن الدنيا بها كثيرٌ ممن جفاهم أقاربهم وذَوُوهم كما حدث لمسعد.
ويبدو أنهم جميعًا قد ظلموا مسعدًا، حتى أسرة جمال؛ فإنهم حين جاءهم خبر وفاة مسعد.. “سارعت عيوننا تتلمَّس الطريق إلى الغريب صاحب الدَّقَّات التي أغضبت والدي، توقَّعنا أن تكون ثرثرته عالية كدقَّاته، لكنّنا لم نسمع شيئًا، همس في أذن والدي كأنه تعمَّد ألا نسمع شيئًا مما قاله، بدا مرتبكًا وحائرًا كأنه يحمل أخبارًا ثقيلة على النفس، لا يعرف كيف يقولها.. انتهى من همسه، حدق أبى في عينيه وبادله كلمات لم نسمعها أيضًا، فاستعادت ملامحه الهدوء”، فالواضح من هذه الصورة التي رسمها الكاتب ومن السِّياق العام لأحداث الرواية أن (الغريب) الذي طرق بابهم قد أخبرهم بوفاة مسعد، وكان حائرًا مرتبكًا؛ ظنًّا منه أنه سيخبرهم خبرًا محزنًا، لكنه عرف من كلام والد جمال وطريقته أن الأمر يسيرٌ جدًّا وليس فيه ما يُحزن؛ إذْ لا مكانة لمسعد عندهم! حتى عندما اتصل الأب ببعض أقاربه أو أصدقائه يخبرهم بوفاة مسعد “وسمعناه يتحدث إلى أحدهم عن انشغاله في أمور كثيرة؛ الظروف الصعبة التي يواجهها في عمله والتي تجعله لا يلتفت حوله، حالته الصحية التي تتدهور.. بعدها أخبره أن مسعدًا مات، وأن أحدهم حضر وقال: إنهم يريدون أحدًا ليتسلَّمه ويقوم بإجراءات الدفن”.
وبعد أن انتهي الدفن ذهبوا إلى حجرة مسعد بصحبة صاحب البيت، فوجدوا بها صورًا كثيرةً كان قد التقطها لهم في مراحل حياتهم السابقة.. “الله يرحمك يا مسعد.. قالها أبي طويلة وممطوطة، كأنه يكتشف للمرة الأولى وفاته، وكأنه تذكَّر أن الميت – الذي يرونه مخبولًا – يستحق الرحمة لأجل هذه الصور التي حفظ لهم بها ذكرى أيام ولَّتْ ولن تعود”، فكأنهم لم يشعروا بوجوده بينهم حين كان حيًّا، ولم يفتقدوه حين مات، ولم يتذكروه إلا بتلك الصور التي سجَّل بها مراحل من حياتهم.
مظاهر التفاوت الطَّبقي
الحديث عن الجانب الاجتماعي في حياة الناس، يقترن في الأغلب الأعم بذكر الطبَقيَّة بما فيها من تفاوتٍ أو توافقٍ؛ وفي هذه الرواية تبدو لنا مظاهر التفاوت الطبقي من خلال الوصف الدقيق الذي ذكره الكاتب لمنزل نجاة في القاهرة، ومنازل البلدة الصغيرة التي تعيش فيها أسرته، وكذلك الحجرة التي استأجرها مسعد بعد أن خدعته أخته نجاة وباعت منزله الذي استولت عليه.. حين ذهب مسعد إلى شقَّة أخته نجاة في القاهرة “الشَّقَّة لم تكن مثل ما نعرفه من شقق أو بيوت؛ كانت أشبه بقصور أمراء وأميرات الخيال؛ السجاد العجمي من القطيفة الخالصة، تغوص فيه قدماه رغم أنه يسير على أطراف أصابعه، التماثيل والأنتيكات التي جمعها أبناؤها من بلاد العالم، أحواض سمك ونافورة تتوسط الشَّقَّة، ربما كانت أكبر من تلك التي تتوسط ميدان بلدنا، وفي الأركان أشجار وأزهار ظنَّها طبيعية، وأثاثٌ لم يَرَ له مثيلًا من قبل.. هو يعرف أنها غنيَّة، ولكن لم يتصور أن تكون بهذه الدرجة من الثراء”.
أما الراوي (جمال) فإنه يعيش في “حارة ضيِّقة رطبة تنتشر بأرضيتها الترابية بثُور من الطين المتجمد، تصلها بعد أن تمر على أكثر من حارة تشبهها، حتى تظن أنها نفس الوجوه الكالحة المرهقة، نفس النسوة بجلابيبهن السُّود، يَسِرن في الشوارع يحملن في جعبتهن وجع النهار وينثرنه على الشفاه مع البسمات وتحيات الطريق، الرجال يلملمون تعب النهار مع الحكايات، يفترشون الأرض الرطبة أمام البيوت التي رشَّتْها النساء بالماء المشبع برائحة النعناع بمجرد أن توارت الشمس خلف البيوت”.
وكذلك المكان الذي استأجره مسعد وأقام فيه بعد أن سرقت أخته بيته وباعته.. “البيوت واطئة من طابق واحد أو طابقين أو ثلاث، ذات أسطح شائهة، غطَّتها عشَش الصفيح والخشب والجريد، وأطباق صغيرة لاستقبال الإرسال التلفزيوني”.
سيطرة الإهمال والجشع
تعرض الرواية أيضًا نماذج من الإهمال المتفشِّي في المجتمع؛ كقول الراوي “إلى وقت قريب كانت أرض المستشفى بها حديقة كبيرة تكسوها الخضرة والأزهار الزاهية، قبل أن يستغلها الأطباء كجراجٍ لسياراتهم”.
وقد صاحَب هذا الإهمال بعض أنواع الجشع “أبي يقول: إن المستشفى نظيفة لأنه لم يَعُدْ أحدٌ يرتادها، العنابر شبه خالية، ولم يَعُدِ العلاج مجَّانًا، صيدلية المستشفى لا علاج بها، العلاج يشتريه المرضى من خارج المستشفى، من الصيدلية القريبة منها، يقولون :إنها مِلك زوجة مدير المستشفى، يتعمد ألا يوجد علاج بصيدلية المستشفى ليروِّج لصيدلية زوجته”.
الفوضى الأمنية
تطرَّق الكاتب أيضًا إلى ظاهرة لها أهميتها الكبيرة؛ وهي ظاهرة الفوضى الأمنيَّة التي تعاني منها بعض المجتمعات بحسب طبيعة الأنظمة السياسية في كل مجتمع؛ فالأنظمة السياسية حين تُبتَلى بالجهل والفشل؛ يدفعها الخوف إلى التَّحصُّن بأجهزة أمنيَّة في مِثل طبيعتها من الجهل، لا تدرك ما تفعله، ولا تريد أن تدرك شيئًا سوى أنها تحمي النظام السياسي الذي جاء بها، وتسير على غير هُدًى، تنظر إلى الناس جميعًا باعتبارهم أعداء لذلك النظام، فتوجِّه التُّهم وتقوم بالاعتقال والحبس دون مبرِّرٍ غير ذلك المبرر الوحيد الذي تضعه نصب أعينها؛ وهو أنها موكَّلة بخدمة النظام الذي منحها سلطاتٍ وصلاحياتٍ لا تستحق شيئًا منها؛ ومما فعلته تلك الأجهزة في أحداث هذه الرواية أنها أرسلت إلى والد جمال ليذهب إليهم، فلمَّا ذهب “تركوه في غرفة لا يدخلها الهواء، ولا يجد بها أحدًا يسأله عن شيء، كلما التفت ناحية الجدران استشعر عيونًا ترقبه وتعدُّ عليه أنفاسه، ثم سألوه عن أشياء كثيرة لم يعرف سببًا لاهتمام الحكومة بها، وزادت من هواجسه ومخاوفه، حتى تسرّب إليه إحساس بأنه مجرم خطير يهدِّد أمن الوطن، رغم أن سبب استدعائه هو السؤال عن مسعد الذي تم اعتقاله لأنه أراد هو ورجل آخر اسمه مرزوق أن يخلِّصا شحاتة (اللص) الذي وضعه الخفر فوق حمار وداروا به في الشوارع؛ حيث طلب مرزوق منهم أن يكتفوا بعقابه العادل، وتَبِعه مسعد، فتمَّ القبض عليهما”.
وفي موقف آخر “الأستاذ محروس زميل أبي في العمل كان في طريقه لزيارتنا، قابلته العربات السوداء المصفحة في الطريق وأخذته معها كما كانوا يأخذون كل من يقابلونه في الشوارع، قال لهم الأستاذ محروس: إنه خرج ليزور أبي كعادته بعد صلاة العشاء ليلعبا الطاولة ويتبادلا الأحاديث والحكايات مع فنجان القهوة؛ لم يسمعه أحد، وظل معتقلًا ستة أِشهر، وبعد خروجه من المعتقل لم نَعُدْ نراه كثيرا؛ حيث أصبح لا يخرج من بيته بعد عودته من عمله إلا لظروف قهرية”.