قراءة في نظام هنري كيسنجر العالمي
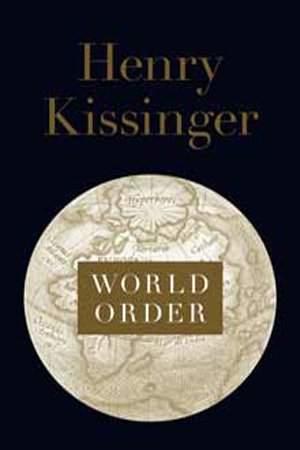
Henry Kissinger, World Order (Penguin Press, 2014).
تقدم “مكتبة السياسة الدولية” في هذا العدد قراءة نقدية ممتعة في كتاب لا تزال عملية ترجمته إلي عدد متزايد من لغات العالم متواصلة، منذ إصداره في سبتمبر 2014، وتجاوزت طبعاته بالإنجليزية العشرين حتي نهاية أبريل .2015 ولا عجب في ذلك، فالكتاب لهنري كيسنجر الذي أسهم في تشكيل الفكر والواقع في آن معا علي مدي عقود طويلة. فهو أستاذ مخضرم في العلاقات الدولية في إحدى أعرق جامعات العالم (هارفارد)، وهو أحد أهم وزراء خارجية الولايات المتحدة والعالم، وأكثرهم شهرة في القرن العشرين وحتى اليوم.
ولأنه جمع بين إنتاج المعرفة والسياسة، والعمل في المطبخ السياسي “الحاكم” للعالم في فترة دقيقة بين 1969 و1977، فهو أكثر وزير في العالم نشر كتبا. وبخلاف ما يفعله وزراء عاديون لا ينشرون إلا مذكراتهم، فقد أثري د. هنري كيسنجر مكتبة العلاقات الدولية بعدد كبير من الكتب التي يتفق أو يختلف علي منهجها، ولكن لا يوجد اختلاف علي أهميتها.
وفي هذه الكتب كلها، ومنذ أولها الصادر عام 1957 من واقع أطروحته للدكتوراه، وعلي مدي ما يقرب من ستة عقود، لم يتغير منهج كيسنجر المحافظ، بل المفرط في محافظته Ultra Conservative. فهو يؤمن بأن هناك قواعد تحكم العالم لم تتغير منذ معاهدة وستفاليا عام 1648، أي منذ نحو أربعة قرون، الأمر الذي يستحيل تخيله بالنسبة إلي أي أكاديمي أو سياسي غير محافظ، حتي إذا لم يكن تفكيره ليبراليا أو تقدميا. ولا يزال كتابه المأخوذ من أطروحته للدكتوراه تحت عنوان (استعادة العالم: مترنيخ وكاستليرج ومشاكل السلام 1812-1822) هو أكثر الكتب كلاسيكية في مجال العلاقات الدولية. وهو كتاب يقرظ دور سياسيين محافظين عملا بدأب علي مدي عشر سنوات 1812-1822 من أجل “هندسة” نظام للتحالفات الدولية بهدف تحقيق الاستقرار في نهاية الحروب النابليونية، وهما الأمير مترنيخ وزير خارجية النمسا، والكونت كاستليرج Castleragh وزير خارجية بريطانيا.
ولا يزال نموذج مفاوضات 1812-1822 وقطباها النمساوي والإنجليزي في قلب وعقل كيسنجر، إلي حد أن بعض ناقديه يرون أنه ربما حلم بالعيش في ذلك العصر، وتخيل نفسه بينهما.
ويعد كتاب “النظام العالمي” الذي يقرؤه لنا الباحث المتميز جمال أبو الحسن تتويجا لمجموعة كتب سيظل لها مكانها المهم في المكتبة العالمية. فإلي جانب كتابه التأسيسي عن مترنيخ وكاستليرج، وعمله الضخم عن تجربته في صنع القرار الأمريكي مستشارا للأمن القومي 1969-1973، ثم وزيرا للخارجية 1973-1977، قدم كيسنجر عددا من الكتب البالغة الأهمية. وربما يكون هو أكثر من استفادوا من خبرتهم في مطبخ صنع القرار، وربطوا هذه الخبرة بمعرفتهم الأكاديمية، الأمر الذي انعكس في معظم كتبه.
فالملاحظ أنه علي مدي 12 عاما بين نشر كتابه الأول، ودخوله البيت الأبيض، لم ينشر إلا كتابا واحدا معروفا لدينا هو “الأسلحة النووية والسياسة الخارجية”. أما باقي كتبه، فقد تتابعت فور خروجه من “مطبخ صنع القرار” عام 1977، وصولا إلي كتابه عن الظام العالمي الذي نقدم قراءة فيه.
واللافت في هذه القراءة أن كاتبها يميل إلي المنهج المحافظ في العلاقات الدولية، إن لم يكن هذا هو منهجه بالفعل. ومع ذلك، قرأ الكتاب بعقل نقدي واع، رغم أن معظم الأكاديميين والباحثين ذوي المنهج المحافظ “يقدسون” مؤلفه، ويكتفون بالتعلم ممن يعدونه المعلم الأول في العلاقات الدولية. فقد قدم جمال أبو الحسن قراءة نقدية عميقة تدل علي أن بين أصحاب المنهج المحافظ في العلاقات الدولية شبابا واعدين يمكن أن يسهموا في تطوير هذا المنهج في قادم الأيام.
النظام العالمي من ويستفاليا إلي تويتر
لا يمكن أن ينتج عصرنا الحالي قادة أو رجال دولة بوزن تشرشل، أو برؤية روزفلت، أو بشجاعة ديجول. في عصر وسائل الاتصال الاجتماعي، لا مكان لأمثال هؤلاء الذين جمعوا بين الشجاعة والرؤية.
لماذا يعتقد كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي، مستشار الأمن القومي الأسبق، أن عصرنا لا يمكن أن يفرز هذا الصنف النموذجي من الرجال/القادة؟ يري كيسنجر أن عصر الإنترنت يركز علي الحقائق، لا التصورات، علي المعلومات، لا المعرفة أو الحكمة. يقدم آليات غير مسبوقة لحفظ المعلومات، ولكنه لا يساعد علي إدراك دلالتها في سياق تاريخي. الأخطر أن هذا العصر، وبسبب الاتصال اللحظي، والشفافية المتزايدة، ووسائط التواصل الاجتماعي، يجعل القادة أسري لإرضاء الجمهور. يجعل من الصعب علي الساسة اتخاذ قرارات تتحدي الإجماع الذي يتشكل لحظيا علي الفضاء الإلكتروني، هكذا، يختفي القائد الذي يستطيع اتخاذ قراره بمفرده، وبوحي من قراءته للتاريخ والواقع. هكذا، تفقد حرفة السياسة الخارجية وقيادة الدول معناها في عصر تويتر.
في كتابه “النظام العالمي”، يتشبث كيسنجر بالتاريخ، لأنه يشعر بأن عصر تويتر يستخف به، ويتجاهل دروسه، ويتعالي عليه. علي نحو ما، لا يشعر كيسنجر بأنه ينتمي إلي عصرنا الحاضر. هو يشعر بذاته وتحققه فعليا في العصر الذي شهد فجر الدبلوماسية الأوروبية منذ القرن السابع عشر. إنه عصر المؤتمرات التي تعيد تشكيل الدول، ورسم الحدود، وإرساء القواعد. عصر صنعه رجال مثل الكاردينال روشيليو، وبالمرستون، وميترنخ، وبسمارك. هؤلاء هم الرجال الذين يشعر كيسنجر -في داخله- بأنه واحد منهم.
كيف “تهندس” نظاما عالميا؟
تتحقق قمة النجاح الدبلوماسي -عند كيسنجر- عندما تتاح الفرصة لرجال متبصرين مثل هؤلاء لصياغة نظام عالمي. النظام العالمي هو تصور كل حضارة أو منطقة عن النموذج الأمثل لتراتبية السلطة وتوزيع القوة في العالم. أهم عناصر النظام هو القواعد والقيم التي تحدد السلوك الشرعي والمقبول. كيسنجر يشعر قارئه بأنه كان يجلس فعليا مع المبعوثين الأوروبيين وهم يضعون هذه القواعد في ويستفاليا 1648، وفيينا .1815
الفكرة المحورية في كتابه هي أن النظام العالمي، كما نعرفه اليوم، هو وليد هذه التجربة الأوروبية الفريدة. انتشار هذا النظام في القرنين التاسع والعشرين -عبر الاستعمار- ليشمل المعمورة كلها لا يعني أنه يعكس توافقا إنسانيا علي فلسفته. فالحقيقة أن العالم شهد أكثر من نظام عبر مراحل التطور التاريخي المختلفة. الإقرار بالنظام “الويستفالي” لا ينبغي أن يؤخذ كمسلمة، إذ إن هناك قوي أساسية في عالم اليوم لم تشارك في صنعه، ولا ترضي بمكانها فيه، وربما تسعي لتعديله (الصين مثلا). وهناك قوي أخري لا تعرف من الأصل بهذا النظام أو بالفلسفة التي يتأسس عليها (الإسلام السياسي، خاصة في تجلياته الجهادية، وآخرها داعش).
ولكن ما سر عبقرية النظام الويستفالي؟ صلح ويستفاليا هو معاهدة سياسية أنهت حرب الثلاثين عاما التي مزقت أوروبا. هذا الصلح وضع نقطة النهاية للحروب الدينية، ولكنه أفرز شيئا جديدا وعبقريا: الدولة ذات السيادة. أساس التوافق الذي أنتج “ويستفاليا” هو الإقرار بسيادة الدولة، وبمبدأ عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية، وهو المبدأ المؤسس للنظام العالمي المعاصر. المنطق الذي يحرك الحروب الدينية هو الصراع الشامل من أجل فرض العقيدة. فكرة “ويستفاليا” -في المقابل- ترتكز علي عدم جواز التدخل في العقيدة الدينية لشعوب الدول الأخري. من رحم هذه الفكرة، ولد مفهوم السيادة، بل وظهرت الدولة الحديثة ذاتها ككيان قانوني مستقل عن الملوك والعائلات الحاكمة.
صلح “ويستفاليا” لا يمنع الصراعات والنزاعات، وإنما يحصرها في نطاق معقول، يحددها ويحتويها. بدلا من النزاعات الخلاصية المقدسة التي دمرت أوروبا، يتخذ الصراع صورة حروب محدودة من أجل تحقيق المصلحة القومية للدولة. في “النظام الويستفالي”، لا توجد فكرة أو عقيدة مهيمنة، وإنما مجموعة من المصالح المتضاربة. جوهر النظام هو التعدد، لا المركز الواحد المهيمن (كما كان في عهد الإمبراطورية أو السيطرة الكنسية). فلسفته تستند إلي أفكار أوروبية جديدة، لا التصور القروسطي القائم علي مركزية الدين. هذا النظام يقبل بالدول والمجتمعات كمعطي، كوضع قائم ومستقر، لا كهدف للتغيير.
الفكرة الأخري المهمة في النظام الويستفالي هي التوازن. توازن القوي هو جوهر فلسفة “كيسنجر” السياسية، ومفتاح فهم أفكاره عن الدبلوماسية العالمية. اقتناعه أن النظام الدولي الذي يتأسس علي هذه الفكرة هو الأكثر استقرارا. العثور علي نقطة التوازن يمر عبر عمليات معقدة من الأحلاف والأحلاف المضادة. لعبت بريطانيا دور “ضابط التوازن الأوروبي” عبر التحالف باستمرار مع الطرف الأضعف، وبهدف منع سيطرة أي قوة منفردة علي أوروبا.
علي أن التوازن له مشكلاته ومعضلاته. هو نظام يفترض أن الدول -باختلاف ثقافاتها وتاريخها- تنظر للواقع بصورة متماثلة. يفترض كذلك أن الواقع ذاته ثابت لا يتغير. لا هذا صحيح ولا ذاك. الحقيقة أن التهديد الرئيسي لهذا النظام يكمن في أن موازين القوي بين الدول تخضع لعملية تغيير مستمرة. احتواء الدول الصاعدة داخل النظام يصير أكبر تحد يواجه استمراره.
كيف يكون النظام شرعيا؟
حملت الثورة الفرنسية (1789م) فكرة تمثل النقيض الكامل لفلسفة “ويستفاليا”. هذه الثورة سعت إلي “إعادة ترتيب العالم”، ليس علي أساس الدين، كما كان الحال في العصور الوسطي، وإنما انطلاقا من فلسفة التنوير. جوهر الثورة الفرنسية هو سيادة الشعب. ولكن ما هو الشعب؟ عند كيسنجر، هو كيان غامض تعبر عنه فكرة غامضة أخري هي “الإرادة العامة”، التي يصبح الثوريون حصريا هم المتحدثين باسمها. إنها فكرة -بحسب كيسنجر- أبعد ما تكون عن الديمقراطية وتوازن السلطة، وقد شكلت المحرك لجميع الحركات الشمولية في القرن العشرين. هذه الحركات التي استلهمت الثورة الفرنسية أثبتت أن التهديد الأخطر لنظام “ويستفاليا” يأتي من تغييرات تحدث داخل الدول ذاتها.
مرة أخري، اجتمعت أوروبا في مواجهة الزخم الثوري الفرنسي -كما جسدته حروب نابليون- وردت هذا الأخير علي عقبه. سعت القوي الأوروبية المنتصرة بعد ذلك لتأسيس نظام سياسي يعد الأكثر كمالا في نظر كيسنجر. مؤتمر فيينا (1815) -الذي وضع تسوية ما بعد الحروب النابليونية- أنتج قرنا كاملا من السلام بين القوي الكبري. كانت تلك الفترة أطول فترة من السلام النسبي تشهدها أوروبا. كيسنجر يعزو السر إلي براعة التسوية التي استوعبت المهزوم والمنتصر في نظام توازن دقيق. هو يرصد سرا آخر لنجاح التسوية: الحفاظ علي الشرعية.
أي منظومة دولية تنجح فقط إذا مزجت بين عاملين: القوة والشرعية. القوة تنضبط بالتوازن المستمر. أما الشرعية، فتعكس مجموعة من القيم والقواعد المستقرة التي يتأسس عليها النظام. في ضوء هذه القيم، يتحدد ما هو مقبول وشرعي، وما هو مرفوض ويتعين مقاومته وردعه. أمام التحدي الذي أشعلته الثورة الفرنسية، كان مطلوبا وضع أساس جديد للسلوك بين القوي الأوروبية. كان ضروريا الاتفاق علي جملة من القيم والقواعد. احتضنت تسوية فيينا النظم الأوروبية القائمة (الملكيات المحافظة) كأساس للشرعية داخل النظام. كانت تلك تسوية محافظة في جوهرها، ولهذا نجد كيسنجر منحازا إليها، ومنبهرا بالرجال الذين صاغوها.
كيسنجر فيلسوف سياسي، ودبلوماسي محافظ. هو يقبل العالم كما هو، لا كما ينبغي أن يكون. بالنسبة له، الصراع جزء أصيل في الطبيعة البشرية ذاتها. محاولة نفي ذلك أو كبته تحت دعاوي مثالية لا تنتج إلا صراعات أوسع وأشد ضراوة. ما يستطيع السياسي -وما يجب عليه- فعله هو هندسة منظومة تجعل الصراعات محكومة قدر الإمكان، أي ترشيد الصراع، وليس القضاء عليه بالكلية. كان هذا بالضبط هو سر إبداع تسوية فيينا.
كان علي أوروبا أن تعبر في حربين عالميتين مدمرتين لكي تصل إلي نقطة توازن جديدة في.1945 التوازن هذه المرة طرأ عليه عنصر جديد. القوة الأساسية التي تضبط التوازن في أوروبا (الولايات المتحدة) صارت خارجها. كيف وصلت الأمور إلي هذه النقطة؟.
مدينة علي تل أم قوة كبري كغيرها؟
الولايات المتحدة لا تعد فقط القوة الرئيسية في النظام العالمي اليوم، ولكنها أيضا الدولة التي أسهمت بالنصيب الأكبر في صناعة هذا النظام، وتشكيله، والحفاظ عليه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولكنها ليست قوة تقليدية، بل دولة لديها فكرة، وتظن أنها صاحبة رسالة إلهية لتخليص البشرية كلها من نير الطغيان. إنها “مدينة علي التل”، عليها واجب مقدس لنشر الحرية ومبادئ الحكومة الذاتية في ربوع الأرض، من خلال توسيع ما أطلق عليه توماس جيفرسون، الرئيس الأمريكي الثالث، ”امبراطورية الحرية”.
إنها المعضلة الأبدية في السياسة الخارجية الأمريكية، كما يراها كيسنجر. الصراع بين نزعة مثالية ترسم للولايات المتحدة دورا في خلاص العالم كله، ونزعة واقعية تري العالم بتوازناته القائمة، وتعقيداته المتأصلة. السياسة الأمريكية هي حصيلة تفاعل مستمر بين هذين الوجهين المتناقضين.
في البداية، وكأي دولة مستقلة حديثة، نأت الولايات المتحدة بنفسها -ولقرن كامل- عن سياسات التوازن الأوروبي. في عام 1890، كان جيشها يحتل مرتبة تالية لبلغاريا. ولكن شيئا ما مذهلا كان يحدث بالتدريج طوال القرن التاسع عشر. كانت الولايات المتحدة تتحول، وبواقع إمكاناتها الذاتية الهائلة، إلي قوة كبري.
كان ثيودور روزفلت، الذي تولي الرئاسة في 1901، هو أول رئيس أمريكي يدرك مغزي قوة أمريكا ودورها في العالم. هذا رجل دولة آخر يعدّه كيسنجر النموذج المثالي لما يجب أن يكون عليه القائد. كان روزفلت رجلا محافطا قرأ الخريطة العالمية كما هي عليه، واستشعر أن لأمريكا، بواقع قوتها البازغة، وأمنها في مواجهة الأعداء، وإطلالها علي المحيطين الهادي والأطلنطي، مصالح في هذا العالم، وأن بإمكانها أن تلعب الدور الذي لعبته بريطانيا في القرن التاسع عشر. ولكن من أجل القيام بهذا الدور، كان علي الولايات المتحدة أن تكسر عزلتها، وتجرب حظها مع لعبة التوازن الأوروبي. كان عليها أن تلعب هذه اللعبة كما هي، وبقواعدها المرسومة، لا بواقع أفكار مثالية، أو دعاوي أخلاقية.
سعي روزفلت لبناء البحرية الأمريكية، وانغمس في السياسة الدولية، فنال جائزة نوبل عن وساطته في إنهاء الحرب بين روسيا واليابان في.1905 بل إنه تنبه لقوة اليابان البازغة، فعمد إلي إبراز قوة أمريكا وسيادتها في المحيط الهادي، عبر رحلة مسالمة تستعرض إمكانيات الأسطول الأمريكي. هو صاحب المقولة الشهيرة: “تحدث بلين، ولكن لوح بعصا غليظة”. كان روزفلت يري أن المجتمعات الليبرالية تستخف -بطبيعتها- بالنزعة العدائية السائدة في العالم، وكان يمقت” تلك النزعة الإنسانية الزائفة التي تري أن الترقي الحضاري يتعين أن ينطوي علي إضعاف لروح القتال، وهو ما سيقود في النهاية لدمار الحضارات المتقدمة علي يد من هم دونها رقيا”.
علي الجانب الآخر، كان ودرو ويلسون (تولي الرئاسة من 1913 وحتي 1921) هو النقيض الكامل لكل ما يمثله روزفلت. كان يجسد المثالية الأمريكية في أنقي صورها. قاد ويلسون الولايات المتحدة لدخول الحرب العالمية الأولي، لا لتعديل توازن القوي، ولكن “لجعل العالم مكانا أكثر أمنا لبزوغ الديمقراطية”. كان يؤمن بـ “الرسالة الإلهية” لأمريكا، وتأسست سياسته الخارجية علي نشر المبادئ التي قام عليها النظام الداخلي الأمريكي في العالم كله. كانت تلك فكرة طموحا وخطيرة في الوقت ذاته.
التسوية التي أنهت الحرب العالمية الأولي لم تعد بناء توازن للقوي، كما حدث في فيينا 1815، وإنما وضعت نظاما مختلفا كليا. في رأي ويلسون (الأكاديمي الدخيل علي السياسة)، مثلت العائلات المالكة والدبلوماسية السرية -لا التناقض المتأصل بين مصالح الدول كما يري كيسنجر- السبب وراء إشعال الحرب. إذا مورست الدبلوماسية بشفافية، وعرضت الحقائق أمام الناس، وقامت نظم ديمقراطية حقا في العالم كله، فإنه يصبح ممكنا استئصال الصراع من العلاقات الدولية، لأن أغلبية البشر عقلاء، ولن يختاروا الحرب، إن توافرت لهم حرية حقيقية. يتعين إذن استئصال شأفة جميع النظم غير الديمقراطية، وإقامة نظام دولي جديد يتأسس علي مبادئ الحكم الذاتي، وحق تقرير المصير. وهكذا، أعيدت هندسة الواقع الأوروبي والعالمي، ليس علي أساس التوازن، وإنما المبادئ.
ولكن كيف يتحقق الأمن في غياب توازن القوي؟ كان الحل الذي طرحه الرئيس الأمريكي هو تأسيس نظام عالمي لما يسمي بالأمن الجماعي. إنه نظام قائم علي تضافر القوي العالمية لردع الاعتداء، أيا كان مصدره أو هدفه. كانت هذه هي الفكرة التي تأسست عليها عصبة الأمم، ثم الأمم المتحدة فيما بعد. المعضلة أن هذا النظام يفترض أن الدول تعرف أمنها بالطريقة ذاتها، وأنها تكون مستعدة للتحرك بشكل جماعي في مواجهة أي حالة من حالات الاعتداء. تبين فيما بعد أن هذا الافتراض يجافي الواقع. الدول -في واقع الأمر- لا تري خرق السلم العالمي بالطريقة نفسها. من الصعب أن تتوافق القوي العالمية علي الحوادث التي تشكل خرقا خطيرا ينبغي ردعه، وتلك التي يمكن التجاوز عنها. ولهذا، فإن هذا النظام صار معطلا وعاجزا في مواجهة الأزمات الخطيرة التي هددت السلم الدولي بعد الحرب الأولي، مثل غزو إيطاليا للحبشة في عام 1931، أو غزو اليابان لمنشوريا في عام 1933، ثم التوسع الألماني فيما بعد.
برغم فشل النظام الذي بشر به ويلسون في حفظ الأمن العالمي، فإن الويلسونية ذاتها لم تمت. جري إحياؤها فيما بعد، سواء في الأمم المتحدة ومبادئها، أو في توجهات السياسة الأمريكية ذاتها. لقد اختارت الولايات المتحدة الانغماس في النظام العالمي الذي قامت بتأسيسه، والدفاع عنه في مواجهة قوة توسعية أخري -الاتحاد السوفيتي- مزجت بين الحماس الأيديولوجي، والنهم الجيوستراتيجي للتوسع المستمر. كان الحل الذي قدمته أمريكا هو الاحتواء، لا المواجهة المباشرة.
الاحتواء ينظر إلي العالم في شموله كرقعة كبري. الخسارة في مكان تؤثر في الموقف الاستراتيجي الشامل. علي هذا الأساس، وجدت أمريكا نفسها تخوض حروبا في هامش النظام: في كوريا، ثم فيتنام. يلاحظ كيسنجر أن الولايات المتحدة دخلت خمس حروب من أجل الحفاظ علي النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. انتهت هذه الحروب -باستثناء حرب تحرير الكويت- إلي نتائج غير حاسمة تراوحت بين التعادل (الحرب الكورية 1951)، والانسحاب (فيتنام، وأفغانستان، والعراق).
لا يري كيسنجر أن هذه الحروب كانت عبثية. يعدّها ضريبة مقبولة للحفاظ علي النظام الدولي نفسه. هو يقتبس من “لي كوان يو”، العقل السياسي الأشهر في آسيا، قوله إن جنوب شرق آسيا كانت لتسقط في قبضة الشيوعية لولا تدخل الولايات المتحدة في فيتنام. مع ذلك، يشير كيسنجر إلي أن هذه الحروب جميعا انحرفت عند نقطة معينة عن مسارها، وبالتالي صار مستحيلا إحراز النصر فيها. في أفغانستان والعراق، تحولت الحروب -التي يقول كيسنجر إنه أيدها علنا بحسبانها الخيار الصحيح- إلي مشروعات مستحيلة لإعادة بناء الدول. جوهر الاستحالة أن أفغانستان كانت تفتقر إلي أي تراث ديمقراطي، بل إلي معني الدولة ذاته، فتاريخها هو حالة مستمرة من الاحتراب القبلي. أما العراق، فلم تكن تربته المشبعة بالطائفية تصلح لأي غرس ديمقراطي، وجيرانه عمدوا إلي إفشال التجربة بكل سبيل. باختصار، كانت هذه المهام ضرورية، ولكنها اندفعت إلي آفاق مستحيلة.
كيسنجر مؤمن بالدور الأمريكي في العالم. هو يري أن الريادة تقتضي الانغماس والاشتباك، لا التراجع والتردد. وبالتالي، لا يقر سياسة أوباما الانسحابية. يراها عارية من أي استراتيجية، وتضعف القيادة الأمريكية. بطبيعية الحال، يتوجه نظر كيسنجر إلي المراكز التي تشكل -لأسباب مختلفة- تهديدا للقيادة الأمريكية، وتحديا لشرعية النظام العالمي الذي تقوده، ولذلك يفرد قسما كبيرا من كتابه لمناقشة المعضلة الصينية، والآسيوية بوجه عام.
القوي البازغة:
إن كانت أمريكا تظن أنها استثنائية، فالصين تري نفسها كذلك أيضا. هي الأخري عبرت في تجربة فريدة، حتي أقامت قوتها الاقتصادية الكبري في عالم اليوم. مفهوم الصين عن النظام العالمي مستمد من خبرتها التاريخية. هي كانت لقرون طويلة نظاما عالميا مستقلا بذاته. تعاملت مع الدول المحيطة بحسبانها برابرة، يتحدد مستوي حضارتهم بمدي قربهم أو ابتعادهم عن النموذج الصيني. قامت تجربتها علي الهيمنة الكاملة علي محيطها، بواقع قوتها الاقتصادية الهائلة، حتي في أوقات ضعفها العسكري. حتي منتصف القرن التاسع عشر، كانت وزارة الخارجية في الصين تسمي وزارة الشئون الحدودية. كانت مهمتها تنحصر في التعامل مع القبائل الرحالة المحيطة بها. إنها تجربة تختلف جوهريا عن خبرة الدول الأوروبية التي تنطلق من تعدد المراكز المتنافسة.
جوهر التجربة الصينية هو الهيراركية، لا التعددية. لذلك، كان طبيعيا أن ترفض طلب المبعوث الإنجليزي الأول، جورج ماكنتري، في نهاية القرن الثامن عشر، بتبادل السفارات والتجارة المفتوحة، ولا تقبل بالانتفاح إلا مكرهة، بعد هزيمتها بصورة حاسمة علي يد بريطانيا في منتصف القرن التالي. يلاحظ كيسنجر أن هذه الخبرة تناقض التجربة اليابانية التي أقرت بالخلل الفادح في توازن القوي مع الغرب، فوافقت علي فتح مدنها أمام التبادل التجاري الحر، بعد أن أصابها الذعر لمرأي مدافع الكومودور “ماثيو بيري” في.1853 اختارت اليابان تحت أسرة الميجي (1868) طريق التحديث الغربي السريع، فكانت أول دولة تنضم للنظام الدولي من خارج الغرب.
النظام الآسيوي حصيلة لهذه التجارب التاريخية المختلفة. هو يضم مراكز حضارية وثقافية متعددة لا يجمعها شيء سوي الخروج حديثا من أسر الاستعمار الغربي، والشعور بأن العصر الحالي يشهد نهضة الأمم الآسيوية، وعودتها لمكانتها الطبيعية في العالم، بعد فترة انقطاع في القرون الماضية، احتل خلالها الغرب -بصورة استثنائية- قمة النظام العالمي. المعضلة أن ثمة أكثر من دولة تشعر بأنها صاعدة، وأنها تستحق مكانا أفضل في النظام الدولي، وأن العالم عليه التعامل مع هذا الصعود. التنافس بين هذه القوي، في غياب دولة تقوم بدور الموازن (كما الحال في النظام الويستفالي)، قد يقود إلي الصراع في المستقبل.
مراحل صعود القوي هي الأخطر في أي نظام عالمي. التوتر بين قوة صاعدة وقوة قائمة يكاد يكون حتميا، ويقود في أغلب الأحيان إلي الصراع. تنزع القوة الصاعدة إلي الولوج إلي مناطق نفوذ القوة القائمة. هي تخشي من أن الأخيرة ستحاول إجهاض صعودها قبل فوات الأوان، فتتجه إلي الاستباق. يري البعض في أمريكا في الصعود الصيني تهديدا أمنيا حتميا لا يختلف كثيرا عن التهديد الذي شكله الاتحاد السوفيتي. بكين تنظر للسياسة الأمريكية التي ترفع لواء حقوق الإنسان بحسبانها مؤامرة لتقويض الاستقرار الداخلي للصين، وتتمسك في مواجهة ذلك بمبادئ ويستفاليا بخصوص السيادة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
ليس في تجربة الصين التاريخية ما يؤهلها للقيام بدورها الطبيعي في عالم اليوم (أن تكون قوة قائدة إلي جانب قوي أخري). ليس في التجربة الأمريكية -في المقابل- خبرة في التعامل مع طرف في مستواها، يكون لها ندا أو شريكا. التفاعل -صراعا أو تعاونا- بين هاتين الدولتين، المحملتين بتجارب وخبرات ورؤي جد مختلفة عن العالم، هو الذي سيحدد مستقبل النظام العالمي.
وإذا كان التوازن الآسيوي هو المعضلة الكبري أمام تشكيل نظام عالمي جديد، فإنه بالقطع ليس المعضلة الوحيدة. آسيا ليست المنطقة الوحيدة التي بزغت فيها تصورات ومنظومات تناقض التصور الويستفالي الغربي عن العالم. الشرق الأوسط المعاصر يعج بأيديولوجيات ومشاريع سياسية لإسقاط النظام الإقليمي والعالمي، انطلاقا من رؤي كونية وخلاصية. كالعادة، يعود كيسنجر للتاريخ ليري الحاضر في ظلاله الممتدة.
حرب الثلاثين عاما من جديد
يعيش الشرق الأوسط اليوم حالة شبيهة بالحروب الدينية التي خاضتها أوروبا قبل صلح ويستفاليا. جوهر المعضلة أن الحضارة الإسلامية تحمل نظرة مغايرة لنظام ويستفاليا. نقطة الانطلاق في التجربة التاريخية الإسلامية لم تكن الدولة، وإنما مفهوم “دار الإسلام ودار الحرب”، وفكرة الجهاد المقدس.
يعترف كيسنجر بأن تلك الأفكار لا يعتنقها بالضرورة غالبية المسلمين اليوم، ولكنها تظل ذات وزن وتأثير كبيرين في الواقع. تعود جذور النظرة الإسلامية إلي النظام الدولي إلي فترة انتشار الإسلام في القرن السابع، وهو حدث تاريخي فريد، ولا مثيل له في تاريخ العلاقات الدولية. لم تنظر الإمبراطورية الإسلامية إلي العالم غير المسلم نظرة ندية أو تكافؤ، بل كان في مرتبة أدني. تحددت العلاقة مع العالم الخارجي علي أساس فرض الجزية أو الحرب. المعاهدات كانت ذات طبيعة مؤقتة، وإلي حين تعديل موازين القوي. مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية (ركيزة ويستفاليا) لا معني له، لأن الولاءات الوطنية انحراف عن الدين، ولأن الحكم القائم في “دار الحرب” يظل -في نظر المسلمين- غير شرعي.
العالم الإسلامي أسس إذن نظاما دوليا قائما بذاته. الإمبراطورية العثمانية، التي ظلت لقرون أقوي من أي تحالف للدول الأوروبية، عززت من هذا النظام، ولم تكن تعامل الدول الأوروبية علي قدم المساوة في أية مرحلة. وعلي ذلك، فإن الدول العربية التي نشأت من رحم انهيار الإمبراطورية -بواقع سايكس – بيكو في 1916- كانت شيئا جديدا علي تاريخ المنطقة. كانت هذه الدول “ويستفالية” بالاسم فقط، ولكن ظل يعتمل داخلها الصراع بين الفكرة المرتبطة بالإسلام السياسي، والفكرة العلمانية.
يتتبع كيسنجر التصورات المستمدة من الإسلام السياسي عن النظام العالمي. يلاحظ أن نظرة حسن البنا وسيد قطب للنظام الدولي الويستفالي هي، في جوهرها، رافضة له، وراغبة في تقويضه. الفرق فقط في درجة الرفض ومرحلية العمل من أجل تغيير هذا النظام. يقول إن أفكار البنا عن أستاذية العالم، وأفكار قطب عن الجهاد، لا تعكس خيالا طوباويا، وإنما برامج عمل وجدت من يؤمن بها، ويعمل بحماس من أجل تطبيقها.
المشروع السلطوي الذي تأسس، بصور مختلفة، في الشرق الأوسط فشل في تحقيق التنمية الاقتصادية. سقط هذا المشروع أخيرا أمام موجة عارمة من السخط الشعبي. يري كيسنجر في الربيع العربي ظاهرة كشفت تناقضات العالم العربي، دون أن تقدم حلا ناجعا لها. يعود لأفكاره التقليدية عن فكرة الثورة ومخاطرها. يتوقف أمام الهتاف الأشهر في ثورات الربيع: “الشعب يريد إسقاط النظام”. يتساءل مجددا: ما هو الشعب؟، وما هو النظام الذي يراد وضعه محل النظام القديم؟. يفتح الباب أمام معضلات كبري أمام السياسة الأمريكية: هل ينبغي أن تساند الولايات المتحدة أي وكل انتفاضة شعبية، حتي تلك التي تقع في دول تعد مهمة لاستقرار النظام العالمي؟، هل أي مظاهرات تعد ديمقراطية بالضرورة؟، هل السعودية تظل حليفا للولايات المتحدة فقط إلي أن تندلع فيها مظاهرات؟. إنها أسئلة كبيرة تحمل في طياتها اتهاما بفشل السياسة الأمريكية في التعاطي مع ظاهرة الربيع العربي.
إن النظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية الأولي في الشرق الأوسط يتداعي. أخطر الظواهر التي تشهدها هذه المنطقة هي انهيار الدولة ذاتها. ثمة مناطق لم تعد فيها سلطة مركزية مقبولة كحكم شرعي من جانب أغلبية معتبرة من السكان. بديل غياب السلطة هو صراعات القبائل والطوائف، وحروب الجميع ضد الجميع. هناك رقع جغرافية تقطنها أعداد كبيرة من السكان خرجت فعليا من النظام الدولي. هذه المساحات التي لا تسيطر عليها دول تصير حتما مرتعا للإرهاب، وساحات لصراعات القوي المحيطة. الديمقراطية، التي تدعو أمريكا الدول العربية إلي تبنيها، لا تقدم علاجا ناجعا، ما دامت هناك فصائل داخل الدول تعتقد أنها في حالة صراع وجودي من أجل البقاء.
ثمة دول، في معمعة هذا الصراع الضاري، سوف تفكر كثيرا قبل الاستماع للنصائح الأمريكية، وستسعي لتوسيع هامش حركتها بالاعتماد علي قوي عالمية أخري، بعد أن خبرت تخلي الإدارة الأمريكية عن النظم القائمة، عقب اندلاع ثورات الربيع. يري كيسنجر أن مصر قد تتحرك في هذا الطريق، وكذلك السعودية التي تخوض صراع وجود حقيقيا في مواجهة الطموحات الإمبراطورية الإيرانية التي تتسربل برداء الثورة الشيعية المقدسة. إن إيران تشكل تهديدا جديا للنظام الويستفالي، إذ إنها لا تزال تنظر لنفسها بحسبانها “قضية وهدفا”، وليس دولة تتعايش جنبا إلي جنب مع دول أخري ذات سيادة واستقلال. إن إيران الخمينية لا تعترف بالدولة ككيان شرعي، وإنما كسلاح يمكن اللجوء إليه، وقت الحاجة، من أجل شن الحرب الدينية المقدسة.
خلاصة:
هل هذا كتاب في التاريخ؟ ليس بالضبط. هل هو كتاب في الدبلوماسية العالمية؟ ليس تماما. هل هو سِفر في الفلسفة السياسية؟ ربما. الحقيقة أن كتاب كيسنجر هو كل هذه الأمور مجتمعة. هو قراءة فلسفية للتاريخ، انطلاقا من فهم للممارسة الدبلوماسية. المؤلف يقر في النهاية بأنه كان في صباه يظن في نفسه القدرة علي إدراك كنه التاريخ، ومغزي حركته، ولكنه عرف اليوم (92 عاما) أن التاريخ يمكن استكشافه بصورة مستمرة، لا العثور علي غايته النهائية.
ما يميز كيسنجر عن أغلب معاصريه، من الأكاديميين والممارسين علي حد سواء، أنه يؤسس طرحه علي فلسفة عميقة، ورؤية للطبيعة البشرية ذاتها. هو ينحاز بوضوح إلي تلك النظرة المحافظة للطبيعة الإنسانية بحسبانها تنافسية وصراعية. يري أن الفكرة الأوروبية بوضع ضوابط علي هذا التنافس، من خلال توازن القوي، هي قمة الممارسة الدبلوماسية، بل هي عين حرفة السياسة الخارجية ذاتها. الوضع المثالي، من وجهة نظره، هو أن يترك لرجال الدولة من ذوي الحكمة والبصيرة المجال لوضع قواعد النظام وصيانته وحمايته. الرأي العام والديمقراطية يضعان قيودا تضر في أحيان كثيرة بعمل هؤلاء الرجال. المجتمع الديمقراطي ليس لديه ما يكفي من الرؤية والعزيمة لإدراك كنه التفاعلات العالمية، وتحديد المسار. الجمهور لا يفهم معني التضحية الآنية من أجل انتصارات علي المدي الطويل. لا يفصح كيسنجر عن هذا بوضوح، ولكن تأويل كتابه والفلسفة التي ينطوي عليها قد يوصل لهذا الفهم المحافظ للتاريخ والسياسة العالمية.
كتاب “النظام العالمي” هو إنجيل السياسة الواقعية. إنها السياسة التي تنطلق مما هو قائم، وتتحرك في هامش محدد في إطاره، لا تتجاوزه أو تتخطاه. لا تتبني أفكارا كبري، أو تعتنق قيما إنسانية عليا. تتعامل مع الواقع بحسبانه معطي متغيرا. لا دليل هاديا لها سوي العبارة الساحرة لبارمستون: “بريطانيا ليس لها أصدقاء دائمون، أو أعداء دائمون، وإنما مصالح دائمة”. تظل أضعف حلقات هذه الرؤية هي الميل اللاشعوري إلي النظر للحاضر بحسبانه مجرد امتداد للماضي علي استقامته. الانغماس الكلي في الواقع كما هو يحول دون استكشاف اتجاهات المستقبل. يصنع وعيا مستغرقا في أفكار وتصورات مستمدة من التاريخ، ربما يكون تأثيرها في الحاضر محدودا.
يدرك الدبلوماسي العجوز هذا المعني. يقر بأنه لا يستطيع تخيل شكل النظام العالمي، في ظل امتلاك مليار شخص لجهاز لهواتف ذكية توفر من المعلومات والقدرات التحليلية ما يفوق قدرة أجهزة استخباراتية لدول قبل جيل واحد فقط، بل في ظل قدرة فرد واحد -خارج سلطة أي دولة- علي التسبب في كوارث كبري باستخدام كمبيوتر نقال (الإرهاب السايبري).
رؤية كيسنجر وفلسفته تفيد ولا شك في إدراك كنه المسار الذي أوصلنا إلي اللحظة الحالية من عمر النظام العالمي. المستقبل وحده سيكشف إلي أي مدي تصلح هذه الرؤية كبوصلة هادية في لحظة قادمة. إنها لحظة غامضة وملتبسة يفتقر خلالها العالم إلي القيمة الأهم علي الإطلاق في نظر كيسنجر: النظام.
* باحث متخصص في قضايا السياسة الخارجية
مجلة السياسة الدولية ( تصدر عن مؤسسة الأهرام المصرية).




