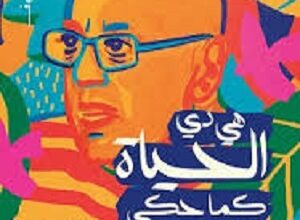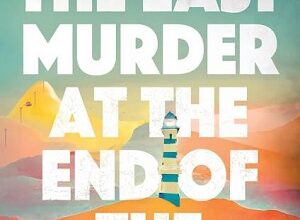من قرأ «طفولتي حتى الآن» وعرَف من كاتبها إبراهيم نصر الله أنّ حكاية جدّه ستُروى في روايته القصيرة القادمة «شمس اليوم الثامن» (الدار العربية للعلوم ناشرون 2023)، ذلك الجدّ الذي مرّت قصّة حبّه مروراً سريعاً في خدمة حكاية «إبراهيم» الصغير، الذي لم يتحدّث خلال النصّ سوى في الشعر الشعبيّ الفلسطيني، سيبدأ بقراءة الرواية ظنّاً منه بأنها ستبدأ مع قصة الحبّ ذلك الشاعر المتيّم. ولأنّ الغلاف تضمّن عبارة «يُسمَح للكبار بقراءتها»، يأتي الإيهام بأن قصّة حبّ الجدّ ستكون فكرة الكتاب، وأنّ إباحيةً ما ستُحكى في تلك الحكاية. ولكن، لا… لن نقرأ قصة حبّ ذلك الجدّ، بل حكايته قبل أن يُولَد!
عنوان النصّ يثير تساؤلات كثيرة حول الغاية منه: هل هي رمزية يردّها الروائي، وهو الشاعر المعروف، إلى الموروث الديني في العهدين القديم والجديد، حيث اليوم ورقمه، والله الذي استراح في اليوم السابع بعد خلق الكون؟ أو المسيح الذي قام في اليوم الثالث بعد الصلب والفداء؟ تكون قصة الجدّ، المندرجة تحت مشروع «الملهاة الفلسطينية»، فيها ردّ من نوع ما على ذلك الموروث؟ تبدأ بالقراءة، فتلاحظ أنّ أمراً جديداً، رمزيّاً عجائبيّاً، حكَمَ الرواية. لكن يبقى اليوم الثامن وشمسه بعيدان من الفهم.
نجد في الرواية ما يمكن تسميته تناصّاً بين هذه الرواية وروايتَي رشيد الضعيف الأخيرتين، فكأنما هذه الروايات تلجأ إلى أساليب الأساطير والخرافات لتوصل حكايةً ما، تحمل فكرة ما، وقضية ما… وهنا لن نخوض في المقارنة، لكن سنبقى مع نصرالله، الذي لجأ إلى القصة الشعبية، في قالب روائي، ليُهدي نصّه إلى أمه تكريماً لها بعد موتها. حكاية الجدّ تبدأ قبل أن يولَد، فنجده يملك جَمَلاً «ليس ككل الجِمال». تنبت نخلةٌ في خُرجه، فتطول وتطول، من ثم تُرمى ببعض التراب طمعاً ببلحها، فتنشأ قطعة أرضٍ فوق سعفاتها، وتمتدّ حتى تصبح أرضاً كبيرة بتربة خصبة، يزرعها ذلك الفتى، عليّ، كل عام نوعاً مختلفاً. ولأنه لم يُولَد بعد، يقرّر خوض رحلةِ البحث عن أبيه وأمه، ساكناً في خيمة في أرضه العالية، تزوره العصافير وتحدّثه كل يوم.
هي حكاية شعبية، خرافية، عجائبيّة، عن جملٍ يحمل نخلةً تحمل أرضاً، اسمها الأرض «العالية». لكن في النهاية يستقرّ الفتى الذي لم يولَد بعد في قرية «الهادية»، حيث يجد جدّته بدايةً فيحبّها ويتمنّاها جدّةً، ثمّ يكتشف ابنها «خليل» الذي تمنّاه أباً، إلى أن يلتقي بالأم في النهاية فينفّذ خليل طلبها، بأن يهديها ويهدي بيتها «النور» ليحظى بها في منافسة قروية، وينتهي النصّ بولادة الطفل أخيراً، وبلقائه بعد أسبوعه الأول بطائر الشمس الفلسطيني الذي حزن لأنه لم يكن بانتظاره يوم وُلِد، مع بزوغ شمس اليوم الثامن… هل تحكي الرواية قصة نُطفةٍ تُعايش مراحل الرجولة لوالدها، وهو الذي استطاع رفع حصانٍ؟ أمر جائز. وهل هي قصّة «فكرة» هي فكرة المولود قبل أن يولَد، وكيف يكون قبل الحمل وفي أثنائه، فكرةً لدى الأهل تحمل معها من الآمال والأحلام الكثير؟ أمر جائزٌ أيضاً.
أم هي قصّة «وطن» لم يولَد بعد ولكنه كان جميلاً مع ما يملك، من جَمَلٍ ونخلةٍ وأرض وطيور، ومحبّةٍ ممن حوله، ولا بدّ من أن يولَد إن هو استطاع أن يختار أمه وأباه، وستشرق شمسه في أيامه كلها، لكن وصول «طائر الشمس الفلسطيني» في اليوم الثامن لهو اليوم الذي ستبدأ رحلة هذا الوطن المولود حديثاً، وتكون لكل من أبنائه قصّته الخاصة كما يقول عليّ المولود الجديد قبل نهاية النصّ: «سأحكي لهما قصّتي من أولها… لن أقول إلى آخرها، لأنّ قصتي لا نهاية لها… فكلّ ما قلته هو ما عشته حتى اليوم… حتى شمس اليوم الثامن». يكون هذا المولود هو كلّ مولود فلسطيني يجب أن تكون له قصة يحكيها، بوصفه «فلسطينيّاً» وصديقه/شعاره هو طائر الشمس. هذا أيضاً، هو احتمال جائزٌ! يقول الكاتب إنه يروي القصة التي سمعها من أمه عن جدّه، التي تفخر بأنها من موروثها وذكرياتها حول والدها. لكنه اختار لها أن تكون روايةً، بعدما كانت موضوعاً لواحدة من قصائد ديوان «بسم الأم والابن» (1999).
لذا وجب على الدارس أن يقرأ النص بوصفه رواية بمعزل عن القصة والجدّ والأسطورة والخرافة، فهل حقّق نصرالله هدفه السردي منها؟ وهل هي مناسبة لتنضم إلى مجموعته «الملهاة الفلسطينية»؟ فتكون الإجابة سهلة وواضحة. إنها رواية بكل ما يحمله التصنيف من خصائص، لغةً وحبكةً وسرديةً ورمزاً وقضايا، بشخصيات رئيسة وثانوية وداعمة، أما المناوئة فلم تكن حاضرة، فالشخصية لم تولَد بعد.
أما العنصر الأبرز، وهو «فلسطينيّة» هذا النصّ بشخصياته وقضاياه، فلم يكن على الكاتب أن يبذل جهداً كبيراً، وإن لم تكن قضية فلسطين التي اعتدنا قراءتها تاريخاً وجغرافيا ومقاومة وهزائم وانتصارات، فهي قضية أبنائها الذين يحلمون ويفرحون ويحزنون ويتخيّلون ويزرعون ويحصدون… أبناؤها الذين لا بدّ من أن تكون اختياراتهم بأيديهم كما اختار عليّ خليلاً أباً والفتاة -الملكة- أمّاً، وأن تكون البلاد لهم وأن يرفعوها نحو السماء لحمايتها إن تطلّب الأمر ذلك، كما رُفِعت أرض الطفل الذي لم يولَد بعد على نخلةٍ يحملها جمل.
إنها رواية من النوع الممتع، بسيطة وتُقرَأ في جلسة أو اثنتين، تقسيم فصولها القصيرة جدّاً جاء داعماً لهذه السلاسة والعذوبة في السرد. ولأنّ الموضوع شبيه بقصص الأطفال الخرافية، حول طفل لم يولَد بعد، يجد القارئ نفسه أثناء القراءة أمام سؤال: «هل هي قصة لنا أم لنقرأها لأطفالنا؟». هي بالفعل تقرؤها أمّ لأطفالها، لتتبيّن المقصد الحقيقيّ وراء كتابة هذه الرواية، ووراء العبارة على الغلاف «يُسمَح للكبار بقراءتها». كأنّ العبارة تنقصها كلمة «أيضاً»، فهي قصة للأطفال، ولكن للأطفال الذين في دواخلنا نحن الكبار، حتى نتذكّر العودة إليهم بين وقت وآخر، فلا ضَير مع همومنا، الشخصية والوطنية، أن نعود أطفالاً نلهو ونحلم ونتوهّم، فالوهم ملاذٌ آمن لعودة الدّهشة!