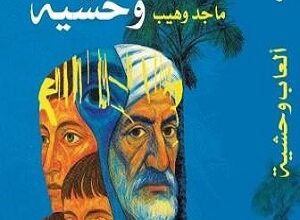الحتمية والخلود موقفان مضادان للتاريخ…انتشرت اليوم ثقافة الإيمان بالحتمية والنظرات الانتكاسية إلى الماضي ورفض الحاضر والخلل في رؤية المستقبل، ومن هنا يحلل الباحث تيموثي سنايدر أسباب هذه التوجهات الفردية والجماعية ونتائجها الوخيمة على الشعوب، مقدما نصائح هامة لتجاوزها.
يفتتح أستاذ علم التاريخ بجامعة ييل، التي تعد واحدة من كبرى الجامعات الأميركية، تيموثي سنايدر كتابه “حول الطغيان.. عشرون درسا من القرن العشرين”، قائلا “التاريخ لا يعيد نفسه، ولكنه يعلم ويثقف”.
انطلاقا من تلك الفكرة يقدم المفكر عشرين درسا لصور تاريخية من القرن العشرين ملائمة للظروف والملابسات التي نحياها في أيامنا هذه. ليقدم من خلالها مجموعة من الوصايا تسعى إلى رفع الوعي السياسي بطرائق الاستبداد في تثبيت أركانه. وكيف يسعى للتمدد أكثر وأكثر، لندرك أن كل درك نعيشه في سواد ظله بالإمكان أن يعقبه درك أشد، وأن كل سوء نعاني منه قد يعقبه ما هو أسوأ.
عدد من النصائح
في مقدمته للكتاب، الصادر عن دار جسور، يلفت المترجم عبدالسلام المحمدي إلى أن ما يحمله من نصائح وإرشادات لعرقلة مسار الاستبداد أن يحل ويجيء، يمكن استثماره في إعاقة تمدده أيضا. كما يمكن استثمار عدد من النصائح في التحضير للحظة مفصلية مستقبلية تقلب الأوضاع رأسا على عقب.
تحدث سنايدر عن أحوال أشخاص عاشوا تحت أنظمة قمعية فعلا. وكيف تباينت أحوالهم بين أدوات وظفت واستعملت لتثبيت تلك النظم القمعية. وأخرى تسامت عن ذلك الواقع السيء وتمكنت من التأثير إيجابيا في المشهد. وهي لقطات مهمة جدا، وفقا لمحمدي، لكل من يعيش في سياقات شبيهة بسياقاتهم.
ولئن وثق التاريخ تلك اللقطات والمشاهد الإيجابية والسلبية معا، كما وثق فظائع تلك الأنظمة القمعية أيضاً. فأمامنا تاريخ لا يزال مفتوحا لم يتم توثيقه بعد. كما أن الكتاب يعالج بعض مظاهر الابتذال السياسي المعاصر ويحللها. وهو ابتذال تتردد أصداؤه بوضوح في محيطنا العربي، كإعادة ترتيب صورة الواقع أو التاريخ بحسب الأهواء الشخصية، تحت لافتة “الحقائق البديلة”. فليس هناك حقيقة موضوعية واحدة يتوارد عليها الناس، بل كل يصدر عن رأيه ومزاجه. فهناك الحقيقة وهناك الحقيقة البديلة. وهي فكرة أخذت تتمدد وتتسع بشكل ملحوظ وعلى نحو فج في فضائنا السياسي المعاصر.
يقول سنايدر إن تاريخ القرن العشرين لأوروبا يكشف لنا أن المجتمعات ليست آمنة من التفكك. كما وأن الديمقراطيات يمكن لها أن تسقط. وأن الأخلاق قد تنهار وتتهاوى أيضا. كما وأن رجالاً عاديين قد يجدون أنفسهم واقفين على شفير خنادق الموت والرشاشات في أيديهم. إنه لمن المفيد لنا اليوم أن نفهم كيف أن الطغيان يمثل استجابة للعولمة: لمظاهر انعدام المساواة الحقيقية والمحسوسة التي خلقتها. وعجز الديمقراطيات الظاهرة عن معالجتها.
الفاشيين
وينبه إلى أن الفاشيين رفضوا المنطق والعقل باسم الإرادة، متنكرين للحقائق الموضوعية لصالح أسطورة مجد صاغها زعماء ادعوا أنهم المعبرون عن صوت الشعب. وقد قاموا بتصوير تحديات العولمة المعقدة بأنها تمثل مؤامرة ضد الدولة. لقد حكم الفاشيون لعقد أو عقدين، مخلفين وراءهم إرثا فكريا يزداد مع كل يوم صلة بواقعنا.
الشيوعيون
أما الشيوعيون فقد حكموا لوقت أطول، قريبا من سبعة عقود في الاتحاد السوفييتي وأكثر من أربعة عقود في أوروبا الشرقية، وقدموا نموذج حكم قائما على حزب منضبط من النخبة المحتكرة لحق تحديد ما يمكن أن يدفع المجتمع نحو مستقبل معين، وفق مجموعة ثابتة من القوانين المدعاة للتاريخ. وعلينا أن نحذر، فقد يتم إغواؤنا بفكرة أن إرثنا الديمقراطي محصن ذاتيا وتلقائيا من مثل هذه التهديدات.
من الدروس التي يقدمها سنايدر التي حلل فيها صورا تاريخية تؤكد عليها وتكشفها “لا تعط الطاعة مقدما”، يقول “أغلب القوة التي تحظى بها النظم الشمولية يتم إعطاؤها لها مجانا. في أوقات كهذه فإن الأفراد يفكرون سلفا في ما تطمع فيه الحكومات القمعية. ثم يقومون بتحقيق تلك المطامع دون أن يطالبوا بذلك. والمواطن الذي يتبنى هذا الدور ينبه السلطة لحقيقة قدراتها وما يمكنها القيام به”.
أخلاقيات المهنة
من الدروس أيضا “تذكر أخلاقيات المهنة” . وفيها يلفت إلى أنه “حين تمثل القيادات السياسية نماذج سلبية فإن الالتزام بالقيم المهنية يكون أكثر أهمية. إنه لمن الصعب تقويض دولة القانون دون محامين، أو إقامة محاكمات صورية دون قضاة. فالمستبدون بحاجة إلى موظفين مدنيين راضخين لهم، كما أن المسؤولين عن معسكرات السخرة يفتشون عن رجال أعمال يطمعون في عمالة رخيصة”.
ولذا يرى أن أخلاقيات المهنة يجب أن تكون هادية لنا. خصوصا في الأوقات التي يقال لنا فيها إن الأوضاع استثنائية. إنه لا مشروعية مطلقا لعبارة من جنس “اتبع الأوامر فقط”. ومتى ما خلط أصحاب المهن بين محدداتهم الأخلاقية وعواطفهم اللحظية فسيجدون أنفسهم يقولون أشياء ويفعلون أمورا كانوا يظنون أنه من المستحيل أن تصدر عنهم.
أيضا درس “كن على حذر من القوى شبه العسكرية”، موضحا “حين نرى رجالا مسلحين ممن كانوا يصرحون دوما بأنهم ضد النظام يبدؤون بارتداء زي موحد، ويمشون في مسيرات يحملون المشاعل في أيديهم ويرفعون لافتات تحمل صور قائد ما، فاعلم أن النهاية قد اقتربت، وحين تمتزج قيادات تلك القوى شبه العسكرية مع قوات الشرطة والجيش فاعلم أن النهاية قد حلت. إن معظم الحكومات في غالب الأوقات تسعى إلى احتكار العنف، فإذا كانت الحكومات وحدها من يحق لها استخدام القوة، وهو استخدام محكوم بالقانون، فإن مظاهر السياسة التي نأخذها مسلمة تصبح ممكنة”.
تقويض الديمقراطية وحكم القانون
ويضيف “إنه لم المستحيل أن نقوم بانتخابات ديمقراطية أو ننظر في القضايا في المحاكم أو نضع القوانين، أو ندير أيا من وظائف الحكومة في الوقت الذي تكون فيه أجهزة خارج نطاق الدولة قادرة على ممارسة العنف، ولهذا السبب تحديدا، فإن الأشخاص والأحزاب الذين يرغبون في تقويض الديمقراطية وحكم القانون ينشئون ويمولون منظمات عدوانية تقوم بإقحام نفسها في مجال السياسة. يمكن لهذه المجموعات أن تأخذ شكل جناح شبه عسكري لحزب سياسي ما، أو حراسة شخصية لسياسي معين، أو مبادرات عشوائية لمجموعة من المواطنين تم الترتيب لها في الحقيقة من خلال حزب معين أو قائد من قواده. وهذه المجموعات المسلحة تبدأ بحلحلة نظام سياسي ما، ثم تقوم بتحويله بالكامل”.
قبول فكرة الحتمية
ويؤكد سنايدر أن قبول فكرة الحتمية أسهم في جعل منطقنا السياسي في القرن الحادي والعشرين متكلفا ومتقعرا. لقد خنق جدالاتنا، وتسبب في توليد أنظمة حزبية تدافع بكلياتها عن الأوضاع القائمة، بينما يقف الآخرون على موقف الضد تماما. لقد تعلمنا أن نقول إنه لا يوجد أي بديل للأوضاع القائمة، وهي حساسية أسماها المنظر السياسي الليتواني ليونيداس دونسكيس “الشر السائل”. فمتى ما قبلت الحتمية كأمر مسلم، فسيكون النقد بالتأكيد أمرا صعبا وخطيرا.
ويضيف “ما يتمظهر في الواقع باعتباره تحليلا دقيقا له فإنه في الغالب يفترض بأن الوضع الراهن غير قابل للتغيير، وبالتالي فهو يعززه بطريقة غير مباشرة، فالبعض تحدث بنقد عن النيوليبرالية، وأن فكرة السوق الحرة قامت بطريقة ما بدفع الآخرين إلى الخارج. وهذا قد يكون صحيحا فعلا، لكن الاستعمال الفعلي لهذه الكلمة عادة ما يكون في سياق تملق لهيمنة واقع ثابت ومستقر”.
ويتابع “بعض النقاد تكلموا عن الحاجة إلى شيء من الاضطراب، مستعيرين مصطلحا من مجال تحليل المبتكرات التقنية. ولكنهم حين يوظفون هذا المصطلح في المجال السياسي فإن سياق التوظيف يكشف مرة أخرى عن إيحاءات بعدم قابلية الواقع للتغيير، وأن حالة الفوضى التي تحفزنا يتم استيعابها وابتلاعها من خلال أنظمة ضبط ذاتية. إن الشخص الذي يركض عاريا في ملعب كرة القدم يسبب قدرا من الاضطراب حتما، لكنه لا يغير من قواعد اللعبة شيئا”.
الحتمية والخلود
يرى سنايدر أن كامل نظرية الاضطراب هي مجرد مراهقة فكرية، إذ هي تفترض أنه، وبعد أن يفرغ المراهقون من خلق فوضى، سيأتي الكبار لتنظيف المكان، ولكن الواقع أنه لا وجود لأولئك الكبار. نحن فقط نتحمل مسؤولية هذه الفوضى. إن الطريقة الأخرى المنافرة للتاريخ في النظر إلى الماضي هي نظرية الخلود السياسي تقوم بتزييف التاريخ ولكن على نحو مختلف. إنها مهمومة بالماضي – ولكن بطريقة خاصة – ينكفئ فيها المرء على ذاته، خلوا من أي اهتمام جاد بالحقائق، ويكون في تلهف دائم للحظات تاريخية ماضية لم تقع فعليا، في عهود كانت في الحقيقة كارثية.
ويؤكد أن المتبنين لهذا المزاج السياسي يستجلبون صورة ضبابية للماضي، كفناء واسع تقبع فيه نصب تذكارية تصعب قراءتها لضحايا قومية، جميعهم بعيدون عن الحاضر على نحو متساو أيضا. وكل إشارة إلى الماضي تتضمن الكشف عن هجوم لعدو خارجي يستهدف نقاء الأمة.
إن جميع القوميين الشعبويين هم سياسيون يتبنون أنموذج الخلود السياسي. ونقطتهم المرجعية المفضلة هي ذلك العصر الذي مسحت فيه الجمهوريات الديمقراطية. وكان منافسوها من النازيين والسوفيات في صعود لا يقهر في ثلاثينات القرن العشرين. ولو فتشت في مخيال أولئك الذين روجوا لبريكست (خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي) لوجدتهم يتخيلون دولة قومية بريطانية. مع أنها في الواقع لم تولد أبدا. نعم لقد كانت هناك إمبراطورية بريطانية. وبعدها وجدت بريطانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي؛ لكن خطوة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في حقيقتها ليست خطوة إلى الوراء تستقر فيها القدم على أرضية راسخة صلبة. وإنما في الحقيقة قفزة في المجهول.
ويشدد سنايدر على أن نظرية الخلود السياسي تغوينا بماض أسطوري يمنعنا من التفكير في مستقبل ممكن.
الحتمية والخلود هما موقفان مضادان للتاريخ. والشيء الوحيد الذي يقف بينهما هو التاريخ نفسه
ويقول “إن الاعتياد على ممارسة دور الضحية يضعف تحفزنا لتصحيح ذواتنا. وذلك أن الأمة يتم تعريفها من خلال فضائلها الموروثة عوضا عن مستقبلها المحتمل. وتتحول السياسة إلى جدل بين الخير والشر. بدلا من الجدل حول حلول ممكنة لمشكلات حقيقية. ولأن الأزمة دائمة، فإن الشعور بأن الحالة طارئة حاضرة على الدوام. مما يجعل التخطيط للمستقبل يبدو مستحيلا. بل قد يعد لونا من الخيانة. فكيف لنا أن نفكر في الإصلاح والأعداء مرابطون دوما على أبوابنا. وإذا كانت الحتمية السياسية شيئا شبيها بالغيبوبة. فإن فكرة الخلود السياسي تشابه التنويم المغناطيسي. حين نحدق في دوامة تلتف من الأساطير الدورية. ونستمر في ذلك حتى نقع في غفوة ثم نغيب عن الوعي، لنقوم بعدها بشيء صادم. بناء على أوامر شخص ما”.
ويشير إلى أن الخطر الذي يواجهنا الآن هو:
الانتقال من فكرة الحتمية السياسية والوقوع في شرك الخلود السياسي، ومن جمهورية ديمقراطية ساذجة ومعيبة نوعا ما إلى حكم نخبة فاشية ومستهترة ومشوشة، فإننا نتهافت للبحث عن طريقة أخرى يمكننا من خلالها تنظيم ما نمر به. والطريق الذي لا يكلفنا الكثير من المقاومة هو ذات الطريق الذي يوصل مباشرة من الحتمية إلى الخلود.
إن آمنت مرة بأن كل شيء سيؤول في النهاية إلى خير، فمن السهل إقناعك بأن لا شيء ينتهي إلى خير. وإن لم تتحرك مرة لفعل شيء لظنك بأن التقدم مسألة حتمية، فبإمكانك أن تستمر في فعل لا شيء بذريعة أن الزمن يتحرك في دورات متكررة.
إن الموقفين: الحتمية والخلود، هما موقفان مضادان للتاريخ. والشيء الوحيد الذي يقف بينهما هو التاريخ نفسه، فالتاريخ يسمح لنا بملاحظة الأنماط وإصدار الأحكام، إنه يرسم لنا مخططا للهياكل الداخلية والتي تمكننا من تلمس الحرية، إنه يكشف اللحظات التي تختلف كل واحدة منها عن الأخرى دون أن تتميز إحداها بفرادة كاملة. ولفهم لحظة معينة فإنه يتعين علينا ملاحظة إمكانية أن يكون المرء مشاركا في صناعة لحظة أخرى.