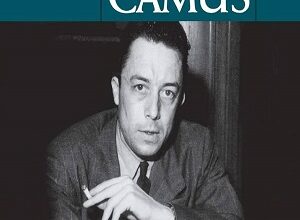يقول الرواي العليم في تقديم نفسه على الصفحة الأولى من رواية «مصائد الرياح» (الدار العربية للعلوم ناشرون ــــ 2024) لإبراهيم نصرالله: «أنا الذي يعرف.
وعادة ما يلتجئ الكتّاب إليّ لمعرفة ما لا يمكن أن يعرفوه بقدراتهم ومعارفهم؛ فلا أحد منهم يستطيع أن يدرك ما يدور في عقل أيّ شخصية، بل يحكم على ذلك إن صدر عنها تصرّف ما، أو حركة ما […] أنا الذي يعرف… بمعنى، أنّ كلّ داخلٍ لي، كما كلّ خارجٍ لي، أما هو فليس له غير مظاهر الخارج». ولأنّ «بعض الأحلام لا يجوز أن تذهب هباءً» كما يقول نصرالله نفسه، كانت هذه الرواية.
تبدأ الأحداث مع عمل إرهابي في إحدى المدن العربية. حدث نبدأ معه باكتشاف الشخصية التي كانت تشارك في مؤتمر للغة العربية هناك. لكن الأبرز كان ظهور شخصية «أحلام»، مع ظهور الساطور والسيف بيد الإرهابي، هي التي رأت ما حدث. ومن هناك، يبدأ الراوي العليم بسرد ما يعلم. الراوي العليم الذي أعطى أحلام اسمها، وإميلي التي تشبهها، فيما بعد، نعرف لاحقاً قصته حيث تدرّج من مطعم شاورما في مانشستر وبعدها إلى مطعم البيتزا حيث أصبح اسمه جيوفاني ليحمي نفسه، هو الذي سمّاه أصحابه «الكاتب»، ليصبح أستاذاً في الجامعة هناك.
لا يخبرنا الراوي العليم صراحةً بهوية أحلام، فلسطينية أم لا، ويستمرّ الأمر، عبر كلام مباشر في مواضيع كثيرة بين الراوي والشخصية/ الكاتب، وبين الشخصية/ الكاتب وأحلام. وبين هذا كله، تدخل قصة الكاتب/ الشخصية في الرواية، مع إميلي، صاحبة الصرخة، تلك الصرخة التي كانت احتجاجاً منذ بداية النص، على تلاعب الكاتب/ الشخصية بقصة جدّها. ومن يبحث عن أسباب اختيار نصرالله أن تكون روايته ضمن سلسلة «الملهاة الفلسطينية»، يكاد لا يقتنع في البداية، لكن تمرّ قصة الجدّ، التي توهمنا الرواية بأنّها مقطع من رواية للشخصية/ الكاتب، وتكون قصة فلسطينية لكنها مرتبطة بالخيل، وتحيلنا بكلمات بسيطة إلى رواية نصرالله الشهيرة «زمن الخيول البيضاء». ولكن يبقى الأمر ـــ مع سيطرة الراوي العليم، والتقنية الجديدة التي قدّمها النص ـــ غير مقنع، إلى أن يظهر الحصان «حسّ»، وتعلّق «أحلام» به، ذلك الحصان الذي يحمل من العمق والرمزية الكثير، ومن هنا يدرك المتلقّي سبب تصنيف العمل من ضمن مشروع «الملهاة».
الغوص في الأعماق الإنسانية سيطر على لغة النصّ ووجهته، كيف لا والراوي العليم مسيطر، طالت كلماته أحياناً حتى كادت الجِدّة تفقد سيطرتها. لكن نصرالله بحرفيته كان يحيلنا إلى قصة الشخصية/ الكاتب وإميلي، فيكسر الرتابة التي كادت تسيطر عندما يعتاد القارئ على صوت الراوي. ومع ظهور الخيل، وتعلّق أحلام بـحصانها «حسّ»، تأخذ الرواية منعطفاً جديداً، فيكاد القارئ ينسى وجود الراوي العليم. ولأنّ أحلام تبقى غير محدّدة الملامح، بوصفها شخصية حقيقية أم أحلاماً بالفعل، تبدأ المتعة بملاحقة قصتها وعلاقاتها وخيلها وما سيصيبه بعد بيعه، في مستوى أعلى وأعمق.
ليست الأحداث هي الأساس في هذا النص، بل العمق والتفكيك المرتبط بالأفكار والمشاعر، وبعلاقة الإنسان بقضاياه وطريقة تعامله معها. ولأنّ فلسطين الحاضر الدائم، تصبح أساساً بعدما نعرف الشخصيات، الكاتب مع أحلام، والكاتب مع إميلي، ومن قبلها ليديا التي رحلت. نبدأ بملاحقة فلسطين بين السطور، ليأتي الحصان «حسّ» وكل ما يرتبط به من رموز الحرية والانتماء والحبّ والقوة وحقّ العودة إلى مزرعته، التي يعود إليها في النهاية، لتصبح هي النصّ.
قبيل نهاية الرواية، تتكشف كلّ معالمها، وعوالمها، فالقمر البدر هو الكاشف لكلّ وهم وكل حقيقة. ظهوره يعطي الوهم معنى، فنرى الخيول ونسمع صهيلها. ومع اختفائه، يتّضح الفراغ والصمت. ولأنّ القمر بضوئه قد يرمز إلى تاريخنا المرتبط بـ«عروبة» ما وهمية في صحراء ما، يكون اختفاؤه ضرورة لظهور الحقيقة. وهو ما تركّز عليه نهاية الرواية، وما اختراق أحلام للبطل سوى تأكيد على أنها «أحلام»، و«حسّ» هو بلادها وملجؤها الآمن، فلا مجال للحل إلا بلقائهما. لكن يجب على اللقاء داخل الوهم أن يختفي، حتى يستطيع «الفلسطيني» أن يسير بوضوح، فيأتي الوضوح مباشرةً، مع ما قد يعتبَر غموضاً أيضاً، عندما يسير البطل، المريض، وتسير الطبيبة ومن سار خلفها، خلفه.
أما مصائد الرياح، وهي الشكل الهندسي الذي لجأ إليه أبناء المناطق الحارة في بيوتهم لتبريد الهواء وتلطيفه، كالبراجيل في الخليج، فلم يكن اختيارها إلا لغاية البحث عنها في البداية. وقد عرّفتنا الرواية بهذا الاختراع في الهامش، وشبّهت أحلام أعمارنا بتلك المصائد، «فكلّ ريح لاهبة ملأت منازلنا، أو أرواحنا أو قلوبنا، كان علينا أن نعمل المستحيل لنحوّلها إلى نسائم أو هواء أبرد، نطرد به النار التي فينا أو في أي مكان كنّا فيه […] كأننا لم نولد إلا لتهبّ علينا الرياح اللاهبة! كم من هزيمة وأمل مكسور عشتَ؟ كم خديعة؟ وكم منفى؟ وكم هجرة؟». وعبر هذا التعريف، ونحن نبدأ الدخول في مرحلة نهاية النصّ، تأتي المصائد لتكون هي الملخّص للحال، فعنوان الرواية هذا لم يكن عتبة، بل خُلاصة.
لغة نصرالله بسلاستها ومفرداتها وفرادتها حاضرة كما تحضر في جميع أعماله، إلّا أنّ المميز هنا قدرته على الغوص، والتعمّق في الغوص، في حوارات وأفكار ونقاشات حملت من الفِكر والتحليل النفسي وخلاصات لأفكار كبيرة الكثير. وهنا نحار كيف نصف الأمر، فقد كان مجهداً ومعيقاً لتتبع الشخصيات، ولكنه كان عميقاً إلى درجة جعلتنا القراءة نتوقف لنفكر كأننا نخوض النقاش أيضاً بين الراوي والكاتب وأحلامه…
هل الراوي العليم هو الخالق في المفهوم الديني، هل هو الأنا الأعلى، هل هو فكرة في بال الكتّاب والنقاد ليس إلّا؟ هذا أمر يحتمل التأويلات جميعها وربما غيرها، ولعل إبراهيم نصرالله قدّم نصّاً جديداً مبنيّاً على سؤال عميق من حيث فكرة «من يؤلّف ويخلق مَن؟»، التي تتعدى الرواية والأدب والفنّ، إلى ما هو أعمق!
تنتهي الرواية مع بداية مشروع رواية جديدة عن يافا، وليس أجمل من جملة قالتها أحلام قبل أن تصبح فرساً وتصهل وتختفي «بِحياتَك… سلّملي على بحر يافا»، لننهي فيها ومعها.
صحيفة الأخبار اللبنانية