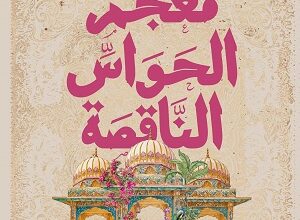كيف أسقطت رائعة “الانطباع الأخير” الاستعمار الفرنسي للجزائر؟

يعتبر مالك حداد من أهم الكتاب الجزائريين الذين كتبوا عدة روايات عن تجربة الاحتلال الفرنسي للجزائر. فمن خلال حداد والطاهر وطار وكاتب ياسين تعتبر الجزائر أهم بلد عربي كتب عن أدب المقاومة.
“لا تطرق الباب كلّ هذا الطرق فإني لم أعد أسكن!”. يقول مالك حداد صاحب رواية “الانطباع الأخير”، مقولة تجسّد الصراع الهويّاتي والحسم الأخير الذّي رافق هذا الروائيّ طيلة حياته، حياة داخل الحيرة، فمشكل الصراع بين الهويّة المسلوبة والهويّة المكتسبة يصيبك بالاغتراب داخل كينونتك. يتناول الكاتب المهموم بشؤون الهويّة ذاته بالكثير من الحذر، إنه شخص ينتمي في لحظة تاريخية ما إلى شيئين متضادين، يقفُ عند مفترق الطرق بين بلدين ولغتين وثقافتين مختلفتين، هنالك وقع عاش فيه عندما فتح عينيه، وهنالك واقع يتشكّل في المستقبل يعيش “آخرون” يحملون تاريخ ما بعد الفاتح من تشرين الثاني/ نوفمبر 1954.
تحيلنا رواية “الانطباع الأخير” لمالك حداد إلى ضرورة استرجاع الذّات من الآخرين، سواء كان هذا الآخر معك أو ضدّك، فتظهر روح البطل “السعيد” المهندس لتحاكي أفول أفكار وبزوغ أفكار أخرى، تراجع وهم الذّات وتقدّم ظلال الذّات المسلوبة بحجج السلام، العنف الذّي يستثمر فيه المستعمرون في السلام أشدّ من العنف العسكري حيث يفقد الإنسان نفسه تحت ضربات الإنسانية والعيش الكريم، وتتحوّل التضحيات إلى إجرام وإرهاب ووصمة عار وجب تجنّب الانتماء إليها، هكذا يشيرُ المستعمر إلى النضال على أنّه عمليّة مسلحة منبوذة، ويقدّم الحرية على أنها انفلات أمني ورغبة في القتل المجاني لكن قتل من؟ قتل المستعمِرين فقط؟ قتل الجزائريّ البارحة مثل قتل الفلسطيني اليوم، شأنٌ لا بدّ منه استعمارياً، حيث لا تعود ثمّة هويّة حينما تتبدّد المعاني وينصهر الـ “هو” تحت قوة الآخر.
فهل تقود الرغبة في الحريّة أبطال مالك حدّاد إلى استعادة كينونتهم أم أنها تفاقم حيرة الهويّة؟
يعتقد الإنسان أنّه يملكُ ذاته، فقط حينما يتوقّف الآخر عن الظهور أمامه، وبذلك يراكم الحيرة في كينونته، يراكم مستقبلاً يبنيه الوهم وتطيلُ وجوده القابلية للاستعمار، يرتمي داخل الحدائق الزائفة التّي تموتُ ورودها كلّما اقتربت منها، إنها رائعة من بعيد، الوهم يصنعُ تلك الألوان، يستدرجُك نحو تدمير ذاتك، وخصوصيتك، تصبح من كتلتهم، وتذوب داخل قناعك، عالم يرفض الآخر باستقطابه نحو أفران الاستعمار، وهذا ما يعالجهُ مالك حداد في عمله الرائع “الانطباع الأخير”، إنّه يأخذ بأيادينا إلى ذلك المصير المتعّدد انطلاقاً من كينونة واحدة، جزائري متعدّد النهايات، “السعيد، بوزيد، الشريف، ليلى، ايدير، أمّا مسعودة..”. يخبرنا عن عيش الإنسان حالة من الوهم الاضطراري يجد فيها ما يفتقد إليه ما أسميه بآليات الدفاع أو ما يسمّى في عالم الأسلحة منظومة دفاع تعتمد على الصدّ اللامحدود الذّي يعتقد فيه هذا الإنسان أنّ كلّ ما يرمى باتجاهه هو محاولة لإلغاء وجوده المسلوب، ومن ثمّ فهو يصدّ حتى الورود الحقيقة تحت ذريعة البقاء.
إن الطريقة المثلى لتنامي هذه البؤرة المدهونة بكلّ شحوم استخراج المعلوم ما هي إلا إعاقة لحركة التاريخ السليمة التّي سيتوقّف معها المردود في إنتاج إشكاليات متطوّرة تمنحنا نتائج جديدة غير مجرّبة لصالح تواريخ قديمة متنازع عليها الآن لأجل إحقاق الـ”هو” مقابل “الآخر”، فالذين لا يستطيعون الاضطلاع بتنوّعهم الخاصّ يجدون أنفسهم أحياناً بين أشدّ القتلة على الهوية فتكاً، يهاجمون الذين يمثّلون ذلك الجزء الذي يريدون طمسه من أنفسهم، إنه كره الذّات الذي شاهدنا أمثلة عديدة عليه عبر التاريخ كما يفسّره أمين معلوف ومثّلته شخصية “الشريف” زوج ليلى أخت “السعيد”، شخصية كارهة لمستقبل بعيد عن فرنسا، رجل وصوليّ أصبح فرنسياً متوسطاً، يردّد “الحشيش سينبت في ساحة الحكومة بمجرّد أن تنال الجزائر استقلالها”، مضيفاً: “ينقصنا التقنيين”. يزعم أيضاً أنّ القبائل لا يشبهون العرب، القنبلة التّي زرعتها فرنسا داخل المجتمع الجزائري قبل أن تغادرها للأبد، التفرقة ما بين أمازيغي وعربي، حرب طائفية لمستقبل ستكون فيه هذه “الفرنسا” خلف البحر المتوسط وقد عادت من حيث أتت تتفرّج على الجسر الذّي أسقطته بين جزائري وجزائريّ آخر، “لن نعيش بسلام أبداً” كان ردّ الشريف حينما سمع بقدوم الفرنسيين للبحث عن بوزيد أخ زوجته الآخر الذّي كان يمثّل الجزائري المناضل الصريح، صوته عالٍ: يحيا العرب.
وبين هذه الشخصيات الثلاث “السعيد، بوزيد، الشريف” يمكننا سماع صوت الهويّات المتقاتلة وكلّها جزائرية، استطاع الاستعمار زرع ذلك وتراجع نحو الخلف تاركاً الساحة لضحايا كلّهم جزائريون، سيكون “السعيد” الحيرة التّي ستحدّد تاريخ البلاد، حيرة الذّين أربكهم الفاتح من نوفمبر، هل الجزائر فرنسية، أم أنّ الجزائر جزائرية؟ سيمثّل بطل “الانطباع الأخير” ما لا يمكن هزمه، المهزوم من الدّاخل سيظلّ مهزوماً إلى الأبد، تظهر روح البطل المليئة بالمفترقات، المهندس، بناء الجسور، الجزائري الفرنسيّ، مقابل المناضل أخ بوزيد المطارد، الجزائري الحرّ.
يستمر مالك حداد عبر عمله هذا في تناول فلسفة الهويّة بلغته الشاعرية الرائعة التّي لا تجرح الحماس النضالي حتى حينما يتحدّث عن المقاومة، إنّه يعطي للغته الشاعريّة التّي تأخذ اتجاه البنادق صيغة الحرب النبيلة، “وهكذا فإنّ الغابة التي نبصرها هنالك على طرف الروابي في أعلى المدينة هذه الغابة تحارب الآن لن يذهب إليها المحبون للتعانق، وهكذا هذه الغدير التي نكشف باتجاه الشرق في هذه الكتلة الخضراء المتروكة في سفوح الأكواخ القصديرية، هذه الغدير تحارب لن يذهب الأطفال للقبض على صغار الضفادع في علب المصبرات الصدئة، الرجال يحاربون الممرات تحارب الينابيع تحارب والسحب تحارب، إنها حرب ذات حدود مبهمة بألف ألف مركز ثقل” الصفحة 11.
فكيف أنقذ البطل صيغة الجزائريّ من مشروع التعايش الاستعماريّ؟
بالفهم، فهم أنك لا تستطيع أن تكون أيّ شيء، لا فرنسياً تماماً ولا جزائرياً تماماً، كلّ ما يدور حول البطل السعيد يساعده على إنقاذ نفسه من الحيرة، الحبّ لم يستطع أخذ جزائريّته، المكانة المرموقة أيضاً، جسره الذّي بناه وكان أغلى ما يملك، الدم المهدور الذّي يعمّق الهوّة بين فرنسيّته وجزائريّته، وحدث بعد حدث نرافقه في رحلته في استرداد هويّته من الحيرة، السعيد ظِلّ مالك حدّاد، مالك حداد ليس ذاتاً خاصّة فحسب، إنّه موقف إبداعي وفلسفي مرفوق بالنّبل الذّي يمكنك أن تلمسه في أعماله ومواقفه، هذه الشخصيّة وبالرّغم من أنها لا تجيد اللغة العربيّة نظراً لمنهجيّة الاستعمار الفرنسي وقتها إلّا أنها بقيت تدافع عن حقّها المسلوب في تعلّمها ممّا جعله يتوقّف عن الكتابة نهائياً إكراماً للغة العربيّة التّي تمنّى لو أنه استطاع أن ينتمي إليها، (أمر كهذا حرمنا من ظاهرة إبداعيّة لذلك أجدني أعارض توقّفه عن الكتابة وفي الوقت نفسه أحترم هذا النّبل في شخصيّته).
لقد مات مالك حداد لغوياً “قتلته اللغة”، لكنه بقي خالداً أدبياً، مثلما مات السعيد في نهاية رواية الانطباع الأخير+ وبقي اسمه مخلّداً في النضال، استشهد الجميع مالك حداد وبطله والجسر، لقد كان يبحث عن ذاتيّته التّي تشتّت داخل لغة جاءته ولم يذهب إليها، أمر كهذا يفسّر فرحه الكبير الذّي يشبه الانتصارات الكبيرة على رمزيّتها حينما ترجم عمله “رصيف الأزهار لا يجيب” إلى العربيّة سنة 1965، وبطله “السعيد” يشكّل معاناة مالك حداد نفسه، شخصية قادمة من أسرة ميسورة مثقّفة له وزنه في الأوساط الفرنسية، عاش طفولة هانئة ومستقبلاً كان واعداً لمهندس تقتله غبطة المساهمة في بناء جسور قسنطينة التّي تفكّ عن سكانها العزلة وتمنحهم حياة أكثر مرونة في التنقّل نحو الطرف الآخر من المدينة، من البلاد، من الذّات.
تشعر أن داخل السعيد معالجة للجزائريّ الذّي لم تقدّم له الجزائر على جزائريّتها بل عاش داخل الجزائر التّي تخطف من جزائرها، الاستعمار يريد أطفالاً فرنسيّين من أرحام جزائريّة، الحبّ الحرب، الوطن وماهيّة الاغتراب، كلّها تعالج بطريقة فلسفية جميلة عند مالك حداد، لوسيا الفرنسية، الحبّ بين طرفين ميئوس منهما، لا زواج سيجمعهما، “المّا مسعودة ترفض ذلك”، إنها لا ترفض زواجاً بين السعيد ولوسيا، بل بين الجزائر وفرنسا، وقوع أمر كهذا يعني موت السعيد رمزياً، مثلما مات عمّه ايدير حينما تزوج سيمون “قتلت عمّك”، لوسيا بجزائرها الفرنسية والسعيد بجزائره الحائرة، لوسيا التّي تقرأ يومياً على حائط حيّ السعيد “الجزائر حرّة”، التّي تحب السعيد وتكره الجزائر التّي في عينيه.
كان يحتاجُ الجميع إلى طلقة طائشة تعيد ترتيب تلك الآمال المغبّشة، ماتت لوسيا بتلك الطلقة، ماتت الجزائر الفرنسية مات التزاوج بينهما، إنّ الحرية حتى تعلو عليها عليك أن تقتل السلام المزيّف لتحصل على سلامها، ماتت تلك الحيرة، يكشفُ لنا الكاتب عن عودة الذّات إلى كينونتها، تدريجياً وقد ظهر هذا داخل محادثات دارت بين السعيد والدكتور روبير ولوسيا في منزله، بين العربيّ والفرنسيّ، بين الحب والحرب، بين قوة العدالة وعدالة القوة، بين الاستعمار والحرية، وقد عبّر السعيد عن تشتّته حينما هاجمه الدكتور قائلاً: “أنت تتحدّث كوطني” اللحظة التي تصبح فيها الوطنية نوعاً من الخيانة تنهار فيها المفاهيم والقيم ويسجن الفرد داخل مزدوجتي عنف الرموز “لا أدري إن كنت وطنياً، ما أعرفه، وأعرفه جيداً، أنني جزائريّ، بل إني أخاف أن أكون قد أصبحت شيئاً آخر” ص 21، يقول السعيد منتصراً على الحيرة التّي زرعها الاستعمار داخل كينونة الجزائري ليتخلّص من وجوده المستقلّ ويلحقه بفرنسا، صحيح أنّه لم يتجرّأ على قول إنّه يخشى أن يكون قد أصبح مضاداً للفرنسيّين، لكن لوسيا سمعتها من دون أن يقولها.
لا يخفي الكاتب ماهية استرداد الهويّة عن طريق بطله فيظهر في حوار مقاوم لتصارع الهويّات القاتلة التّي حاول الاستعمار جاهداً استخدامها ضدّ وصول الجزائري إلى أخيه الجزائري، محاولة عزله عن كينونته وإلحاقه بالكائن اللاجئ هويّاتياً، وبهذا يضمن خراب أيّ مشروع لبناء الفرد الجزائري المواطن بعيداً عن الأعراق والانتماءات الأيديولوجية، “لكنكم أنتم يا السعيد أنتم لستم كالآخرين، معكم يمكن أن نتحدّث يمكن أن ندعوكم، يمكن الحديث معكم عن روني شار وبتهوفن، لستم كالآخرين نخاطبكم بالضمير، معكم لا نقطّب وجوهنا تقزّزاً ليست لدينا ردود الأفعال الخانقة، معكم يمكن أن نتفاهم” صفحة 84. محاولة استمالة الآخر باختراع المكانة له، هو ليس جزائرياً مقزّزاً، ومن المؤكّد أنّه لن يصبح فرنسياً راقياً، لكن السعيد يرفض هذه الطبقية، والأيديولوجية: “خطأ أني كالآخرين، وزوارقي الصغيرة لا تضيف شيئاً ولا تنقص شيئاً، إني كالآخرين في شارع الرهبان في سان ميشال في الفوج أو سانت ايتيان، إني كالآخرين إني مع الآخرين”.
وهنا تحسم الشخصية أمرها، في مسألة النضال، والانضمام إلى أفكار “الإرهابيين” كما تطلق الصحافة الفرنسية عليهم، “أفهم خبزهم وبندقيّتهم، أتحدّث عن أمي كما يتحدّثون عن أمهاتهم، أقبل أبنائي كما يقبلون أبناءهم، أخاف السلب كما يخافونه، إني كالآخرين كلّ شيء يربطني بهم، كلّ شيء يجعلني مماثلاً لهم، أنا لست سوى معهم، اختارت الشجرة غابتها، العلامة الموسيقية سمفونيتها، الوحيدون الذين أستطيع أن أفهمهم هم أهلي” صفحة 84، فالثورة التي انطلقت خلخلت مفاهيم الاندماج وأفكار الاستعمار بأنّ الجزائر فرنسية، لقد بدأت الانهيارات الذاتية القديمة في الحدوث مقابل بزوغ أفكار صارمة وصامدة تجاه التحرير، وتأكّد الجزائري المسلوب أنّ مأساته تخصّه لوحده “يمكن أن تنفجر، قنبلة الأرض تدور، يمكن أن ينحرف قطار، الأرض تدور، يمكن أن تنفجر قنبلة في الحديقة العامّة الكبيرة للمدينة، الأرض تدور، لا مبالاة عجيبة” صفحة 12.
الهويّة الحائرة عزّزت خساراته، عليه أن يكون حاسماً، كلّ هذه التمهيدات، والرحلة نحو اكتشاف الماهيّة، عزّزت النهاية التّي ستؤول لصالح الجزائر، “لقد آن الأوان ليلتحق كلّ واحد بطائفته” يقتطفُ سعيد من مقالة ألبير كامو، لهذا لم يجد أيّ تردّد في أن يوافق على تهديم الجسر الذّي بناه، الجسر الذّي أصبح عدواً، فحينما يرى نهج الولايات المتحدة المقابل للمحطة تسير عليه قافلة لا متناهية من الدبابات والسيارات المصفّحة المقبلة من سكيكدة باتجاه باتنة، باتجاه الأوراس أين تشتعل الحرب، الذهاب نحو إطفاء “حلم اليقظة”، إطفاء الجزائر الحرّة عليه أن يعيد حساباته، جسر يجب أن يستشهد لينتصر لجزائريّته، فقدّم لبوزيد وأصدقائه من أين يؤكل كتفه، لقد حسم الكاتب جزائرهُ مثلما فعل بأدبه، اللغة الفرنسية حاجز بيني وبين وطني يقول مالك حداد، أشدّ وأقوى من حاجز البحر الأبيض المتوسط، وأنا عاجز عن أن أعبّر بالعربية عمّا أشعر به بالعربية، إنّ الفرنسية لمَنفاي”، إحدى الافتتاحيات الخالدة التّي تطرح المعاناة داخل كينونة الأنا وغزو الـ “هو” في عمل سأهبك غزالة، كما أنه خاطب صديقه الشاعر الفرنسي أراغون: إن الفرنسية هي منفايَ الذي أعيشُ فيه، بلى، يا أراغون، لو كنت أعرف الغناء، لتكلّمت العربية..، لقد قرّر بكلّ نبله أن يسقط الجميع لتحيا الجزائر، الأدب، الحب، الجسر، والسعيد نفسه.
الميادين نت