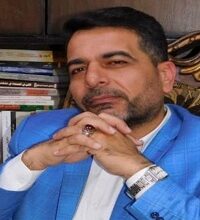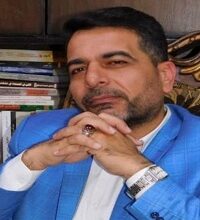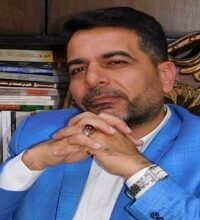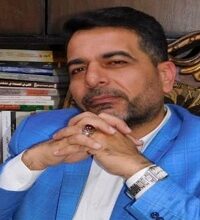تبدو مسألة شرعيّة السلطة ومنحها المشروعيّة مسألةً أساسيّةً في الفقه والثقافة والعقيدة. ويبدو أنّ الحاكم أو السلطان أو الطاغية بحاجةٍ ماسّة إلى شراء الذمم، وصناعة الأشخاص القادرين على تبرير ممارساته، وإضفاء الشرعيّة على سلوكه وأفعاله أيًّا كانت.
ومن هنا يأتي حرص السلطان على شراء وابتزاز المثقّف ورجل الدين للقيام بمثل هذه الأدوار، إيماناً منه بأنّ الرصيد المعنويّ الذي يمتلكه هؤلاء يفيده كثيراً في شرعنة ما يقوم به من استبدادٍ وفسادٍ وظلمٍ بحقّ الشعب الذي شاء له القدر أن يحيا في ظلّ هذا الحاكم.
وبدل أن يكون المثقّف والكاتب والمبدع هو الركيزة الأساسيّة في رفض الظلم، والكاشف لممارسات الحاكم بحقّ شعبه، فإنّه يذهب في اتجاهٍ آخر مختلفٍ تماماً، يقوم أساساً على التبرير والتبجيل وتقديم فروض الطاعة للحاكم، بل وطلبها من الجماهير مستغلّاً حالة الفاقة والعوز والحاجة لديهم، تماماً كما استغلّ الحاكم حاجة المثقّف ورجل الدين من أجل ابتزازهما بل وانتعالهما، بعد انتقالهما من مهمّة إضفاء الشرعية، إلى مهمّة الدفاع عن أخطاء الحاكم وتبرير ارتكاباته بحقّ شعبه.
بل إنّ المثقف ورجل الدين تحوّلا إلى العصا الغليظة التي يستقوي بها الحاكم على شعبه. وكان بعضهم يجهد فكره ولغته في إسباغ الألقاب والصفات ذات الدلالات الإلهيّة على هذا الحاكم أو ذاك، ونادراً ما نجد فقيهاً أو مفكراً أو مثقفاً يملك من العقل وصوابيّة الرأي ما يمنعه من هذا الانحدار المدمّر للحاكم والمحكوم على حدٍّ سواء، ومن دون تفكيرٍ بمخاطر هذا السلوك مستقبلاً، أو قراءةٍ واعيةٍ للتاريخ وما قام به بعض المفكرين والفقهاء من مواقف لا تزال حاضرةً في الذاكرة رغم مرور مئات السنين عليها.
فهذا هو “الماوردي” صاحب “الأحكام السلطانيّة”، يقوم بالدور الأبهى في ممانعة طلبات السلاطين، من خلال رفضه الإفتاء بجواز منح الخليفة للسلطان “جلال الدولة” لقب “ملك الملوك” “شاهنشاه” رغم أنّ غالبيّة الفقهاء أفتوا بذلك آنذاك، ورغم الصداقة التي كانت تربطه “بجلال الدولة”.
أمّا “ابن رشد”، سليل العائلة التي تولّت مناصب قضائيّة وفقهيّة رفيعة، والذي شغل منصب القضاء في إشبيلية وقرطبة أيضاً فضلاً عن تولّيه منصب الطبيب الخاصّ للخليفة الموحدي “أبي يعقوب يوسف”، فقد كان حادّاً في نقده جريئاً في مواقفه التي دفع ثمنها غالياً سواء في الفلسفة والفكر والثقافة أو في السياسة، وما قدّمه من أفكار إصلاحيّة ونقدٍ لاذعٍ للحكّام وممارساتهم، خاصّة الاستبداد القائم على أسسٍ دينيّةٍ أو معرفيّةٍ بلبوسٍ مدنيّ.
لهذا نجد أنّ الحرصَ “الرشديّ” على إقامة الدولة المدنيّة كان كبيراً، لأنّها وحدها الكفيلة بوضع حدٍّ لابتزاز المثقف، وللتخلّص من الانتعال الطاغوتيّ الاستبداديّ الذي تمارسه السلطة، سعيًا منها لاستمرار جمهوريّة الخوف والتسلّط بعيداً عن المدينة الفاضلة والحكم العادل الذي يحقّق العدالة والمساواة بين أبناء الشعب بمختلف انتماءاتهم.
لا غرابة إذاً أن يُعجب عددٌ كبيرٌ من المفكّرين والمثقّفين الأحرار بالنهج الرشديّ وبالشجاعة الملازمة له، ومنهم “الجابريّ” الذي أُعجب أيّما إعجابٍ بشجاعة “ابن رشد” ونقده اللاذع للاستبداد الثيوقراطيّ.. ولهذا يقول:
“نستطيع أن نقول باعتزاز إنّ في تراثنا ما يستجيب لهمومنا السياسيّة المعاصرة، بل يتحدّى شجاعتنا وقدرتنا لينوب عنّا في نقد أساليب الحكم في مدننا هذه وزمننا هذا”.
لقد آن الأوان لخروج المثقّف من حالة الخنوع والخضوع والمذلّة ومن الحياة البائسة التي أوقع نفسه أو أوقعه فيها الحاكم، الأمر الذي جعله يعيش حالةً من البؤس والتشظّي، نتيجة رضاه بالعيش على فضلات موائد السلطة، وتقديمه الحاكم على أنه المخلّص، بعد إسباغ صفات الألوهيّة عليه، بعد انحدار بعض المثقّفين إلى فكرٍ مستنسخٍ وثقافة هشّة، تضفي قداسة وهميّةً على الحاكم ورجالاته، في منطقٍ يُجرّد الثقافة والمعرفة من أثرهما المجتمعيّ الفاعل.
وإذا كان من الممكن تبرير صمت العامّة وابتعادهم عن تمجيد الطاغية، خوفاً على حياتهم وحرصاً على قوت أبنائهم، فإنّ ما يقوم به المثقّف من تبريرٍ لأفعال الطاغية، يساهم بشكلٍ كبيرٍ في ترسيخ الاستبداد، ويُغري المستبد بابتزازه أكثر لإيمانه بأنّه الأقدر على تزييف الحقائق، وتشويه المنظومة الأخلاقيّة عند العامّة، لدفعهم إلى السير في قافلة التسلّط.
صحيح أنّ النموذج “السقراطيّ” للمثقّف القادر على التضحية حتّى لو اضطرّ لشنق نفسه على مقصلة الحقيقة لم يعد موجوداً في مشهدنا الثقافيّ، لكنّ ما يقوم به المثقّف من تبريرٍ للحاكم هو السبيل الأقصر والأخطر لابتزازه واحتقاره والنيل من ثوابته.
بوابة الشرق الأوسط الجديدة