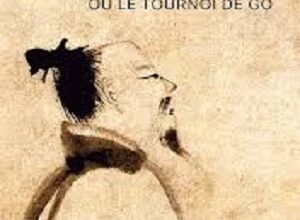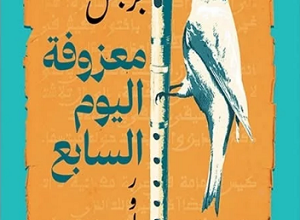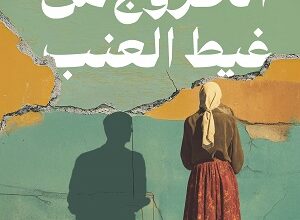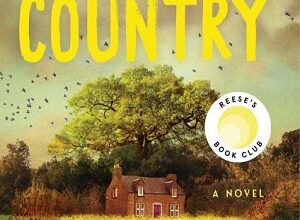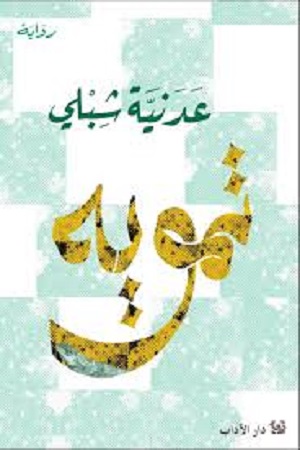
في روايتها «تمويه»، تواصل عدنية شبلي تفكيك العلاقة بين اللغة والاستعمار، إذ تصبح العبرية والعربية ساحة صراع. عبر طالبة في جامعة إسرائيلية وأسير محرر، تكشف كيف يتحوّل الاحتلال إلى استعمار لغوي يمحو الهوية ويحوّل الذاكرة إلى ميدان مقاومة بالكلمات.
في ذلك الهامش اللامرئي، تكمن لغة أخرى، نحاول قراءتها لنقرأ المكان، كأنّنا مرةً أخرى نكتشف أنّ العالم لغة وكذلك الزمن. كأنّ الاستعمار هو أيضاً استعمار لغوي، يشظّي المكان إلى جغرافيات متناحرة، وهذا أيضاً ما فعله الاحتلال.
لغة المستعمِر والمستعمَر
في روايتها «تمويه» (الآداب ـ 2025)، تُعيد الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي النظر في هامش كانت قد تأمّلته جلياً في روايتها السابقة «تفصيل ثانوي»، التي دخلت فيها إلى تلك الهوة التي يمكن تسميتها بنفق الصراع، لتضع يدها على الجرح الفلسطيني عبر لغة المستعمِر ولغة المستعمَر اللذين يدوران في فضاء جريمة النكبة وعبر تفصيل هامشي يشكّل قلب الجريمة وهو اغتصاب فتاة.
وفي «تمويه»، تشكّل سردية عدنية رحلةً أخرى داخل فضاءات الاستعمار في فلسطين حيث تشكّل اللغة جوهراً لمحو الفلسطيني. وربما تلك المناطق أساسية جداً لأنها تدخل القارئ الى منطقة الألم عبر تلك الكلمات التي تحارب بعضها وتنفي وجود بعضها الآخر.
في مكان لا تسمّيه لكننا ندركه حيث تتداخل اللغتان العربية والعبرية في تمويه لا يمكنه التناغم أبداً، تتضح فكرة الاستعمار والمحو والإبادة وترتكب الجريمة ويصبح لفظة العدو واضحةً جداً من دون تمويه.
في الرواية، يبدو جلياً ما يختلف عن البحث الثقافي واللغوي، لأنّ عدنية شبلي تبتكر فضاءات مكثفة في عالم متكامل يبدو المجاز فيه أقل، لكنّ رموزه حقيقية في معانيها الكبيرة التي تشير إلى زوايا الصراع الكبيرة.
رغم غياب الأسماء داخلها، تعطي الرواية أسماء أخرى غير معرّفة لكنها ليست نكرة كأنّها لا تعني فقط أشخاصاً بذاتهم إنما هم استعارة لكل فلسطيني وأيضاً لكلّ مستعمر تحت الاحتلال.
شخصيات الرواية في مواجهة المحو
تدعى الفتاة الطالبة التي تعاني من أزمة عدم حديثها اللغة العبرية كباقي الطالبات في جامعة إسرائيلية، وهذا ما يفتح أمامها كوة الصراع، لتنسحب من الحياة الاجتماعية المثقلة بالظلم والانكسار. فلا شيء يعرف مَن هي سوى أنها الطالبة ولاحقاً عاملة التنظيف.
على الضفة الأخرى، نرى هذا الصراع في جغرافيا أخرى وهي السجن الذي سمّاه المفكر وليد دقة بالجغرافيا السادسة، لأن هناك جغرافيات أخرى مثقلة أيضاً بواقع ذي فضاءين ولغتين مضادتين ليس لأنهما مختلفان، لكن لأنّ هناك وجوداً يستعمر الآخر ويمحوه ويلغيه ويقلل منه ويحتلّه ويقيم في المكان على جثته.
تحويل اللغة العبرية من لغة دين إلى لغة السياسة والأدب
تظهر أيضاً في غزة والشتات والضفة والتقسيمات الأخرى تلك السجون والغيتوات التي تفرض على الفلسطيني إما موته جسدياً أو ـــ وهو الأخطر ــ موته نفسياً وفكرياً.
وطبعاً من جمالية رواية شبلي أنّها لم تذكر كل الجغرافيات، بل كثّفت عالم الرواية إلى ثنائية في كل مكان. فالشخصية الأخرى أسير في السجون يعاني أيضاً من جريمة المحو رغم إتقانه اللغة العبرية، لكن مسألة اللغة هنا تبدو واضحة لأنّ زمنه أسير ومعزول.
حتى حين يخرج إلى الحرية، يبقى اسمه الأسير السابق. كأنّ اللغة أيضاً لا تنسى أنّ للاستعمار إرثاً يلاحقنا، ولو تحررنا منه، فإنّه يترك آثار جرحه على اللغة. أحياناً، نحتفي بمبدعين وكتاب فنانين انطلقوا إلى الحرية وما زلنا نطلق عليهم الأسرى المحررين من باب الفخر، وربما أيضاً لأنّ تلك التجربة لا تُمحى.
في موضوع الزمن واللغة
هنا تظهر مسألة الزمن التي تضيء عليه الروائية الفلسطينية التي ولدت في فلسطين الداخل وحملت تلك الأسئلة التي تحتاج إلى الفن كي يبحث فيها، رغم أنّ الأسئلة موجودة فكرياً وأكاديمياً وخصوصاً مسألة زمن المستعمر والأسير والزمن الموازي.
وكما أكّد المفكر الراحل إدوارد سعيد، فإنّ الزمن الحق هو الحاضر الحيّ الذي يُعاد فيه إحياء الماضي بأسره والمستقبل الممكن تصوّره.
وفي «تمويه»، تحفزنا عدنية شبلي على النظر داخل المكان لاكتشاف التناقض الرئيسي مع الاستعمار، وهو لغة لا تحدد الماضي والحاضر، لكنها تشكل أساساً تحضر فيها هذه الأزمنة. لغة لا يهمنا فيها التمويه أصلاً لأنه سيظهر هذا الظلم والتوحش الآن أو بعد غدٍ أو حتى من بدايات القرن الماضي. فالمشغلة هي المحتلة والمستوطنة.
ورغم عدم ذكر ذلك، تفصح اللغة عن نفسها داخل الحديث بين الطالبة والأسير المحرر، وفي الأسئلة حتى البسيطة منها مثل السؤال عن الاختلاف في اللكنة وسبب اختيار الجامعة العبرية. كأنّ عدنية شبلي توجّه القارئ ليتخيل أنّ ما لا يظهر على السطح، لا يعني أنّه غير موجود في العمق. وهذا ما حدث للأسف في تاريخنا من اتفاقيات «سلام» عبّرت عن ذلك الحقد والاحتلال والظلم وأدت إلى ما أدت إليه حتى الآن.
وكما يحدث للحب وللحرية ـــ نقيض الظلم والاستعمار ـــ فإن التقاء الفضاءات اللغوية وانسجامها وتناغمها هي التي تقود إلى الحبّ، فهذا أيضاً ما يحدث للطالبة وللطالب الأسير المحرر.
ولعل المدهش أيضاً، أنّ عدنية شبلي لا تنسى داخل هذه الرواية المكثفة وجود الطبيعة والحيونات والانتباه إلى لغتها المتشابكة مع لغة الوجود بأكمله.
وربما هنا نعود إلى إعادة قراءة قصيدة مهمة لمحمود درويش «قافية من أجل المعلقات» يقول فيها: «أنا ما قالت الكلمات: كن جسدي»، فالعالم تاه داخل الكلمات لأنّ الاحتلال هو أيضاً احتلال لغوي. وكما أشار الكاتب الشهيد غسان كنفاني في كتابه «في الأدب الصهيوني»، إنّ البروباغندا الصهيونية في العالم استخدمت الأدب واللغة لتمكّن نفسها من احتلال أرض الغير عبر تحويل اللغة العبرية من لغة دين إلى لغة السياسة والأدب.
صحيفة الأخبار اللبنانية