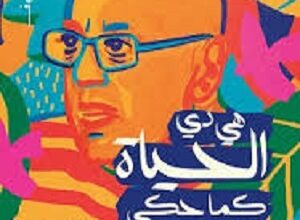الرواية تكشف عن الأعماق المنسيّة للمقاومة في وهران، حيث يتقاطع العنف الاستعماري مع هشاشة الإنسان، ويتحوّل التاريخ من وثيقة إلى مرآة للأخلاق وصراع النفس بين الولاء والخيانة.
في رواية “ما لا يخفيه الظلام”، ليست الغاية إعادة استحضار تاريخ مستهلك أو وصف حقبة مألوفة بسطحية وثقة زائفتين، وإنما استعادة ما تراكم في الهوامش؛ ما تخشاه السرديات الكبرى وما تتعمد تجاهله. فالعمل لا يسعى إلى إحياء صور محفوظة عن الجزائر زمن الاستعمار بقدر ما يفتش في الأعماق التي تتخبّط فيها النفس البشرية حين تُحاصَر بين احتمال البطولة وهاوية الخيانة، وحين يصبح الولاء سؤالا معلّقا لا يستقر على يقين. ليس التاريخ في هذه الرواية مادة للتوثيق، وإنما مرآة لعالم مضطرب تتجلى فيه جروح الأخلاق حين يُدفع الناس إلى ارتداء وجوه لم يختاروها.
يتشكل النص من مسارات رجال مقاومة داستهم روايات السلطة الاستعمارية، وأُفرِغت أسماؤهم من معناها، وطُبعوا بملصقات التمرد والوحشية، حتى باتت حكاياتهم أكثر غموضا من الحقيقة نفسها. لكن الرواية تعيد إليهم ملامحهم الأصيلة: رجال اندفعت أرواحهم إلى الثورة لا بفعل بطولات خارقة، وإنما من شدة الاختناق الذي فرضته منظومة استعمارية مستفحلة في وهران. لم يكن اندفاعهم الأول استجابة لنداء المجد، بل صرخة بدائية لحماية شيء هش اسمه الكرامة. ومع ذلك، فإن الطريق الذي خطّوه، القاسي والمشوَّه، رفعهم من حيث لا يدرون إلى مقام النماذج التي تتخطى حدود الزمان، رغم محاولات السلطة تحويلهم إلى أشباح باهتة في سجلاتها. ومن خلالهم ترتفع الرواية فوق واقعها التاريخي لتلامس منطقة الأسطورة؛ تلك المنطقة التي يتعرّى فيها كل عصر يحاول فيه الجبروت تكسير روح شعب كامل.
لم يشأ الأستاذ قويدر ميموني أن يسمح للحكاية بأن تتقدّم بخطوات واثقة نحو مصيرها؛ ولكن انتزعها من نهايتها، من تلك اللحظة التي يُعدم فيها لوط، لحظة تبدو خاتمة لكنها في الحقيقة شقٌّ خفيٌّ يُفضي إلى مجرى أعمق. ومن هذا الممر الموارب يؤخذ القارئ إلى زمن مبلّل بعرق المقاومين الجزائريين، إلى مفترق طرق يتواجه فيه الرجال مع ظلال قدرٍ لا تمنح وضوحا وإنما تكثر فيها الانعطافات. فالحقيقة هنا ليست صفحة صافية، ولكن لوحة تتبدّل ألوانها كلما تحوّل صوت الراوي أو تبدلت زاوية الرؤية.
وفي هذا الفضاء المتوتر، يتخذ الحب هيئة نوبة عارمة، قد ترفع صاحبها إلى انتصار بطعم الخسارة أو تدفعه إلى ثأر يظل ناقصا كجرح لا يندمل. أما الشرف، فيغدو صرخة يتيمة تواجه ضجيج البنادق وسطوة القمع. وبين هذين القطبين، تقف الخيانة لا بوصفها فعلا عابرا، بل ككيان هشّ يتأرجح فوق هاوية، كجسر متهالك يصل بين حياة تُستنزف وموتٍ يتربص، منتظرةً الدافع الذي سيمنحها شكلها الأخير.
وجدت البنية السردية غير مؤسسة على الأحداث وحدها، وإنما على ما يتسلل بينها من صمت ثقيل، وعلى الإيماءات الصغيرة التي تتحول إلى رموز، وعلى الخيانات التي تُكتب كمحطات ضرورية لإتمام ملحمة لم يخترها أحد. إن العالم الروائي هنا، بخفاياه وأطيافه، يردّ الإنسان إلى تعدديته: إلى كونه صادقا ومخادعا، عاشقا وقاسيا في الوقت ذاته. ولعل شخصية شيباني تجسد هذا التمزق على نحو أشد قسوة؛ إذ يقف عند الحافة التي تلتقي فيها الفضيلة بالعار، وفي صراعه الداخلي تتردد أصداء أسطورية تشبه رجع خطوات خائن مُرهَق لم يخن إلا نفسه. أمامه يقف ألفونس بوصفه مظهرا مكثّفا للسلطة الاستعمارية: داهية ذو حضور طاغٍ، لكنه ينطوي على هشاشة يتفاداها بالغطرسة، كأنما يخبّئ إنسانيته في قبو لا يجرؤ على فتحه.
وفي دوامة هذا الصراع، تتفتح قصة حب معلّقة في فضاء مستحيل بين لوط، الشاب الذي وجد نفسه مساقا إلى دروب المقاومة قبل أن يكتمل وعيه بها، وليزا، المرأة التي تعد واحدة من أبناء الثقافة الغازية، لكنها في داخلها تقف على حافة انفصال صامت عن إرثها. لقد ولد بينهما حبّ لا يطلب الاعتراف ولا يسعى إلى النجاة، بقدر ما يُحتجز في منطقة رمادية يتصارع فيها الواجب مع الحاجة الداخلية إلى الانتماء. تتحول علاقتهما إلى امتحان حيّ: هل يمكن لروحين أن تتعانقا حين يصبح كل شعور ترفا، وكل انجذاب خطيئة محتملة، وكل تسامح نوعا من التمرد على ما يفرضه المجتمع والدم والماضي؟
ومع هذا، نفهم من قصتهما أن الحب لم يكن يوما كائنا يخضع لحدود البشر أو يقف عند تخوم اختلافاتهم، ولكنه كان دائما يشبه ذلك الضوء العنيد الذي يشقّ العتمة مهما تضاعفت حوله الجدران. وفي قلب هذا الجوهر المتفلّت من كل قيد، وُلدت علاقة ليزا بلوط، علاقة لم تفهمها السلطة الاستعمارية إلا باعتبارها جريمة يجب خنقها، جرحا مفتوحا أراد المستعمر الفرنسي أن يوقف نزفه بالقوة، فحوّل قصة حب إلى ذريعة يشعل باسمها الحرائق في الأرض والذاكرة والوجدان.
هذه المصائر المتشابكة لا تُعرض هنا كدراما فردية، وإنما كعلامات على سؤال أكبر: كيف يحافظ الإنسان على جوهره حين تتراكم عليه طبقات الإهانة، ويصبح القتل دفاعا، والصمت نجاة، والانتقام لغة مشتركة؟ كيف يميز الفرد بين العدالة التي تداوي، والقصاص الذي يعمي؟ أين ينتهي الشرف، وأين يبدأ الوهم الذي يبرر كل شيء؟ وفي أي لحظة يتحول الحب إلى جسر أخير نحو خلاص شخصي، أو إلى قيد يجر صاحبه نحو هلاكه؟ تتجول الرواية بين هذه الأسئلة لتكشف أن الغضب مهما بدا قوة مطلقة يمكن أن يبتلع قدرة الإنسان على التعاطف، وأن الدمار قد يحفر شقوقا يتسرّب منها ضوء لا يمكن قمعه.
في هذا العمل، يتداخل حضور الموت مع حضور الحب حتى يتعذر أحيانا الفصل بينهما؛ يتحرك كلاهما في جسد النص كقوتين متعارضتين ومتكاملتين في آن واحد. وبين طيات السرد، تتولد أسئلة عن الذات والآخر، عن كيف يمكن لفرع هشّ أن ينقلب على جذر عتيق، وعن الخط الفاصل بين الحرية والقدر. يمضي النص كرحلة داخل العتمة، لكنه يمنحنا في كل خطوة شعلة صغيرة تكشف شيئا من الوجود ومن سرّ الحضور الإنساني.
رواية “ما لا يخفيه الظلام”، كما يلمّح عنوانها، ليست مجرد حقيقة تاريخية أو حكاية مقاومة فحسب، هي أيضا انكشاف لروح صوفية ظلت ترفرف حول لوط، تظهر له في لحظات الانكسار كما تظهر في لحظات الشجاعة، لتعيد تشكيل معنى الوجود ذاته. إنه نص يتجاور فيه البعد الروحي مع العنف الاستعماري، والغرام مع الفناء، كأن الرواية بأكملها محاولة لفهم المسافة العجيبة بين أن نحب وأن نُعدم، بين أن ننتمي وأن نتمرّد، بين أن نرى العالم بعيوننا أو بعين السارد الذي يملك وحده خيوط الضوء والظلال.
في النهاية، يقدم الأستاذ قويدر ميموني في”ما لا يخفيه الظلام” رؤية واسعة للإنسان ككائن يتنقل بين الخراب والبعث: يهوي ثم ينهض، يدمّر ثم يبني، يكره بمرارة، ثم بلا مقدمات يجد نفسه قادرا على منح الغفران كما لو كان ذلك آخر أشكال الصمود. وحتى حين تُباد الأحلام وتُسحق البطولات وتُطمس الوجوه، تبقى في الأعماق مساحة دقيقة لا تطالها يد الطغيان، شرارة لا يتقن الظلام إطفاءها. فثمة شيء في الإنسان، مهما استُنفد، يرفض أن يُجهز عليه تماما؛ وتلك هي الحقيقة التي تدور حولها الرواية: أن ما يظل حيا في الأرواح لا يستطيع الليل ابتلاعه، مهما طال.
ميدل إيست أونلاين