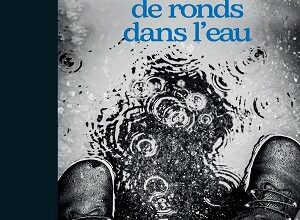السعي لتعزيز تدخل الاتحاد الأوروبي في سوريا (ماغنوس نوريل و ديفيد بولوك)
ماغنوس نوريل و ديفيد بولوك
لو شاءت أوروبا أن تحقق ديمقراطية حقيقية في أعقاب سقوط الأسد فيتعين عليها وقف ما يحدث من تلاعب بها من جانب «الإخوان المسلمين» والبدء في مساعدة المتمردين على الأرض عسكرياً.
كان الرأي المتعارف عليه أن المعارضة السورية منقسمة بشدة، مما يجعل إرسال المساعدة والدعم من المجتمع الدولي أمراً صعباً. إن انعدام وجود "عنوان موحد" يمكن من خلاله تنسيق الأمور يجعل أيضاً أية أفكار حول قيام تدخل عسكري أكبر وأسرع أمراً مستبعداً جداً. ومما يضيف إلى تلك الصعوبة هو الرفض المستمر من جانب روسيا والصين لدعم قرارات أكثر فاعلية من قبل مجلس الأمن، ومن ثم فلا عجب أن المذبحة في سوريا قد استمرت لنحو ما يقرب من ثمانية عشر شهراً في الوقت الذي ينظر إليها العالم مكتوف اليدين.
وربما يكون صحيحاً أن هناك حشداً من المنظمات تتحدث باسم المعارضة. وبنفس هذه الدرجة من الصحة نجد أن العديد من هذه المنظمات والجماعات – هي على خلاف مع بعضها البعض. وربما يكون من الصعب جداً أحياناً التمييز بين هذا العدد الضخم من الجماعات والتوصل إلى تقييم حول أي منها هي ديمقراطية حقيقية بينما تدعي الأخرى بأنها كذلك. وقد اتضح ذلك بصورة أكثر خلال زيارة لتقصي الحقائق إلى تركيا نظمتها "المؤسسة الأوروبية للديمقراطية" (منظمة غير حكومية مقرها في بروكسل) في أوائل تموز. وقد كشفت خمسة أيام من الاجتماعات مع الجماعات والأفراد السوريين (في أنطاكيا واسطنبول) – شملت الطيف الأيديولوجي والسياسي الكامل – عن قيام انقسامات وانشقاقات داخل المعارضة، بل وبدرجة كبيرة بين أولئك الذين ينشطون داخل سوريا نفسها.
إلا أن الزيارة قد كشفت أيضاً عن شيء آخر أهم بكثير وهو أن المعارضة ربما تكون منقسمة إلى حد ما لكنها ليست منقسمة حول الهدف المتمثل في التخلص من الأسد. كما أنها ليست غير منظمة بل غير مركزية. وقد أوضحت المناقشات التي جرت خلال خمسة أيام مكثفة جداً أنه كان بالإمكان تخفيف العنف الذي يعاني منه الشعب السوري (مناطق قليلة جداً في البلاد لم تعانِ من العنف) من خلال تقديم دعم أكبر من المجتمع الدولي. كما أصبح واضحاً وضوح الشمس بأن الخوف – الذي غالباً ما يُذكر في الغرب – من الوجود الإسلامي المتنامي في المعارضة يرجع إلى حد كبيرإلى حقيقة أنه لم تتقدم جماعة أخرى إلى صدارة الفعل. فالإسلاميون (النشطون في المجموعات المصطفة مع «الإخوان المسلمين» أو المنتمية إليهم والجماعات السلفية الأكثر تشدداً) يتبعون تكتيكات عتيقة الطراز ويستغلون هذا الموقف، ويسعون – خلال نشاطهم – إلى إزاحة المنظمات والجماعات الأخرى التي ليس لها انتماء إسلامي أو أنه ضعيف جداً.
وبالنسبة للكثيرين في الغرب، ربما يُرى هذا الاتجاه بوضوح أكبر بأنه أصبح أكثر تماهياً مع المعارضة السورية وهو "المجلس الوطني السوري". فالغالبية العظمى ممن التقينا بهم – بغض النظر عن انتمائهم الأيدلويوجي – قالوا الشيء نفسه وهو أن «الإخوان المسلمين» قد تسللوا بقوة إلى "المجلس الوطني السوري" وسيطروا عليه. إلا أن ذلك يتناقض مع المعلومات القادمة من سوريا على مدى العام الماضي والتي تلقي الضوء على الانقسامات التي هي أحياناً عميقة بين المعارضة داخل سوريا والأخرى المنظمة المقيمة خارج البلاد، وفي تركيا في المقام الأول. ووفقاً لمحاورينا نجح «الإخوان المسلمون» في تقديم "المجلس الوطني السوري" باعتباره جماعة "تسيير الأمور" يمكن من خلالها توجيه المساعدات أياً كانت قلتها. وكون ذلك قد تحقق تحت سمع وبصر الاتحاد الأوروبي إنما يرجع بالتأكيد إلى حقيقة أن "الاتحاد" قد وجد عنواناً في "المجلس الوطني السوري"، تم استغلاله من قبل النشطاء المهرة في «الإخوان المسلمين» لتقوية موقفهم. إن حقيقة قرب الحكومة التركية من «الإخوان المسلمين» قد ساهم في توضيح هذا الأمر بصورة أكثر، وأن عدم وجود دعم من دول ديمقراطية أخرى في الغرب قد سهل العملية.
وعلى أية حال لا يتمتع الإسلاميون بهيمنة داخل سوريا. وقد أصبح ذلك واضحاً أيضاً خلال نقاشاتنا بصورة أكثر. وعلى العكس من ذلك، فقد اتضح لنا بقوة أن الغالبية العظمى من المعارضة قد فضلت الاتحاد الأوروبي الذي تُعتبر هياكله الديمقراطية هي البديل السياسي الأمثل بعد سقوط الأسد. لكن عدم وجود دعم من الغرب والرفض المستمر للمساعدة عسكرياً إنما يمنح المعارضة غير الإسلامية خيارات محدودة ونادرة.
وقد دلَّ تعقب "عنوان واحد" من جانب الاتحاد الأوروبي إلى أذرع «الإخوان المسلمين»، ومن خلال قيامه بذلك ساهم "الاتحاد" في تعقيد الهدف الذي تقول أغلبية من المعارضة إنها تريد تحقيقه وهو قيام دولة ديمقراطية حقيقية لها كيان قانوني وسياسي يشبه الاتحاد الأوروبي. وبدلاً من وضع جميع البيض في سلة "المجلس الوطني السوري" ينبغي على المجتمع الدولي أن يقوم بتنويع ودعم العديد من الجماعات الأصغر التي تقوم بالفعل بعمل بطولي في محاولتها مساعدة السوريين داخل سوريا وخارجها. فالمعارضة اللامركزية تثمر عن استجابة لامركزية. وليس هناك أي مشاكل في العثور على أشخاص مناسبين للعمل معهم هنا. كما أن حقيقة كون المعارضة لامركزية هي أيضاً سبب آخر مهم جداً في عدم سحقِها بعد. وفي الغرب وخاصة في الاتحاد الأوروبي ينبغي أن نحوّل ذلك لصالحنا قبل فوات الأوان، وأن نستغل حسن الظن الذي ربما ما زلنا نتمتع به. واللافت للنظر هو أنه على الرغم من الدعم الضئيل القائم من قبل الاتحاد الأوروبي إلا أنه ما يزال يُنظر إلى "الاتحاد" باعتباره نموذجاً لما قد تسفر عنه الأمور في سوريا. ومع ذلك، فكلما طال انتظارنا تضاءلت الفرصة بأن يكون هذا كافياً لوقف المد الإسلامي في سوريا، وجعل البلاد ديمقراطية حقيقية أمراً ممكناً.
ولحسن الحظ أنه بعد أسبوعين من عودتنا من لقاء المعارضة السورية في أنطاكيا واسطنبول وقعت العديد من التطورات المشجعة يفرض كل منها بعض المشاكل الجديدة – التي يمكن في المقابل علاج كل واحدة من تلك المشاكل أو على الأقل التخفيف منها بشكل كبير من خلال تقديم مساعدات خارجية حكيمة.
أولاً: توقَّف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن الإصرار على أن "المجلس الوطني السوري" هو العنوان الوحيد أو الرئيسي للمعارضة السورية، وجاء هذا التوقف في التصريحات العامة والاجتماعات الخاصة للإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وربما أيضاً في خططهم الجديدة للمساعدة. وهذا لا يعني التخلي عن "المجلس الوطني السوري" بل تكميل جهده بأفراد وجماعات أخرى أكثر تنوعاً ويؤمل أن تكون أكثر قدرة "داخل سوريا".
وبالطبع فإن مشكلة هذا النهج هي أنه يخاطر بتمزيق أكبر للمعارضة التي هي مفتتة بالفعل. فعلى إحدى المستويات نجد النتائج بالفعل مثيرة للسخرية حيث تظهر كل أسبوع تقريباً فصائل منشقة ومنظمات مظلة جديدة، جميعها تحت مسمى "توحيد" المعارضة. ومع ذلك، فإن الحل بسيط ويتمثل بـ : التوقف حتى عن توحيد المعارضة، والسعي بدلاً من ذلك إلى التعامل مباشرة مع الجماعات المختلفة التي تستحق أنواعاً مختلفة من الدعم الخارجي. وسيكون هناك وقت كاف – أثناء الفترة الانتقالية لما بعد الأسد – لتنسيق هذه الجماعات وجمعها في نهاية المطاف في حكومة جديدة قادرة.
ثانياً: على صعيد ذات صلة، توحَّدَ أكراد سوريا – الذين كانوا منقسمين بعمق سابقاً – على الأقل حالياً لمعارضة نظام الأسد بوعدهم بعدم دعم أعمال العنف التي يقوم بها "حزب العمال الكردستاني" ضد تركيا. وبما أن أكراد سوريا البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة يسيطرون الآن على قطاع من الأراضي – المهمة للغاية استراتيجياً – على طول الحدود مع تركيا فإن ذلك يساعد على فتح مدينة حلب وأهداف أخرى رئيسية أمام المعارضة مع التخفيف في الوقت نفسه من مخاوف تركيا الأمنية حالياً.
والمشكلة هنا – كما سمعنا بشيء من التفصيل خلال زيارتنا – هي أن المعارضة العربية السورية التي تمثل الأغلبية والأكراد الذين يمثلون أقلية يختلفون بشدة حول "الفيدرالية" أو شكلٍ ما من أشكال الحكم الذاتي الكردي في سوريا ما بعد الأسد. غير أنه حتى هذا الانقسام العرقي الحديث والبارز بوضوح داخل المعارضة يوفر فرصة لقيام توسط خارجي خلاق. ولذا ينبغي على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة انتهاز هذه الفرصة من خلال العمل بصورة نشطة وقوية مع تركيا و"حكومة إقليم كردستان" في العراق وآخرين للتوسط من أجل التوصل إلى تفاهم سياسي استرضائي بين المعارضة السورية السائدة والأحزاب الكردية الرئيسية في البلاد. وليس فقط أن ذلك سوف يعجل بسقوط الأسد بل سيسهم أيضاً في تجنب قيام صراع عرقي خطير بعد رحيله عن المشهد.
ثالثاً: ربما كان الجانب الأكثر معنوياً في الأمر هو أن نظام الأسد قد عانى من اغتيالات وانشقاقات لكبار الشخصيات في الأسبوعين الماضيين. كما أن كوفي عنان قد استقال لتوه وبذلك أزال ورقة التوت الأخيرة للدبلوماسية المهترئة. الأمر حتى الآن جيد.
غير أن المشكلة هنا مثيرة للسخرية وبشكل مضاعف، حيث كانت تلك الأحداث مثيرة جداً على نحو جعل بعض المعلقين وربما بعض صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يسارعون الآن بالقول إن سقوط الأسد قد بات وشيكاً أو على الأقل حتمياً حتى بدون قيام أي تدخل خارجي إضافي. ولذا، على سبيل المثال، فإن التسريب الأخير عن المساعدات الأمريكية المتزايدة إلى المعارضة يشير على ما يبدو إلى "كشفٍ " استخباراتي قد تم التوصل إليه في الحقيقة منذ عدة أشهر ولا يشمل أية معونات بـ "السلاح". ولذا فإنه يبدو كما لو كان عذراً للتقاعس عن القيام بعمل ما، أكثر منه تطوراً سياسياً حقيقياً. لكن ومع غياب دعم خارجي حقيقي متصاعد للمعارضة فمن المؤكد أن سقوط الأسد سيستغرق وقتاً أطول بكثير وسيحصد المزيد من الأرواح وينتج محصلة أقل اعتدالاً أو استقراراً أو ديمقراطية مما لو لم تكن الحال على ما هي عليه.
إن حل هذه المشكلة هو من أبسط الحلول ويتمثل باستخدام المكاسب الأخيرة للمعارضة السورية كفرصة لإنهاء هذه الأزمة وليس كمبرر لإطالتها. وبعبارة أخرى، التحرك بعجل وحزم لزيادة المعونات الإنسانية والسياسية بل والعسكرية للمعارضة. وهذا يعني ليس فقط المساعدة بـ "السلاح المهلك بصورة مباشرة" بل أيضاً بالأسلحة المضادة للدبابات والطائرات التي يطلبونها ويحتاجون إليها لمقاومة الهجمات القاتلة الأخيرة التي يرتكبها النظام بلا هوادة.
ويؤدي منطق هذا الموقف إلى نقطة نهاية واحدة ربما كانت أكثر مخالفة لما هو متوقع أو مألوف. ففي خارج سوريا كان الجميع ينتظر أن تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة في هذه الموضوع، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة الأكثر تطوراً. إلا أن استطلاعاتنا الموثقة ومحادثاتنا الشخصية المكثفة داخل سوريا توضح بأن السوريين يتطلعون أولاً وقبل كل شيء إلى الدول الأوروبية مثل فرنسا أو تركيا لإنقاذهم. فلماذا إذاً لا تأخذ هذه الدول الأوروبية روح المبادرة وتترك الولايات المتحدة "تقود من الخلف؟" لقد نجح هذا الأمر في ليبيا في الربيع الماضي. والسؤال هنا لماذا لا يحدث هذا في سوريا الآن؟
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى