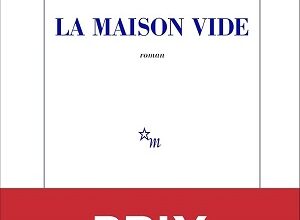الإسلام والمسرح بين التحريم وسوق الفهم (جلال خوري)
جلال خوري*
أحد روّاد العصر الذهبي للمسرح اللبناني يغوص في الخلفيّات الاجتماعيّة والسياسيّة والدينيّة لغياب أبي الفنون عن اهتمام الإسلام، رغم احتكاكه جغرافياً بثقافات تمارس المشهديّة كوسيلة لمقاربة الواقع.
كانت علاقة الإسلام بالمسرح ولا تزال موضع جدل مشغوف. غيابه في الدائرة الثقافيّة، الخاصة بالأمة المحمدية، يثير تساؤلات تتخطّى إطار الفنّ لتلاقي علمَي اللاهوت والمجتمع. تاريخياً، إذا أخذنا في الاعتبار ازدهار هذا الشكل في العالم الغربي، تبيّن لنا أنّ غياب المسرح في بلاد الإسلام أمر غريب، بعدما وصل به الإسكندر حتى أبواب الهند قبل 23 قرناً، وبعد الاكتشافات الحديثة التي أظهرت وجود حواريات مكتوبة في زمن الفراعنة، ألفي سنة قبل الميلاد، وأخرى من بلاد ما بين النهرين تعود إلى عشرة قرون قبل عصرنا هذا، ويبدو أنّها وُضعت، في كلتا الحالتين، لتتجسد على أيدي أشخاص.
في الفترة الزمنية التي كانت الحضارة الإسلامية تُكمل انتشارها، كان العمل جارياً في الهند لتحويل ملحمَتي «المهابراتا» و«الراميانا» إلى شكل من الرتب الموسيقية والكوريغرافية، فيما كان يُعمل في الصين، على تطوير رقص البلاطات الملكية في اتجاه مهّد الطريق أمام مسرح ذي أسلوب تعبيريّ فائق التزيين Hautement stylisé تميّزت به الفنون المشهدية لإمبراطوريّة الوسط. حتّى في الجنوب، على مساحة القارّة السوداء، كانت هناك مجتمعات وثنيّة توقّر الظواهر الطبيعية المعروفة بالمذاهب الحياتية Animistes، فتؤبد طقوساً احتفالية تَضيع جذورها السحريّة في الزمن. إذاً، كان الإسلام محاطاً، من كل جانب، بثقافات تمارس المشهدية كوسيلة مقاربة للواقع، وتظهير له، ولم يكن ليجهل هذه الأنماط التعبيرية، بحكم الاتصالات والتبادلات، فإذا فعل، فلا شكّ أنّ هناك أسباباً وجيهة، لا بد أن ننظر إليها بتمعّن.
بالنسبة إلى بعض المحللين، إنّ غياب المسرح في الدائرة الإسلامية، ناجم عن حظر صارم من الدين لكلّ ما هو تشخيص أو تصوير فنّي للإنسان. وبما أنّه لا يوجد في القرآن الكريم أي كلام واضح عن الموضوع، يعتمد أصحاب هذه النظريّة على حديث جاء فيه: «… إنّ الذِين يصْنعون هذه الصور يُعَذَّبون يوم القِيامة، يُقال لهم: أحيوا ما خلقتم» (البخاري 5607). لكن المستشرق لوي ماسينيون يفسّر هذا الحديث من منظار آخر، إذ يقول إنّ هذا الحكم «يعني بشكل غير مباشر التصوير… إنّه قيد يُقصَد به عبادة الأصنام لا الفن بحدّ ذاته».
تجب الإشارة هنا إلى أنّه ورد ما قبل الإسلام، في اليهودية أولاً، حِرْم مشابه جاء على الشكل الآتي: «لا تصنع لك تِمثالاً منحوتاً ولا صورةً ما، مما في السَماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض» (الخروج 20). في هذا السياق، نحن أمام تحريم شبيه بالذي حصل في القرن الرابع، بعد اعتناق الإمبراطورية الرومانية للمسيحية، عندما أقدم آباء الكنيسة على إدانة «هذا المسرح الذي يعجّ بالفحش ويحتفل بآلهة وثنيّين»، إدانة أسفرت عن منعه كلّياً، ما أدّى ألى «ثقب أسود» في تاريخ هذا الفنّ دام ستة قرون، قبل أن يتبلور، في بداية الألفية الثانية، في رعاية الكنيسة بالذات، نوع من المسرح خاصيّته دينيّة، نشأ في رحبة الكاتدرائيات ليُقَدّم، يا للمفارقة، كمزيّن ومفسّر للاهوت. أضف إلى سلسلة التحريم التي كان الدين سبب إقرارها، كراهية البروتستانت لكلّ ما هو تصوير أو تشخيص.
من جهة أخرى، تعزو مجموعة المفسّرين غياب المسرح عند العرب لجهلهم ما ابتُدع قبلهم من إنتاج فني كأعمال كبار كتاب التراجيديا الإغريقية أو الكوميديا الرومانية. لكن الحقيقة هي العكس تماماً. يذكر التاريخ أنّه في العصر العباسي، وفي عهد الخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون، تولّدت حماسة منقطعة النظير لترجمة تراث الحضارات السابقة، الإغريقية تحديداً. لكن هذه الحماسة، غالباً ما توقّفت عند التعليقات حول الفن («الشعر» لأرسطو)، لأنّ هموم حكّام بغداد، آنذاك، كانت تتمحور بشكل أوّلي حول الفلسفة، ومفاهيم الدولة، والدين، والعلوم المعنية بالواقع كالهندسة، والفلك، والطبّ… فبقيت الابتكارات الفنية خارج دائرة اهتمام العرب أو فضولهم، فمرّوا بها مرور الكرام. هكذا تُرجمت كلمة تراجيديا بمفاخر أو فواجع، وكلمة كوميديا بمساخر أو هجاء، بما يدلّ على أنّ عدم الدقة في التسمية قد يشير إلى عدم التعامل الجدي مع الموضوع، وتالياً عدم الاهتمام به.
لكن هناك من يرى أنّ للعرب أشكالاً مسرحيةً مميّزة، خاصة بهم، مثل خيال الظلّ، مسرح الدمى الذي جاءهم من الشرق الأقصى (جزيرة جافا في أندونيسيا)، وازدهر في مصر أوّلاً، في عصر الفاطميين، وترك آثاراً مكتوبة تمثّلت في أعمال ابن دانيال، قبل أن ينتقل إلى اسطنبول، ويأخذ الشكل المعروف بالكراكوز الذي انتشر تحت أسماء مختلفة على مساحة الإمبراطوريّة العثمانية. ومن ابتداع زمن الفاطميّين أيضاً: الحكواتي.
الحكواتي هو الراوي الذي يحيي سهرات رمضان بتلاوة الملاحم الفروسيّة كسيرة عنترة بن شداد، أو أبي زيد الهلالي، أو الزير… يَعتبر البعض هذه السِّير ومهارة الراوي الأدائية مسرحاً بحدّ ذاته، نظراً إلى الجانب التمثيلي الذي تتسم به في بعض الأحيان، وتفاعل الحضور معه ومع الطابع المثير للأحداث المرويّة.
بشكل عام، يتميّز فن الحكواتي كونه يتوجّه إلى مخيّلة السامعين، ما يشكل _ بالنسبة إلى البعض _ فناً عربياً راسخاً، فيدعم بذلك نظريّة القائلين إنّ الشعوب السامية تتوق بشكل خاص إلى التجريد، بعكس آخرين يهوون التجسيد كما يظهر ذلك في المسرح والفنون الغربية. يجب الإشارة هنا للتوضيح لا للانتقاص إلى أنّ الحكواتي يقرأ فقط، وينشد أحياناً مقاطع شعريّة من الملاحم المذكورة. التِّلاوة عنده تقف عند هذا الحدّ، فلا يضيف بتأديته شيئاً جوهرياً على المكتوب. إنه يختلف كلّ الاختلاف عن رواة المجتمعات التقليدية للقارة السوداء، الغريبة منها، في الأخص هؤلاء المعروفين بالـ«غريّو» Griots، المنحدرين من أسر متخصّصة في التراث، يتوارثون المعرفة والخبرة أباً عن جدّ. إنّهم في الدرجة الأولى، ممتهنون التوصيل Communicateurs، مؤتمنون، عبر تعابير شفهيّة وموسيقيّة، مرمّزة وعفويّة في آن، على تاريخ الأسر وأنساب الجماعات Généalogies. دورهم إحياء التقاليد العريقة بالمحافظة على الذاكرة الجماعية، وتأويلها، وإنعاشها، وعصرنتها في وجدان الحضور.
الزجل، كما هو معروف، هو الفن الشاعري الشعبي المنشود أو المتمحور أحياناً حول مجادلات أو مبارزات مرتجلة. إنه، على تنوّعه، شائع في أنحاء عدة من العالم العربي. يعتبر البعض الزجل، بفعل لعبة التخاصم التي يتسم بها، وخصوصاً في لبنان منذ القرن التاسع عشر، رديفاً للمسرح كونه منبريّاً، وشفهيّاً، وفي مكان ما، تصدامياً، علماً بأنّ الزجل لا يتعدى المواقف الفكريّة، أو الأخلاقيّة، أو الجماليّة، فلا تابعة مصيريّة أو ذيول مباشرة له على من يشارك فيه، كما هي الحال بالنسبة إلى الشخصيات الدراميّة.
وأخيراً التعزية، التمثيليّة التي تُحْيي مأساة الإمام الحسين في كربلاء سنة 680، وتُقام في إيران، والعراق، ومنذ القرن الماضي، في لبنان (ابتداءً من سنة 1916 تحديداً) في العاشر من شهر محرّم. التعزية تكوّنت في بلاد فارس في القرن الحادي عشر الميلادي، في ظلّ سلالة بني بويه، لكنها لم تأخذ شكلها الحاليّ إلا بعد مجيء الصفويين، بداية القرن السادس عشر.
التعزية هي تجسيد مهيب لحدث مفْجع، الهدف منه الاحتفاء، أو المشاركة من خارج الزمن، بمأساة حفيد الرسول. وبكونها إعادة مآثِر، قد تكون التعزية الشكل الأقرب إلى المسرح كما هو متعارف عليه، نظراً إلى طبيعتها الصداميّة، وبنيتها الدراميّة (قصد، نزاع، يؤول إلى تغيّر حال)، والقَدَر المحتوم لأبطالها. مع الفارق بين مأساة الإمام الحسين وشخصيات التراجيديا الإغريقيّة، إنّ سلوك حفيد الرسول ناجم عن إيمان مطلق، ويقين راسخ بأنّ ما يفعله يستجيب للمشيئة الإلهية، ويحقّق مرادها، في الوقت الذي نرى فيه شخصيّات التراجيديا تتصرّف انطلاقاً من خيارات ذاتيّة، فرديّة، مرتبطة بدوافع خاصّة بها، غالباً ما تتنافى مع السلوك العام أو القيم السائدة (مثال على ذلك، تصرّف أنتيغونا التي بادرت إلى دفن أخيها بولينيس الذي كان قد التجأ إلى أعداء مدينته طيبا، على أثر خلاف على السلطة. أنتيغونا أقدمت على عملها من منطلقات أخلاقيّة خاصّة بها، رغم الحِرم الصارم الذي أصدره خالها كريون، حاكم المدينة).
بقيت التعزية ظاهرة فريدة ووحيدة، محصورة في مناسبة عاشوراء، مع الإشارة إلى أنّ هناك في إيران أعمالاً مسرحيّة كُتبت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في ظلّ انتشار المسرح الغربيّ، وفي الشكل المعهود لهذا الفنّ، وتناولت مواضيع مرتبطة بالإسلام وتاريخه من دون أن تتطرق إلى جوهر الدين، كما، على سبيل المثال، عند موليير في «دون جوان»، الفاسق الشهير، أو في النسخات المتعددة لـ«فاوست»، الرجل الذي باع روحه للشيطان، وبالأخص مسرحية «الدكتور فوستوس» لكريستوفر مارلو، المؤسس لدراما العصر الإليزابيثي.
في المقابل، لدينا فرضيّة مفادها أنّ غياب المسرح عند العرب مردّه، بكلّ بساطة، إلى عدم شعور هؤلاء يوماً بالحاجة إليه لكي يقتبسوا، أو يستلهموا، أو يحرّموا. لتوضيح ذلك، يحب التذكير بأنّ المسرح الذي نتكلّم عنه هو النموذج الغربيّ، المعروف في ماهيّته، وبنيته، وجوهره كفن صدامي، كما أوضحنا مراراً، تولّد في بلاد الإغريق منذ 25 قرناً، على أثر تطورات سياسيّة واجتماعيّة أفضت إلى ظهور حضارة اتسمت بالفرديّة والمعاناة، نتيجة الكفّ عن الاحتكام إلى الماورائيات، وارتداداً على إصلاحات سياسيّة تمثلت في الديموقراطيّة، وأدت إلى فكّ الارتباط بين الفرد والجماعات القبليّة. هكذا برز هذا الفن مواكباً لعمليّة إزاحة نظام مصدره الآلهة، واستبداله بآخر يرتكز على تشريعات دنيويّة، وترتيبات قانونيّة من ابتكار البشر تماشياً مع متطلباتهم التنظيميّة.
بعكس ذلك، ترسّخ الإسلام في دائرة المقدّس، في نظام سماويّ، إذا صحّ التعبير، فجاءت شريعته من وحي إلهي، وتكوّنت الأمة المحمديّة كجامعة المؤمنين، الأسرة الكبيرة الحاضنة لكلّ الأسر التي يقع على عاتقها توطيد وحدة أعضائها، وتماسك الجسم الاجتماعي، وتحدد سلوكيّة الجميع، بالإضافة إلى تعيين هامش الحريّة والمسؤولية لكل فرد من أفرادها.
في لحظات موصوفة من تاريخه، كان المسرح الغربي الإطار المميز للتعبير عن هواجس حضارة تركت الفرد وحيداً، بلا استنجاد ولا مسلّمات إيمانيّة أو غيبيّة يرجع إليها، أو يستلهم منها سلوكه سوى نفسه، فوجب عليه أخذ القرارات الجوهريّة والأخرويّة Eschatologiques بمفرده والتي شكّلت مصدراً للمعاناة والقلق، على غرار «فاوست» غوته الذي «يبحث عن النور في بلبلة نفسه». إن المسلم بقي في منأى عن تلك التساؤلات التي عانى منها الفرد في الغرب، فلم يكن يوماً في حاجة إلى فنّ تميّز بكونه وسيلة تعبير عن هذه المعاناة، ومحاولة التعامل معها. بغض النظر عن وجود أو غياب حِرْم، من البديهي القول إنّ الدين يستجيب بشكل شامل وكلي للتساؤلات الشمولية للمؤمنين، من معنى الحياة، إلى مبرر الوجود، مروراً بالمصير النهائي للإنسان… أمام هذا الأمر، هل للدراما الصداميّة التي تعبّر عن نفسها في المسرح على الطريقة الغربيّة، أي مبرر أو دور جوهري في الدائرة الثقافيّة للإسلام؟
*مسرحي لبناني
صحيفة الأخبار اللبنانية