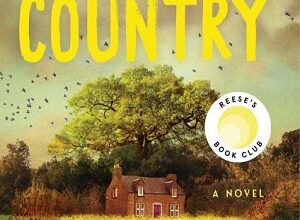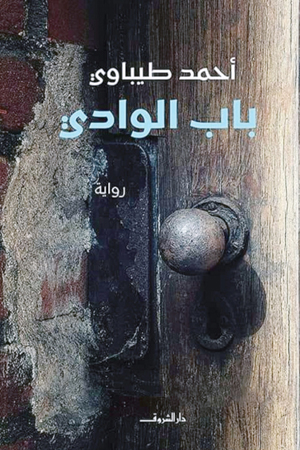
روايةُ الكاتب الجزائري أحمد طيباوي (1980) الجديدة «باب الوادي» (دار الشروق ـــ 2023)، روايةٌ ملحميةٌ في التاريخ والحب والسياسة، وهي روايته السادسة بعدما حاز «جائزة نجيب محفوظ للأدب» (2021) عن روايته «اختفاء السيد لا أحد». بصوت قادم من حي باب الوادي، أحد أشهر الأحياء الشعبية في العاصمة الجزائرية، يقصّ أحداث الحكاية، ويقدمُ للقارئ باباً مفتوحاً على تاريخ الجزائر، واضعاً مسألة الهوية ضمن إطار زمني امتدّ من زمن الاحتلال والثورة، وحتى وقتنا الحالي. تحكي الرواية عن السياسة وعن آثارها تحت سطوة المحتل، وبعد ثورةٍ منحت كل بطلٍ من أبطالها وعياً مختلفاً عن الآخر. بعضهم أراد الحرية الحقة، وآخرون عاشوا مقموعين داخل انتماءاتهم الدينية والسياسية، ما منح الحكاية بعداً سياسياً، على الرغم من تركيزها على الشخصي فيه، إلا أنه بعدٌ صنعه أبطالٌ صاغوا العالم تبعاً لأفكارهم وانتماءاتهم الذاتية.
يمنح الكاتب أبطاله أصواتاً متوازنة الحضور من دون أن ترجح كفة الضحية على كفة الآثم.
يسمح للجميع بالتحرك والسرد، ولربما في بعض المواضع نلمس محاولة بعض الشخصيات التمرد على راويها والتملص من الحكاية نفسها، كما يفعل كمال، حين تُثقِلُ عليه حياته ويفترضُ أن مصيره بيد راوٍ يتحكم بها، فيركن إلى فكرة التحرر من سلطة قلمه. إذ يُشكل عيشه في باب الوادي، موئلاً يتشعب منه الراوي لحياكة قصص أخرى. وكمال الذي أمضى ردحاً من عمره مع أمه وخالته وخاله يحاول معرفة أبيه، إذ لطالما شعر بأسرارٍ تحكم عالمه، وأسهمت نظراتُ خاله المشككة، وزلات لسانه لتزرع الحيرة في قلبه. يدرك الطفل باكراً أنه ابن لحكاية غامضة، ويقلقه شعور عارم بالخزي، لا يعلم إن كان لقيطاً، ولا إجابات تشفي شكوكه، ما خلا حكاية محكمة الإخفاء، تتناسل بعد أن يكبر وينخرط في رحلة البحث عن أبيه الحقيقي، وحتى يكتشف أنه عاش ضحية تلفيقاتٍ دفعتهم للتكتم على الخطيئة.
«لم يكن الماضي هو الذي يسجنه، بل هو من كان يسجن عقله وقلبه عنوةً في ذلك الماضي». من هنا يبدأ كمال رحلة البحث عن الهوية، ويضمر الكاتب عبرها رصد الأحداث التاريخية في البلاد، من خلال نكوص زمني، وكتابةٍ تشتبك بمن فقدوا مصائرهم، وفقدوا أوطانهم، وحُكِم عليهم أن يبدؤوا حياتهم في أماكن أخرى، ما جعل كتابة الروائي كتابة ملحمية، وهي لا تُظهِر الصراع فقط من جانب الشخصيات، إنما تسِم أفعالها بعنفٍ وطد من شتاتهم النفسي.
فالصراع بين كمال وآسيا من جهة وبين كمال ومريم عنوانُه الرغبة والخوف من الوقوع في الحب، والصراع ما بينه وبين خاله يحيى يسوّغه المال والجشع، فيما ينمو صراعٌ من نوع آخر بين عبد القادر بن صابر وبين خوفه من أن تجعل زوجته الأجنبية ابنهما أوروبي الطباع، وتغيّر له دينه. هذا إلى جانب عقدة فتيحة وحرمانها من الأمومة، وهو ما دفع عبد القادر لاختلاق كذبة موت الجنين ومنحه لها، ما منح الكذبة أيادي وأذرعاً، ومنح الطفلَ كمال مصيراً شائكاً، كأن الكاتب بحث عبرهُ عن روح البلاد، ليس باعتبار المكان بطلاً للرواية، إنما امتداداً للإنسان، ومؤثراً في عالمه.
يطرح الكاتب هموم شبان هاجروا وتلقفتهم قوارب الهجرة، وآخرين حلموا عبر الانتماء إلى تنظيمات متشددة بالسطوة، فانتهوا رهائن للتعصب والسواد. وهو ما كرّس للعنف الذي ظهر في شتاتهم بعد مرور الزمن، وفي ضمائرَ أعياها صوت الحق الصارخ. نجد ذلك جلياً في حكاية عبد القادر بن صابر والد كمال الحقيقي، وقصة عيسى البوسعادي، وميل تلك الشخصيات لتكون رهناً لانتهاك العرف الاجتماعي والهرب مما اقترفته قبل سنواتٍ طويلة. عبد القادر كشخصية عاصرت أحداثاً سياسية، لم يفلح زواجه من فرنسية في تبديل الماضي الغائر فيه. ذلك الخوف من معاندة العرف المزروع في ذاته، دفعه لمنح ابنه لفتيحة في الجزائر، ما جعله رجلاً غارقاً في الماضي، ومملوءاً بالذنب، وهو ماضٍ نما في الشعور بالخطيئة إزاء طفل حرمهُ من هويته الحقيقية.
من صورة بطل ممزّق يسعى لتجاوز حياته المزيفة، وشاب يبحث عن ولادة جديدة، يرحل كمال محمّلاً بسؤاله الكبير، يستجدي العارفين به، وهو ما جعله يهرب طوال حياته من مواجهة ذاته والآخرين، وجعله عاجزاً، جراء تكريس حياته للبحث عن سؤال هويته؛ وهو سؤال من الماضي وعنه، قادم من الآخرين وعنهم، ما منحه ذلك الاغتراب في شخصيته، ومنحه دور الضحية. تلك المراوحة بين الماضي والحاضر، والإخفاق في كشف الحقيقة، جعلته شاباً مستكيناً، يحيا في الانتظار. إذ نجده في النهاية، وبعد اكتشاف الكذبة، مطالَباً بالصفح عن الجناة، بكل تلك البساطة، ووفق سرد يهدر عمراً من الحزن، وحكاية طافحة بالتيه، يطلبُ من الضحية أن تسامح الجلاد، ما يجعل من قصة الجناة والقضاة قصةً أزلية، تتحرك في كل الأزمنة، وينجرف كمالٌ معها حين يدرك أنها لم تكن قصته وحده، بل كانت قصة أمّ تبنّته لتخمد حرمانها، وقصة أبٍ تكتّمَ خوفاً من الفضيحة، وحبيباتٍ عشن في مدار حكايته من دون أن يقدرْنَ على تحريره من ثقل الانتظار.
يعلم كمال أنه بعد موت فتيحة، أمه الوهمية، عاش حياته من دون شغفٍ، إلا أن الحقيقة التي خلص إليها في النهاية كانت أفضل من حياةٍ صنعتها الأكاذيبُ والأوهام. «تاريخ الإنسان هو تاريخ هروبه من السقوط، وهو قرر أن يكون مختلفاً. لا شيء أقوى من الحتمية، وسينجرف معها بكامل ضعفه واستسلامه. عندما يموت، سيكون قد عاش حياته بدون شغف تقريباً، لكنها لن تكون في النهاية حصيلة من الأوهام والخيبات المروّعة».