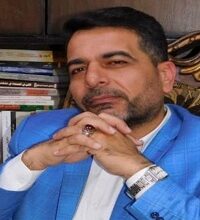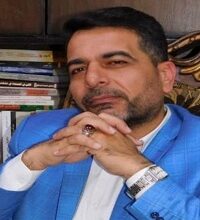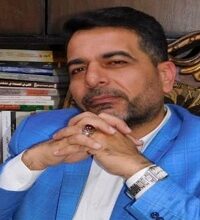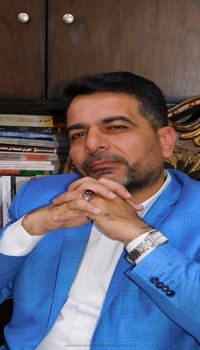
يمكننا القول: إنّ المسرح، بكل ما فيه من أدبٍ وفنٍّ وثورة على الخلل المتمكّن من حيواتنا، يمثّل الركيزة الأهمّ في التنوير والنهوض، وهو اللّوحة الأبهى في تجسيد العلاقة الفلسفيّة الأدبيّة الفنّيّة، ففيه يجد المتلقّي الأدب بكلّ ما فيه من رهافة الأديب وإبداعه، وفيه يتجلّى جمال العلاقة بين الفلسفة والأدب، في النصوص المسرحيّة وتمثّلاتها على الخشبة، ومن خلالها يمكن مشاهدة تفاعل مفاهيم فلسفيّة معقّدة، خاصّة تلك التي تتعلّق بالوجود، اللغة، والمعنى. ولعلّ المتابع لأعمال المسرحيّين الكبار في الغرب مثل: برخت، أونسكو، وصامويل بيكيت، يعرف تماماً كيف أجاد هؤلاء وأمثالهم في استخدام خشبة المسرح لطرح أسئلة فلسفيّة حول الحقيقة والمعرفة والإنسانيّة. فثمّة أعمال مثل: “أنتيجونا” و”في انتظار غودو” تسلّط الضوء على العزلة الوجوديّة والتساؤلات حول المعنى والهدف في حياة الإنسان. وفي مسرح برخت، على سبيل المثال، يظهر جلياً كيف يمكن استخدام الفنّ لإيصال رسائل فلسفيّة عن الظلم الاجتماعيّ والسلطة، بينما في مسرح يونسكو، يتجلّى الشعور بالعبثيّة، ويُطرح تساؤل حول المعنى في عالم لا منطق له. وهو ما يؤكّد مقولة أنّ المسرح ليس مجرّد وسيلة للترفيه، بل أداة لتفكيك المفاهيم الفلسفيّة المعقّدة وتسليط الضوء على التوتّرات بين الفكر والفنّ، ومن هنا تكون الشرارة المعرفيّة والأدبيّة والفنيّة لإطلاق المشروع التنويريّ مجتمعيّاً، إذ إنّ هذا المشروع لا يمكنه النجاح إذا كان بعيداً عن الهمّ العام ووجع الشارع أو منسلخاً عنه.
ولعلّ هذا الجانب كان الأكثر حضوراً في النصوص والعروض المسرحيّة السوريّة للآباء المؤسّسين، حيث اشتغل هؤلاء على تكريس الجوانب الإنسانيّة التي تدحض الظلام والعنف والاستبداد وتعمل على اجتثاثه، وكانت الأعمال المسرحيّة النوعيّة تقف له بالمرصاد، تحاربه وتكافح من أجل تكريس البديل والوجه الآخر الأفضل، وهذه الأعمال لا تعدّ ولا تحصى، ولعلّ (سهرة مع أبي خليل القبّانيّ) للسوريّ (سعد الله ونّوس)، تأتي في طليعة هذه الأعمال فقد طرح في سهرتهِ مسيرة رائد المسرح العربيّ والصعوبات السياسيّة والدينيّة، التي اعترضته، وأخرجته من أرضه، وكأن سعد الله ونّوس أراد أن يوجّه التحيّة لرائد المسرح التنويريّ العربيّ بعد سنوات على رحيله وبعد الظلم الكبير الذي تعرض له من أعداء الحرية والنوير في بلاده وخارجها، وقد جاءت سعد الله ونوس للقباني بعد أن كاد وهج المسرح التنويري يخبو تماماً بفضل التحالف الشيطانيّ بين الدين والسلطة ورجال المجتمع المرضى، ولهذا لا غرابة أن يتصدى الفكر الرجعي لأبي خليل القبّانيّ ويسعى لإحراقه والتخلص منه، ومنعه من العمل والعرض، لا سيمّا أنّه يحمل عمقاً فلسفيّاً وثورة تنويريّة فنّيّة، وهو ما كان حاضراً بقوّة في عرض (يوم من زماننا) للمسرحيّ السوريّ الرّاحل (سعد الله ونّوس) أيضاً، حيث عرضت مسرحيته مع غيرها من النصوص المسرحيّة الأخرى على مساحة الوطن العربيّ لعشرات المرّات، داخل سورية وخارجها، ليؤكّد من جهة أخرى أنّ المبدع السوري يمتلك الرؤيا الفكريّة العميقة والهمّ الإنسانيّ، الذي يجعله يناقش هموم الواقع العربيّ كلّه، وقد قارب النصّ الواقع العربيّ ونقد الفكر المتطرّف والمغالي بأفكاره وفتاويه المستكينة للجهل وتعمية العقل، وقد استمرّ المسرح بنقد الفكر الأسود وتعريته عبر أعمال مسرحيّة كثيرة، نهضت بمسؤوليتها تجاه الناس، وحقّقت دورها التنويريّ الذي يتحدّى الفكر المتخلّف بكلّ وجوهه وأشكاله، ولا سيّما من خلال مضامين حملت أبعاداً إنسانيّة راقية في كلّ الاتجاهات، بكلّ ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وبُعد، وقد مجّدت الأعمال المسرحيّة السوريّة ضرورة احترام الإنسان، وضرورة احترام الفكر الآخر، والثقافات الأخرى والحضارات، وكم من عرض مسرحيّ قَدّم في سياق أحداثه صوراً عن ثقافات الشعوب الأخرى وفنونها وحضاراتها، ولا مبالغة إن قلنا، إنّه لم يخل عمل مسرحي سوري من الفكر التنويريّ بشكل من الأشكال، حيث اكتظّت عروض المسرح السوريّ بها، وقد شغلها البحث عن الرؤية الإنسانيّة الأفضل والأمثل عبر مقولاتها، كي تقدّم بشكل دائم أجوبة المعادل الايجابيّ، الذي يواجه ويعاكس الفكر الجامد والمنغلق على نفسه، وهو ما نجده حاضراً بقوّة في مسرح أبي خليل القبّانيّ الذي حقّق حضوراً لافتاً في كثير من الدول العربيّة ودول العالم.
ولم تكن الأفكار التنويريّة والتثويريّة في المسرح السوري مقتصرة على الاهتمام المحلّيّ، وإنّما تعدّتها إلى العربيّ البعيد جغرافيّاً، كما هو الحال في مسرحيّة “الغضب” لمصطفى الحلّاج الذي عالج ويلات التعذيب الوحشيّ الذي يطال المناضلين الجزائريّين دون حياء أو خجل، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على تشابك القضايا وتداخلها في المسرح السوريّ خصوصاً والعربيّ عموماً، وهو تشابك من شأنه أن يساهم في تنويرٍ عربيٍّ شامل لولا همجيّة الحرب السلطويّة عليه ومحاربته بشتّى أنواع الأسلحة من الظلاميّين وأصحاب الفكر الرجعيّ على حد سواء. وهو ما ألهم المسرحيّين السوريّين مجدّداً من خلال عروضهم واشتغالاتهم، كما هو الحال في الرّائعة المسرحيّة للأخوين ملص والتي عرضت في دمشق أيار ٢٠٢٥ تحت عنوان “كلّ عار وأنتم بخير”، وركّز العرض بشكل أساسيّ على أحلام وطموحات ومشاريع المثقّفين التنويريّن، وهي المشاريع المنكسرة أمام أوهام العسكر العقائديّة وأعوانهم من سادة الجهل والظلام، ولهذا فقد تعرّض هذا العمل لمحاولات كثيرة لإجهاضه وقتله في مهده، بسبب ما يشكّله هذا الفكر التنويريّ من تهديد لأصحاب المشاريع الظلاميّة والأفكار المتخلّفة.
ولعلّ أبرز ما اتّسم به العمل الرائع للأخوين ملص، تركيزهما في مسرحيّتهما على الاختلاف الكبير بين المثقّف والعسكريّ، والنّاجم عن تباين الثقافة والتعليم والمجتمع المحليّ لكلّ منهما، لكنّهما انتهيا للخيبة ذاتها، فلا أحلام الشعر والشهرة والارتباط بالحبيبة تحقّقت للأوّل ولا كوفئ العسكريّ على تفانيه عندما كبر وتقاعد، ويركّز الأخوان ملص، في عملهما على تناقضات أوسع في المجتمع، أسقطاها على شخصيتي “يوسف” و “رامز”، وفيه يظهر الخلاف الجليّ بين الفكر العلمانيّ والدينيّ، وبين صراع الأفكار والسلاح. ولعلّ المفارقة الكبيرة والصادمة هي أنّ الأفكار والعروض المسرحيّة التنويريّة مازالت حتّى اليوم تتعرّض للحروب ومحاولات إسكات الصوت تماماً كما حدث مع رائد المسرح التنويريّ السوريّ والعربيّ أبي خليل القبّانيّ قبل أكثر من قرنٍ ونصف من اليوم ( ١٨٣٣- ١٩٠٣)، والذي أجبره على الارتحال من دمشق إلى شيكاغو مروراً بعدد من العواصم والمدن العربيّة، بعد انقسام الدمشقيين خصوصاً والسوريين عموماً حول أعماله بين مؤيّد ومعارض. وكان لإظهار الفئة المتنوّرة استمتاعها بمسرحيّاته عامل دفاع عنه، وتثميناً لجهوده، وتقديراً لهذا الفنّ الجميل، كما كان لخصومه، المدعومين سلطويّاً، أكبر الأثر في رفع عريضة إلى الوالي، تطالب بإغلاق مسرحه وإيقاف نشاطاته، ما أدّى إلى ثورة الدمشقيّين استنكاراً لها، الأمر الذي مثل حالة من الصراع بين كتلتين، تقليدية وتحديثية تنويرية، بعد هذا وجد القباني نفسه مضطراً إلى مغادرة دمشق إلى بيروت، ومنها إلى مصر، درءاً لحدوث شرخ وفتنة في المجتمع الدمشقي، وحذراً من الاصطدام برجالات السلطنة العثمانيّة، لتبدأ المرحلة المصريّة من نشاطه العريض في المسرح، والتي تخلّلتها رحلته الشهيرة إلى شيكاغو، ثمّ عودته إلى مصر، فالرجوع الأخير إلى دمشق.
وهنا يمكن للقارىء والمتابع أن يسأل بحرقة وألم: إلى متى يستمرّ الخوف من الفكر التنويريّ في مختلف الأجناس الأدبيّة، وإلى متى يبقى فكرنا ومسرحنا وأدبنا ركيزة أساسيّة في تنوير الآخرين ونهضتهم، فيما يبقى البعض متباهياً بقتل آبائنا التنويريّين من فلاسفة ومسرحيين وأدباء والرقص على جثثهم بعد تشويهها وتقطيع أوصالها؟!.
لاشكّ.. سيظلّ المسرح منذ أبي خليل القبّانيّ إلى اليوم، ساحةً للمعرفة والحريّة، ومساحةً يلتقي فيها الفنّ بالفكر، والإنسان بالإنسان. وإذا كانت القوى الظلاميّة قد نجحت مراراً في محاربة العروض وإقصاء المبدعين، فإنّها لم تستطع إطفاء شرارة السؤال ولا إلغاء أثر المسرح في الوعي، ولا بدّ من العمل على استعادته كأداة للتنوير وبناء مجتمع أكثر عدلاً وحريّة.
بوابة الشرق الأوسط الجديدة