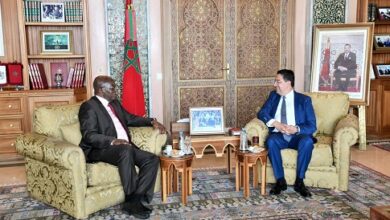كان بمقدور الولايات المتحدة الأميركية أن تتأقلم باستمرار مع طموحات المشروع الصهيوني. غير أن جموح هذه الطموحات، خاصة بعد وصول اليمين الديني المتطرف إلى السلطة في “إسرائيل”، بات يشكل عبئاً قد لا تستطيع واشنطن تحمله.
تبنّي الولايات المتحدة الأميركية للمشروع الصهيوني في المنطقة لا يحتاج إلى برهان، فمن المسلّم به أنها أنقذته في مراحل مفصلية من تاريخ تطوره، ولولاها لما أمكن، على سبيل المثال لا الحصر، تمرير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين عام 1947، والذي استند إليه إعلان قيام “الدولة اليهودية” من جانب واحد في 14 أيار/مايو 1948.
أسباب هذا التبني معروفة للكافة، ولم تعد موضع خلاف يذكر بين الباحثين، غير أن الخلاف ما زال محتدماً بين الباحثين بشأن المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التبني، أي حول طبيعة وحدود المشروع الصهيوني الذي يمكن أن تتطابق مصالحه مع مصالح الولايات المتحدة أو، على الأقل، ترى الولايات المتحدة أن دعمه لا يشكل عبئاً استراتيجياً عليها.
فحتى سنوات قليلة مضت، كان بمقدور الولايات المتحدة الأميركية أن تتأقلم باستمرار مع طموحات المشروع الصهيوني، ومع تحولات النظام الدولي في الوقت نفسه.
غير أن جموح هذه الطموحات في السنوات الأخيرة، خاصة بعد وصول اليمين الديني المتطرف إلى السلطة في “إسرائيل”، بات يشكل عبئاً قد لا تستطيع الولايات المتحدة تحمّله في ظل المرحلة الحالية من مراحل تطور النظام الدولي، والتي تتسم باشتداد المنافسة الكونية بينها وبين كل من روسيا والصين، وتلك مسألة هامة لم تحظ بعد بما تستحقه من نقاش على الصعيدين الاستراتيجي والجيوسياسي.
لقد كان على الولايات المتحدة، حين راحت تهيئ نفسها للعب دور كوني في نظام عالمي ثنائي القطبية استقر في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أن تضبط علاقاتها بأطراف الصراع العربي-الإسرائيلي في مرحلة ما بعد هدنة 1949، في ضوء الأهداف الجيوسياسية التي سعت لتحقيقها في تلك الفترة، ألا وهي احتواء الاتحاد السوفياتي ومحاصرة نفوذه في العالم من خلال تطويقه بسلسلة من الأحلاف العسكرية.
ولأن موسكو سارعت إلى الاعتراف بـ”الدولة” الإسرائيلية فور الإعلان عن قيامها عام 1948، فقد تصورت الولايات المتحدة أن قدرتها على احتواء النفوذ السوفياتي في منطقة الشرق الأوسط تتوقف إلى حد كبير على قدرتها على التوسط لإيجاد تسوية للصراع العربي -الإسرائيلي بالطرق السلمية، وهو ما حاولته فعلاً مع مصر الناصرية خلال الفترة من 1953-1955. غير أن ميلها الطبيعي إلى “إسرائيل” حال بينها وبين لعب دور الوسيط النزيه، ما أدى إلى فشلها في تحقيق الهدفين معاً، أي في تسوية الصراع العربي-الإسرائيلي واحتواء النفوذ السوفياتي، وهو ما بدا واضحاً عقب إقدام مصر على إبرام صفقة الأسلحة التشيكية عام 1955.
ومع ذلك، فإن تصاعد المد القومي العربي بقيادة مصر الناصرية فرض على الولايات المتحدة ضرورة توخي الحذر في علاقتها بـ”إسرائيل”، وهو ما تجلى بوضوح إبان أزمة السويس عام 1956، ومن ثم فقد شهدت العلاقات الأميركية -العربية بعض التحسن خلال الفترة التي تلت أزمة السويس وحتى قرب منتصف الستينيات.
حينها، بدت الولايات المتحدة حريصة على عدم الظهور بمظهر الحليف الرئيسي لـ”إسرائيل”، رغم أن ذلك لم يمنعها من تشجيع بعض الدول الأوروبية على تلبية كل الاحتياجات الإسرائيلية من السلاح الغربي، لكن العلاقات الأميركية -العربية سرعان ما عادت للتوتر من جديد عقب مصرع كيندي وتولي جونسون السلطة، إلى أن وصلت إلى ذروة توترها إبان حرب 67 التي انحازت فيها الولايات المتحدة بشكل مطلق إلى جانب “إسرائيل”.
ولا شك أن حرب 67، بما أسفرت عنه من نتائج جيوسياسية بالغة الخطورة، شكلت نقطة تحول كبرى في تاريخ العلاقات الأميركية -الإسرائيلية. فقد عدّت الولايات المتحدة الانتصار الكاسح الذي حققته “إسرائيل” في هذه الحرب انتصاراً للسلاح الغربي على السلاح السوفياتي، وبالتالي يؤهل “إسرائيل” للعب دور الحليف الأكثر قدرة على كبح جماح النفوذ السوفياتي في المنطقة.
صحيح أن الانتصار العربي في حرب 1973 تحقق باستخدام سلاح سوفياتي، غير أن هنري كيسنجر سرعان تمكن من سرقة نتائج هذا الانتصار، حين نجح في إقناع السادات بأن بوسع الاتحاد السوفياتي أن يقدّم سلاحاً للعرب لن يحقق لهم النصر على “إسرائيل”، أما الولايات المتحدة فهي الدولة الوحيدة التي يمكنها المساعدة في التوصل إلى تسوية متوازنة، محققاً بذلك أهم اختراق استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الباردة.
فبعد حرب 73 تراجع النفوذ السوفياتي كثيراً في المنطقة، ثم راح يتراجع بمعدلات مختلفة في أنحاء متفرقة من العالم إلى أن اختفى نهائياً مع تفكك وانهيار الاتحاد السوفياتي نفسه في بداية التسعينيات، ما مكّن الولايات المتحدة، ولأول مرة في تاريخها، من الهيمنة المنفردة على قمة النظام الدولي.
بوسع كل متأمل لمسار العلاقات الأميركية -الإسرائيلية منذ ذلك الحين أن يكتشف أن هذا المسار اتسم بوجود ظاهرتين متوازيتين في التوقيت ومتناقضتين في النتائج، الأولى: ترسخ الاعتقاد لدى الإدارات الأميركية المتعاقبة بأن كل ما يحقق مصلحة لـ”إسرائيل” ينطوي في الوقت نفسه على مصلحة أميركية مؤكدة، ما أدى في النهاية إلى تسابق الرؤساء الأميركيين على خدمة المصالح الإسرائيلية أولاً، والاستجابة بشكل أعمى لكل مطالبها في المنطقة، بصرف النظر عن طبيعة النخبة الحاكمة في “إسرائيل”.
الثانية: تحول النظام السياسي في “إسرائيل” تدريجياً إلى نظام يميني متطرف يسعى بكل الوسائل المتاحة لتصفية القضية الفلسطينية بدلاً من تسويتها، إلى أن وصل إلى شكله الحالي كنظام فصل عنصري توسعي استيطاني يرفض من حيث المبدأ كفالة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ما أدى في نهاية المطاف إلى عملية “طوفان الأقصى”.
الآن، وفي ظل استمرار الانحياز الأميركي المطلق لـ”إسرائيل”، والذي وصل إلى ذرى غير مسبوقة في مرحلة ما بعد “طوفان الأقصى”، فقد بات على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كان بمقدورها تحمل النتائج المترتبة على هذا الانحياز الأعمى في ظل تحولات عميقة طرأت مؤخراً على النظامين العالمي والشرق أوسطي، وبالتالي تفرض عليها إدخال تعديلات جوهرية على سياستها الشرق أوسطية إذا أرادت الاحتفاظ بما تبقى لها من مكانة في المنطقة وفي العالم.
ولأن إدارة بايدن بدأت تشعر أنه لم يعد بمقدورها التخلي عن “إسرائيل” وفي الوقت نفسه لا تستطيع دفع “إسرائيل” إلى ترشيد سياساتها، فقد بدأت قطاعات واسعة من النخبة الأميركية تشعر بعمق المأزق الذي وصلت إليه بسبب سياستها المنحازة لـ”إسرائيل”، والتي أصبحت تتناقض بشكل صارخ مع المصالح القومية الأميركية.
لم يكن حرص إدارة بايدن على تقديم دعم غير مشروط لـ”إسرائيل”، عقب عملية “طوفان الأقصى”، بالأمر المستغرب، ومع ذلك يشي سياق الأحداث اللاحقة بأن هذه الإدارة بنت حساباتها على افتراض أن “الجيش” الإسرائيلي سيتمكن من تدمير حماس وإسقاط حكمها في غزة وتحرير الأسرى خلال فترة زمنية وجيزة، ما دفعها إلى القيام بكل ما في وسعها لمساعدة “إسرائيل” على بلوغ تلك الأهداف التي اعتقدت أنها تحقق مصالحها في الوقت نفسه، على أمل انتهاز الفرصة لوضع الخطط اللازمة لإدارة “مرحلة ما بعد حماس”.
اليوم، ما تزال “إسرائيل” عاجزة عن تحقيق أي من تلك الأهداف، رغم مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر ونصف، بل وارتكبت في الوقت نفسه أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وضعتها في قفص الاتهام وأصبحت تحاكم بموجبها أمام محكمة العدل الدولية.
ولأن عدداً من المسؤولين الأميركيين، على رأسهم بايدن نفسه، شاركوا بأنفسهم في بعض اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي، فليس من المستبعد أن توجه إلى الولايات المتحدة رسمياً تهمة المشاركة في ارتكاب هذه الأعمال التي تمثل فضيحة أخلاقية وقانونية وسياسية.
فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن سياسة الدعم غير المشروط لـ”إسرائيل” أدت إلى انخراط الولايات المتحدة حالياً في عمليات عسكرية مباشرة مع أطراف عديدة في المنطقة، سورية وعراقية ويمنية ولبنانية وغيرها، ما يهدد باندلاع حرب إقليمية شاملة تشارك فيها إيران وربما تمتد لتشمل أطرافاً أخرى، وهو ما لا يريده الشعب الأميركي بأي حال من الأحوال، لتبين لنا عمق المأزق الذي تواجهه الولايات المتحدة في المرحلة الحالية.
لم تجرؤ إدارة بايدن حتى الآن أن تطلب من “إسرائيل” وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، لأنها ترى أن ذلك سيؤدي حتماً إلى انتصار حماس وتمكينها من إعادة سيطرتها على القطاع، وهو ما ترفضه بالمطلق وتتفق فيه كلياً مع حكومة نتنياهو.
غير أنها تدرك في الوقت نفسه استحالة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاع عملية الطوفان، وبالتالي تعتقد أنه من الضروري الاستمرار في منح حكومة نتنياهو ما تحتاجه من وقت للقضاء على حماس والوصول إلى هدن إنسانية، مع العمل في الوقت نفسه على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على ما تبقى من الضفة الغربية مضافاً إليها قطاع غزة، شريطة أن تحكمهما معاً سلطة فلسطينية مجددة وأكثر فاعلية.
ويبدو أن بايدن يسعى حالياً لإغراء نتنياهو بتطبيع العلاقات مع السعودية في مقابل القبول بحل يقوم على هذا التصور. غير أن هذا النوع من الحلول لم يعد في تقديري قابلاً للتطبيق على أرض الواقع وسيقابل بالرفض حتماً، ليس من جانب حكومة نتنياهو المتطرفة فحسب ولكن من جانب الفصائل والقوى الحية في الشعب الفلسطيني.
لذا، يبدو أن “إسرائيل” ستظل عالقة برقبة الولايات المتحدة إلى أن يغوصا معاً في رمال غزة، خصوصاً إذا ما تحوّلت العمليات العسكرية التي تشاركان فيها معاً في الوقت الراهن، والتي يتسع نطاقها يوماً بعد يوم إلى حرب إقليمية شاملة، وهو الاحتمال الأرجح.
الميادين نت