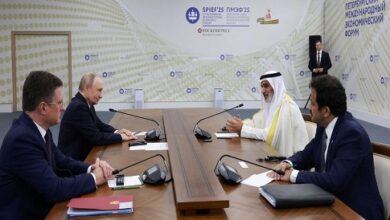أهم عاقبة لاستمرار الحرب على الكيان الصهيوني، اقتصادياً، هي تقويض أركان قطاع التكنولوجيا المتقدمة فيه، وخصوصاً أن ذلك القطاع يمثل أحد أهم أعمدة اقتصاده وصادراته.
كانت التقديرات الأولية قبل عامٍ تقريباً تشير إلى أن تكلفة الحرب على غزة سوف تحمّل الموازنة العامة في الكيان الصهيوني نحو 50 مليار دولار من التكاليف.
لكن حاكم المصرف المركزي في الكيان الصهيوني حذر في نهاية أيار/مايو الفائت من أن عبء الحرب على الموازنة العامة سوف يبلغ نحو 67 مليار دولار حتى نهاية عام 2025، تتضمن الإنفاق العسكري المباشر على الحرب (32 مليار دولار)، وتكلفة إجلاء النازحين وإسكانهم في أماكن بديلة (10 مليارات)، والعائدات الضريبية المفوتة نتيجة تقلص النشاط الاقتصادي (6 مليارات)، والفوائد على القروض المسحوبة لتغطية الإنفاق الإضافي نتيجة الحرب (2.4 مليار دولار)، إضافةً إلى بنودٍ أخرى.
كان ذلك قبل تصعيد العدوان على لبنان جواً وبحراً. وبحسب “تايمز أوف إسرائيل” في 7 أكتوبر 2024، فإن تكلفة تأمين الديون الحكومية ضد التعثر ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 12 عاماً، مع تخفيض التصنيف الإئتماني للكيان الصهيوني تكراراً، في حين يستمر الإنفاق بالعجز من جراء قصور الإيرادات المتقلصة عن تغطية النفقات المتمددة، وهو ما يزيد في الحاجة إلى الاقتراض، وبفوائد أعلى، بما يتناسب مع تزايد المخاطر.
أضف إلى ذلك، بحسب التقرير ذاته، أن المستثمرين الأجانب في السندات الحكومية “الإسرائيلية” يحاولون التخلص منها، بسبب المخاطرة وعدم اليقين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ما يملكونه منها إلى 8.4% من قيمتها، نزولاً من 14.4% قبل سنة، وهذا يقلل قيمتها طبعاً ويرفع معدل الفائدة.
كذلك، وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 67%، بعد أن بلغت تلك النسبة 62% سنة 2023، انطلاقاً من 60% سنة 2022، في حين سيصل العجز الحكومي هذه السنة إلى نسبة 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكلها نِسَب لا تُعد مؤشراً على انهيارٍ شاملٍ وشيك بعد، وليست من أسوأ النسب عالمياً، وخصوصاً أن احتياطيات “إسرائيل” من العملة الصعبة بلغت 213 مليار دولار في آب/أغسطس الفائت.
لكنها تبقى، على الرغم من ذلك، مؤشرات تدهور من المتوقع أن يتسارع نتيجة استمرار الحرب، وتباطؤ نمو الاقتصاد، وتسارع نمو الإنفاق العام، الأمر الذي يعني تزايد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حتى إن “معهد القدس للشؤون العامة” (صهيوني طبعاً) توقع وصول تلك النسبة إلى 80% في نهاية سنة 2025، في حين توقع تقرير لـ “معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي”، نُشر في 19/8/2024، أن تتراوح نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 80 و85% في سنة 2024 إذا دخلت “إسرائيل” حرباً موسعة في لبنان.
لكنّ تقارير شتى من إعلام العدو نقلت عن اقتصاديين “إسرائيليين” بارزين، منهم المديرة العامة التنفيذية سابقاً لبنك ليئومي، راكِفِت روساك أمينوآش، في تصريحات للقناة 12 العبرية، في 15/8/2024، أن تكلفة الحرب تجاوزت 67.3 مليار دولار حتى ذلك التاريخ، أي قبل نهاية عام 2025 بـ 16 شهراً.
يدور الحديث، حتى الآن، عن تكلفة الحرب المباشرة على الموازنة العامة في الكيان الصهيوني، لكنّ آثار الحرب اقتصادياً تتضمن، فضلاً عن ذلك، تكاليف الحرب غير المباشرة على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعدلات التضخم، ومؤشرات الاقتصاد الكلي عموماً، والتي يتوقع أن تشهد كلها مزيداً من التدهور.
يُذكر أن المصرف المركزي في الكيان الصهيوني خفض توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% سنة 2024 إلى 0.5%، وكان ذلك قبل العدوان البري على لبنان.
كما يُذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض 29% سنة 2023، وكان أحد أسباب ذلك، قبل 7 أكتوبر، أزمة “التعديل القضائي” التي أثارت جزع المستثمرين من تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ثم جاءت الحرب ومخاطرها لتعمق ذلك الاتجاه.
تضاف إلى ذلك طبعاً الحملات الشعبية في الغرب لمقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه، والتي فعلت فعلها، ولاسيما أوروبياً، بحسب تقرير بهذا الخصوص لـ “تايمز أوف إسرائيل” في 5/11/2024.
ويزعم بعض التقارير “الإسرائيلية” أن الاستثمار الأجنبي المباشر عاد إلى الارتفاع بقوة في ربيع سنة 2024، لكنّ من المبكر جداً الحكم إن كانت تلك نزعة موسمية أو اتجاهاً ثابتاً قبل صدور إحصاءات تشمل سنة 2024 برمتها، وخصوصاً بعد العدوان البري على لبنان.
ومن الطبيعي أن تزايد نفاذ الصواريخ والمسيرات عميقاً داخل فلسطين المحتلة، من لبنان، ومن اليمن والعراق، وتعطل الطيران الجوي تكراراً، وتعليق شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى الكيان الصهيوني، وإغلاق مرفأ “إيلات” فعلياً، وعويل صفارات الإنذار على مدار الساعة، والحاجة إلى الانبطاح في الطرقات أو النزول تكراراً إلى الملاجئ… إلخ، لا يخلق بمجموعه أفضل الظروف الجاذبة للمستثمرين الأجانب.
كما أن المحيّر في الإحصاءات التي تزعم تزايد تدفقات الاستثمار الإجنبي المباشر إلى الكيان الصهيوني في الربع الثاني من سنة 2024 هو تناقضها مع تقارير شتى في الإعلام “الإسرائيلي” والعالمي تشير إلى العكس في الفترة ذاتها، ومنها مثلاً تقريرٌ في “واينت” في 27/5/2024، أي في عز ما يفترض أنه “طفرة” في تدفق الاسثتمار الأجنبي المباشر إلى “إسرائيل”، تبدأ الجملة الأولى فيه هكذا: “يمثل انخفاض تدفق رأس المال الأجنبي إلى إسرائيل منعطفاً حاسماً بالنسبة إلى المستقبل الاقتصادي للبلاد”.
يضيف نص تقرير “واينت” أن الاستثمار في المشاريع الجديدة تحديداً في “إسرائيل” بلغ 29 مليار دولار سنة 2021، 17 مليار دولار سنة 2022، 7.3 مليارات دولار سنة 2023، و5 مليارات سنة 2024 حتى تاريخ النشر، وأن ذلك التقلص يصيب قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الكيان الصهيوني تحديداً في مقتل.
ينقل تقرير “واينت” آنف الذكر أيضاً عن “هيئة الابتكار الإسرائيلية”، وهي السلطة الحكومية المتخصصة بدعم المشاريع الجديدة في قطاع التكنولوجيا: “الوضع قاتم للغاية. لقد اختفى المستثمرون الأجانب من “إسرائيل”، والأموال الحكومية المخصصة للاستثمار ليست كافية”.
لا بد من الإشارة، في هذا السياق، إلى أن أهم عاقبة لاستمرار الحرب على الكيان الصهيوني، اقتصادياً، هي تقويض أركان قطاع التكنولوجيا المتقدمة فيه، وخصوصاً أن ذلك القطاع يمثل أحد أهم أعمدة اقتصاده وصادراته وأحد أهم أبواب تشغيل الكفاءات التي بدأت تهاجر الكيان، كما أوضحت في مادة “استمرار الحرب يدخل الاقتصاد الإسرائيلي في دورة تأكّل”، في 21/7/2024.
كذلك، من المعلوم أن تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة “الإسرائيلية”، عسكرياً وأمنياً، تمثل إحدى أهم التحديات التي تواجهها المقاومة، لكنْ من دون أن نشعر، راح استمرار الحرب يقوض أساساتها على قدمٍ وساق من زاوية تهديم بنيتها التحتية الاستثمارية، وهو ما ينبئ بمزيد من تحول موازين القوى في المنطقة على غير ما يشتهي الكيان الصهيوني، حتى يصبح “عالةً” بالكامل على حلفائه الغربيين.
يذكر هنا، على سيرة تحول الكيان الصهيوني إلى “عالة”، النزف المالي للبنتاغون من جراء دعم العدوان الصهيوني، سواءٌ بصورةٍ مباشرة، أو للإنفاق على العمليات باهظة التكلفة التي يديرها في البحرين الأحمر والعربي، وفي مواجهة الضربات على قواعده في المنطقة الشرقية لسوريا.
وبحسب “معهد واتسون للشؤون العامة والدولية”، وهو مركز أبحاث أميركي تابع لجامعة براون، في تقريرٍ نشره في موقعه في 7 أكتوبر 2024، يبلغ ما أنفقته إدارة بايدن لدعم الكيان الصهيوني على خلفية “طوفان الأقصى” بين 7/10/2023 و30/9/2024 فقط، من دون حساب قيمة المساعدات المرصودة له مستقبلاً، 22.76 مليار دولار.
وجرى توجيه 17.9 مليار من تلك المساعدات مباشرة للكيان الصهيوني، و4.86 مليار كتكاليف تكبدتها الولايات المتحدة الأميركية لتغطية عملياتها في المنطقة، ذهب جلها لمواجهة الإخوة اليمنيين الذين أعجزوا أكبر وأقوى قوة بحرية وجوية واستخبارية في العالم ومعها كل حلفائها، فلم تتمكن من كسر الحصار اليمني على البحر الأحمر وميناء “إيلات”، على الرغم من كل ما بددته من ذُخرٍ وذخيرة، فلله درك يا يمن!
يضيف تقرير “معهد واتسن” ذاته أن المساعدات العسكرية الأميركية المباشرة للكيان الصهيوني لم تبلغ في تاريخها، منذ بدء تقديمها سنة 1959 (على خلفية الوحدة المصرية – السورية)، ما بلغته في العام المالي الذي أعقب “طوفان الأقصى”، حتى إذا أخذنا عامل التضخم بعين الاعتبار، أي حتى لو حسبنا القوة الشرائية لمساعدات تلك السنوات بأسعار سنة 2024.
فهي بلغت أكثر قليلاً من 12 مليار دولار عشية حرب 1973، وأكثر قليلاً من 14 مليار في السنة التي تلت توقيع اتفاقية “كامب ديفيد”، في حين أنها بلغت نحو 18 مليار دولار بين الطوفان و30/9/2024 (وما زال الحبل على الجرار). ويشهد هذا، بذاته، على مدى الخطر الذي يستشعره الطرف الأميركي – الصهيوني من جبهات المقاومة.
اقتصادياً، أدى استمرار الحرب، واستدعاء الاحتياط بمئات الآلاف، إلى حدوث نقص في القوى العاملة، ولاسيما العمالة الماهرة، وأدى هذا بدوره إلى وقوع أثرين:
أ – تعطيل ثاني أهم قطاع في الاقتصاد “الإسرائيلي”، بعد قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وهو قطاع الصناعة.
ب – ارتفاع أجور العمال بما يتجاوز معدل التضخم، من جراء نقص العرض عن الطلب.
كما أدى منع العمال الفلسطينيين من الضفة وغزة من العمل في الأرض المحتلة عام 1948 إلى نقص في العمالة غير الماهرة، وهو ما أثر في قطاعات الإنشاءات، وفي قطاع السياحة الذي يعاني أصلاً انخفاض السياح من جراء الحرب، وهي من النقاط التي سبق بسطها في مادة “إلى متى يحتمل الاقتصاد الإسرائيلي حرباً مطولة؟”، في 16/12/2024.
يعني ما سبق كله أن استمرار الحرب يساهم في تقويض حيوية الاقتصاد “الإسرائيلي” المتقدم، وبالتالي قدرته على التحول إلى بؤرة إمبراطورية “شرق أوسطية”، كما حلمَ شمعون بيريز، هذا الحلم الذي بدا كأنه في طور التحقق عشية توقيع “الاتفاقيات الإبراهيمية” عام 2020، ليعود كما بدأ قاعدةً عسكرية سياسية – أمنية للغرب الجماعي والحركة الصهيونية العالمية.
لن يؤدي عجز الاقتصاد “الإسرائيلي” عن القيام بأوده إلى انهيار المشروع الصهيوني في فلسطين برمته إذاً، لأنه مشروع جيوسياسي أساساً، حلموا بأن يجعلوه قطباً يصهين المنطقة، فوقفت لهم المقاومة بالمرصاد وأعادته أعواماً إلى الخلف، وهذا سيرفع تكلفته، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، لكن بقاءه لا يقوم حصرياً على ازدهاره اقتصادياً، بل يتطلب ازدهاره اقتصادياً إخضاع محيطه وتفكيكه واختراقه تطبيعياً.
ولعلها مفارقة كبرى أن تتذرع الأنظمة العربية بمزاعم “الحاجة إلى التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة” للانخراط في التطبيع، فإذ بذلك القطاع يبدأ الانهيار، وإذ بالأنظمة تسارع إلى إنقاذ الكيان الصهيوني اقتصادياً عبر جسورها البرية والبحرية والجوية إليه. وما هي إلا ذريعة أخرى للتطبيع عرّاها الطوفان وأغرقها تماماً.
العبرة أن بعضنا لا يريد أن يفهم طبيعة العلاقة العضوية بين الإمبريالية والصهيونية، ولا يريد أن يرى مدى التداخل بين الظاهرتين، لا بصفة إحداهما تابعة للأخرى، بل بصفتهما ظاهرتين مندمجتين، النخب اليهودية بالنخب المعولمة من منظور الاقتصاد السياسي، والنخب المعولمة بالصهيونية من منظور الأيديولوجيا.
ومن المستغرب أن الليبراليين الجدد، الذين لا يكفون في عصر العولمة عن إبراز قلة تمثيل النساء والشبان والأقليات العرقية والطائفية (وحتى المثليين والمتحولين جنسياً) في الإدارات العامة والخاصة، يجن جنونهم ويطلقون سيلاً من تهم “معاداة السامية” عند الإشارة إلى كثرة تمثيل اليهود في وول ستريت والبنوك والبورصات العالمية والإعلام الغربي وهوليود وملكية وسائل التواصل والإدارة الأميركية والجامعات الرئيسة… إلخ، بنِسبٍ تفوق نسبتهم من السكان بعشرات الأضعاف.
لهذا لا يصح القول إن الكيان الصهيوني هو مجرد قاعدة للغرب في منطقتنا، لأن ذلك يقفز من فوق النفوذ العالمي للحركة الصهيونية العالمية ودورها في صناعة السياسة والثقافة بما يتجاوز الشؤون المرتبطة بالكيان الصهيوني مباشرة.
كما لا يصح القول إن الغرب هو مجرد أداة للحركة الصهيونية العالمية، لأن ذلك يحوله إلى “ضحية” ويبرؤه من كل سجله الاستعماري الدموي ومن دوره في تأسيس منظومة الهيمنة التي ما برحت تقارعها شعوب الأرض منذ بدء الغزوات الأوروبية في العصر الحديث.
الحركة الصهيونية ليست مجرد أداة، ولا هي مدير أو مالك حصري، للقرار الغربي، وإنما هي شريكٌ رئيسٌ في منظومة الهيمنة التي تحكم العالم، وتمادى دورها بعد انطلاق العولمة، أي بعد تحول رأس المال الدولي عن صفته الوطنية إلى صفة عابرة للأقطار، اقتصادياً وثقافياً.
ومن هنا أصبحت مقولة “حقوق الإنسان”، مجرد، “ديانة”، وأصبحت أيقونتها المفروضة بقرار دولي سردية “المحرقة”، وهي سردية لا تبرر حق “إسرائيل” في الوجود فحسب، بل تبرر بقاءها فوق أي قانون، والأهم، أنها تبرر النفوذ اليهودي العالمي، وتصهُيُنَ العالم.
لذلك كله، سوف يهرع الغرب الجماعي إلى إنقاذ “إسرائيل”، لكنّ ما تقوم به المقاومة الآن من مراكمة نقاط، ومنها استنزاف “إسرائيل” اقتصادياً، سوف يرفع تكلفة دعمها، ويسرّع الإجهاز عليها، في مرحلة يدخل فيها الغرب مرحلة أفول. ويسجل أن الدين العام الأميركي بلغ في 15/11/2024 مستوى 36 ترليون دولار، أي 123% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على أي اقتصاد، لولا هيمنة الدولار عالمياً.
بناءً على ما سبق، تتطلب مواجهة الطرف الأميركي – الصهيوني، مع الاستمرار في مراكمة النقاط، تأسيس جبهات شعبية عريضة، عربياً وإسلامياً وعالمياً، لأننا لو كنا نواجه “إسرائيل” وحدها، لتكفّل المقاومون الفلسطينيون واللبنانيون وحدهم بالقضاء عليها، لكنّ القدر شاء أن تكون معركة فلسطين هي معركة كل أحرار العرب والمسلمين والعالم.
الميادين نت