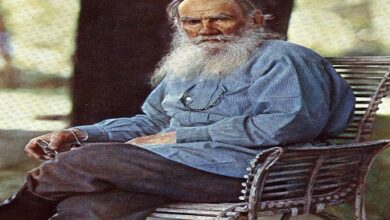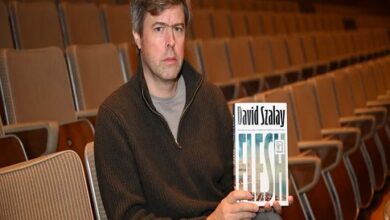لم يكن الراحل ميشيل كيلو معارضاً سياسياً فحسب، بل كان مفكراً حرّاً وعقلاً منفتحاً وقلباً نابضاً بحياة جديدة حرّة أبيّة، لم يفكر فقط بل نقل أفكاره إلى حيز التنبيه من خلال صرخات متتالية في مجال السياسية وفي مجال أدبه الرمزي ، محذرا خطورة الواقع الذي عاشه وعاينه على الإنسان العربي ، ومن الطبيعي أن يعيش الإنسان في واقع فرض عليه ولكن من غير الطبيعي أن يتأقلم ويقبل بالذل والخنوع، وقد سبق أن وقفت عند دراسة أدب الخيال العلمي في كتاب استشراف أدب الخيال العلمي ، ومن خلال تجربتي لمست أن ميشيل كيلو فيما كتبه استشرف آفاق المستقبل وعاين المستقبل البعيد من خلال نظرته العميقة لواقع مأساوي حاول التحذير منه من خلال كشف الماضي واستشراف آفاق المستقبل، ودعونا نقول: إن ما قاله الراحل ميشيل كيلو سواء أكان في مجال السياسة أم في مجال الأدب، ما هو إلا دعوة صريحة للخروج من القوقعة ، وسأوضح ذلك من خلال هذه الدراسة المتواضعة لأدبه.
فإن وقفنا عند إحدى قصص الأطفال التي تشرت له والتي وصف من خلالها الطفل في الزنزانة، نجده يخالف أفق التوقع في فكر القارئ، إذ اعتدنا على سماع قصص الأطفال التعليمية التي تبنى على غرض العظة أو التعلم ، أما هو فقد لامس الواقع الأليم، إذ إنَ الطفل في سورية أو في المناطق العربية المنكوبة لا يشبه أطفال العالم، إذ تخطى مرحلة الطفولة بعقله وتجاوزها بعد أن عاش حياة لا تمس للطفولة بصِلة، فأيّة طفولة وهو يعيش في سجن، أو يعيش في خراب ودمار، يشم رائحة الموت والبارود في كل مكان؟ وأيّة طفولة تحرمه من الضحك واللعب وهو يبحث عن ملجأ آمن في الغابات والبحار؟ وأيّة طفولة والدم يسيل في أرضه التي لم تعد ترتوي إلا بدماء أبنائها الشرفاء؟
ومن المعلوم أنّ الأدب ما هو إلا نقل الواقع بكل ما فيه، ورسالته رسالة نبيلة مبنية على الصدق والضمير الحي ، فأين نحن من هذا الأدب اليوم الذي فقد الواقعية ومازال يرتبط بأفكار القدماء وحكاياتهم التي لم تخرج عن إطار التقليد ، فلكل مرحلة زمان ومكان، وأدب وأدباء، وهذا ما دعا إليه الراحل ميشيل كيلو عندما صوّر لنا الطفل المحروم من كلّ حقوقه وهو في الزنزانة ، لا يعرف العصفور ولا الشجرة، ورمز بهذه الزنزانة إلى وطن بأكمله حرم أطفاله من الحرية والعيش بكرامة، في وطن لا يعرف الطفل الطيور لأنها هاجرت، في وطن سلب فيه الإنسان كل معالم الإنسانية .
ولا شك أن قصص الأطفال التي تحمل المعاني القديمة من خلال الموعظة والتعليم لم تعد تعني لأطفال وطننا الشيء الكبير؛ لأن الطفل بات عقلاً شارداً بين حنايا الأشلاء والدماء، فلهذا اختلف الكاتب بقصص الأطفال عن غيره من الكتّاب؛ لأنه رسم الواقع بكلّ ما فيه من ألم ومأساة فخرج متمردا على الإطار القديم .
من القصة إلى الرواية :
قرأت ميشيل كيلو بفكر جديد رمزي في رواية حُمّلت بدلالات رمزية تكاد تنطق واقعاً أليماً عاشه كلّ سوري شريف ، وكلّ إنسان عاش في وطنه وهو غريب …
ميثولوجيا مزار الدب:
لم تكن مزار الدب رواية فحسب، بل كانت وطناً تائهاً، يبحث أهله عن ذاتهم في ظل حاكم فاسد أفسد حياتهم وقريتهم بعد أن سلبهم كلّ شيء، واستباح الأرض لخدمته ، في قرية مزار الدب التي رمزت للوطن ، في مغارة كانت ملجأ للدببة ، وأصبحت ملجأ للناس في هذه القرية التي كتب عليها الشقاء ، اعتمد الكاتب تقنية السرد المتداخل ومع أنّ الأحداث اجتمعت في البداية مع الشخصيات ، كالذي ينظر من بعيد إلى الوطن يجد المكان والناس يعيشون بأمن وسلام ، ولكن ما أن دخلنا بتفاصيل النص إلا أن الأحداث بدأت تنكشف وتظهر ، فاعتمد على التعريف بالمكان والشخصيات المتعددة، وعمد إلى تقنية تفكيك الأحداث في جوّ من المتعة الخيالية التي طغت على النص، وقد عرف عن البشر الالتفات إلى الخيال أكثر من الواقع، وهذا ما أشار إليه الكاتب عندما دمج بين الأحداث الواقعية والخيالية في الرواية كلّها بشكل عام ، وفي هذا إشارة واضحة إلى الميثولوجيا وعقل الإنسان الذي لا يتجاوز بخياله إلا الخيال ، فيفسر مالا يفهمه بخياله وليته خرج من الخيال ، ومن المعروف أن العقل العربي بني على الخيال وما قصص الجدات والعجائز إلا صورة عن هذا الخيال الذي زرع بعقول الأجيال وتناقلوه دون معرفة صحته من جيل إلى جيل ، وقد آمنت فئة غير قليلة من العرب بتلك الخرافات التي كانت تفسيرا لما يجهله الإنسان ، فضلا عن الأساطير التي ارتبطت بالمعتقدات والديانات التي ما زالت إلى يومنا موجودة .
والسؤال هنا، هل شعور الخوف هو الذي دفع بالإنسان إلى تصديق ما يسمع؟ أم ضعف بعض البشر وخنوعهم للواقع ؟ أم غباء بعضهم الذي جعلهم يسيرون وراء أقاويل من المحال تصديقها ؟
كل ذلك وجدناه في أحداث الرواية، إذ اعتمد الكاتب تقنية الرمز، وقد تحول الرمز الديني إلى أيقونة أثّرت على مجريات الأحداث بالكامل، فعمد إلى الأدب الرمزي السياسي ليكشف من خلاله واقعاً مريراً تعيشه البلاد، فحاول رصد الأحداث، ومن ثم بيّن سبب الواقع المرير من خلال وصف الشخصيات بدقة متناهية .
ومن الجدير بالذكر أنه جمع في روايته عالم الإنس والجن ، وعالم الإنسان والحيوان فأثار اللغز بقصة زهرة التي تحولت إلى ضبعة ، ورمز من خلال زهرة المرأة الجميلة إلى رمز الكون والطبيعة، ولكن سرعان ما تحول هذا الرمز بظروف غريبة أثارت جدل سكان القرية باختفائها في المغارة ومن ثم تحولها إلى ضبعة ، وأنجبت فتاة جميلة وهي كلثوم، ورمز من خلالها إلى سورية، إذ ارتبطت كلثوم بالطبيعة والجمال فكانت مطمع الجميع، وبدأت الأحداث تتشابك عندما اختفت كلثوم التي رمزت للحياة والطمأنينة والراحة ، وقد كانت العجائز تحكي عن ائتلافها بالطبيعة والورود والينابيع ، إلا أن هذه الأيقونة التي ارتبطت بالجمال والحياة اختطفها رجل يدعى حمدان الأبرص الذي عُرف بدهائه السياسي، وحسن استغلاله للعقول ، فأوهم الجميع أنها اختفت، ومن ثم كانت اللحظة الحاسمة عندما أعلن زواجه منها، وكيف لا وكل ما حول هذه الأيقونة تخلى عنها حتى أبناء أرضها، هذا الشعب المسكين الذي مازال يعيش بأوهام الماضي وخرافاته، استطاع حمدان الرجل الأحمق بخبثه أن يستغل عقولهم بأوهام لا أساس لها من الصحة ، فتحولت هذه القرية من مكان جميل إلى مكان يعيش فيه الشياطين والجان وبشر لا أصل لهم ، وتوالت على القرية سبعة أيام غزاها الحيوانات بشتى أنواعها إلى أن تحولت من مكان هادئ وآمن إلى مقر للشياطين ، فضاعت السكينة البشرية الروحية، وتحولت إلى خوف يسكن قلوب الناس وبدع وأباطيل كاذبة، فمن خلال قصص الجدات والعجائز تناقل سكان القرية الإشاعات التي لبّت مطلب الشيخ حمدان الذي باشر من خلال أسلوبه اللعين بعد أن تقنع بقناع الدين في إيهام الناس أنه هو الهادي الذي سيخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الطبيعي أن يميل الإنسان الجاهل إلى تفسير مالا يعرفه بوهم قاتل يسحبه إلى الطاعة والانقياد لمن يظنه الأقوى، فلقب الشيخ حمدان نفسه بالهادي وأخذ يسلب عقول الناس وإرادتهم وقلوبهم إلى عالم مجهول يكسب من خلاله كل شيء، فمثّل الرجل الدكتاتور الذي سلب الناس حقوقها فاستغل فقر العقول ، وأعلن أنه سيهب ما يملك لأهل القرية مقابل أن يكون كل ما يملكه الناس في هذه القرية مشاعا له ، وتحت مسميات عدة، كمجالس الألفة ، ومنظمة رعاية الأحلام .. وغيرها من المنظمات التي استطاع من خلالها استغلال الناس مستعينا بمن يراه مطاوعاً له ومصدقاً له، فحاول كسب نايف المفزلك الذي عرف بشخصيته المتمردة وسلمه الناطق بلسانه وظهر كذراع أيمن للهادي الأبرص، وامتاز بقوته وعنفه، وكذلك إبراهيم الناطور الذي أوهمه أنه بعصاه يستطيع تغيير العالم من حوله، واستخدم العنف كأداة لتحقيق أهدافه، وبدأت رحلة الاستغلال من خلال سلب أراضي الناس، وممتلكاتهم ، وزراعة التبغ في الأراضي، فبعد أن كانت الأراضي ملكاً للناس أصبحوا كالعبد المأمور يعملون في أراض ملكها حمدان جميعها، وأصبح أهالي القرية أتباعاً للشيخ الذي يبهرهم بأساليب عدة بأوهام لا تصدق وكلام يسلبهم عقولهم، وقد عمد إلى أسلوب الحوار بين الشخصيات وهذا الأسلوب رسم الشخصيات وملامحها بدقة ، فضلا عن تقنية المونولوج الداخلي الذي وضح من خلاله تناقض الإنسان ، فها هي عبلة الفتاة التي عارضت حمدان وكانت تحذر منه نعتوها بالمجنونة، وآثرت عدم الخضوع له في حياتها ومماتها عندما حاول نقل قبرها ، فالجميع تابع له وكل من خرج عن طاعته مصيره الموت، فالطاعة أهم من الإيمان في نظره ، إلى أن وصلنا إلى الذروة عندما أعلن نفسه الرسول الهادي لهم لنصل إلى نهاية مفتوحة ، ضمن أسئلة عدة لا إجابة لها، وتقنية النهاية المفتوحة تفتح الباب على مصراعيه أمام القارئ ، بعد أن غاب الشيخ حمدان ووجد أن معتقده يخالف ما سعى إليه، وهذا بعد أن صنع جمعية رعاية الأحلام ، فحتى الحلم واسترداد الذكريات هو من الممنوعات على أهالي القرية ، وأطلق شعار (انسَ نفسك) بدلاً من شعار (اعرف نفسك)، لنجد أهالي القرية باتوا أشباهاّ بالإنسان لا ذكريات لهم ولا حاضر ولا مستقبل، ما هم إلا أدوات لخدمة مصالح الشيخ حمدان، إلا أن نايف المفزلك وإبراهيم الناطور مازالا يحتفظان بالذاكرة ، وهنا كانت النهاية ، أسئلة بطريق المونولوج الداخلي تدور في فكر نايف الذي بات يعاني ما يعانيه بسبب ذاكرته التي علمت أن الناس بالطيبة والسذاجة تحولوا إلى أتباع لذلك الشيخ الذي قادهم إلى الجحيم بخباثته .
وهذه النهاية تفتح أمامنا أسئلة عدة عن حياتنا كعرب عامة وكسوريين خاصة ، تحت إطار السلطة وتحت إطار الدين المزيف كم شخص مازال يتساءل من هو ؟
وقد أفادنا الكاتب بنظرته إلى الطقوس الرمزية والميثولوجيا ليجد أن العرب مازالوا يقلدون ويتبعون دون التفكير بمصيرهم وبمستقبلهم ، وبهذا عاين الواقع بكلّ ما فيه من سلبيات طمست الحقائق وعمت الكثير عن رؤية الحقيقة ، فقادتهم إلى نهاية مأساوية.
كما أنه عمد إلى استشراف أدب الخيال ، فمن خلال الخيال والرؤية التي كانت تظهر لبعض الشخصيات وظف الوقائع ضمن أحداث تنبئ بمرحلة خطيرة ومصير مجهول، ومن خلال ما سبق نجد دعوة الراحل ميشيل كيلو إلى الخروج عما عهدناه في زمن الظلم والتبعية لنعيش حياة الأحرار الكرام ، وكل ذلك كان ضمن الإشارة والرمز ، فسمعنا صوت العقل الباطن قبل أن نسمع صوت الضمير الحي ، وشاهدنا لغة الشيخ من خلال همساته وصوته الذي أوهم الناس من خلاله بحديثه مع الجان ، وصوت الباطل الذي مثله نايف الذي لاقى مصيره بعدم النسيان، وعلى الرغم من اختطاف كلثوم وتخلي أهل القرية عنها إلا أنها ظهرت بقوتها التي تقاوم الشيخ وتتحداه، وهي كانت صوت الحقيقة الذي كان يهابه، وهذه سورية الأبية صوت العزة والكرامة ، كانت مطمع الكثير إلا أنها تقاوم وهي تؤمن أن هناك من يدافع عنها من أبنائها الشرفاء الذين حاولوا تخلصيها من مخالب حمدان ، الذي خطفها وأهلها إلا أن الحق يعود إلى أصحابه مهما طالته يد الشر، ولم تكن هذه الرواية إلا صرخة في وجه الظلم، ودعوة صريحة للخروج من القوقعة ، ويبقى السؤال مفتوحا ، كنهاية الرواية التي كتبها في زمن لا صوت فيه إلا للحر الشريف ، هل خرجنا من القوقعة ؟؟
بوابة الشرق الأوسط الجديدة