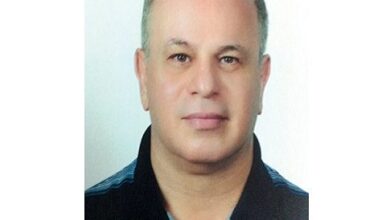الشرق الأوسط بين الجغرافيا والتاريخ والسياسة: جذور أزمة التطور والاستقرار
ماهر عصام المملوك

يعلم الغالبية بأن مشاكل الشرق الأوسط هي أحد أقدم مشاكل المراكز الحضارية في التاريخ الإنساني، والتي تشكل مهدًا للديانات الكبرى، وملتقى للتجارة والثقافات. ومع ذلك، ظلّت هذه المنطقة على مدى قرون تعاني من دورات متكررة من الحروب والصراعات وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، على عكس العديد من مناطق العالم التي استطاعت، ولو بعد مراحل صعبة، الوصول إلى مستويات مقبولة من الأمن والتنمية. هذه المفارقة تثير سؤالًا محوريًا: هل تكمن جذور المشكلة في سكان هذه المنطقة، أم في قادتها، أم في عقائدها، أم في موقعها الجغرافي الفريد؟
فمنذ انهيار مراكز الإمبراطورية الكبرى في المنطقة، بدءًا من الدولة العباسية في القرن الثالث عشر الميلادي، دخل الشرق الأوسط في حالة من الانقسام السياسي والتشرذم. وأصبحت السلطة تتوزع بين دويلات وسلطنات متنافسة، ما أضعف القدرة على بناء مؤسسات سياسية واقتصادية مستقرة.
خلال الحقبة العثمانية (1516–1918)، وفرت الإمبراطورية مظلة سياسية واسعة، لكن التركيز كان على حفظ النظام وجباية الضرائب أكثر من تطوير البنية الاقتصادية أو تعزيز التعليم. وعقب الحرب العالمية الأولى، جاء الاستعمار الأوروبي ليعيد رسم الحدود وفق اتفاقيات سايكس–بيكو، ما عمّق الانقسامات الطائفية والعرقية، وزرع بذور نزاعات مستقبلية.
فهل كانت الجغرافيا نعمة أم نقمة؟
فحقيقة الموقع الجغرافي للشرق الأوسط يجعله قلب العالم القديم، وجسرًا بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وممرًا حيويًا للتجارة الدولية. كما أنه غني بالموارد الطبيعية، وعلى رأسها النفط والغاز. هذه العوامل جعلت المنطقة مطمعًا للقوى الكبرى عبر التاريخ، من الحملات الصليبية إلى الاستعمار الحديث، وصولًا إلى التنافس الدولي في القرن العشرين والحادي والعشرين.
لكن هذه المزايا الجغرافية تحوّلت في كثير من الأحيان إلى نقمة؛ إذ أدّى التنافس على السيطرة إلى صراعات مسلحة، وتدخلات خارجية متكررة، وحروب بالوكالة، مما أعاق بناء منظومات تنمية مستقرة. وبالمقارنة، نجد أن بعض المناطق الأقل أهمية جيوسياسية نجت من الكثير من التدخلات الأجنبية، ما منحها فرصة أكبر للاستقرار.
نعود هنا للإشارة والبحث عن موضوع الفرق بين القيادة والحكم وأزمة الشرعية والمساءلة.
فمنذ الاستقلال في منتصف القرن العشرين، ورثت معظم دول الشرق الأوسط أنظمة حكم سلطوية أو شبه سلطوية، تعتمد على شخص الحاكم وحاشيته أكثر من اعتمادها على مؤسسات قوية ومستقلة. في كثير من الحالات، تحوّلت هذه الأنظمة إلى حكم فردي طويل الأمد، قائم على الولاء السياسي والأمني لا على الكفاءة.
غياب المساءلة والشفافية، وتداخل السلطة مع المصالح الاقتصادية الخاصة، أنتج منظومات فساد مزمنة، وعطّل الابتكار، وقيّد الحريات العامة، ما دفع شرائح واسعة من السكان إلى الشعور بالاغتراب السياسي وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة.
في المقابل، لم تنجح المعارضة السياسية في كثير من الأحيان في تقديم بدائل ديمقراطية واقعية، إما بسبب القمع أو الانقسامات الداخلية أو ضعف الخبرة المؤسسية.
اما بخصوص العامل الثقافي والعقائدي وماهية التعددية وازمات الاصطدام، فيتميّز الشرق الأوسط بتنوع عرقي وديني ولغوي واسع، من العرب والأكراد والفرس والتركمان، إلى المسلمين والمسيحيين واليهود والبهائيين، مرورًا بمذاهب وطوائف متعددة داخل الدين الواحد.
ورغم أن هذا التنوع قد يكون مصدر غنى ثقافي، إلا أن غياب الإدارة السياسية الرشيدة لهذا التعدد حوّله في كثير من الأحيان إلى عامل صراع. فقد استُخدمت الانتماءات الدينية والطائفية كأدوات للتعبئة السياسية أو لتبرير الإقصاء، ما ولّد انقسامات أعمق وأطول أمدًا.
كما لعبت بعض القراءات الجامدة أو الإقصائية للعقائد دورًا في تعزيز الانغلاق الفكري، وتقييد انفتاح المجتمعات على التجارب التنموية الحديثة.
وبرغم الثروات الطبيعية الضخمة، ظلّت اقتصادات كثير من دول المنطقة تعتمد على تصدير المواد الخام، دون تنويع حقيقي للأنشطة الإنتاجية. هذا النمط جعلها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة، وأعاق بناء قاعدة صناعية وتقنية مستدامة.
كما أدى التوزيع غير العادل للثروة إلى فجوات طبقية واسعة، غذّت السخط الاجتماعي. وعوضًا عن استثمار العوائد في مشاريع تعليمية وبحثية، جرى في حالات كثيرة توجيهها لتعزيز أجهزة الأمن أو لشراء الولاءات السياسية.
في المقابل، تُظهر بعض التجارب في الخليج وتركيا وماليزيا (خارج النطاق الجغرافي المباشر للشرق الأوسط) أن الاستثمار الذكي في البنية التحتية والتعليم والتقنية يمكن أن يحقق قفزات نوعية، ما يطرح سؤالًا عن غياب الإرادة السياسية في بقية الدول.
ولايخفى على احد حجم التدخلات الدولية على مدى التاريخ والحلقة المفرغة من الصراعات والحروب في هذه المنطقة .وكذلك لا يمكن إغفال أثر التدخلات الدولية في صياغة أزمات المنطقة. من الحرب الباردة إلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ومن الصراع العربي–الإسرائيلي إلى الحرب في سوريا واليمن، ظل الشرق الأوسط ساحة لتصفية الحسابات الدولية.
هذه التدخلات لم تكتفِ بتغيير موازين القوى، بل كثيرًا ما أطاحت ببنى الدولة نفسها، ما فتح الباب أمام الفوضى والميليشيات والحروب الأهلية. وبدلًا من أن تكون السيادة أداة لحماية المصالح الوطنية، أصبحت في بعض الحالات ورقة تفاوض بين القوى الإقليمية والدولية.
ويعود السؤال الذي يطرح نفسه هو هل المشكلة في الشعوب ام في ادارتها وأسلوب الحكم فيها والتعاطي مع شعوب هذه المنطقة ؟
يذهب بعض المحللين إلى أن جزءًا من الإشكال يكمن في الثقافة السياسية السائدة بين الشعوب، حيث تميل قطاعات منها إلى قبول الحكم الفردي أو الزعامات الكاريزمية، أو إلى تفضيل الاستقرار الأمني على الإصلاح السياسي.
لكن هذا الطرح يتجاهل أن أنماط السلوك الشعبي تتشكل تحت تأثير قرون من التجارب السياسية والاجتماعية، وأن بناء ثقافة ديمقراطية يحتاج إلى بيئة تعليمية ومؤسساتية تسمح بالمشاركة الفعلية وتحمي الحقوق. وبالمقارنة، نرى أن مجتمعات مرت بتجارب مشابهة كأوروبا الشرقية التي استطاعت أن تنتقل نحو أنظمة أكثر انفتاحًا حين توفرت لها الظروف الدولية والمحلية الملائمة.
ومختصر القول فإن أزمة التطور والاستقرار في الشرق الأوسط ليست نتيجة عامل واحد، بل هي حصيلة تفاعل معقد بين التاريخ والجغرافيا والسياسة والاقتصاد والثقافة.
فالموقع الجغرافي جعل المنطقة مطمعًا، والتاريخ أرسى انقسامات، والقيادات السياسية كثيرًا ما افتقرت إلى الرؤية المؤسسية، فيما فشل النظام الدولي في توفير بيئة آمنة تسمح بالتنمية.
لكن هذا لا يعني أن المستقبل محتوم بالسلبية.
ويمكن للمنطقة أن تفتح صفحة جديدة إذا ما توفرت ثلاثة شروط أساسية:
- 1. إصلاح سياسي عميق يضمن فصل السلطات والمساءلة الحقيقية.
- 2. تنويع اقتصادي يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا بدلًا من المواد الخام فقط.
- 3. إدارة رشيدة للتنوع الثقافي والطائفي تعزز المواطنة بدل الانقسامات.
- اعادة الثقة بين الحكام والشعوب في منطقة الشرق الأوسط مبنية على ثقة كاملة وبعيدة عن التشكيك في نوايا الأمم ورعاياهم واختيار الكافات المبنية على الخبرات والمؤهلات والمقدرات العلمية وليست تلك مبنية على الولاءات والانتماءات والتحزبات وبان مصيرهم مشترك ويجب ان يتطور في النهاية نحو غاية البلد اولاً وليس الحاكم وعائلته وعشيرته اولاً.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستظل المنطقة رهينة لموقعها الجغرافي وأعباء تاريخها، أم ستنجح في تحويل تلك العناصر نفسها إلى مصادر قوة ونهوض كما فعلت حضاراتها القديمة؟
بوابة الشرق الأوسط الجديدة