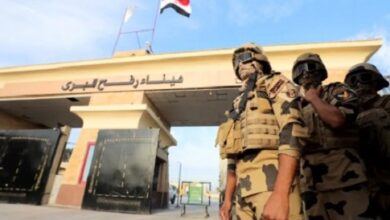الصين لا تريد أن تغير العالم
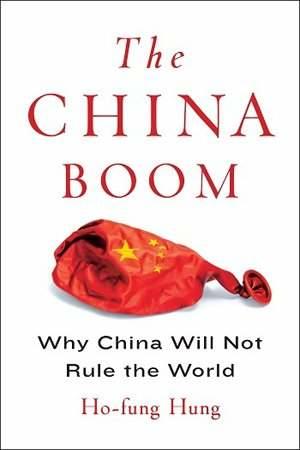
عرض ومناقشة: محمد الخولي
الناشر: جامعة كولومبيا، نيويورك، 2016
عدد الصفحات: 264 صفحة
ثمة هاجس ظل يستبد بصانعي القرار ومخططي السياسة في الولايات المتحدة، متمثلاً في ما ظل يعرف باسم التحدي الآسيوي. وينبع هذا الهاجس من واقع الحرص على مكانة أميركا، بوصفها القطب الأول في العالم.
ثم جاءت طفرة التصنيع اليابانية لتشكل تهديداً لهذه المكانة، التي تعززت بالنسبة لأميركا، وخاصة بعد زوال خصمها السوفييتي. وما إن انحسر هذا التحدي الياباني، حتى تجسد التحدي الجديد في صين الألفية الثالثة، وقد أصبحت المنافس رقم واحد في العالم، من حيث الإنتاج والتصنيع والتصدير، وخاصة لصالح المستهلك الأميركي.
وقد بلغ الأمر إلى الحد الذي انتشرت فيه في مطلع القرن الحالي، شعارات تلخص هذه التحديات، وكان من أبرزها شعار «الصينيون قادمون»، لكن هذا الكتاب يكاد يسبح ضد هذا التيار، حيث يتدارس مؤلفه مسيرة الصين في مجال التنمية والتصنيع، بادئاً من جذور هذه التجربة التي اجتازت أطواراً مختلفة من حياة الصين بعد ثورتها الكبرى عام 1949، ما بين حقبة ماوتسي تونغ، ثم حقبة دنغ هيساو بنغ وخلفائه، التي أنجزت مرحلة التصنيع ولكن في المراكز الحضرية والمدن الساحلية، وجاء ذلك بدوره على حساب شقاء الملايين من سكان الداخل والأرياف الصينية، وصولاً إلى حقبة التصنيع من أجل التصدير، التي يرى المؤلف أنها لا تصلح لجعل الصين القوة رقم واحد في عصر العولمة الراهن.
في كتابه الصادر منذ بضع سنوات، بعنوان «عالم ما بعد أميركا» يذهب الكاتب الأميركي، من أصل هندي، فريد زكريا، إلى أن عالم القرن الحادي والعشرين، جدير بأن يشهد، خلال السنوات المقبلة، ساحة عالمية، تظل فيها أميركا قطباً محورياً في مجالات السياسة والاقتصاد. ولكن في إطار عالم متعدد الأقطاب، كما يقول فريد زكريا، الذي لم يسهب الحديث في كتابه الذي ذكرناه عن روسيا، حيث لم تكن كرامات رئيسها الحالي بوتين قد ظهرت بعد، ولكن زكريا أوضح أن عالم السنوات المقبلة، سوف يشهد بروز دولتين محوريتين على النحو التالي:
• الأولى: دولة حليفة لأميركا، وهي الهند.
• الثانية: دولة غريمة لأميركا، وهي الصين.
والحاصل أن الكاتب الأميركي المذكور، كان يصدر، شأنه في ذلك شأن الكثير من سياسيي الولايات المتحدة ومحلليها، عن نظرة أقرب إلى التوجّس إزاء صعود الصين الجديدة، كما يسمونها، في مضمار ساحات التنافس العالمي، ولا سيما في مجالات التصنيع والإنتاج، ومن ثم النفوذ السياسي.
في غمار هذه الأفكار والتصورات والمراهنات السياسية على ما يمكن أن تؤول إليها الأحوال في عالم السنوات المقبلة، بدأ يروج الشعار الأميركي المعروف، وهو: الصينيون.. قادمون.
هذا الشعار ظل متكرراً في حياة العديد من أجيال الولايات المتحدة، فيما كان يصدق على الروس خلال الحرب الباردة، أو على اليابانيين الذين ما زالت سياراتهم تغمر الأسواق الأميركية، بل جاءت أيام كان يصدق فيها الشعار المذكور على.. العرب، وخاصة خلال طفرة أسعار البترول في منتصف سبعينيات القرن الماضي.
لكن حكاية «الصينيون قادمون» ما لبثت أن لقيت نوعاً من المصداقية بحكم ما لقيته، ولا تزال تلاقيه، المنتجات والمصنوعات الصينية من قبول واسع النطاق لدى ملايين المستهلكين الأميركيين، بفضل رخص أسعارها، وغزارة حجم إنتاجها، فضلاً عن لماحية الذكاء الصيني، الذي عمد إلى إصدار منتجاته بعد دراسة دقيقة ومتأنية لأذواق، وربما لأهواء المستهلكين.
أجواء المنافسة والتوترات
في هذا الإطار، انشغلت الأوساط البحثية والسياسية في أميركا بالشأن الصيني، وهو انشغال ما زال يتعدى حكاية الصين غريماً على الساحة الدولية، أو الصين طرفاً مهيمناً، إلى حد الإغراق أحياناً على سوق الاستهلاك الأميركي، أو الصين جاراً يهدد الأوضاع السائدة في المحيط الهادئ وهو الساحة المشتركة جغرافياً بين البر الصيني (بحر الصين الجنوبي) وبين الجناح الغربي لقارة أميركا الشمالية، بل إن المنطقة الباسيفيكية المذكورة، تحولت خلال الأشهر، وربما الأسابيع الأخيرة، إلى ساحة يسودها التوتر والترقب واحتمالات الصدام بين قوى عاتية، ليس أقلها الصين واليابان وأميركا.
هذه الأجواء انعكست على ما صدر في الولايات المتحدة أخيراً من كتابات وبحوث، تناولت بالدرس والتحليل علاقة الصين مع أميركا، من منظور معطيات الحاضر وتوقعات المستقبل.
من هذه البحوث، كتاب يصف علاقات واشنطن وبكين، بأنها علاقات تجمع في خصائصها بين الحسم والتشاؤم، بمعنى أنها معلقة في ميزان الأقدار. وفي الدراسة المذكورة، يتوقع كاتبها، البروفيسور جوردن شانغ، أن تظل الصين في حالة انشغال بتطّورها وأدوارها في المستقبل، فضلاً عن احتمالات، وربما مخاطر، منافستها مع أميركا بشكل خاص، والغرب الأوروبي بشكل عام.
ولكن، على خلاف هذه النظرة المتوجسة إزاء ما اصطلحوا عليه بشأن الخطر الصيني، بمعنى خطر سيطرة الصين على مقاليد عالمنا في سنوات المستقبل، يخفّ باحث آخر، يحمل هذه المرة اسماً له إيقاع صيني بحت، ليصدر منذ أشهر قليلة، كتاباً يحمل وجهة نظر مغايرة، ويختار له العنوان التالي: الطفرة الصينية: لماذا لن يقدّر للصين أن تحكم العالم.
نهج المفارقة التاريخية
من هنا، يبدأ مؤلف كتابنا، البروفيسور هُو فنغ هونغ أستاذ علم الاجتماع في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة، الذي يعمد إلى متابعة تطورات تجربة الصين الشعبية، وخاصة بعد اكتمال معالمها مع أواخر خمسينيات ومطلع الستينيات من القرن العشرين.
والحق أن القارئ المتمعن لطروحات هذا الكتاب، لا يلبث أن يكتشف أن المؤلف يعمد إلى استخدام نهج يمكن أن نصفه من جانبنا بأنه، المفارقة التاريخية، وبمعنى أن ترسم هذه الزعامة أو تلك القيادة في هذا البلد أو ذاك، مساراً معيناً من واقع قناعاتها أو تجربتها، فإذا بهذا المسار يصب في موقع لم يكن موضوعاً في حساب القائد أو الزعيم من قريب أو بعيد.
في ضوء هذا النهج، الذي نكاد نصفه بأنه سخرية الأقدار، يذهب مؤلف هذا الكتاب إلى أن الزعيم ماو كانت تستبد به رغبة عارمة، ثورية بالطبع، في تصنيع الصين تحت أعلام الاشتراكية، فما كان منه إلا أن ألقى عبء هذه المهمة على عواتق الفلاحين الفقراء، البسطاء في بلاده، وهو ما أفرز أحلاماً من السخط والمعاناة، ما لبثت أن مهدت السبيل إلى السير عكس الاتجاه، كما قد نسميه، وهو الاتجاه الرأسمالي الذي اختطته قيادة دنغ هيساو بنغ.
هنا يتدخل مؤلف كتابنا، موضحاً أن دنغ وخلفاءه عمدوا إلى اتباع نموذج كان فريداً بدوره، بقدر ما كان نمطاً آسيوياً في جوهره، من رأسمالية الدولة، حيث انصبّت جهودهم على تبّني وتشجيع اقتصاد قائم على أساس التصدير، ومقيم من حيث مواقعه ومصانعه على رقعة المدن الساحلية في الساحة الصينية الشاسعة، وهو ما أدى إلى ازدهار تلك المراكز الحضرية في البلاد، فيما أدى إلى تهميش وإهمال المواقع الريفية في دواخل شبه القارة الصينية.
ويلخص مؤلفنا محصلة هذا الاتجاه الذي شهدته حقبة الربع الأخير من القرن الماضي، إلى نمو اقتصادي كان سريع الإيقاع بحق، ولكن توازت معه آفات الفساد في مجالات التسيير والإدارة، فضلاً عن تفّشي أساليب القمع أو الظلم في مجال الحكم المحلي، وإفراط في الاعتماد على الصادرات الموجهة بداهة إلى الخارج. وكان أن أفضت محصلة هذه التطورات إلى مزيد من المعاناة التي كُتب على جموع الفلاحين والعمال أن تكابدها من النواحي الاقتصادية والسياسية على السواء.
مقارنات عسكرية واقتصادية
يؤكد المؤلف قائلاً، إن الصين لا تزال حتى الآن قادرة على تصدير هذه النواتج الصناعية المفرطة إلى خارج حدودها، لكن إلى متى تستطيع الاستمرار في هذا المجال؟. وبمعنى آخر، يحرص المؤلف على إثبات مقولة محورية، يلخصها في العبارة التالية: الصين لا تريد أن تغيّر العالم.
ثم يفسر هذه العبارة على أساس أن الصين تستثمر تراثها العريق وحصافتها الآسيوية، حيث تفيد من الوضع العالمي الراهن، أنها لا تهدف إلى استخدام إمكاناتها العسكرية لاستعراض قدراتها أو مَنَعْتها على المسرح الدولي: إنها راضية، حسب تحليلات هذا الكتاب، بموقعها كدولة تصدير، وليس كدولة هيمنة، وهي تستغل ما يسود عالمنا حالياً من ميول جامحة أحياناً إلى الإفراط في سلوكيات الاستهلاك.
ليس معنى هذا أن المؤلف يشيح النظر أو يتجاهل موقع الصين أو طموحاتها، ولكنه يقول إن الصين من شأنها أن تضطلع بدور فاعل بكل معنى في سياسة العالم، وإن كانت مكامن ضعفها تتمثل، في رأي البروفيسور هونغ أيضاً، في اعتمادها المفرط على أسواق التصدير، ومن ثم على دولار الولايات المتحدة، ومن ثم على استمرار النظام الدولي على ما هو عليه في الوقت الراهن، ومن ناحيتيه الاقتصادية والسياسية أيضاً.
كأنما تستعيد صفحات هذا الكتاب ملف اليابان الذي سبق أن روّع الأميركيين، وعُقدت عليه آمال عراض على مستوى العالم كله.
ولكن هذه الشمس اليابانية ما لبثت أن آلت إلى غروب، وهو ما يتصور الكتاب تكراره بالنسبة للنموذج الصيني، فيما نتصور من جانبنا العربي، أنها نظرة مسجونة ضمن سوابق التاريخ، خاصة وأن نموذجي طوكيو وبكين بينهما فروقات كثيرة، ليس أقلها أن اليابان تعاني انحساراً في حجم السكان وتضخماً في أجيال الشيخوخة، في حين أن الصين تشهد ضخامة بالغة في حجم السكان، بل تنبهت أخيراً إلى ما سببته سياسة الطفل الواحد للأسرة من سلبيات، فعمدت في الفترة القريبة الماضية إلى تصحيح هذا المسار.
القفزة العظمى أدت إلى المعاناة
نلاحظ أن المؤلف يبني مقولاته على أساس منظور، ربما يحمل عنوان تجربة أميركا مع اليابان، خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. وقتها سادت الساحة الأميركية خشية من أن النظام الياباني على وشك أن يهيمن على المنظومة العالمية في مجال التجارة وإدارة الأعمال. يومها أيضاً كان اليابانيون، كما يلمح مؤلف كتابنا، هم الذين يصنعون الصُلب، وينتجون السيارات بماركاتها المختلفة، والشهيرة أيضاً، ويحققون المكاسب الطائلة جداً، وبها كانوا يشترون العقارات على نطاق واسع في داخل أميركا ذاتها.
وفي خضم هذه الأجواء، تدفقت غزارة الآراء والتحليلات التي كانت تصبّ كلها في صالح اليابان، ولكن مع مطلع هذه الألفية الثالثة، ورغم مواصلة اليابان جهودها في مضمار التقدم، إلا أن مخاوف الأميركيين ما لبثت أن انقشعت، حين انكشف الغطاء عما كان يشوب التجربة اليابانية من مشكلات وسلبيات.
في حالة الصين، ينتقد المؤلف تلك المرحلة التي صاحبت ما يُعرف في التجربة الصينية بأنه القفزة العظمي: صحيح أنه يسلّم بما أسفرت عنه الخطوة المذكورة من تحديث لمرافق الاقتصاد الصيني، إلا أن القفزة أفضت إلى معاناة ملايين من مواطني الصين، سواء خلال ما وصف بأنه الثورة الثقافية التي صاحبتها اعتقالات ومحاكمات ومظالم خلال العقد الستيني.
ولدرجة يصفها المؤلف أيضاً أنها كانت أحياناً قفزة إلى الوراء، حيث تفاقمت معها حالة اللا مساواة بين المدينة والقرية، وبين أهل الحضر المحظوظين، وسكان الريف المهّمشين، وهو ما جعل النمو في أجور العاملين يتخلف كثيراً عن النمو في مجالات الاقتصاد ككل (ص 151).
ثم ازداد الوضع تفاقماً، كما يوضح المؤلف، بفعل التغير من نقيض إلى نقيض خلال ملابسات المسيرة الاقتصادية في الصين: بدأت المسيرة بنشاط اقتصادي تحت السطوة، الحديدية كما قد نصفها، للدولة، وطبعاً للحزب الوحيد الحاكم.
وعندما بدأت هذه المسيرة تشهد تحولاً عن هذه السطوة الحكومية، ترجموا هذا التحول إلى سلطات واسعة للغاية، تم تخويلها إلى الولايات الإقليمية والوحدات المحلية في الصين، وبما أتاح لها أن تتصرف في أمور الاقتصاد بصورة مستقلة، وهو ما أوجد، كما يؤكد مؤلف الكتاب (ص 155)، حالة من الفوضى المنافسة في ما بين تلك المناطق المحلية، وأدى إلى قيام قدرة إنتاجية تفتقر إلى التنسيق، وتستند إلى بنى وهياكل أساسية يشوبها الاضطراب والتضارب.
“التنين” قاتل الحلم الأميركي
الصين حلت محل اليابان بوصفها قاتل الحلم الأميركي، لكن مخاوف الأميركيين من أن يشتد ساعد الصين إلى حيث تستثمر ما حققته من ازدهار اقتصادي لا ينكرها أحد، أو إلى حيث ترجمته إلى أن تصبح القطب رقم واحد كما يتصور مؤلف هذا الكتاب، الذي يجهد كي يثبت أن بكين لن يصل بها الأمر إلى حكم العالم، و يمضي المؤلف إلى القول بأن الصين لن تستطيع مباراة أميركا من الناحية العسكرية، فميزانية بكين المرصودة للجيش تبلغ 129.4 مليار دولار، بينما تصل ميزانية واشنطن المعتمدة للأغراض العسكرية إلى مبلغ 571 مليار من الدولارات. ثم إن الصين لم تجعل حكم العالم هدفاً أساسياً لها.
المؤلف
يعمل الدكتور هو فونغ هونغ، أستاذاً لعلم الاجتماع في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة. وقد جاءت نشأته وتحصيله العلمي الأول في وطنه الأصلي بالصين، حيث حصل على درجة الليسانس من جامعة هونغ كونغ، ثم حصل على الماجستير من جامعة ولاية نيويورك، وبعدها أكمل الدكتوراه، متخصصاً في بحوث العلوم الاجتماعية بجامعة جونز هوبكنز. وقبل أن يعمل أستاذاً بالجامعة المذكورة، عمل محاضراً في التخصص نفسه بجامعة إنديانا.
صحيفة البيان الأماراتية