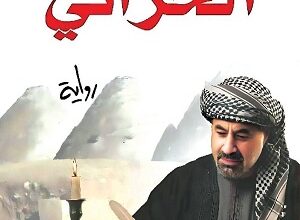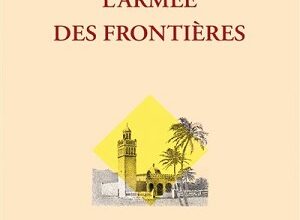الغَيْبُ مَلِكُ الزّمَان| “الأميرة والخاتم” لرشيد الضعيف

الأميرة والخاتم
الراهن ليس قدرا روائيا مؤبدا، ذلك ما تنبئنا به النصوص التي سعت إلى استعادة تخاييل الكتب المقدسة والملاحم والأساطير القديمة، المؤرَّقة بأسئلة الخليقة والفناء والقدرة والإيمان. بيد أنه سبيل بات شديد العسر، وخارج مآرب التعبير المأخوذ بأسئلة المجتمع والسلطة وتقلبات الزمن المعاصر، ولعل الإصدار الأخير للروائي اللبناني رشيد الضعيف “الأميرة والخاتم” (دار الساقي، بيروت، 2020)، أحد التجارب المجبولة بهذا التناول الصعب والنادر، لجوهر الوجود، توسل صاحبه بأساليب كتب السير الشعبية ومدونات مفسري القرنين السادس عشر والسابع عشر ومؤرخيهما، مزيج من لغة “بدائع الزهور في وقائع الدهور” لابن إياس و”منامات الوهراني” و”حكايات الليالي”… كتبها صاحبها لإعادة تمثل صلة الخليقة بالمشيئة الغالبة، تلك التي يسميها المؤمنون تارة بـ”الله” وتارة بـ”الخالق”، ويسميها غيرهم بـ”الطبيعة”، بينما يستعمل الروائي مفردة ملتبسة يلجأ لها الحائرون، مفردة “الغيب”. قدرة منبثقة من الأزل تحتوي التَّصاريف، وتضع لها قوانين، وتوكلها للزمان، وتهب سطوتها لملوك الوقت، وتبعث بنواميس عبر أحلام ورؤى، تعطي مفاتيحها لأصفياء، سُمُّوا “رسلا” و”أنبياء” و”معلّمين” و”حكماء” و”عارفين”، وجعلوا في خدمة الملوك والأمم.
ولتخييل أمثولة الوجود، أعاد الروائي تركيب حلقات السيرة الإنسانية في مجابهة الفناء، عبر حكاية تنهل من الرصيد العجائبي المنجم عبر الثقافات والأديان، أميرة يافعة يتيمة الأم، قدِّر لها أن ترث ملك والدها، تعجز عن إيجاد زوج لائق، في زمنها، وتوحي المنامات بوجود نومها في سرير من خشب سحري، يصاغ منه خاتم خشبي، يرافقها في غفوتها الطويلة، الممتدة لقرون، تنهض فيها أمم وتبيد أخرى، وتُتوارث خطوب وأفراح، وتتبدل أحوال وصفات، في الكون الواسع. قبل أن تُلهَم الأميرةُ بإشارة القيام، للبحث عن رجلها في زمانه، فتهيم متقفّية العلامات الواردة عبر النواميس، وتفاسير الحكماء، حتى تحل بأرض فلسطين، لتجد الشخص الموعود، الذي لن يكون لها، وإنما لزمانه. مُعلّم تتقاطع في ملامحه وتعاليمه صور الأنبياء والقديسين، مزيج من “موسى” و”الخضر” و”المسيح”. يُعيدها، بعد أن يشقّ الزمان، إلى وقتها، وإلى أبيها، فتتزوج من مملكتها، وتهب المعلم العائد إلى زمنه خاتمها الخشبي الذي انغرس في صخرة بأرض القدس لا يعلم مستقرّها أحد، ستلهب عبر الأزمان مخيلة الفاتحين والغزاة والمنقبين والحالمين. وتتخلل المحكية عشرات التفاصيل المتصلة بالأرض والماء والشجر والسماء والجبال والملك والأحلام والكنوز والتفاسير والمعرفة والإيمان، ثم الصبر أولا وأخيرا، صيغت بمفردات ومجازات “الأولين” الساعية لفهم إعجاز القدرة ولغز المشيئة.
انطوت الرواية على اثنين وستين فصلا، عَنْوَن الكاتب أولها بـ”في زمن بعيد” وآخرها بـ”البحث عن الخاتم”؛ وما بينهما تواترت عشرات العناوين، الدالة على مفاصل الحكاية وعوالمها وألغازها وشخوصها، المشدودة إلى مأرب البحث عن تأويل للصلات بين الغيب والملْك والزمان، وما بين الجسد وقرائن الإرادة، ثم السعي إلى تنزيل ظلال الرسل الأولين عبر مجازات “المعلّم” العارف.
في مقطع من الفصل الحادي عشر، المعنون بـ”على الأميرة أن تحلُم”، يقول السارد “إنّ الملوك يسوسون الزمان، وإنّ سياسة الزمان مشاركة للغيب في مشيئته، لأنّ بهم تتحقّق هذه المشيئة. إنّ الملوك الصالحين هم يدُ الغيب في الزمان، وهو الذي كلّفهم أنْ يرفعوا من الناس ما ارتفع، وأن يَضعوا من الناس ما اتّضع. وهو الذي جعل ألّا يَصلَحَ الزمانُ إلّا بهم” (ص 35 – 36).
ينهض “الغيب” في الرواية بوظائف البطولة المهيمنة على مرتكزات التخييل والسرد، هو القاعدة التي تستدعي الأفعال والاستجابات وتمنح الشخوص أساس التصرف، بحيث ترتد كل المقاطع والصور والأسماء والوقائع إلى دائرة سطوته، والسعي إلى تفسيره، وتبيين أسباب قدرته، وكل الأبطال الفرعيين، من “الملك الأب”، إلى “الأميرة”، إلى “المعلّم”، إلى غيرهم من الشخصيات العابرة، يَمْثُلُون بوصفهم تجليا لسياسته، وتمكينه، وتنازله عن جزء من صفاته، في التحكم والقدرة، والمنح والمنع، والإبقاء والإزالة، في الدنيا التي ليست شيئا آخر إلا “زمانا”، بالوصف السردي، الذي تتحول فيه الرواية ذاتها إلى “خبر” مبتدؤها “الغيب” وخبرها “الزمان”.
لا جرم، من ثم، أن تضحى المقاطع الروائية، المفعمة بالإشارات والتنبيهات، والأحلام وتأويلاتها، عتبة للنفاذ من ضوء اليقين المبهر، المتوارث عبر الثقافات، والنصوص المقدسة، إلى ظلال الحيرة المحترقة بالسؤال، عن غيب لا يفسِّر غيابه ولا حضوره، ولا نأيه أو تدخله في الأحوال والأقدار، بقدر ما يهب جبلّة التخييل، التي توائم بين عدل الغيب وعدل الملك، وبين حق المشيئة وحق الزمان. ف: “الغيب لا يهوى التدخّل في الزمان كلّ يوم” (ص 215)، من بدء الخليقة إلى يومنا، تماما كنوم الأميرة المسافر عبر الدهور ثم عودتها على البدء، دون تحصيل المراد، إلا خوض تجربة السفر التخييلي الخارق لبداهة الأشياء.
يتصل الغيب في الرواية بالملك صلة أصل بفرع، بيد أن الفرع يرتدّ على الأصل بما هو تعيّنٌ وظهور، لا مجرد قدرة، هو سلطة من لحم ودم وملامح، وقرائن ممتدة من العمران إلى الناس والحيوان والشجر؛ المرتهنة كلها لإرادة الملك، الذي يمثل في المبنى الروائي بما هو ظل وامتداد لإرادة الغيب، وتصريفٌ لمشيئته، وحارس لقوانين كونه في الزمان. على هذا النحو تُشرّح السرديّة أمثولة السلطة المتوارثة عبر قرون، ملتفعة إيهابات شتّى، من الأدبيات اللاهوتية إلى السلطانية إلى التسلطية الحديثة، حيث تضحى “سياسة الزمان” إطلاقا لــ”اليد” المصطفاة، في رسم المصائر لسعيدة والشقية للبشر. ولأن تلك اليد قدرا غيبيا، فقد اختارت الرواية أن تجعل لها سمات من أصلها، تتخطى قدرات الخلق، فالملك عارف وعادل وقادر وعابر للزمان.
الجسد وقرائن الإرادة
بيد أن الملك الأب، وابنته الأميرة الموعودة بالحكم، كلاهما جسدان؛ الأول ثابت في زمنه والثاني عابر للدهور، يفترض السارد أن الملك بشر آيل إلى زوال، وأن الأميرة امتلكت طاقة البقاء في منام، بترويض الجسد على التواؤم مع حال السفر الأسطوري، وتطويع الحواس على الزهد في القوت، ثم الصوم الطويل، والاكتفاء بضوْع العطر. هل هو صعود للروح؟ أم مجرد استكانة لضجعة مؤقتة؟، تنبئنا الرواية، عبر عشرات المقاطع، والمشاهد، المفعمة توترا، أن ثمة حقيقة ظاهرة للكائن، لا مراء فيها، هي الجسد، بيد أنها غير ميسّرة للإدراك؛ لا يكفي الحديث عن “العُمْر” لفهم طاقة الحياة، الساكنة في الكيان الظاهر، وإنما ثمة قارة واسعة متصلة به، هي “الجوهر” وبإدراك كنهها ندرك حقيقة الموت. يقول السارد “لا يغيب عن بال الغيب أنّ جسد الإنسان يتحوّل مع الوقت ثمّ يتهاوى، وأنّ هذا قدَرٌ خطَّه هو بنفسه، لا ينفع معه حذَر الإنسان و لا عنايته، إنّما هي الكتبُ والألواح قد دُوِّنت فيها مصائر المخلوقات، ومآلات الأشياء، فكلّ شيء في هذا العالم حلقةٌ في الحسبان، وما من ذرّة من ذرّات هذا الكون إلا حدثت بإرادة، وما من ذرّة من ذرّات هذا الكون إلا وَكَّلَ الغيبُ بها جوهراً لطيفا لا يُرى ولا يُسمع له صوت، ولا يَتَقرّاه لمس، وما من قطرة إلا ويرافقها جوهر ينزل بها من الغيم، ويضعها في المكان الذي قُدِّر لها، ثمّ يدعها تجري بعنايةِ جوهر آخر. عندما انتَبه الغيب إلى هذا الأمر، وهو الذي لا يغيب عن باله شيء، إنّما لكلّ شيء عنده إبّان، أرادتْ حكمتُه أن يترك للزمان أن يشاء” (ص 133).
تُنَجَّمُ هذه المقاطع التأملية في مجمل فصول المتن الروائي، المشدود إلى بنية الحكاية الفنطازية المشوقة، مثلما يحدث في مصنفات الرسائل والأخبار والسير والتفاسير، حيث تستثار “الحكمة” من صلب الوقائع، تعقيبا عليها، وتبيينا لمعانيها، وتأويلا لمقاصد الحدث الخارق منطقَ الإمكان فيها. بحيث تتحول المحكية، في العمق، إلى نثر عقائدي، بصدد الوجود في العالم، وحرية الاختيار والإرادة. وينخرط السارد تدريجيا في بيان جدل الجسد و”الجوهر اللطيف” (وهو مفردة من المعجم الصوفي)، بالموازاة مع تنامي وظائف الشخصيات في مواكبة حدث النوم الأسطوري، مفصلا الحديث عن مراتب الفناء، في النوم والحلم، قبل الضَّجْعَة الأبدية؛ ناحتا مجازين للكائن، يتفتق عنهما الحال والمآل، هما “القرين الحي” و”القرين النائم”، المتحدان دوما في اليقظة والمفترقان في الحلم، واللذين إن دام افتراقهما كان الفناء.
مجازات المعلم العارف
تسطّر الرواية هدفا لنوم الأميرة هو بلوغ زمن يظهر فيه فتاها الموعود، الذي لن يكون في النهاية لها وإنما للناس كافة، كما تقول العبارة السردية، هو مزيج من أحوال النبي “موسي” في شقه الزمان إلى نصفين، لعبور الأميرة إلى مملكة أبيها، وملامح “الخَضِر” في ظهوره وغيابه، والسيد “المسيح” في تعاليمه، وانتهائه في يد جند ملك القدس. غير أنه يتجلى في كل الأحوال بما هو “معلّم” ينطق بلسان الفطرة البشرية، متأملٌ متسائلٌ، مأخوذ بالزمان، ومفارق لمشيئة الغيب. إنسان مخترق بالشكوك، حائر بصدد المآل، يقول السارد “في المقلب الآخر من الزمان، في المقلب الآخر من الدنيا، وراء الجبال التي تفصل الغيب عن الزمان والدنيا، وفي باحة، أمامَ بيت متواضع قديم، في حيّ منعزل من مدينة القدس، في بلاد فلسطين، كان السيّد المعلّم الذي فتق الزمان برفقة الأميرة، يتأمّل غروبَ الشمس، متّكئا على صخرة، في ظلّ زيتونة، ويتأمّل عبور الزمن على هذه التضاريس في مرمى نظره، ويتأمّل كيف تتغلغل الأيام في ثنايا الأرض، ويحاول أن يدُرك كيف أن الزمن جزء من الزمان، وكيف أن الغيب لا زمن له، ولا زمن فيه، لا ماضيَ له، ولا مستقبل، ولا أرض، ولا قاعدة، ولا قانون، ولا سبب”. (ص 234).
***
يمكن اعتبار رشيد الضعيف، على الدوام، روائي الزمن العربي الحاضر، وإن تلفّعت محكياته بمجازات قديمة، ذلك أن هواجس ما يجري في تربة الجغرافيا المعقدة المسماة “الشرق الأوسط” من التباسات اجتماعية، وتقاطب فكري وعقدي، واحتراب جسدي، وارتداد مطرد إلى أسئلة “الغيب”.. ما هو إلا صيغة أخرى لحرب أهلية مخفية بين التلافيف والحنايا، لا تلبث امتداداتها أن تستعر مع ازدهار عوامل النكوص إلى المحافظة وتراجع مكتسبات النهضة. من هنا كانت رواية “الأميرة والخاتم” استعارة ممتدة لهذا الاحتراب الذي لم يفارق يوما أصوله الأولى، من حيث هي جزء من هوية هذا الشرق الذي احتضنت أعطافه الأديان والرسائل والأساطير والتخاييل الغيبية، مثلما احتضنت تربته رفات الأنبياء والأولياء والقديسين، ولبثت مثلما هو حال الخاتم الأسطوري، في الأسطر الأخيرة من خاتمة الرواية “لا يُدرِك سرَّه أحد. وما زال خبراء الكنوز يحفرون، وكلّما بلغوا قاعاً، حفروا أيضًا” (ص 239).