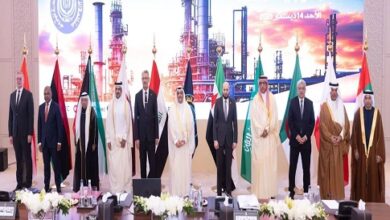اللحظة «السيّابية» كما تتجلى في الثقافة العربية الراهنة

قبل عشرين عاماً… كتبت عن السيَّاب، بوصفه صورة تقريبية لحال العراق، حيث الحصار، والجوع، والمرض، وقلَّة الدواء، والموت التراجيدي، جعلت بلاد الرافدين آنذاك في حالة بدت فيها «سيابية» بامتياز! ولعلَّ التعاطف مع الحالة السيابية، وهو ينطوي على نوع من الشعور بالإشفاق أمرٌ في منتهى القسوة، لا يليق بشاعر خلاق كالسياب، بل أن بدراً نفسه وصف هذا الإشفاق الذي قد يطاوله بنوعٌ من العار، ذلك أنَّ «الموتُ أهونُ مِنْ خَطِيَّة» كما كتب في قصيدته «غريب على الخليج»
واليوم، في الذكرى الخمسين على رحيله، يمكن أن أنقِّح ذلك التوصيف قليلاً ليغدو أوسع، فأقول: إنَّ «الحالة السيابية» لم تعُد مجرد لوحة وطنية محلية، في لحظتنا العربية الراهنة، بل غدت صورة تبدو نمطية لثقافة أُمَّة. فالمتن الشعري للسيَّاب يكشف لنا عن شاعر وارثٍ لِمِحَنِ الأولياء والشهداء والقدِّيسين، من آلامه الأيُّوبيَّة التي كتب عنها سِفراً للآلام بعشرة مقاطع بإيقاعات عروضية متعدَّدة تنويعاً للألم، إلى عذاباته اليسوعية المركَّبة التي تحفل بها أشعاره، واللافت هنا مصادفة يوم رحيله مع ميلاد السيد المسيح، في 24-12- 1964 لتتكرَّس حبكة تلك الحكاية التراجيدية عن رجلٍ شقيٍّ، رحل في الثامنة والثلاثين من عمره، وأحدث الانعطاف الأساسي في الشعر العربي في القرن العشرين، وترك كل هذه الضجة من بعده، وهو بعدُ في الشطر الأول من عشرينيَّاته!
وهم الأممية
والواقع إن فتى جيكور القادم من أبي الخصيب، انسحب نحو ما بدا لهُ «روح الأمَّة» بعد أن تملَّص من وهم «الأمميَّة» لكنه لم يخطر له بالتأكيد ولا حتى في هذياناته في مرضه، أنه سيخضع لمقاربة طائفية في عراق ما بعد 2003، أو لنقل في الثقافة العربية الواقعة إلى حدٍّ ما، منذ تلك اللحظة، تحت طائلة هذا التشريح الغريب لجسمها الثقافي. فعلى إحداثيات الخريطة الطائفية الجديدة في العراق، بدا ممكناً بل متاحاً لمن يرغب مراجعة موقفه من الشعوبية، التي أكثر في تفنيدها وشجبها خاصة في كتاباته النثرية، بأثر رجعي وإسقاطي بل وحتى إحياء غمزه من الجانب العِرقي لخصومه وغرمائه من الشعراء!
ومع هذا، وبه أيضاً يبقى السياب صورة تقريبية، إن لم تكن نموذجية، للأمَّة في راهنها، حتى لتكاد الثقافة العربية راهناً تتجلِّى «سيابية» إلى حدٍّ بعيد! فثمة جسدٌ يتناهبه الإعياء والأعباء على حدِّ سواء، وساقان متباعدان يجرُّهما كمصاب في حروب أهلية، بينما فتك به المرض الغامض، ونالت من عنفوانه النفسي الصراعات السياسية التي لم تكن تجري على أرض «الوطن» أو «خريطة الأمة» فحسب، وإنما على ذاته المتصدَّعة، وصحَّته المتردِّية باستمرار، لتنعكس بالتالي على مجمل تجربته الشعرية.
ولأنَّه معادل موضوعي لحال «أمَّة» يجري التعاطف معه بنوع من آلية الشَفَقة على الذات، فليس ثمة من نزوع في الثقافة العربية نحو نقد الذات بقدر تمجيدها أو تأبينها، حتى وإن جاء ذلك التمجيد منطوياً على صيغة العطف والشفقة، لا الاعتزاز وتقدير الذات.
لكن مشهد الثقافة العربية الراهن باحتياج مُلحٍ إلى نقدٍ تشريحيّ، لا إلى نقدٍ تأبينيّ، مثلما هو الأمر مع السياب بعد نصف قرن على رحيله! من هنا أهمية إعادة قراءة القلق، في التجربة الحياتية والسياسية للسيَّاب، لا على أساس الدوافع الإيديولوجية الراديكالية المنظَّمة، وإنما على أساس الرواسب الاجتماعية في الشخصية، والنوازع النفسية الْمُضمَرة، وهو ما لم يحدث على الأقل في النقد العراقي، بسبب الواقع السياسي الذي كان سائداً، فقد قرأه الشيوعيون بوصفه مارقاً، في مرحلة، وضحيةً في مرحلة لاحقة! تناغماً مع الخطاب السياسي، فيما حاول القوميون تطهيره بعذاباته الشخصية، وبتحويل البوصلة للطرف الآخر بوصفه سبباً من أسباب تلك العذابات، لكنه ببساطة كان شاعراً حائراً وقلقاً ويتمتَّع بسمات الضعف الإنساني الطبيعي، فانطلق شيوعياً قبل أن ينعطف إلى المهرجان القومي، وبينهما كان يتمرَّغ في برهة وجودية قلقة هي الأخرى.
لازمه ذلك القلق في الموقف السياسي منذ تجربته مع الحزب الشيوعي، الذي بدا له مدافعاً عن الحريات في مكان آخر، فكانت محاولته الأولى لكي يبدو ذلك الشاعر ذا النزعة الإنسانية منذ قصيدته «حاطم الأغلال» في ديوانه الأول «أزهار ذابلة» المهداة إلى المغنِّي الزنجي الشيوعي الأميركي «بول روبسن» وهي قصيدة تتحدَّث بلغة وشكل تقليدين عن اضطهاد الزنوج في أميركا، مُحدثة انحرافاً ووجوداً نافراً في مناخات الديوان بأجوائه الذاتية لعاشق كتب معظم قصائده غزلاً توسلياً لزميلات المقعد الدراسي وهو لا يزال في العشرين من عمره!
انتهت مغامرته الجمالية وفكرته الطوباوية عن «تحرير العالم» سريعاً، ليكتشف أن العبيد الذين يتوقون للحرية ليسوا في مكان بعيدٍ، فراح يكتب عن: فلسطين والسويس والأوراس وجميلة بوحيرد والمغرب العربي. بعد أن تخلى نهائياً عن الحزب الشيوعي عام 1953، والذي كان قد دخل إليه باسم حركي مستعار هو «جرير» وليكتب لاحقاً اعترافاته المشهورة «كنت شيوعياً» في سلسلة مقالات نشرها عام 1959 في مجلة «الحرية» ذات التوجه القومي! في وقت كان فيه الشيوعيون تحت رعاية السلطة وفي أحضان الشارع.
وهكذا تقريباً كان حال تنقله بين المجلات العربية المعروفة آنذاك «الأديب» و«الآداب» بهويتهما العروبية، ومن ثمَّ انقلابه السريع نحو مجلتي «شعر» و«حوار» بنزعتهما الليبرالية. وهكذا أيضاً دأب في نقده للأدب الشيوعي ونظرته المحدودة، مستفيداً من عروبية تلك المنابر من جهة، وليبرالية المنابر الأخرى من جهة ثانية، بخاصة أنَّ هذه المنابر باختلاف توجهاتها كانت جزءاً من التعقيدات والتفاعلات الثقافية للحرب الباردة.
خصومات شعرية
حتى خصوماته الشعرية، كانت في الواقع ترجيعاً واضحاً للقعقعة الصارخة لذلك الصراع، فخصومته مع البياتي على سبيل المثال، لم تكن شعرية محضة، ولا تتوقف عند تلك «الواوات» التي انتقد تكرارها الرتيب في قصيدة البياتي «سوق القرية» لأنه سيتكئ، هو الآخر، على تلك «الواوات» كتقنية تكرارية بلاغية واضحة في أبرز قصائده: «أنشودة المطر» و«في المغرب العربي» على سبيل المثال، لكنها كانت خصومة في «واوات» أخرى ليست للعطف اللغوي الظاهر وإنما عطفاً على سياق صراع متعدِّد الأشكال بين جماعات شتَّى. فإذا كان البياتي ابن المدينة «بغداد» قد استأثر برعاية الشيوعيين في العراق، وعناية «الآداب» في لبنان، فأن السيَّاب، القادم من الريف الجنوبي وجد نفسه يتخبَّط في أكثر من طريق ويترنَّح مقدماً نفسه ضدَّاً نوعياً للشيوعيين أمام البعثيين، ويتحمِّس بنزعة ريفية نحو «المنظمة العالمية لحرية الثقافة» في مواجهة «مجلس السلام العالمي» وقلقاً بين «الآداب» من جهة، و«حوار» و«شعر» من جهة مقابلة.
وهكذا انقلب الخطاب من نعوت تبجيلية: «الزعيم العبقري» و«الفذ» في وصف عبد الكريم قاسم، إلى هجائيات متشفيِّة، فبعد أن كتب من سرير مرضه في مستشفيات لندن «أغثني يا زعيمي» مخاطباً عبد الكريم قاسم في قصيدة نشرت في الصحف العراقية، ولم تصل إلى «الزعيم» الذي كان هو من يحتاج إلى الغوث، في مواجهة بنادق الإعدام على كرسي في مبنى الإذاعة ببغداد، كتب السيَّاب بعد أيام وعلى السرير ذاته هجائيته «عُمَلاءُ قَاسِمَ يُطْلقونَ النَّارَ آهِ عَلى الرَّبيع» أول جملة في قصيدة «إلى العراق الثائر» وهي آخر قصيدة في ديوانه «منزل الأقنان» ومؤرخة في الثامن من شباط يوم انقلاب البعثيين وإعدامهم «الزَّعيم» وهي قصيدة هابطة فنياً وركيكة بلاغياً، وتمجَّدُ ربيعاً دامياً، بيد أنَّ أهميتها تأتي فقط من كونها تبشّرُ بربيع مزعوم، سيأتي به «تموز» آخر كما تنبأ السيّاب، في مصادفة رمز تموز الأسطوري، مع الشهر الذي سيقود فيه البعثيون انقلاباً ثانياً لم يكن بدر حاضراً ليمجِّدَه كما فعل مع شباط/ رمضان 1963، لكن السياب نفسه، كان يردِّد إنه متهم «بالتموزية» أكثر من كونه بعثياً، بمعنى أنه أقرب، فكرياً، إلى طروحات أنطون سعادة، وألصق، فنياً، بالنزعة الانبعاثية في الشعر.
إذاً فالظلال العميقة لصورة السياب لا تكمن في تلك التخطيطات التي هيمنت عليها تداعيات الصراع السياسي بين الماركسيين والقوميين، وإنما في تلك الخطوط الداخلية العريضة في تجربته الذاتية البحتة: نزعة شخصية مهيمنة في شعره عبر تكرار الموتيفات: الأمّ الراحلة، الخوف من المطر، أسفار المرض الممض الذي أضطره إلى «استجداء الطغاة» كما يقول، مستعيراً من صايغ: «كَسْيح وما مِنْ مَسِيح» الإشادة بالريف وهجو المدينة «بغداد» بوصفها «مبغى كبيراً» مستعيراً من توفيق صايغ مرة أخرى هجاءه للندن بوصفها «مرحاضاً كبيراً»، كذلك: ألفة النهر، ووحشة البحر، إلخ… وهو ما يظهر بقوة في ديوانه «منزل الأقنان» ديوان المرض السيَّابي بامتياز، وبخاصة مطولته «سفر أيوب» وقصائده «نداء الموت» «منزل الاقنان» «أسمعه يبكي» «قصيدة من درم» «قالوا لأيوب» «الليلة الأخيرة» «هرم المغنِّي» حتى يتحول مع «شناشيل ابنة الجلبي» إلى حالة برزخية من الموت العضوي.
اكتملت صورة السيَّاب بوصفه ضحية، ليس للمرض العضوي الذي أنهكه لثلاث سنوات حتى أودى به في مثل هذا الوقت من عام 1964، وهي سنوات الصراع الدموي على السلطة في العراق، وها هي صورة الثقافة العربية تبدو «سيَّابية» بامتياز، بيد أنها لا تقف عند حدود كونها ضحية للصراعات السياسية التقليدية، وإنما تغدو ضحية لعنفٍ دمويٍّ متطرِّف.
لقد أُريدَ للشاعر أن يكون شاعراً أممياً! لكنه كان يطمح أن يغدو شاعراً إنسانياً يطارد الأفق الأزلي، ودفعته الوقائع التي لا دخل له في معطياتها، ليركن إلى قضايا «الأُمَّة» لكن قضيَّته الدقيقة حقاً هي «أُمُّه» بالهاء لا بالتاء! ومطرُهُ الريفيّ ومرضه الشخصيّ، فَرضِيَ «من الغنيمة بالإياب» ولذا فإنَّ محاولات إعادة قراءة السيَّاب على أنه شاعر جماعة! تندرج في سياق من التجاذب المزمن الذي يتجلى في صور شتَّى آخر ما تعكسه في مراياها الدامية هو: صورة الشاعر.
صحيفة الحياة اللندنية