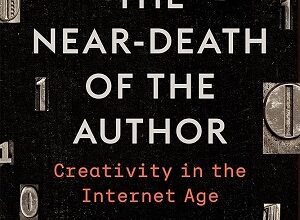المجتمع الحديث لا يوفر سوى مكانة متدنية لتعليم الفنون

ييؤكد الشاعر والناقد والمترجم د.شربل داغر ،في مقدمته للطبعة الجديدة من ترجمته لكتاب “ما الجمالية” للباحث الفرنسي، المرموق في الجماليات ،مارك جيمينيز، افتقار المكتبة العربية إلى كتب الفـن، بين تاريخه ونقده وغيره من العلوم التي تعنى به، وأن أشد ما تفتقر إليه هو الوقوف عند الجمالية، فالكتــب العربيــة الموضوعة في هــذا الصنف الكتابي معدودة للغاية، عدا أن ما يترجم منها قليل هو الآخر. هـذا فيما لا يجد طالب الفن، ودارس الفن، في كليات ومعاهد عربية، ما يساعده في الدرس والتحصيل.
الكتاب الذي صدرت طبعته الجديدة عن دار خطوط وظلال الأردنية يشكل مرجعا في درس الفن والجمال، حيث يراجع تاريخياً ونظرياً وتحليلياً انبناء “الجمالية” كسبيل دراسي وفلسفي، منذ التفلسف الإغريقي مروراً بالنظريات “الكلاسيكية” بلوغاً إلى المذاهب الفلسفية المتأخرة. وهو بقدر ما يعاين الخطاب الجمالي يعاين أيضاً التجارب والأساليب الفنية، فضلاً عن أنه يعاين تشكّل هذا الخطاب الخصوصي في نظرية الحداثة نفسها. ومن ثم فهو يقع أيضا في صلب الجدل حول الحداثة وما بعدها، وفي رهانات المجتمعات والثقافات لجهة أحكامها وقيمها وخياراتها الذوقية والأخلاقية والفنية وغيرها.
يقول جيمينيز في توطئته الخاصة بالطبعة العربية إنه “قبل عشرين سنة، بدأت علامات الشيخوخة المبكرة على لفظ الجمالية، المستعمل لتعيين التفكير الجمالي في الفن. كما ظهر اللفظ باليا وقابلا للاندثار، على الرغم من أن معناه الحديث يرقى إلى القرت الـ 18 فقط، بل ذهب بعض الفلاسفة حتى التصريح أن “الجمالية بانت على الرعم من أعوامها المئتين، من منتصف القرن الـ 18 حتى منتصف القرن الـ 20، مثل فشل ساطع عامر بالنتائج”. إلى ماذا تعود مثل هذه المفارقة؟ إلى اختلاف معاني لفظ الجمالية طبعا؛ وهو ما سنعالجه لاحقا، إلا أنها تعود أيضا إلى غرض الجمالية نفسه، أي الفن؛ وإلى التناقضات الكثيرة التي يثيرها.
وهي ما نعايشه في جاري أيامنا. كيف لنا أن نفهم على سبيل المثال، أن المجتمع الحديث، المنضوي تحت حضارة الصورة، لا يوفر سوى مكانة متدنية لتعليم الفنون التشكيلية؟ حصلت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، بالطبع، وتمثلت في إيجاد شهادات عالية وامتحانات عديدة للفنون، إلا أن أساتذة الفروع الفنية المختلفة يعرفون جيدا أن مكانتهم المخصوصة لا تقوى على منافسة زملائهم في العلوم الرياضية أو الأدبية أو اللسانية، مثال آخر: توالد الموسيقى ـ وجب الحديث عن أنواع الموسيقى كلها ـ عالما صوتيا نسوح فيه دوما، بل تكثف هذا العالم وزاد إتقانه بفضل انجازات استعمال التقنيات الجديدة ومرونتها، لنفكر في أجهزة الاستماع وأسطوانات الليزر المتنقلة، لكن لو وضعنا جانبا بعض الاختصاصات الدراسية المحددة ـ أي مكانة يحتلها تعليم الموسيقى في صفوف المرحلة الثانوية؟ كم طالب مرشح، في امتحانات الثانوية العامة، يتمكن على الأقل من قراءة نوتة معزوفة موسيقية؟ وأخيرا ما يمكن القول في تعليم الجمالية، وهي المادة المدرجة في برنامج الفلسفة للصفوف الختامية، التي ينتقل درسها إلى نهاية السنة الدراسية.. إن بقي وقت لذلك”.
ويضيف “الفن ـ إذن ـ ميدان على حدة، بل يزيد على ذلك أنه غامض، فهو موصول بممارسة، ويولد أشياء قابلة للمس، أو يسمح بإقامة ظواهر ملموسة تتعين في الواقع؛ يسمح الفن بعروض، وفق مختلف معاني الكلمة. ويمكن القول بعد بيار فرنكستيل المؤرخ وعالم الاجتماع في الفن؛ “الفن ليس نية بل إنجاز”. غير أن الفن لا يكتفي بأن يكون موجودا، لأنه يعني كذلك طريقة في تقديم العالم، في إظهار عالم رمزي موصول بحساسيتنا، وحدسنا ومخيالنا، واستيهاماتنا؛ وهو جانبه التجريدي. يتنزل الفن، في الإجمال، في الواقع من دون أن يكون واقعا بالكامل، ناشرا عالما متوهما يحلو لنا العيش فيه أحيانا ـ لا في صورة دائمة ـ بدلا عن الحياة.
إن فهم غموض الفن وتفسيره يشكلان باختصار تحديا لا يتوانى عالم الجماليات عن رفعه، أيا كانت مخاطر الفشل. فنحن نستطيع من دون مشقة قياس صعوبة هذه المهمة، لأن الجمالية ورثت غموض الفن، وهذا نشاط عقلاني، من جهة، يشترط مواد وأدوات، وهو نشاط غير عقلاني، من جهة ثانية، طالما أنه يقيم على مبعدة من الأعمال اليومية التي تشغل غالب وجودنا”.
ويشير جيمينيز إلى مجموعة من الأسباب تفسر هذا الميلاد الجديد للجمالية، يقول “الفن الحديث في بدايات القرن العشرين، وردة الفعل القوية عند دعاة هذا الفن تجاه التقليد، وعنف التظاهرات الطليعية، هذه كلها تبلبل، في اللحظة الحالية، عمل منظري الفن، فهناك قلة من علماء الجمال خاطرت، بين العام 1910 والحرب العالمية الثانية، مثلا، في اقتراح تفسير نظري وفلسفي لأعمال الفن الجاهز لمارسيل دوشان، ولأعمال مجموعة دادا الاستفزازية، أو للوحات بيكاسو التكعيبية، أو للمعزوفات غير النغمية لأرنولد شونبرغ، أو لبرنامج أندريه بروتون السوريالي، بعد سنوات على ذلك. ولهذا لم تتبلور النظريات الأولى للفن الحديث، في صورة متماسكة ومتسقة إلا ابتداء من ستينيات القرن العشرين”.
ويرى أنه من الممكن فهم هذا الحذر بالطبع، فإذا كان التعرف على الأعمال الفنية الحديثة يتم بسرعة، بفعل الصدمة تحديدا التي تحدثها في الحساسية، فإن الاعتراف بها من قبل المؤسسات بالذات، يحدث بالمقابل، في وقت متأخر، وبشكل متفرق. إن مختلف التيارات والميول ـ وكل ما تلحق بها اللاصقة: “ــية” ـ يتتابع وفق إيقاع سريع؛ وهي تمثل في هيئة موضات عابرة بشكل أو بآخر، ما يعقد مهمة الفيلسوف الجمالي. ذلك أن هذا الأخير يعتني، في المقام الأول، بإظهار الثوابت، بدل تفسير الأعمال المعزولة، التي يعتبرها أحيانا، عن خطأ أو صواب، مثل تجارب بسيطة مزعجة ومستفزة. بالإضافة إلى ذلك تتضمن الأعمال الطليعية وعلى طريقتها، تفسيرها الجمالي، الفلسفي، والسياسي أحيانا، المخصوص بها. فهناك كتابات عديدة تعرض بدايات هذه الحركات، وتعرف بأهدافها، وتحدد برنامج للتنفيذ، هذه مهمة البيانات، سواء “المستقبلي”، أو “الدادائي”، أو “السوريالي” أو “البنائي” ـ بعيدا عن اختلاف الوسائل، وتقضي بتحويل القيم القديمة وتعريف العلاقات الجديدة التي ينشئها الفنانون مع الطبيعة والعالم والمجتمع”.
ويؤكد جيمينيز أن الفن الحديث ينهل قوته، إجمالا، من ديناميته الخاصة في تأكيد شرعيته، فلقد كانت التوافقات السابقة تتساقط واحدا بعد الآخر، بفعل الثورات الشكلية التي أسقطت معها القواعد والمعايير التي كان الفن القديم يتقيد بها، بينما كانت تنهض بالمقابل فوق الأرض المحروقة ـ لو تمت استعادة العبارة الدادائية المعروفة ـ قواعد جديدة. وهي قواعد سريعة الزوال، يتم استبدالها بغيرها سريعا، إلا أنها تبقى خلفها إشارات دالة عليها، مثل منارات مشيرة إلى أفق الفن الحديث. غير أن الأمور تغيرت اليوم؛ فالفن المعاصر يعاني من أزمة في شرعيته، أي واحد يمكنه التحقق من ذلك، فالفنانون الحاليون مهتمون باستساغة السهولة، وبإنتاج أي شيء كان، وبتفضيل صيتهم الإعلامي على حساب الإبداع الفني، كما يتم توجيه الاتهام في صورة متكررة إلى الفن الحديث، وإلى تصوره الحلمي عن عالم محسن بفضل الفن، بوصفهما مسئولين عن الانهيار هذا.
ويتابع أن النزعة الحداثوية بعد أن قطعت مع كل تقليد وكل منزع كلاسيكي، سرعت تفكك القناعات، كما يسرت اختفاء القيم الموصولة بالجمال، والتناغم والتوازن والنظام. هكذا تكون النزعة الحداثوية قد خلفت لفناني عصرنا تركة ثقيلة، تركة مشئومة، بدليل أنها قادت مباشرة إلى موت الفن الذي جرى الإعلان عنه مرارا في السابق، من دون أن يعتبره البعض موتا فعليا، لكنه بدا حتميا في أنظارهم في أدنى الأحوال. إن أزمة تشريع الفن أصابت الفن نفسه في ماهيته، وحالت دون تسمية ما يمكن أن يكون عليه، أو ما ليس هو عليه، وما عادت تسمح بالإجابة عن السؤال الابتدائي: متى يكون أو لا يكون هناك فن؟”.
ويلفت جيمينيز إلى أن تاريخا للجمالية بات قابلا للتصور شريطة أن نحدد لهذا اللفظ معنى متوسعا: سيكون هذا التاريخ، عندها، لا تاريخ النظريات والعقائد عن الفن وعن الجميل أو عن الأعمال الفنية، وإنما تاريخ الحساسية والتخييل والخطابات التي سعت إلى إظهار قيمة المعرفة الحساسة ـ المزعومة أنها متدنية ـ مثل نقطة مقابلة للامتياز الذي حصلته المعرفة العقلانية في الحضارة الغربية. ولا جرم أن هذا التاريخ يجري، على ما يظهر، في صورة مقابلة لتاريخ العقلانية، ومع ذلك لا يكتب هذا التاريخ وفق الوجهة عينها، ولا وفق التتابع عينه، بقدر ما يرسم تاريخ العقل حركة تتابعية تتم نسبتها، ربما عن خطأ، إلى التقديم، يكشف تاريخ الجمالية، عبر التقطعات المتتابعة، بأن الحساسية ما توانت عن معارضة النظام المسيطر الذي للعقل.
ويوضح أن الجمالية “كون من الحساسية والانفعالات والحدس والشهوانية والرغبات، أي أنها ميدان يسود فيه نزاع قاهر بين الرموز وبين نسق التدوين المناسب لها، فالعمل الفني في المخيال الفردي أو العمومي، يعيش من تعدد التفاسير الممكنة، ومن الأحكام المدققة، المتناقضة أحيانا والمتغيرة، التي يستثيرها ويقول جيمينيز إن العمل الفني يخفي عناصر تاريخية واجتماعية، تتوكل الجمالية بالكشف عنها. فالعمل لا يكتفي فقط بـ “الحكم” على التاريخ، وعلى المجتمع، وفق طريقته، بل هو مرشح أيضا بدوره للتقويم والتثمين من قبل الجمهور. كما لو أنه يتكفل بإصدار حكمه، في كل مرة، على جودة المقترح الفني.
ويضيف “لا يتوافر في أي نظرية جمالية اليوم، الدليل الذي له أن يسمح في صورة لا تحتمل الخطأ بتوزيع نجوم التميز على أعمال، هي في الغالب في حال انتظار لتفسيرها. في نهاية القرن العشرين، تجد فلسفة الفن نفسها مجبرة على التخلي عن طموحها السابق؛ أي النظرية الجمالية العامة، التي لها أن تغطي عالم الحساسية والتخيل والإبداع. لا يسعنا أن نكون على الشرفة وأن نرى إلى أنفسنا مارين في الشارع، على ما قال أوغست كونت. فالجمالية، القريبة والبعيدة في آن من الأعمال، تجد نفسها في هذه الوضعية؛ وما تقوى عليه هو التأسف على أنها لا تملك موهبة أن تكون في كل مكان. فهي منغمسة في عصرها، ويجوز لها أن تفكر في إنجاز اجتماع آخر غير الذي يقترحه النسق الثقافي؛ كما يجوز لها أيضا أن تسعى إلى بلورة معايير متحررة من إلزامات سوق الفن والترويج الإعلامي والاستهلاك. إن مهمتها تشبه مهمة سيزيف.